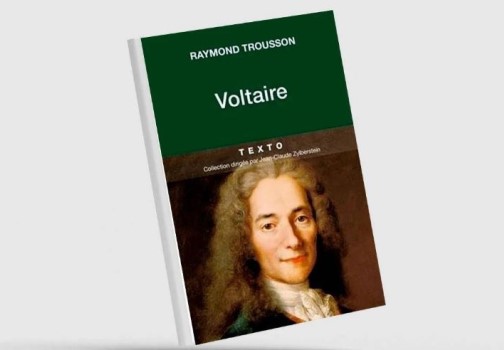قراءات نقدية
نبيه القاسم: مع د.عاطف أبو سيف في روايته "مُشاة لا يَعبرون الطّريق"

المَدخل المُثير
يضعنا الكاتب من البداية، في مُواجهة مع المشهد الذي اختاره ليكون عنوان روايته "مشاة لا يَعبرون الطريق"(الأهلية للنشر والتوزيع طبعة أولى. عمّان 2019) حيث يرتسم في مخيّلتنا مشهدٌ للعَشرات أو المئات أو الآلاف من الناس الذين يُقيمون داخل بلدة، قد تكون مدينة غزة حيث عاش الكاتب، محاطة بطريق طويلة، تشدّ بأهلها للمُخاطرة والسّعيّ لعبورها كي ينطلقوا نحو عالم جديد أكثر اتّساعا وأوفر حظا، لكنّهم إذا ما حاولوا، يجدون أنفسَهم عاجزين عن تحقيق رغبتهم، فيعودون، وقد أيقنوا أنّهم يعيشون داخل سجن كبير لا يُمكنهم الخروج منه، ليتابعوا حياتَهم بروتانيّتها المملّة وطموحاتها المحدودة.
وهذا الارتداد وافتقاد الأمل، وحتى الحلم بالأفضل، يأخذنا إلى النهاية الحَتْميّة التي هي الموت الذي "تنثر ضرَباتُ حوافره على الإسفلت دويّا صارخا يُقلق مضاجعَنا، وفي مرّات كثيرة يمرّ مرور البرق لا نكاد نتيقّن من وقوعه إلّا بعد أنْ يرحل مَن نحبّ"(ص7)، حيث لا يبقى لنا ما نتلهى به غيرُ نَدْبِ حاضرنا واستعادة أرواح موتانا الذين رحلوا، وترقّب الآتي، حيث لا بدّ وأنّه قادم، إن لم يكن في الغد، فبعد الغد.
بداية ليست من عالم السينما
اعتدنا في القصص والأفلام السينمائيّة البولسيّة على البدايات المثيرة، حيث تقع الجريمة، وتبدأ تحرّياتُ الشرطة في السّعي للوصول إلى مُرتكب الجريمة، فتأخذ بنا الأحداثُ إلى كلّ الاتّجاهات، وتتداخلُ الأزمنة والأمكنة وتتقاطعُ، وتتوالى الشخصيّات، تؤدّي دورَها المناط بها وتختفي.
لكنّ الكاتب عاطف أبو سيف لم تشده بداياتُ الأفلام والقصص البوليسية، وإنّما استمدّ بدايةَ قصّته، كما كشف في أمسية أدبية أقيمَتْ له في مدينة رام الله، من حادثة حقيقيّة حدثت معه حين أقَلّ على وجه السّرعة مُسنّا سقط أرضا دون مَعرفة السّبب من أزقّة المخيم إلى المستشفى، وهناك أصرّ الشرطي على اتّهامه بالمسؤوليّة، لولا أنّه، وبعد حين، ثبتت براءتُه حين استفاق المسنّ وقال الوقائعَ كما حدثت".
هذه الحادثة تركت أبو سيف في حالة ذهول لم يستوعبها في البداية.
فماذا كان سيحدث له لو لم يستفق الرجل المسن، ومات؟
كيف كان سيُثبت براءتَه وأنّه قام بعمل خير فقط؟
وكيف كان سيقضي السّنوات الطويلة في السجن أو يُحكَم عليه بالإعدام بتهمة قتل الرّجل المسن.
وتساءل أبو سيف: كم من بريء تَرمي به الصّدفةُ في واقعة تكون المدمّرةَ لحياته.
وأخذت خيوطُ القصّة تتشابك، وترسم المشاهد، وتستحضر الشخصيّات، وتبني واقعا مُتَخيّلا، يضيق بكثرة الناس الذين رمَت بهم نكبةٌ هجّرتهم من بلداتهم المختلفة وجمَعتهم في مخيّم ينتظرون فيه يوم عودتهم. يعيشون حياتهم البسيطة العاديّة، يسعون لتأمين الطعام والشراب لأفراد أسرهم، يخافون أنْ يفقدوا عملَهم فيما لو أغضبوا المتحكّمين بهم، السّارقين قوت أطفالهم باسم الوطنيّة والنّضال والاستعداد لليوم الموعود.
حقيقة لا لبس فيها، أنّ حياة الواحد منّا، طالت أم قصُرَت، تتوزّع على عالمين لا ثالث لهما: عالم الواقع المعيش الذي نحياه بحواسّنا الخمس. والعالم المتخيّل الذي نحلم به طمَعا في حياة أفضل، أو نخافه لأنّه يُهاجمُنا على شكل كوابيس مُرعبة تشلّ إرادتَنا، وتوقعنا في مَطبّات مجهولة ومُعاناة وعذابات.
ويقيني أيضا، أنّ كلّ عالَم مُتَخَيّل ينطلق من الواقع المعيش الذي نعملُ على تَغييره، فنعيش ساعات البُعد والحريّة والانطلاق لنعودَ بعدها إلى حيث كنّا، نتفقّدُ أحوالنا، ونراودُ أحلامَنا، وننطلق بخيالنا.
هكذا انطلق عاطف أبو سيف من الواقعة التي حدثت له مع الرجل المسنّ الذي سقط أمامه، وقام بنَقله إلى المستشفى، ليُواجَهَ هناك بتهمة التّسبّب في سقوط المسن. ليبني عالما متكاملا يرويها في قصّته "مُشاة لا يَعبرون الطريق".
"مرّت الشّاحنة سريعة عند المنعطف. كان يجرّ درّاجتَه الهوائيّة القديمة، يكاد يعبرُ الشارع حين صدَمته الشاحنة. وقعَ أرضا. ندّت عنه صرخة خفيفة. عجلاتُ الدّراجة الهوائيّة ظلّت تدور بوَهن بعد أن ارتمت على وجه الإسفلت. لم تتوقّف الشاحنة أكثر من عشرين ثانية ثم واصل السائق اندفاعَه في الشارع، كأنّ شيئا لم يحدث. ثم كأنّه انعطف عند نهاية الشارع شرقا إلى الضواحي المجاورة. مشهد بسيط لكنّه حدَث بتَعقيد كبير."(ص9)
هذا المشهد الكامل الذي حدث، افتتح به الكاتب روايتَه ليتابعَ في عالمه المتخيّل رسمَ المشاهد وبناءَ قصّته المتكاملة.
وطبيعي أنْ يثيرَ هذا المشهدُ مَن تَواجد صدفة في المكان. وبالفعل سارع صاحبُ دكّان الفاكهة القريب لمساعدة المسن، ومثله فعل السائق الذي مرّ، والفتاة الجامعيّة التي نزلت لتوّها من الباص، حيث قاموا بإدخال الرجل المسن إلى السيارة التي نقلته إلى المستشفى.
لم يستغرق الحدَثُ وقتا طويلا. ولم يُثر اهتماما كبيرا. فالحياة مستمرّة والناس يُتابعون حياتَهم الاعتياديّة:
"طفل صغير، يمرّ صدفة، استغل عدمَ وجود الفاكهاني في دكّانه فتناول حبّة خوخ وأكلها غير عابئ بكلمات التأنيب التي يقذفه بها بائعُ الترمس والفول. شابّ يجلس على شرفة يُدخّن نرجيلة بطعم التّفاح، رأى المشهد كاملا ولم يُحرّك ساكنا. بائع في الثلاثينات من عمره يجرّ عربة ترمس وفول نابت. امرأة خمسينيّة تجرّ طفلها متأفّفة من الحرّ. تلاميذ مدارسَ يخرجون من الشارع الذي تقع فيه مدارسُهم. باص يتوقّف في المحطة لتنزلَ منه طالبة جامعيّة. ثلاث صبايا يدخلن محلَّ الموبايلات الذي افتتح حديثا. رائحة الدّجاج المشوي تفوح من داخل المطبخ الكبير على مَدخل أحد الأزقّة. من فوق سطح يقف طفل لم يتجاوز العاشرة يُطلق العنان لطائرته الورقيّة تحمل أحلاما كثيرة لتسافر بها إلى فضاء آخر. صوت الأم يحذر ابنَها من السقوط. تطير الطائرة الورقيّة سارحة في السّماء الواسعة شمالا. الأعينُ الكثيرة تشخص نحوها محلّقة في مساحات لا مُتناهية. الطائرة الورقية تبدو وكأنها تستقرّ فوق المستشفى الذي تمّ بناؤه حديثا على التلّة شمالي المخيم حيث ستَنقل السيّارة الرجلَ العجوز الذي دهسته الشاحنة"(ص10-12).
هذه المشاهدُ العاديّة لحياة الناس اليوميّة غير المبالية لوقوع هذا الحدَث أو ذاك، فكلٌّ مَشغول بهمومه الخاصّة. والأحداثُ العارضة تمرّ سريعا، لا تترك أثرا لها.
كان من الممكن أنْ تنتهي القصة بإدخال المسن إلى المستشفى، ونُتابع مشاهدَ الحياة الروتانيّة للناس. الدّالّة على استمرارية الحياة العاديّة.
لكنّ الكاتب عاطف أبو سيف عاد لتجربته الخاصّة، واتّهام الشرطي له بالتّسبّب في سقوط الرجل الذي نقَله إلى المستشفى لينطلق في عالمه المتَخَيّل، ويتغلغل في دواخل الشخصيّات التي استحضرها، ليكتشف سرّها وطُرقَ تفكيرها وعوالمها السريّة التي لا يعرف حقيقتَها غيرُها.
"أمام باب قسم الطوارئ في المستشفى التَمَّ المارّةُ والزوّار حول السيّارة ليساعدوا في نَقل الرجل إلى الدّاخل. الجميعُ يهتم لمعرفة ما حدَث: ما الذي حدث؟ ما له؟ حادث؟ شجار؟ هل اعتدى عليه أحد؟ أين عائلته؟ مَن قريبُه؟ معقول لا أقارب له؟ هل من قريب هنا لهذا الرجل؟ معقول أنّ الرجل نزل من الفضاء؟ مَن اللعين الذي حاول قَتْل الرجل؟ لكن أين أهله؟ لا بُدّ أنّ له ابنا أو بنتا أو زوجة أو أخا أو أختا. مقطوع من شجرة؟ لا بُدّ أنّ سائق السيارة الذي أحضره يعرف؟ أين سائق السيارة؟"(ص13-14).
الجلبة التي حدثت عند وصول الرجل المسن إلى المستشفى، واهتمام كلّ مَن صدَف وجوده بالحدَث، انتهت بمجرّد أن أُدْخِل الرجلُ إلى المستشفى، فتفرّق الناس، كلّ إلى همومه، وانحصر الاهتمامُ بالرّجل بين الذين أحضروه والصّحفى الذي يريد كتابة تقريره عن الحادث، والممرّضات والطبيب. ثم سرعان ما أصبح الرجلُ حالة طبيعيّة بالنسبة للممرّضات والطبيب. وظلّ الاهتمامُ به ينحصر في السائق وبائع الفاكهة والطالبة الجامعيّة والشرطي الموكل على الأمن والصحفي.
فَنيّة الكاتب الذّكيّة
استمرار الرجل المسن في غيبوبته أخرجَه من مركز الأحداث، وحوّله لينحصر في كونه نقطة الارتكاز الحياديّة التي يلتقي الجميع حولها. ممّا أتاح للكاتب أن ْينطلق في غَوْر ذاتيّة كلّ شخصيّة على حدَة ليكتشف المشترك بينها ويقفَ على الخاصّ بكلّ منها.
الصفة المشتركة البارزة التي جمعت بينهم، وحتى مع باقي الناس المّارّة والمتجمّعة في الشارع، حيث سقط الرجل المسن، والناس المتواجدين أمام المستشفى والممرضات والطبيب، كانت الناحية الإنسانيّة الدّافعة بالواحد ليكون إلى جانب الضّعيف والمريض والمصاب ليمُدّ له يدَ المساعدة المطلوبة. لكنّها حالة عابرة، سرعان ما يرتدّ الواحدُ عنها ليعتني بمشاغله ومتطلّبات حياته. وأيضا هذا الارتداد هو حالة إنسانيّة تفرضها رغبةُ كلّ واحد في استمرار حياته وتجاوز الصّعاب فيها. وهذا ما حدث بالفعل حيث عاد الفاكهاني إلى دكّانه، والسائق إلى عمله، والطالبة إلى جامعتها، والشرطي لمزاولة عمله المناط به، والصّحفي ليكتب التقريرَ المطلوب منه للجريدة. رغم أنّ حالة الرجل المسن لم تغب عن أيّ منهم، وظلّت تدفعهم لزيارته والاطمئنان عليه.
الصّفة المشتركة الثانية التي جمعت بين الجميع هي الشّك. فسَعْيُ كلّ منهم لمعرفة ما حدث للرجل، وكيف أصيب وسقط، أدْخَلت كلا منهم في دوّامة مُقلقة مخيفة، جعلت الواحدَ يشكّ في الثاني، والجميع يشكّون ببعضهم البعض، ويُطلقون الاتّهامات في كثير من الحالات بصوت عال وواضح. كما حدث بين السائق والشرطي "انفجر السائق في وجه الشرطي: أنت تشكّ؟ ونحن نشكّ فيك أيضا. نعم نحن نشكّ فيك. أنت تشك في كلّ شخص، تريد أن تحرف الحقيقة لأنّك تعرفها، أو لأنك فعلا جزء منها. لماذا تكون بريئا ونحن كلّنا متهمون؟ تعتقد أنّنا لا نعرف الحقيقة. الحقيقة أنّنا كلّنا متّهمون، وأنت متّهم أيضا. لماذا أنت وحدك بريء؟"(ص145).
والشكّ صفة إنسانيّة أيضا، فيها الجوانبُ الإيجابيّة التي تجعل الواحدَ لا يقتنع بما هو عليه، ولا يقبَلُ بالمسلّمات، ويريد تَغيير كلّ شيْء للأفضل، ويدفع الواحد للبحث والتّنقيب والعمل. وفيها السلبيّة التي توتّر العلاقات بين أقرب الناس، وقد تُدمّرُ حيوات الكثيرين، فتمزق الأسرَ والمجتمعات، وقد تؤدّي إلى الفوضى والعِداء.
وهذا ما حدث لجميع الشخصيّات التي التقت عند الرجل المسن الغائب في غيبوبته الطويلة، فكل واحد يشكّ في الثاني بأنّه وراء الجريمة التي حدثت، وكلّ واحد يعتقد أنّ الثاني يريد التّستّر على ما قام به، مُلقيا التّهمة على الآخر. ومع كل رواية جديدة تغيب الحقيقة أكثر، ويظلّ الرّجل في غيبوبته.
لم يشأ الكاتب أنْ يقفَ بنا عند شكّ الواحد في الثاني، وينهي الحكاية بهذه الحالة المرفوضة، وإنّما انطلق من فكرة أنّ حياة الواحد موزّعة، كما قلت سابقا، بين عالمين: عالم الواقع والعالم المتخيّل. وهما مُتداخلان في حياة كلّ إنسان. وانطلاقُنا من واقعنا لنُحلّق بالمتخيّل قد يُخلّصنا من جمودنا وافتقار إبداعنا لننطلقَ بالمتخيّل الذي يفتح أمامنا عوالمَ لا نهاية لها، وآفاقا تدفعُ بنا أكثر وأكثر.
وإذا كان الشرطي يُمثّل الغَباء برغبته في إرضاء المسؤول عنه الذي لا يقلّ عنه غباء، وهمّه فقط إثبات التّهمة وإلصاقها بأيّ واحد ليبرز موهبته وقُدُراته أمام المسؤولين عنه. فإنّ السائقَ والفتاة وحتى الفاكهاني يريدون التخلّصَ من شكّ الشرطي بهم باتّهام الغير. والحقيقة التي يعرفها، ورصدَها الشاب الذي كان يجلس في الشرفة بأنّ الشاحنة لم تصدم الرّجل المسن، وأنّه سقط وحده، ظلّت مَخفيّة، لأنّ أنانيّتَه، وقد يكون تخوّفُه من التّورّط في التّحقيق معه، دفعاه لالتزام الصمت، وعدم الإدلاء بمعلوماته لأحد.
هذه الحقائقُ الواقعيّة التي أبقت أصحابَها في دوّامة من الضّياع، كانت بحاجة لمَن يتحرّر منها ليخرجَ الجميع من دوّامتهم. وكان صوتُ المحرّر صاحب الصحيفة الدّافع لهذا التّحرّك. "القصّة الحقيقيّة ليست فيمَن حضر، بل فيمَن غاب. الغائبون هم الذين يصنعون الحكايات الحقيقيّة. فالقاتل غائب، كما أنّ أهل الرجل غائبون" (ص76).
والتقط الصحفيّ الإشارة الذكية من المحرّر، وفكّر: "عالم الغائبين، هو العالم الذي عليه أنْ يقومَ بصياغته، وخَلق حكاياته. من المؤكّد أنّ عالَمَ الحاضرين حول السّرير مليء بالقصص، أمّا البطل الحقيقيّ للتّقرير، الذي عليه أنْ يُبرزه، أيّ الرجل العجوز، فهو الغائبُ الأكبر في الحكاية. الحكاية والبطل توأمان عادة، لكن في هذه الحالة فثمّة حكاية بطلُها غائب. ومهمّته الكبرى يجب أنْ تكون خَلق عالم خاصّ بالرّجل العجوز. تخيّلُ حكايته الخاصّة، وافتراضُ وجود هذا العالم وتلك الحكاية، وتأسيسهما وفْق منظومة علاقات من الأشياء التي تتوفّر في مَتْن الحكاية، وتأثيثهما بكلّ ما تمّ العثور عليه على قارعة الحكاية."(ص77).
هكذا أخذت القصّة المتَخيّلة تنبني انطلاقا من "صورة بالأسود والأبيض لشابّة جميلة وُجِدَتْ في محفظة بنيّة اللون، احتفظ بها الرجل. ودرّاجة هوائيّة قديمة. ثلاثة أشياء لا بُدّ أنْ تصلحَ لكتابة قصّة حياة الرّجل العجوز.". (ص 77)
القصّة المتَخَيّلَة
صورة الشّابّة الجميلة التي وُجِدَت في المحفظة كانت بدايةَ الانطلاق في بناء القصّة الكاملة. فلا بدّ أن تكون صاحبةُ الصورة عشيقةَ الرّجل، حيث احتفظ بها كلّ هذه السّنوات الطويلة. هكذا افترض الصّحفي في قصّته المتخيّلة. "فالحبّ هو الشيء الوحيد الذي لا يذوي في حياتنا. نشيبُ، وتوهن أجسادنا، ويفتك الزمن برغباتنا، وتدوس عرباتُه أحلامَنا، لكنّ الحبّ يظلّ فتيّا في القلب. له نفسُ إيقاع النّبضة الأولى، دهشةُ الرّوح ذاتها، وارتعاشةُ الجسد نفسها حين يخطر على بالنا مَن نُحبّ. فأجملُ ما في الحبّ هو إصراره على البقاء، على عبور الزمن، على التّعبير عن نفسه في أشدّ اللحظات قسوة، مقدرتُه على مَدّنا بأكسجين الأمل. لذلك فمَن نُحبّ يظلّ شابّا، فالعشّاق لا يشيخون، لا تدوس أرواحَهم عربةُ الزّمن". (ص78)
واختار اسمَ "سلوى" للفتاة لتتجسّدَ حقيقةً ملموسة. كلاهما من مدينة يافا. التقيا صدفة في أحد نهارات نيسان من العام 1946، كانت عائدة من مدرسة "حسن عرَفة" الثانوية فيما كان هو عائدا من مدرسة "العامريّة". وقف مثل مَن صَعَقته الكهرباء أكثر من دقيقتين دون أنْ يرمش. ظل يُحَملق إليها وهي تخطو مثل طاووس بين صديقاتها. وتطوّرت العلاقة بينهما، وتقاربت الأسرتان، وانتهزا فرصةَ التقاء العائلتين في سهرة من ليالي يافا الرّائقة ليختليا معا، ويخطفا قبلة سريعة، لا يُفارقُه مذاقُها طوالَ العمر. أمِلا بالزّواج بعد انتهاء دراسته في الكلية العربية في القدس والحصول على شهادة "المَتْرك". وكانت سلوى في وداعه ساعة سفَره إلى القدس، وظلّت تلوّح له بيديها والدّموع تُغطّي وجنتيها حتى اختفت الحافلة.
وحدث ما لم يكن مُتوقّعا. وقعت النّكبة. واحتلّ اليهود مدينة يافا وطرَدوا أهلَها العرب، فتشتّتت العائلاتُ. وحملت النّكبةُ عائلتَه إلى مدينة غزّة فيما كان هو في القدس. وفقط بعد ستة أشهر نجح في الوصول إليهم. لم ير محبوبتَه سلوى منذ لقائهما الأخير، ولم ينجح في العثور عليها أو معرفة أيّة معلومة عنها. ظلّ عمره كلّه ينتظرها. رفض كلّ العروض التي قُدّمت له للعمل، وفضّل أن يعمل ساعيا للبريد عَلّ رسالة منها تصله. مرّت السنوات وقارَبَ الثمانين من عمره وهو ينتظر، حتى جاءه خبرٌ من صديقه حبيب بأنّ أخبارا جديدة ومُفرحة من سلوى سيُفاجئه بها. وغمَره الفرحُ مرّة واحدة، استعدّ للقاء سلوى، صفّف شعره ، رتّب هندامَه نزلت دمعة ساخنة على خده، رشّ العطرَ على جسده، فكّر باستئجار سيارة توصله إلى بيت صديقه حبيب، لكنّ نظرته الخاطفة إلى درّاجته أعادته إلى صوابه. فهي رفيقة عمره في انتظاره لسلوى والبحث عنها. احتضن الدرّاجة الهوائيّة، شعر أنّه يستعيدُ شبابَه، اعتلاها وقادها شاقّا زقاقات المخيّم صَوْبَ بيت صديقه حبيب، حيث تنتظره، كما كان متأكدا، محبوبتُه سلوى. ، لكنّه وقد اقترب من الشارع الرئيس، نزل عن درّاجته من شدّة الازدحام، وتقدّم يجرّ درّاجته نحو الشارع، وإذا بالشّاحنة اللعينة تصدُمه، فسقط ودخل في غيبوبة طال أمدُها، وحرمته من الوصول إلى بيت صديقه حبيب واللقاء بمحبوبته سلوى. وكانت النهاية بأنْ عادت سلوى إليه، كما أمِلَ طوال سنوات عمره، حضرت إلى المستشفى "فتحت البابَ ودخلت. كانت عتمة تسحب عباءتَها عن الغرفة. وضعت يدَها على رأسه فأفاق من الغيبوبة على اللمسة التي ظلّ ينتظرها عقودا وعقودا. ترَجّل ونهضَ عن السرير مثل شمس تُشرقُ من بين تلال الغيوم. كأنّه كان ينتظرها، فتح عينيه وملأهما بحضورها في قلبه الثمانيني. وعاد طفلا يلهو في أزقّة يافا". (ص203)
مُواجهة المستسلمين الخانعين
كنتُ على ثقة، ولا أزال، أنّه لا وجودَ لإبداع حقيقيّ إذا لم يرتكز إلى واقع قائم، نتعايشُ معه بكل علّاته وفَضائله، ويتطلّع إلى واقع افتراضيّ يرسمُه له الخيال، يعمل على تَحريره من قيود الواقع المعيش المقَيِّد، ويأتي بالأفضل.
ومن هذا المنطلَق، كما أعتقد، أدخلَنا الكاتبُ في روايته إلى هذين العالمين ليوقفنا على الأخطار التي تتهدّدُ الناسَ الذين عاشوا وناضلوا وضحّوا لتحقيق أمل، حرصوا عليه عقودا وعقود، وبدأ يتوارى ويُغلّفُه الإهمال، وحتى النسيان، أمام هموم الناس اليوميّة، ولا مَعْقوليّة، ولا مُبالاة العالَم القريب والبَعيد، وتَحميل كلّ واحد لغيره مسؤوليّة الذي يحدث.
فالرجل المسن المقتربُ من الثمانين عاش عمره كلّه، رافضا أيّ عمل يُبعده أو يلهيه عن هدفه الوحيد في البحث عن محبوبته والوصول إليها والتّوحد معها. وفضّل العملَ ساعيا للبريد، يُوزّعُ الرّسائلَ إلى أصحابها وهو يقود عربتَه الهوائيّة. بينما باقي الناس أخذتهم المشاغلُ اليوميّة. منهم مَن أغرتهم المناصبُ والسّلطة فاتّخذوها وسيلةً للوصول إلى الغِنى والتّحكّم برقاب الناس ومَصائرهم. ومنهم مَن انشغل بهمومه العائلية الضيّقة البائسة، فلم يفكّر بغيرها. ومنهم مَنْ زاول حياته العادية اليومية فارتاح إليها، واختار هَدْأةَ البال على مُواجهة الصّعاب ومخاوف الموت والإبْعاد والسّجون. فتركوا أحلامَهم الكبيرة وعزَفوا عن العمل لتَجسيدها.
ووحده مَن عانى من تضاؤل تَعاطفِ الناس معه، والاكتفاء بالكلام المعسول المخادع، وشهد انحدارَ الجميع في خوضهم صراعات البقاء فيما بينهم، كلّ يشكّ بغيره ويُباعِده ويُعاديه ويعمل على إضعافه، وحتى مَحوه من الوجود. والرجل تُرهقُه السنواتُ الطويلة وهو يرفض الاستسلامَ، ويتشبث بالأمل والإيمان بأنّ محبوبتَه ستعرفُ الطريقَ إليه وستأتيه ليبدآ حياة جديدة سعيدة.
قصص جانبيّة ولَسَعات قد تُنبّه
كما في كلّ رواية، انطلق الكاتبُ ليتابعَ قصصَ الشخصيّات الأخرى التي تُحيط بالشخصيّة المركزيّة، لدورها المهم في بناء الجسم الكامل للرواية التي تُصوّرُ عالما مُتكاملا تنبضُ فيه الحياة، وتتفاعلُ الشخصيّات، وتتهادى الأمكنة، وتتزاحمُ الأزمنة.
لكنّ المثيرَ أنّ كلّ الشخصيّات مشغولةٌ بأمورها الخاصّة وحاجيّاتها اليوميّة غير مُنتبهة أو مُهْتمّة بالشّأن العام أو واضعة أمامَها هدَفا تسعى للوصول إليه. فالناس العاديون أمثال السّائق وبائع الفاكهة يهمّهم تأمينَ لقمة العيش لأفراد أسَرِهم. والشرطي الذي شارك في الانتفاضة واعتُقل خمسَ سنوات، وفرح يوم التقى الرئيس ياسر عرفات الذي كان يُخبّئ صورتَه في السجن ويرسمُه على الورق، أصبح العبدَ المطيعَ المنافقَ الساعي لنَيل رضا الضابط المسؤول عنه، ولا يفكّرُ بغير رضاه ليضمنَ لنفسه استمراريّة الوظيفة وتأمين مستقبل الأسرة. والطالبة الجامعيّة رغم لفتتها الإنسانيّة ومساعدتها للرجل المسن إلّا أنّ شغلَها الشّاغل في التفكير بحبيبها الذي تركها، وتعملُ جاهدةً لاستعادته ونَيْل رضاه، بينما هذا الحبيب تركها لأنّه غير راض عن تصرّفاتها. وهو شاب أنانيّ غير مهتم بكل ما يدور حوله، ويجري أمامه، فهو جَبانٌ لا يُواجِهُ، ويُؤْثرُ السّلامةَ على تَعْريض نفسه للخطر. والصّحفيُّ يُسايرُ رئيسَ التّحرير ويقبل بنصائحه ويجتهد ليكتب التّقرير الأفضل. ومنهم مَن انقلبَ على ماضيه النّضالي، وتسلّق سلالمَ السلطة الدينيّة والدّنْيَويّة، فتحكّم َبرقاب الناس، وظلمَهم، واستغنى على حسابهم باسم الوطن والنّضال.
عالم افتراضيّ هو أقربُ إلى الواقع المَعيش
في روايته "مُشاة لا يعبرون الطّريق" اهتمّ الكاتبُ عاطف أبو سيف أنْ ينقلَ لنا الصورةَ الحقيقيّةَ للواقعِ المأساويّ اليوميّ الذي يعيشُه الشّعبُ الفلسطيني في الأراضي المحتلّة. وقد اجتهد أن يُقدّم، بهدوء وبعيدا عن الصراخ والشعارات المعتادة، صورة بانوراميّة لمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة نتيجة لثقل نير الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة وحرمان أبناء غزّة من المَخارج الجويّة والبحريّة والبريّة، إضافة إلى ثقل وظلم حكم المتسلّطين على الحكم في غزّة وانفلات الفئات الاستغلاليّة الانتهازية التي تلتهم أموال الناس، وتغنى على حساب الفقراء باسم النضال ومحاربة المحتل. فالشعب الفلسطيني يعيشُ حياةً باهتة، فارغة، عبثيّة، حالمة، غافلة عمّا يحدُث ويُنَفّذُ يوميّا. ويشهدُ انحسارَ الوطن، وافتقاده، وضياعَه، ولا يملك القُدرةَ على التّصدّي والمواجهة. يعيشُ حياة يتهدّدُها الخَرابُ، كما قال النّاقد فيصل درّاج "الممتدّة من متزعّم تآلف مع "الأنْفاق والمولات"، إلى مواطن بسيط هاجسُه "تأمين الأولاد" ومناضل قديم يوغل في التنازل يُفاخرُ بأنّه لا يتنازل، وصولا إلى فتاةٍ يقهرُها إخوتُها وأبٍ ينتظرُ زيارة ابْنٍ بَعيد، ومعلّم شبه أميّ غدا مسؤولا تربَويّا عالي المقام، وإنسان فاسد حافظ على امتيازاته في أزمنة غزة جميعا".(مجلة الكلمة.عدد 151 نوفمبر 2019)
نهاية الكلام
"مشاة لا يَعبرُون الشّارع" ليست مُجرّد رواية تُضاف إلى عدَد الروايات التي صدرت قبلها، وإنّما هي صَرخةٌ عالية، يوقفُنا بها الكاتبُ على الهُوَّةِ السّحيقة التي تنتظرُ الشعبَ الفلسطيني فيما لو ظلّ على حالِه مِنَ الاتّكاليّة والأنانيّة والانشغال بالصّراعات والعَداوات والهموم اليوميّة التي تُثقل كاهلَه.
في مجتمع يعيشُ حالةَ اغتراب، فقَدَ بوصلتَه، وضَيّع هدفَه. ومع شعب يُعاني تحت الاحتلال، يبحث عن طريق خَلاصِه، تصدرُ روايةُ عاطف أبو سيف "مُشاة لا يعبرون الطريق" لتصرخَ مُنبّهةً ومُثوّرةً ومُحذّرةً أنّ الاستمرارَ في المشي البطيء مرفوضٌ في زمن السّرعة الفَوْق ضَوئيّة اللامَعْقولة. والقُبولُ بالطّريق المسْدودة الملتفّة حول الأعناق، لم تَعُدْ بالقَدر المحتوم المرضي عنه. والعبورُ لم يَعد اختيارا، وإنّما هو فَرْضٌ حَتْميّ لحياة كريمة حرّة.
ولحرص الكاتب على تَثْبيت إيمان أبناء شعبه بمستقبلهم يرسمُ، من البداية، المشهدَ الذي يبعث الأملَ، ويُطمْئنُ على المستقبل الآتي مهما بعُد، "مَشهدَ طفل لم يتجاوز العاشرة، يقف فوق سطح البيت، يُطلقُ العنان لطائرته الوَرَقيّة، تحمل أحلاما كثيرةً لتُسافرَ بها إلى فَضاء آخر. تطيرُ الطائرةُ الورقيّةُ سارحةً في السّماءِ الواسعة شمالا، تَشْخَصُ نحوَها الأعْينُ مُحَلّقة في مساحات لا مُتناهية، لتستقرَّ أخيرا فوق المستشفى الذي تَمّ بناؤه حديثا على التّلّة شماليّ المخيّم، حيث ستقلُّ سيّارةُ الأجرة الرّجلَ العجوزَ الذي دهسته الشّاحنة". (ص12)
***
د. نبيه القاسم - الرامة - فلسطين