قراءة في كتاب
عدنان حسين أحمد: الجندرية والمِثلية والبِغاء (2-2)
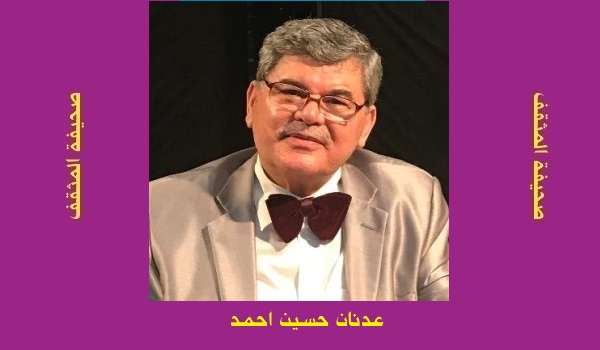
فن الحوار الصحفي الذي قَلَبَ الصورة النمطية عند المتلقّين
خصص الدكتور قاسم حسين صالح الفصل الرابع للدين وناقش فيه العديد من الموضوعات من بينها مواصفات الحاكم ونموذج الپاپا وشخصية السيستاني وأربعة علماء نفس واجتماع مشهورين. يعتقد الباحث أنّ كثيرين هم الذين تحدثوا عن مواصفات الحاكم من بينهم المفكر السياسي جون لوك والفارابي إلّا أنه يعتبر الإمام علي أفضل من حدّد قيم الحاكم وسلامته النفسية والعقلية والجسدية في تاريخ الإسلام من خلال دراسة تحليلية لنص "عهد" الإمام علي لمالك بن الأشتر في كتاب "نهج البلاغة" وشدّد على أهمية أن يتمثل الحاكم بالقيم الإيجابية في شخصيته بوصفه قدوة تتماهى به الرعية وتقلّده. وأن تكون هذه القيم هي الرابط الذي يوحّد أفراد المجتمع وتَحُول دون تمزيق نسيجه الاجتماعي الذي يفضي إلى إشاعة الكراهية والعنف والعدوان. وقد حدّد الإمام علي المواصفات النفسية والعقلية للحاكم بمفهومها الحديث واشترط توافر الضمير لدى الحاكم وقد خاطبه بكلام واضح وصريح:"لا تكونن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم .." ويُثني الباحث على مقولة الإمام عميقة المعنى بأنّ "الناس صنفان: إمّا أخٌ لكَ في الدين، أو نظير لك في الخلق"(ص156). يعتقد الباحث أنّ القيم التي شاعت في عهد حكم أحزاب الإسلام السياسي وما بعدهما هي الضدّ النوعي الذي دعا إليه إمام سلطة الحق.
تناول الباحث في هذا الفصل أنموذجين دينيين وهما الپاپا فرنسيس والسيستاني؛ فالأول يختلف عن سابقيه لأنه يتعاطف مع الفقراء والمساكين أيًا كانت ديانتهم كما أنه ضد السلطات القمعية التي تضطهد شعوبها لذلك استقبله العراقيون بمحبة كبيرة ووجدوا فيه مصدر فرح للجميع. تضمّنت زيارة الپاپا إلى العراق ثلاث رسائل مهمة جدًا: الأولى تؤكد على مرجعية النبي ابراهيم ودعوته إلى التعايش بين الديانات السماوية الثلاث، وتضامنه مع مسيحيي العراق الذين لم يبقِ منهم سوى 400 ألف من أصل مليون ونصف المليون مسيحي عراقي، والثالثة تشتمل على لقائه بالسيستاني الذي يمثل رأس المرجعية الشيعية في العراق. يختم الباحث هذا الفصل القصير بموقف فريقين متضادين من أشهر علماء النفس والاجتماع وهم "فرويد، وإريك فروم، ويونغ وفرانكل". ومن يتوخى المزيد من الفائدة فعليه قراءة هذا الكتاب الجامع المانع.
فن الحوار الصحفي
ينتمي الفصل الخامس من هذا الكتاب إلى فن الحوار الصحفي الذي يقْلب الصورة المُعتادة عند المتلقين أو يُغيّرها في أقل تقدير. كما تصطف المقالات الأخرى إلى ما يُحاذي الاستذكارات أو السير الذاتية للأدباء والأصدقاء الحميمين فكريًا وإنسانيًا. تناول الكاتب والناقد قاسم حسين في هذا الفصل ثماني شخصيات ثقافية وفنية يعْرفها القارئ العراقي والعربي إلى حدٍ ما وهي على التوالي: مظفر النوّاب، جاسم المطير، عفيفة إسكندر، يونس بحري، خالد الشطري، كامل شياع، مظهر عارف وحِسَب الشيخ جعفر وغالبيتها شخصيات إشكالية واستثنائية كما يعرف القارئ الكريم. فالمقال الأول يحمل عنوان "مظفّر النوّاب .. من زنزانة السجن إلى مقهى "هاڤانا" يُذكِّرنا فيه الكاتب بأن علاقته بمظفر النوّاب تعود إلى ستينات القرن الماضي يوم جاءهم من "نقرة السلمان" إلى سجن بغداد المركزي فضيّفهُ الراوية في زنزانته التي تضم مُكرّم الطالباني والمقدم عبدالنبي، قائد قوات المظليين ومدير الخطوط الجوية العراقية. وفي عام 2008 سوف يلتقي الدكتور قاسم حسين بمظفر النواب لقاءً حميمًا في مقهى "هاڤانا" بدمشق ويحاوره حوارًا مطولًا سوف يظهر لاحقًا في كتاب. كما أهداه في هذا اللقاء كتابه المعنون "المجتمع العراقي" ووثّق اللقاء بصور الموبايل الذي اشتراه بمبلغ 250 دولارًا وهو ثلث المبلغ الذي كان يحمله في تلك الزيارة.
الهروب الجماعي
أما الكاتب الثاني فهو الباحث الاقتصادي والسياسي والقاص والروائي جاسم المطير الذي رحل عنا سنة 2023 في منفاه الهولندي فقد استذكره الدكتور قاسم حسين من خلال مقال كتبه الراحل بعنوان (الدكتور قاسم حسين من ركّاب "سفينة الشاعر مظفر النواب") يتحدث فيه عن عملية هروبهم الجماعي من سجن الحلة وقد أثنى الراحل على شعرية النواب ومواقفه النضالية المشهودة كما أشاد بالجهود العلمية لعالِم النفس د. قاسم حسين. ومن يحب الاستزاده عليه بالرجوع إلى هذا الكتاب أو المقال المُشار إليه سلفًا والمنشور في أكثر من موقع وصحيفة عراقية.
ومثلما أشعرنا الباحث بالجو العاطفي الذي تهتز له الأبدان في لقائه بالنوّاب فإن لقاءه بأيقونة الطرب العراقي الفنانة عفيفة إسكندر يثير الشجون لجهة المعلومات الجديدة التي كشفها عن والديّ الفنانة وعن حياتها الشخصية والعاطفية على وجه التحديد. فقد كانت عفيفة متزوجة من إسكندر اصطيفان الذي كان يكبرها بأربعين سنة ومنه أخذت هذا اللقب.
أمّا عن قصة حبها للشاعر المتمرد حسين مردان فقد تبيّن "أنه حُب من طرف واحد .. وأنها لم تكن تحبه لشخصه وإنما تحب فيه الشاعر المتمرد الجريء"(ص 190). وقد كشفت في هذا الحوار الذي يعود إلى سنة 1972م أنها تحدّرت من أبٍ أرمني وأم يونانية وأنّ والدتها كانت تعزف على أربع آلات موسيقية وأنَّ والدها كان مُغنيًا أيضًا. تكمن أهمية هذا اللقاء في أنّ المُحاوِر قد عزف على أوتار جديدة لم يلامسها أحد (آنذاك) وقلبَ الصورة النمطية عنها في أذهان العراقيين الذين يحبونها ويتابعون منجزها الغنائي.
المُلاحظ أنّ غالبية موضوعات هذا الفصل إشكالية ومثيرة للجدل ولعل اختياره للحديث عن يونس بحري ومواهبة المتعددة ككاتب، وصحفي، وإذاعي، وسياسي، ورحّالة، وصديق للأمراء والشيوخ والملوك، ومارشال في الجيش النازي، ومُقرّب من هلتر، والناطق الرسمي باسم الملك غازي، ومذيع بإذاعة الزهور تثير الفضول لدى القارئ وتدفعه للتعرّف على هذه الشخصية التي تبدو غريبة وعجيبة وأسطورية في الوقت ذاته. فعدد زوجاته كما يذهب المؤلف بحدود المئة شرعيًا، وبحدود المئتين مدنيًا ومن جنسيات مختلفة. وقد أنجب الكثير من الأولاد لكن عائلته الموصلية تتألف من ثلاثة دكاترة وهم لؤي وسعدي ومنى، زميلة الكاتب السيكولوجية التي صرحت في لقاء لها بأنها لا تعرف عن والدها سوى "تناتيف" مع أنّ شهرته طبقت الآفاق.
لا تختلف حياة الشاعر خالد الشطري عن كثير من الشعراء الوطنيين في العراق وكأنّ السجون المُشرعة الأبواب في مدن العراق كلها تنتظرهم على أحرّ من الجمر لأنهم يؤمنون بالكلمة الحُرة، والفكر التقدمي الذي وفدت شرارته من خارج الحدود. لم يكمل خالد تحصيله الدراسي لكنه بالمقابل كان موهوبًا في كتابة الشعر، فثقّف نفسه بنفسه والتهم العديد من الكتب التي شحذت قريحتهُ، وفتحت ذهنه، وطوّرت ذائقته الأدبية والفنية. ومثل العديد من أقرانه السياسيين وُجهت له التهمة بالانتماء إلى الحزب الشيوعي العراقي التي أدخلتهُ إلى سجن "نقرة السلمان" حيث أمضى سنتين ثم نُقل إلى سجن الكوت وسجن بغداد المركزي حتى انتهى به المطاف سنة 1992م إلى سجن مديرية الأمن العامة بتهمة التهجّم على رئيس النظام فخرج فاقدًا للذاكرة ليغادرنا إلى الأبد بعد أقل من ثلاثة شهور!
لا أحد يشك في موهبته الشعرية وقد وصفهُ الشاعر محمد حسين آل ياسين "بالشاعر المظلوم نقديًا وقرائيًا ولم يُعطَ حقه حتى الآن دراسة وكشفًا ووقوفًا على إبداعه الجميل"(ص 199).
عاشق الثقافة والوطن
تنطبق مقولة "لكل امرئ من اسمه نصيب" على الكاتب الراحل كامل شياع، فهو كامل في أخلاقه وسلوكه ودماثة خلقه الرفيع. ولعل ما قاله الدكتور قاسم حسين بحق كامل شياع صحيح تمامًا ويشفي الغليل. فهو بحق "عاشق الثقافة والوطن" في آنٍ واحد. وقد عاد إلى العراق لكي يؤدي رسالة ثقافية كان يؤمن بها منذ زمن بعيد. توقف الدكتور قاسم عند مؤلفات الراحل الثلاثة وهي "تأملات في الشأن العراقي" و "قراءات في الفكر العربي والإسلامي" و "الفلسفة ومفترق ما بعد الحداثة" إضافة إلى عشرات المقالات والأبحاث الثقافية والفنية والفكرية. يؤكد الباحث "أنّ كل مثقف تقدمي هو مشروع شهيد في ظل قادة أحزاب وكتل سياسية مصابة بحوَل عقلي ومنغلقة على معتقدات ماضوية وخرافية ومأزومة بعقدة الضحية التي تبرر لها الاستفراد بالسلطة والثروة"(ص 204). فلا غرابة أن تستهدف سلطة الأحزاب الإسلامية أي مثقف تنويري ينشر ثقافة الحب والجمال وهذا ما فعلتهُ مع الناقد الفني قاسم عبدالأمير عجام والروائي علاء مشذوب والدكتورة رهام يعقوب وما سواها من الأسماء المؤثرة في المشهد الثقافي العراقي.
نجح الباحث كثيرًا حينما اختار هذه الشخصيات التي تركت بصمتها الواضحة في الثقافة والسياسة والفكر. فمظهر عارف لم يكن صحفيًا فقط وإنما كان سياسيًا ومُفكرًا بقدرٍ أو بآخر. يُظهر ما في طويته ولا يُبطن شيئًا. وقد كتب هذا المقال المعنون " 40 سنة أخوّة مع قاسم صالح" وأردفه بعنوان ثانٍ هو "عالِم كبير ومناضل وطني شجاع" لكنه قد يختلف معه سياسيًا ولا ضير في ذلك الاختلاف. كما يؤكد مظهر عارف بأن قاسمًا قد اختلف مع نظام البعث ودخل السجن لأنه وطني يساري لم يقتنع بالطريقة التي يُدار بها الحكم في العراق. وبعد التغيير لم ينل المنزلة التي يصبو إليها وبدلًا من أن يضعوه في المكان المناسب لدرجته العلمية تركوه هدفًا للاختطاف والاغتيال من قِبل الفاشيين أعداء الحرية والثقافة والعلوم.
القصيدة المُدوّرة
يختم الدكتور قاسم حسين هذا الفصل بالحديث عن الشاعر حِسَب الشيخ جعفر بطريقة مكثفة تُغري القارئ بالاستزادة. فالشاعر من مواليد 1942 في ناحية "هور السلام" بمحافظة العمارة التي تلقّى فيها تعليمه الدراسي ثم حصل على بعثة لدراسة الأدب في معهد "غوركي للآداب" ونال شهادة الماجستير سنة 1966م وختمها بنشر مذكراته بموسكو في كتاب يحمل عنوان "رماد الدرويش". يُتحفنا الباحث بعدد من المجموعات الشعرية لحِسَب من بينها "نخلة الله"، "الطائر الخشبي"، "زيارة السيدة السومرية"، "عبر الحائط في المرأة" و "في مثل حنوّ الزوبعة" إضافة لترجمته لعدد من مؤلفات الشعراء الروس. عمل حِسَب بين العامين 1970 - 1974 رئيسًا للقسم الثقافي في إذاعة بغداد ومحررًا في جريدة الثورة، كما شارك في العديد من الأنشطة الثقافية داخل العراق وخارجه. لم يستسغ الراوية عمله في الإذاعة لأنه اعتقد أنّ عمل المذيع ليس أكثر من امتداد لآلة الميكروفون فانتقل إلى القسم الثقافي الذي كان يرأسه حِسَب الشيخ جعفر وكان معظم العاملين فيه يساريين يتوفرون على خبرات ثقافية وفنية واضحة المعالم ولم يكن بإمكان البعثيين استبعادهم أو الاستغناء عنهم. كان الدكتور قاسم يكتب في مجلة عراقية واسعة الانتشار وهي "الإذاعة والتلفزيون" التي يرأس تحريرها الشاعر والكاتب الصحفي زهير الدجيلي ويكتب فيها العديد من الكتاب والمثقفين العراقيين اليساريين أمثال فالح عبدالجبار ومحمد الجزائري وفاطمة المحسن وسؤدد القادري الذين رفدوا المجلة بالكثير من الموضوعات الأدبية والفنية والفكرية الشائقة. وبما أنّ الدكتور قاسم كاتب ومختص بعلم النفس فلا بد أن تظهر لمساته النفسية على كتاباته التي يتناول فيها الأدباء والفنانين والمفكرين ويحلل منجزهم الأدبي والفني والثقافي على هذا الأساس. فمن خلال لقاء واحد ربما استطاع أن يلمح مسحة الكآبة أو الحزن المرتسم على وجه الشاعر حِسَب الشيخ جعفر وتطوّع لحل مشكلته النفسية إن كان يعاني منها لكنه سرعان ما اكتشف بأن هذا الشاعر متواضع جدًا، ولا يحب الظهور الإعلامي، ولا يعاني من عُقدة النرجسية و "تضخّم الأنا" مثل غالبية الشعار والأدباء الكبار. وحينما طلب أن يحاوره في برنامج "كبار" أجابه ممازحًا:"تعال بعد عشرين سنة"! ثمة معلومة مهمة أوردها الراوية مفادها أنّ "حسب الشيخ جعفر كان استثنائيًا أيضًا في ابتكاره القصيدة المُدورة"(ص211) وهي السمة أو الملمح الأبرز في قصائده الجميلة التي يبحث فيها عن معنى الحياة أو الوجود بالمعنى الفلسفي. ثمة إشادة مُستحقة بالدكتور الشاعر عارف الساعدي؛ الإنسان الراقي فكرًا وأخلاقًا كما يصفه مؤلف الكتاب الذي لولاه لما أعيدت طباعة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر المجدد حسب الشيخ جعفر. وكعادة الدكتور قاسم حسين في مطالبته الدوائر المعنية لإنشاء نصب وتماثيل للشعراء والأدباء والمفكرين والفنانين العراقيين مثل علي الوردي، وخالد الشطري، وحسب الشيخ جعفر ولكن دعواته المُخلصة كانت تذهب أدراج الرياح.
مماليك لُقطاء حكموا بغداد
يشتمل الفصل السادس والأخير "كوميديا عراقية" على تسع مقالات متنوّعة تنطوي حِكم كثيرة يمكن أن يستشفها القارئ إذا تأمّلها جيدًا وقرأ ما بين السطور وأولها مقال "أبو ليلة وعادلة خاتون" حيث يأخذنا الكاتب إلى حقبة تكاد تكون منسية في تاريخنا الحديث الذي يمتد من أواسط القرن الثامن عشر حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر، وتحديدًا منذ عام 1749 وحتى 1831 وهي الحقبة التي حكم فيها المماليكُ العراقَ لمدة 82 سنة تقريبًا وعاثوا فسادًا وتخريبًا في الشؤون الإدارية والمالية والأخلاقية. ففي بداية هذه الحقبة اشترى الوالي العثماني حسن پاشا أطفالًا وصبيان من بلاد القفقاس وأدخلهم في مدارس خاصة ببغداد يتعلمون فيها فنون القتال وبما أنهم كُرماء النسب؛ أي لُقطاء فقد أصبح ولاءهم الكامل للسلطة التي أغدقت عليهم ومنحتهم مناصب رفيعة في أروقة الدولة. تُرى، هل تعمدت الدولة العثمانية هذا التخريب المُمنهج؟ وقد أُشيع في حينه أنّ هؤلاء الصبيان المماليك، وليس كلهم بالتأكيد، كانوا يمارسون اللواط مع بعضهم بعضا فوجدت هذه العادة الشاذة طريقها إلى شريحة من المجتمع العراقي. يؤكد الدكتور قاسم حسين بأنّ سليمان پاشا هو أول من تولى الحكم في العراق من المماليك وكان حازمًا في ضبط الأمن وقاسيًا مع من يحاول التمرد على القوانين المرعية فأطلق البغداديون عليه ألقابًا متعددة من بينها أبو ليلة وأبو سمرة وسليمان الأسد الذي يهابه الناس ويخشاه الأعداء لكنه كان في بيته إمِّعة مطيعًا لأموامر زوجته، بل أنها كانت تغيّر الأوامر التي يُصدرها على الرغم من كونه الوالي الذي يُفترض فيه أن يكون الآمر الناهي. وعودًا على بدء كانت زوجته عادلة خاتون في صباها قد خرجت مع والدها أحمد پاشا إلى ساحة الميدان ببغداد حيث يُباع الرقيق فلمحت صبيًا وسيمًا فاشترته في الحال ليصبح مملوكًا يعيش في بيتها والدها الوالي ويتعلم فنون الفروسية والقتال. وذات مرة اصطحبة الوالي لزيارة عگرگوف فهجم عليهم أسد هائج فقتله سليمان في مشهد بطولي استقر في ذاكرة الناس كنموذج للشجاعة والإقدام فطلبت عادلة خاتون من أبيها أن تتزوج هذا الفتى الجسور لكن القائد العسكري التركي اعترض على هذه الزيجة. ولكي تتخلص من هذا القائد دعتهُ إلى وليمة في منزلها ودسّت له السم في طعامه فمات وأصبحت عادلة خاتون سيدة العراق الأولى والحاكم الفعلي للبلد على الرغم من وجود سليمان پاشا قاتل الوحوش والضواري الذي وافته المنية سنة 1762 ثم تبعته عادلة خاتون بعد ست سنوات. لم يُعرف أحد الطريق إلى قبر سليمان پاشا لكن قبر عادلة خاتون ما يزال موجودًا في مبنى المحكمة الشرعية القديمة في شارع النهر غير أنّ كاتب المقال لا يعرف إن كان هذا القبر مهملًا أو مندرسًا أو قابعًا في مدارج النسيان.
مفهوم الشفاعة
تتمحور القصة الثانية على الشقي "حسن كبريت" الذي كان سفّاكًا يقتل القتيل ويمشي في جنازته. وتدل القرائن النفسية التي يلاحظها الباحث بأنّ هذا الشقي كان ساديًا يتلذذ بالقتل ويجد ضالته في سفك الدماء. وكان لا يكتفي بقتل الجنود في واقعة الشعيبة في الحرب العالمية الأولى وإنما كان يقطّع رؤوسهم ويأتي بها إلى رجال الدين الذين يتقززون من أفعاله الشنيعة ويمنعونه من القيام بها ولكن دون جدوى. ورغم أنّ هذا الشقي قد قتل عددًا كبيرًا من الناس لكنه يعتقد بأنّ الله سيغفر له ذنوبه (بشفاعة فاطمة الزهراء بنت النبي). وحينما أنقذ فتاة في مقبرة الشيخ معروف كانت تستغيث وتتوسل بفاطمة الزهراء أن تنقذها من الرجل الذي يحاول اغتصابها قرر حسن كبريت أن يضيف هذا المُغتصب إلى قائمة ضحاياه العديدين فطعنه من الخلف وأرداه قتيلًا في الحال. ويذهب الباحث إلى أنّ الشفاعة من وجهة نظره هي تبرير يهدف إلى خفض القلق وتطمين النفس من عقوبة كبيرة أو من فعل شنيع. وهذا تفسير منطقي ومقبول إلى حد بعيد.
المفارقة السوداء
أما المقال الثالث الذي سنتوقف عنده فهو مسرحية "اغلقي عينيكِ وفكري بإنگلترا" وهي قائمة على تقنية الصدمة أو المفارقة السوداء التي تثير الدهشة وتُنير ذهنية القارئ في خاتمة المطاف. وثيمة هذه المسرحية التي عُرضت لمدة عشر سنوات في سبعينات القرن الماضي أنّ لوردًا دعا أحد الشيوخ العرب إلى وليمة عشاء. وكان هذا اللورد رئيسًا لمجلس إدارة شركة بترول عملاقة. وعلى حد رأي المؤلف، فإنّ عمالقة البترول هم أنفسهم عمالقة السياسة. وعلى عادة الإنگليز الاستخباراتية فقد جمع هذا اللورد معلومات كثيرة عن شخصية الشيخ العربي فاكتشف أنه يفضّل النساء الشقراوات الأمر الذي دفعه لأن يوحي إلى زوجته أن تدعو أكبر عدد ممكن من النساء الشقراوات كي ينتقي منهنّ من تثير غرائزه الجنسية فأخذ يُداعب هذه ويقرص تلك لكن زوجته أسرعت إليه مرتبكة مبهورة الأنفاس لتخبره بأنّ اختيار الشيخ قد وقع عليها من دون باقي النساء اللواتي تفوح منهن روائح العطور الفرنسية فما كان من هذا اللورد إلّا أن يقول لزوجته المدهوشة:"حبيبتي .. اغلقي عينيكِ وفكّري بإنگلترا"!!
لا بد من الإشارة إلى أنّ بقية المقالات أو القصص جديرة بالقراءة النقدية مثل قصة الموسيقار اليوناني المبدع "ياني" الذي جمع شمل العراقيين الموزعين على أربعة أقسام في الصالة الكبيرة وقسم خامس "لمملوم"على حد وصف الكاتب وخلطهم بعضهم بعضا فلقد أصلحت الموسيقى ما أفسدته السياسة في الزمن الديمقراطي!
من يتأمل هذا الكتاب سيجد أنّ فيه العديد من القصص والحكايات التي تصلح لأن تكون أفلامًا أو مسلسلات أو تمثيليات مستقلة في أضعف الأحوال وأولها قصة "الحاجة مبروكة" وهذا الأمر ينسحب على بائعات الهوى وتصريحاتهن الجريئة وهنّ يتحدثهن عن هذه المهنة وكأنها مثل أية مهنة أخرى في هذا العالم. أمّا اللقاءات والحوارات الصحفية الجميلة والمذكّرات فهي جميلة وجريئة ولافتة للانتباه ويمكن تحويلها إلى أعمال سينمائية أو روائية في أقل تقدير.
***
عدنان حسين أحمد - لندن







