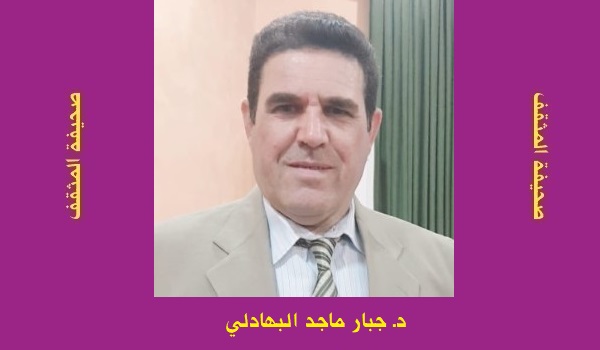قضايا
بدر الفيومي: الغزو الفكري الحرب الناعمة (1): صراع العقول بين الانبهار والممانعة

ليس أخطر على الأمم من أن تفقد وعيها بنفسها، أو تُسلِّم عقلها لمن يفكر عنها ويختار لها ما تراه وتريده. فالهزيمة العسكرية، مهما كانت فادحة، يمكن للأمة أن تتعافى منها بمرور الزمن، أما الهزيمة الفكرية فهي التي تخلع عنها روحها وتبدل معاييرها حتى تغدو كيانًا آخر لا يشبه ذاته.
ولعلّ هذا ما يجعل الغزو الفكري أخطر أشكال الصراع الإنساني، لأنه لا يكتفي بالهيمنة على الأرض بل يسعى إلى الهيمنة على الإنسان ذاته، فيعيد تشكيل وعيه ومعاييره ومقاييسه في الخير والشر، والحق والباطل، والجمال والقبح. إنّها معركة الوعي التي تدور بلا ضجيج، ويخرج منها المهزوم وهو يظن أنه منتصر. لقد عبّر رينيه ديكارت (1596–1650م) عن مركزية الفكر في الوجود الإنساني بقوله الشهير، (أنا أفكر إذن أنا موجود)، وهي عبارة تبدو فلسفية مجردة، لكنها في جوهرها إعلانٌ أنّ الوجود الإنساني لا يُقاس بما يملك الإنسان من ثروةٍ أو سلاح، بل بما يملك من وعيٍ قادرٍ على التمييز والنقد والاختيار.
ومن ثمّ فإنّ السيطرة على الفكر ليست مجرد هيمنةٍ معرفية، بل هي نوع من إعادة التكوين للإنسان نفسه وفق مقاييس الغالب، حتى يصبح المقهور نسخةً عن الغازي في سلوكه وتفكيره، وإن ظلّ يحمل اسمه ولغته.
وحين نتتبع المسار التاريخي للعلاقة بين العالم الإسلامي والغرب الحديث، ندرك أن مفهوم الغزو الفكري لم يكن اختراعًا طارئًا، بل وُلد من رحم الاحتكاك الحضاري العنيف الذي شهده الشرق في نهاية القرن الثامن عشر، حين حلّت الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798م. فالحملة لم تكن مجرد حملةٍ عسكرية؛ كانت مشروعًا سياسيًا وثقافيًا يهدف إلى إعادة تشكيل وعي المنطقة وفق النموذج الغربي.
وقد أدرك مفكرو النهضة الأوائل أن المدافع سترحل، لكن الأفكار التي خلفتها الحملة ستظل فاعلة في العقول. ومنذ تلك اللحظة بدأت الأمة تطرح سؤالها المصيري؛ كيف ننهض؟، أبانسلاخنا عن تراثنا؟، أم بعودتنا إليه؟ أباتباع الغرب أم بمقاومته؟. سؤال لم يُغلق إلى اليوم.
وأمام هذا التحدي الحضاري الجسيم، وما خلّفه من صدمة فكرية وانقسام في الوعي الجمعي، برز تياران متناقضان من رواد الفكر والتجديد في العالم العربي والإسلامي في مواجهة هذا السؤال. تيارٌ رأى في الغرب نموذجًا للمدنية الفاضلة والعلم ينبغي استنساخه مهما كلف الأمر، وتيارٌ آخر رأى أنّ نهضة الأمة لا تكون إلا من داخلها، باجتهادٍ يعيد قراءة التراث ويستنطق قيمه الحيّة، دون ارتهانٍ للوافد أو انغلاقٍ على الماضي. وكان الصراع بين التيارين صورةً مكثفةً لما يمكن أن نسميه اليوم جدلية «الانبهار والممانعة».
أما التيار الأول؛ فقد انبهر بإنجازات الغرب العلمية والتنظيمية، وعدّها المقياس الوحيد للتقدّم، فراح يستوردها كما هي دون أن يتفكر في جذورها أو مقاصدها. فرفاعة الطهطاوي (1801–1873م)، مثلاً، رأى في فرنسا صورة للمدينة الفاضلة الحديثة، حيث دعا إلى نقل نظمها التعليمية والإدارية إلى مصر، مؤمنًا أن النهضة لا تقوم إلا بالاحتذاء بتجربتها. وجاء بعده علي عبد الرازق (1888–1966م) في الإسلام وأصول الحكم، ليتبنى فكرة فصل الدين عن الدولة على غرار النموذج الأوروبي، وهو فصل لم يعرفه تاريخ الإسلام، إذ لم يكن في حضارته كهنوتٌ يحتكر الدين أو سلطةٌ كنسية تقيد العقل. وسار سلامة موسى (1887–1958م) في الاتجاه ذاته حين دعا إلى (أوربة الشرق)، معتبرًا أن التقدّم لا يتحقق إلا بالخروج من عباءة التراث والتخلي عن موروث العادات والتقاليد. وشاركهم في هذا النزوع فرح أنطون (1874–1922م)، الذي رأى العلمنة شرطًا للنهوض، وشبلي شميل (1850–1917م) وإسماعيل مظهر (1891–1962م) حين أدخلا الفكر المادي الدارويني إلى الساحة العربية، مؤكدَين أنّ التمدن لا يقوم إلا على أسسٍ علميةٍ خالصة. ثم جاء طه حسين (1889–1973م) في مرحلة «الشعر الجاهلي»، ليطبق المناهج الغربية النقدية على التراث العربي، ففتح الباب لجدلٍ واسع حول حدود التجديد وموقع الدين في المشروع الثقافي.
ومهما اختلفت دوافع هؤلاء الرواد، فقد جمعهم تصورٌ واحد مؤداه أنّ الحضارة الغربية نموذجٌ كوني يجب اللحاق به. لكنهم أغفلوا أن أوروبا حين فصلت الدين عن الدولة لم تفعل ذلك إلا بعد صراعٍ مرير مع الكنيسة التي احتكرت تفسير النص وادعت العصمة، وهو وضع لم تعرفه حضارتنا الإسلامية في أي مرحلةٍ من مراحلها.
فالإسلام منذ بداياته جعل الاجتهاد مفتوحًا أمام كل من امتلك أدواته، ولم يعرف سلطةً دينية تفكر نيابة عن الناس، بل عرف عقولًا تناقش وتجتهد وتختلف في إطار النص والمقصد. ومن هنا كان خطأ التيار المنبهر أنه استورد أزمة لم يعشها، وجاء بحلولٍ لمشكلٍ لم يعرفه. على الضفة المقابلة، كان هناك من أدرك خطورة هذا الانبهار، فحاول أن يوازن بين الإفادة من الغرب والحفاظ على الذات. خير الدين التونسي (1810–1890م) في كتابه أقوم المسالك كان من أوائل من نبهوا إلى أن النهضة لا تكون بتقليد الغير، بل بإصلاح الداخل وتقويم مؤسسات الحكم والتعليم، مع الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى دون تفريط في الثوابت. وجاء جمال الدين الأفغاني (1838–1897م) داعيًا إلى مقاومة الاستعمار الفكري والسياسي، فبعث الوعي في الأمة وأعاد الثقة إلى نفسها. ثم تبعه محمد عبده (1849–1905م) الذي سعى إلى تحرير الفكر الديني من الجمود، وجعل الإصلاح العلمي والديني وجهين لمشروعٍ واحد يهدف إلى إحياء روح الاجتهاد. وفي مطلع القرن العشرين وقف مصطفى صادق الرافعي (1880–1937م) يدافع عن اللغة العربية بوصفها رمزًا للهوية ووعاءً للفكر، قائلاً: «ما فقدت أمة لغتها إلا فقدت نفسها».
ومن الشرق الإسلامي قدّم محمد إقبال (1877–1938م) رؤيته الفلسفية التي مزجت بين الإيمان والعقل والإرادة، مؤكدًا أن الإسلام ليس عقيدةً جامدة بل طاقة روحية خلاقة. ثم جاء أبو الحسن الندوي (1914–1999م) ليذكّر بأنّ انحطاط المسلمين لا يضرهم وحدهم، بل يُفقد العالم توازنه الروحي والحضاري.
وتواصلت المسيرة في القرن العشرين مع أنور الجندي (1917–2002م) ومحمد محمد حسين (1912–1974م)، اللذين فضحا آليات الاستشراق ومظاهر التغريب، ليصل الفكر المعاصر إلى جيلٍ جديدٍ من المفكرين كطه عبد الرحمن (1944م ) وعبد الوهاب المسيري (1938–2008م) وفهمي جدعان (1940م) ومحمد عابد الجابري (1935–2010م)، الذين حاولوا أن يعيدوا التوازن بين الحداثة والأصالة، بين نقد الذات ونقد الغرب. فطه عبد الرحمن دعا إلى حداثةٍ أخلاقية تُستمد من روح الإسلام، والمسيري حذّر من العلمانية الشاملة التي تفصل الإنسان عن قيمه، والجابري وضع مفهوم النقد المزدوج الذي يراجع التراث والوافد معًا ليقيم توازنًا معرفيًا لا يميل إلى أحد الطرفين.
وإذا ما انتقلنا من التاريخ إلى الواقع، وجدنا أن الغزو الفكري قد غيّر أدواته من المدفع إلى الشاشة، ومن البعثة التبشيرية إلى المنصات الرقمية. فوسائل الإعلام الحديثة وشبكات التواصل تؤدي اليوم الدور نفسه الذي أدته المدارس والمطبوعات الموجهة في القرنين الماضيين، لكنها تفعل ذلك بذكاءٍ ونعومةٍ أكبر. فهي لا تفرض الفكرة بالقهر، بل بالإغراء، ولا تهاجم الهوية علنًا، بل تذيبها تدريجيًا في بحرٍ من الصور والمضامين السريعة التي تشدّ الانتباه وتسرق الزمن. لقد صار المتلقي يظن أنه يختار ما يشاهد، بينما الحقيقة أن خوارزمياتٍ ذكية تختار له ما ينبغي أن يراه، وتُشكّل له رأيه بطريقةٍ ناعمةٍ لا يشعر بها. وهكذا تحوّلت المعركة من مواجهةٍ مباشرة إلى عملية اختراقٍ بطيئةٍ للعقل، تتسلل إلى الوجدان باسم الحرية والانفتاح والتسلية.
إنّ أخطر ما في هذا الواقع الجديد أنه يصنع إنسانًا يعيش في زمن السرعة والنسيان، إنسانًا تستهلكه الصور وتطارده الإعلانات فلا يجد وقتًا للتأمل أو التساؤل. ومع غياب التفكير العميق تتحول المعرفة إلى معلومة، والمعلومة إلى خبرٍ عابر، والخبر إلى انفعالٍ مؤقت، فتضيع القدرة على النقد والتمييز. وهكذا يتحقق الغزو بأهدأ الطرق؛ بأن تفقد الأمة قدرتها على التفكير المستقل، وأن ترى العالم بعيون غيرها.
ولئن حاول البعض مواجهة هذه الموجة بالانغلاق والتشدد، فإنّ الانغلاق لا يصنع وعيًا، بل يضاعف الغربة. فالمطلوب ليس رفض العالم بل فهمه، وليس الهروب من الحداثة بل استيعابها بميزانٍ أخلاقيٍّ راسخ. فالإسلام الذي شجّع على العلم وأطلق حرية البحث لم يربط النهضة بالتقليد الأعمى، بل بالتفكير والاجتهاد، وهو ما يجعل الدفاع عن الهوية لا يكون بالجمود على الماضي، بل بإحياء روح النقد فيه. فالعقل الذي لا يسأل ولا يناقش يفقد حريته حتى وإن ظن أنه يدافع عنها.
ومن هنا، فإنّ معركتنا اليوم ليست معركة شعارات ولا بيانات، بل معركة على الإنسان نفسه: كيف يفكر؟، وبأيّ قيمٍ يقيس الأمور؟، وكيف يحدد موقعه في هذا العالم المتغيّر؟، إنّ أخطر ما يمكن أن يصيب أمةً هو أن تفقد قدرتها على إنتاج الأفكار، وأن تكتفي بترديد ما يُلقى إليها من الخارج، لأنها حينئذٍ تفقد حقها في الوجود الحضاري، مهما امتلكت من ثروةٍ أو قوة. فالمعركة على العقول لا تُحسم بالقوة، بل بالوعي، ولا تُكسب بالصراخ، بل بالبحث والتعليم والإبداع.
وإذا ما أردنا أن نستخلص العبرة من كل ما مضى، فسنجد أن الأمة التي تريد أن تصون نفسها من الغزو الفكري عليها أن تبني إنسانها من الداخل؛ من خلال تحصن لغته، وتربّي ذوقه، وتغرس فيه روح النقد والمسؤولية، وأن تجعل من المدرسة مصنعًا للعقل لا مستودعًا للمعلومات، ومن الجامعة فضاءً للحوار لا ساحةً للحفظ، وأن تقدم الدين في صورته الرحبة التي تجمع بين الإيمان والعقل، بين الروح والعمل، حتى لا يكون التدين قشرةً جامدة ولا الفكر انفلاتًا بلا ضابط. وإذا فعلت ذلك استقامت لها شخصيتها واعتدل ميزانها بين الانبهار والممانعة، بين الانفتاح الواعي والتمسك الأصيل.
فالأمم لا تموت حين تسقط جيوشها، بل حين تذبل عقولها، والإنسان الذي يترك لغيره أن يفكر عنه، لا يختلف كثيرًا عمن سُلبت حريته، ولعلّ ما تحتاجه أمتنا اليوم ليس أن ترفع شعارات الرفض أو التبعية، بل أن تستعيد عقلها المفكر، وأن تجعل من الوعي سلاحها الأسمى في معركةٍ لا تُدار في الميدان بل في الأذهان، فإذا وُجد هذا العقل الرشيد، انكسرت موجات الغزو الناعم، وبقيت للأمة بصيرتها التي تهديها مهما تكاثرت العواصف.
وللحديث بقية...
***
بقلم: د. بدر الفيومي