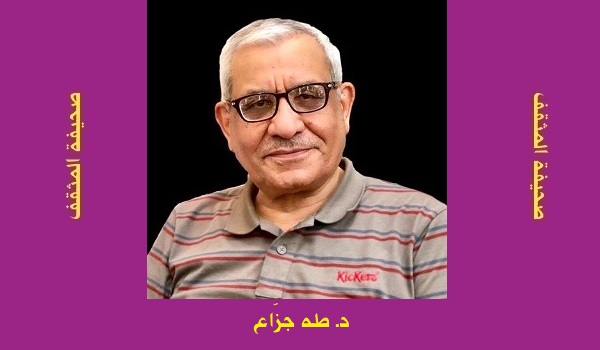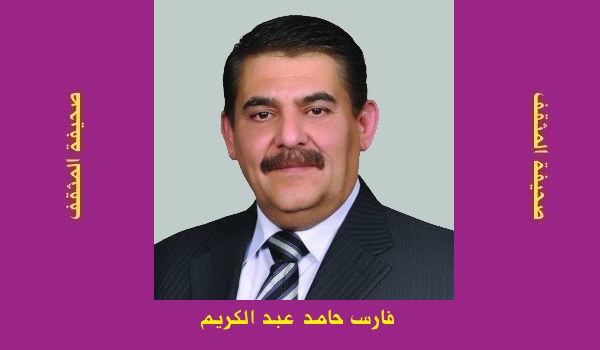قضايا
عبد الله الفيفي: صوتُ صَفيرِ الباطلِ.. التقنية الحديثة ونشر الأكاذيب

تحتلُّ التقنية الحديثة ميدانًا جديدًا واسعًا لنشر الأكاذيب والأباطيل، على القدماء والمحدثين معًا. وزاد (الغباء الاصطناعي) الطِّين بِلَّة، من حيث يعتقد كثير من الناس أنَّه ذكاء حقًّا، كما سُمِّي لهم، فيعتمدون عليه، وما هو سِوَى جمع معلوماتٍ مضطربة، وكيفما اتَّفق. وفي هذا آيةٌ أخرى على أَضعاف ما كان يحدث في التراث، ممَّا يتقبَّله اليوم بعضنا بقبولٍ حسَن، ويُجِلُّه غاية الإجلال، ويَعُدُّه من المسلَّمات؛ فتنبني عليه أضاليلنا المعاصرة. من هٰذا، مثلًا، أبيات ركيكة جدًّا ينسبها بعض ذوي الأهواء من المعاصرين إلى (طه حسين)(1):
كنتُ أظنُّ أنكَ المُضلُّ وأنكَ تَهدي من تشاء
الضارُّ المغيثُ المُذلُّ عن صلفٍ وعن كبريـاء
ولولا أنَّ هؤلاء في غاية الجهل، ويقبعون في عالمٍ آخر غريب عن اللُّغة العَرَبيَّة والشِّعر أصلًا، ما نسبوا هذا الهراء إلى الشِّعر أصلًا، فضلًا عن نسبته إلى (طه حسين)، أو حتى إلى من في الدَّرك الأسفل دونه! والأغرب أن ينتشر مثل هذا ويجد من يصدِّقه وقلَّما يجد من يفضحه!
هكذا بادرنا (ذو القُرُوح) بالقول. فقلتُ:
ـ ظاهرة النَّحْل والانتحال في الشِّعر العَرَبي، التي أثارها (طه حسين) نفسه- بعد (ابن سلام الجُمَحي)، و(مارجليوث)، و(أحمد ضيف) وغيرهم- ما زالت مستمرَّة جهارًا نهارًا، إذن، وقد طالت طه حسين نفسه!
ـ لأنَّ أحفاد الكَذَبة القدماء- كالمتَّهمَين المشهورَين (حمَّاد الراوية) و(خلف الأحمر)- ما زالوا بيننا، وإنْ بصُوَرٍ جديدة، خالية من العِلم بالشِّعر واللُّغة، والإبداع في سَبْك الأكاذيب؛ لتأتي الأكاذيب المعاصرة هكذا ساذجةً، خالصةً لوجه الكذب؛ لأسباب أيديولوجيَّة، أو لمجرَّد التباهي بملامح الجهل الكُبرى! وإذا كان من الشِّعر القديم ما يفضح اصطناعَه بنفسه، فإنَّ من الحديث ما يفضح ذلك لدَى القارئ البصير.
ـ كيف يفضح الشِّعر القديم اصطناعَه بنفسه؟
ـ ذلك كقول الشاعر (عبدة بن الطَّبيب)، أو قل كالمنسوب إليه، في البيتَين:
ثُمَّتَ قُمْنا إلى جُـرْدٍ مُسَوَّمَـةٍ
أعرافُـهُـنَّ لأيـدينـا منادِيـلُ
*
ثُمَّ ارتحلنا على عِـيْسٍ مُخَدَّمَةٍ
يُزْجِي رَواكِعَها مَرْنٌ وتَنْعِيلُ
أفلا ترى كيف قفز من وصف الخيل إلى وصف الإبل؟!
ـ وماذا في ذاك؟ ما أكثر ما يقفز الشاعر القديم من فكرة إلى أخرى!
ـ إنْ كان الرَّكب الذين يصفهم أهلَ خيلٍ، فكيف تحوَّلوا فجأةً إلى بدوٍ يرتحلون على ظهور الإبل؟! فقد قاموا، كما قال في البيت الأوَّل، بعد تناول الطعام، إلى خيلٍ مُسَوَّمَة، ثمَّ إذا هم يرتحلون على عِيْسٍ مُخَدَّمَة، لا على الخيل التي قاموا إليها! وهذا لا يستقيم تصوُّره في آنٍ معًا، وفي سياقٍ واحدٍ من بيتَين متعاقبَين، إلَّا بتأوُّلٍ بعيدٍ متكلَّف. وإنَّما أغلب الظنِّ أنَّ الراوي نفسه أراد أن يَصِف الخيل والإبل معًا، فنسب ذلك إلى الشاعر.
ـ أ ولا ترى أنَّنا أُمَّة الكذب الكُبرى؟
ـ بلى أرى، مع الأسف، وليتني لا أرى! وهذه ثقافة جاهليَّة، ثمَّ أُسْلِمت، ولكن صار الكذَّاب «المسلم» يضيف عبارة «إنْ شاء الله»، فيعلِّق أكاذيبه بمشيئة الله سبحانه!
ـ وهذا أسوأ!
ـ ومع ذلك حتى الأطفال صاروا يعرفون أنَّ من يستعمل عبارة «إنْ شاء الله» كثيرًا هو غالبًا كذَّاب، ولن يفي!
ـ بل حتى أصبحت تلك نكتة عالميَّة! ظهرت في مناظرة الرئيس الأميركي السابق (جو بايدن) مع (ترمب)، حين كان يقول له (بايدن) متهكِّمًا بمواعيده العرقوبيَّة: «إن شا له؟!» ولسان حاله: «يا نصاب يا كذَّاب، العب غيرها!»
ـ وقبل ذلك سَخِر «القرآن الكريم» من الكَذَبة حين يحتجُّون بمشيئة الله على سوء أعمالهم.
ـ مثل؟
- مثل الآية: «قَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ؛ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمُهْتَدُونَ!» (البقرة: 70). فهم يستعملون هنا «إنْ شاء الله» كما يستعملها كَذَبة العُربان والمسلمين! أو الآية: «إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ: أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ، قَالُوا: لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً؛ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ.» (فُصِّلت: 14). أو: «وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، قَالُوا: وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا، قُلْ: إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ، أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟!» (الأعراف: 28). أو: «وَقَالُوا: لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، مَا لَـهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.» (الزخرف: 20).
ـ «يَخْرُصُوْن» هنا بمعنى: «يَخْرُطُوْن»، كما يقول العامَّة! «القرآن»، إذن، ما يفتأ يفضح هذه السُّلوكيَّات النفاقيَّة في كلِّ زمانٍ ومكان. لكن لنعُد إلى أكاذيب الأدب.
ـ منها ما يحدث مع المشاهير، كـ(المتنبِّي)، أو (طه حسين)، أو نِسبة كُلِّ غَزَلٍ بـ(ليلى) إلى (مجنون ليلى: قيس بن الملوَّح)، أو كُلِّ شِعرٍ ماجن إلى (أبي نواس الحسَن بن هانئ)، أو كُلِّ شِعرٍ حماسيٍّ إلى (عنترة بن شدَّاد). والشاهد من هذا كلِّه أنَّ ما يحدث في الثقافة المعاصرة من نشر الأكاذيب- مع انكشاف الأوراق لكلِّ ذي عينَين- دليلٌ على ما كان يحدث في الثقافة القديمة من نشر الأكاذيب، مع العمَى المطبِق الذي كان يلفُّ معظم الآفاق.
ـ ومَن أيضًا؟
ـ مِن أولئك الأعلام الذين قد يقع عليهم الوضع (الأصمعي، أبو سعيد عبدالملك بن قريب الباهلي البصْري، ـ216هـ= 831م). ولعلَّ أسخف نظمٍ يمكن أن يمرَّ بك- إنْ كنتَ ممَّن يميز غثَّ النَّظْم من سمينه- تلك المنظومة السمجة المنسوبة إلى الأصمعي، التي تتردَّد عادةً على منابر الوعَّاظ والمتظارفين، من ورثة عصور الانحطاط اللُّغوي والأدبي والفكري، بعنوان شطر المنظومة الأوَّل «صوتُ صفير البُلبلِ»! ويبدو أنَّ أوَّل من سوَّقها على الناس ناظمٌ مِصْريٌّ صُوفيٌّ، عاش في عصر المماليك، خلال القرنَين الثامن والتاسع الهجريَّين، وكان مغرمًا بالغرائب والنوادر. اسمه (شمس الدِّين محمَّد بن حسَن بن علي النواجي، ـ859هـ= 1455م)، عمِل ورَّاقًا، يرتزق بنَسخ الكُتب، عُمْرًا من عُمْره. وقد ذُكِر عنه أنها «حدثت مشاحنات بينه وبين معاصرِين له بسبب كتابته بعض الكتب للآخَرين، وخاصَّة كُتب الهجاء...».(2) ومن هنا لا يَبعُد أن تكون حكاية الأصمعي تلك ومنظومة «صفير البُلبل» من صناعة النواجي نفسه، أو صناعة مَن على شاكلته من مروِّجي النوادر والأقاصيص. وحسبك أنَّ تلك الحكاية قد أوردها في كتابٍ له عنوانه «حَلَبة الكُمَيْت»، وهي حَلَبةٌ في الخمر، والنوادر المتعلِّقة بالخمريَّات.
ـ وهل تذهب مذهب من يعلِّل مثل هذا بنزوع مبيَّت إلى النَّحْل والكَذب والادِّعاء، بالضرورة؟
ـ كلا! وإنْ أسندَه صانعُه إلى أعلام مشهورين. بل نرى أنَّ تلك هي طبيعة النوادر أصلًا، بوصفها جنسًا أدبيًّا. فمن المعلوم أنَّ فنَّ النوادر- منذ نوادر الورَّاق الأوَّل (الجاحظ)، على سبيل النموذج الأقدم والأشهر- لم تكن بروايات عن وقائع تاريخيَّة بالضرورة، بل هي أقاصيص متخيَّلة مؤلَّفة، في معظمها إنْ لم يكن برُمَّتها، لأغراض من الفكاهة والإدهاش والقصِّ وإيصال بعض الرسائل الاجتماعيَّة. لكن «الشَّرهة» على من يصدِّق واقعيَّتها، من سَذَجة المتلقِّين!
ـ ماذا عن (شمس الدِّين النواجي)؟
ـ الحقُّ أنَّ (النواجي) لم يُسنِد تلك الحكاية، ولم يزعم لها عزوًا، وإنَّما صدَّرها بالقول: «(ومن لطائف ما اتَّفق) أنَّ بعض الخلفاء...». وكأنَّما هذه النادرة على غرار نوادر (الجاحظ) عن «البخلاء»؛ فقد جاءت حول بُخل أحد الخلفاء- لم يُسمِّه، وإنْ تطوَّع لاحقوه بتسميته بـ(المنصور) أو (هارون)- وأنَّه كان بخيلًا في العطاء، لا يكافئ الشعراء، متنصِّلًا من ذلك باتهام الشاعر في أصالة قصيدته، بحُجَّة أنها نصٌّ معروفٌ محفوظ، لا جديد فيه؛ فليَبُلَّها صاحبها ويشرب ماءها، إنْ شاء، فلن يحظى من الخليفة بدينارٍ ولا درهم.
[وللحديث بقيَّة].
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي
......................
(1) وهذه ظاهرة؛ إذ يبدو المفكِّر المعاصرُ شغوفًا بالبحث عن «جماعة»، وعن رصيدٍ بَشَريٍّ يتَّكئ عليه، من الأعلام والعلماء والمفكِّرين، حتى لا يبدو- أمام نفسه قبل غيره- شاذًّا عن أُمَّته. فتراه كثيرًا ما يسعى إلى نِسبة المشاهير إلى مذهبه الفكري. وحبَّذا أن يكون هؤلاء المشاهير من الماضي والتراث! ولذا نرى، مثلًا، الإلحاح على أنَّ (المعرِّي) ملحد، أو لا ديني. مع أنَّ شِعره ناطق بنقيض ذلك، مهما كانت فيه من شطحات، لا يخلو منها شِعر شعراء آخرين، وقد تكون محض قراءات في خطاب الرجل أو تأوُّلات لنصوصه. وإنَّما هو البحث عن «عزوة» لدَى المعاصر، (أدونيس نموذجًا)، الذي لا يكفُّ عن ذِكر (أبي العلاء)، ووصفه بأنه لا ديني، على مذهبه! مستجلبًا هذا الزعم بمناسبةٍ وبغير مناسبة. وهذا محض ادِّعاء، بلا دليل، من قَبيل غيره في جهاز اجترار الأباطيل، قديمًا وحديثًا.
(2) النواجي، (2005)، تأهيل الغريب، تحقيق ودراسة: أحمد محمَّد عطا، (القاهرة: مكتبة الآداب)، 13.