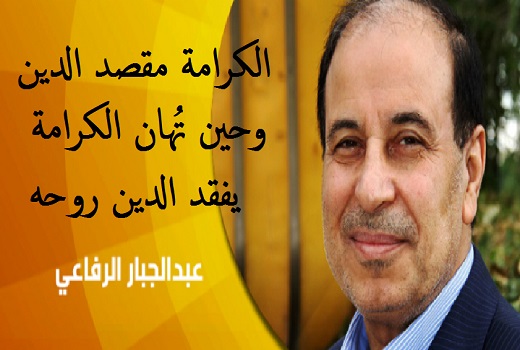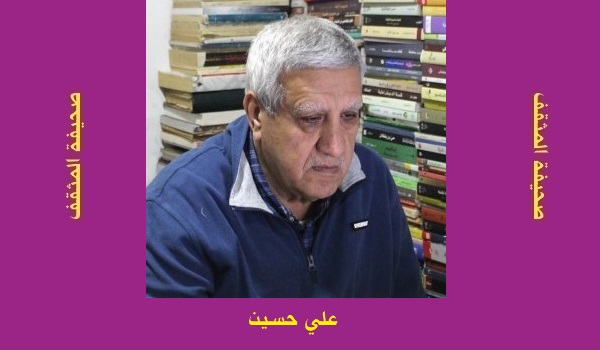قضايا
عماد خالد رحمة: العلم الإنساني و"المنعطف الأنطولوجي الحاسم"

نحو هيرمينوطيقا جديدة للفهم الذاتي
لقد ظلّت العلوم الإنسانية، منذ لحظة تشكّلها في القرن التاسع عشر، مأسورةً بين مطرقة النموذج العلمي الصارم الذي جسّدته العلوم الطبيعية والتقنية، وسندان سؤال خصوصيتها بوصفها علوماً للفهم لا للتفسير وحده. وهنا انبثق المشكل المعرفي الذي سيتحوّل لاحقاً إلى منعطف أنطولوجي حاسم، كما سمّاه مارتن هايدغر، حين وضع اللغة لا كوسيلةٍ للتواصل فحسب، بل كبيتٍ للوجود، وسلّط الضوء على الفهم الذاتي بوصفه شرطاً لتجربة الكائن في العالم.
إنّ فيلهلم دلتاي، الذي دشّن مشروع "نقد العقل التاريخي"، قد ميّز مبكراً بين علوم الطبيعة (Naturwissenschaften) القائمة على التفسير السببي، وعلوم الروح أو الإنسانية (Geisteswissenschaften) القائمة على الفهم (Verstehen). فالإنسان عنده ليس مجرد موضوع خارجي يمكن قياسه كمياً، بل كائن يختبر ذاته من الداخل عبر التاريخ والمعنى. وهذا ما سيجعله الأب المؤسس للهيرمينوطيقا الحديثة، التي مهّدت الطريق للفلسفة الوجودية والأنطولوجيا الهيدغرية.
هايدغر، في كتابه "الكينونة والزمان"، حوّل النقاش من سؤال "كيف نعرف؟" إلى سؤال "ما معنى أن نكون؟". ومن ثمّ فإنّ العلوم الإنسانية، في أفقه، ليست مجرد أدوات لإدراك السلوك الاجتماعي أو النفسي، بل ساحة انكشاف للكينونة ذاتها عبر اللغة والفهم التاريخي. اللغة هنا ليست وسيلة توصيف، بل هي – كما يقول – "بيت الكينونة"، حيث يسكن الإنسان. إنّ الفهم الإنساني ليس عملية ذهنية تفسيرية فحسب، بل تجربة وجودية تكشف عن توتر الكائن بين التناهي والزمانية، بين الموت كأفق وجودي، والتاريخ كتجربة متجددة للذات.
ويبدو أنّ "المنعطف الأنطولوجي الحاسم" الذي أشار إليه هايدغر ليس سوى تلك النقلة النوعية التي أعادت الاعتبار إلى العلوم الإنسانية، لا باعتبارها نسخة ناقصة عن العلوم الطبيعية، بل كفضاء مستقل له منطقه الخاص. وهو ما أكّد عليه بول ريكور حين رأى أنّ التأويل (Herméneutique) هو البنية العميقة للعلوم الإنسانية، إذ إنّ النصوص، الرموز، والأفعال لا تُفهم إلا عبر جدلية الذات والآخر، والجزء والكل، والتاريخ والمعاصرة.
إنّ هذا المنعطف أعاد توجيه السؤال من البُعد الإبستمولوجي الضيق إلى البُعد الأنطولوجي الأرحب. فبدلاً من الاكتفاء ببحث صلاحية مناهج العلوم الإنسانية أو عجزها عن تحقيق "الصرامة العلمية" للعلوم الطبيعية، أصبح السؤال: ما الذي تكشفه هذه العلوم عن الإنسان بما هو وجود متناهٍ وزمني وتاريخي؟. وهو السؤال الذي سيجد صداه عند فوكو حين تحدث عن "أركيولوجيا المعرفة" وعن الإنسان كـ"اختراع حديث" قد يختفي مع انمحاء الشاطئ الذي كُتبت عليه صورته.
إنّ الفهم الذاتي، كما تبلور في هذا المسار، ليس نزعة نفسية أو تأملية محضة، بل عملية تاريخية تتوسّطها اللغة والرموز والمؤسسات. لذلك، فإنّ العلوم الإنسانية – من الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع، ومن الفلسفة إلى علم النفس – ليست مجرد أدوات لقياس السلوك أو وصف البنى، بل هي حقول تكشف عن معنى الكائن في التاريخ، عن حدوده وهشاشته وقدرته على إنتاج المعنى من العدم.
لقد أدرك دلتاي أنّ التاريخ هو الشرط الجوهري لفهم الإنسان، فيما رأى هايدغر أنّ الزمانية هي بنية الوجود نفسه، وأضاف ريكور أنّ الهوية الإنسانية لا تُفهم إلا عبر السرد والتأويل. أما هابرماس، فقد أشار إلى أنّ العلوم الإنسانية لا تكتفي بالتفسير أو الفهم، بل تحمل دائماً بعداً نقدياً تحررياً يفتح أفق التواصل العقلاني.
إنّ ما يجمع هذه المقاربات هو الإقرار بأنّ العلوم الإنسانية ليست "علوماً ضعيفة" قياساً إلى العلوم الطبيعية، بل هي حقول أنطولوجية-هيرمينوطيقية تكشف عن جوهر الإنسان في تعدده، وعن لغته كمرآة للوجود، وعن تاريخه كمساحة لتجربة المعنى.
ولعلّ ما نحتاجه اليوم، في زمن تغوّل التقنية (High-Tech) وتشييء الإنسان في مقاييس السوق والبيانات الضخمة، هو إعادة إحياء هذا "المنعطف الأنطولوجي الحاسم"، لكي نستعيد مركزية السؤال الإنساني: ما معنى أن نكون؟. فهذا السؤال، الذي بدا في زمن الحداثة ترفاً فلسفياً، هو اليوم شرطٌ وجودي أمام أزمة المعنى التي تهدد الحضارة المعاصرة.
خلاصة:
العلم الإنساني في أفق المنعطف الأنطولوجي ليس بديلاً عن العلم الطبيعي، ولا نسخة مشوّهة عنه، بل هو مسعى آخر: مسعى الكشف عن الإنسان بوصفه كائناً متناهياً، لغوياً، تاريخياً، وزمنياً. وهذا ما يجعل الفهم الذاتي – كما طرحه دلتاي، وأعاد صياغته هايدغر، ووسّعه ريكور – قلب العلوم الإنسانية ومعيار استقلاليتها.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - بر لين