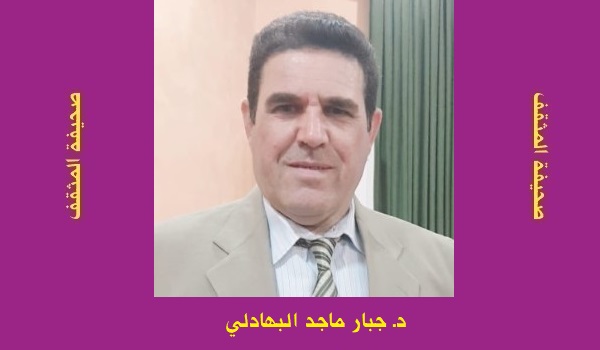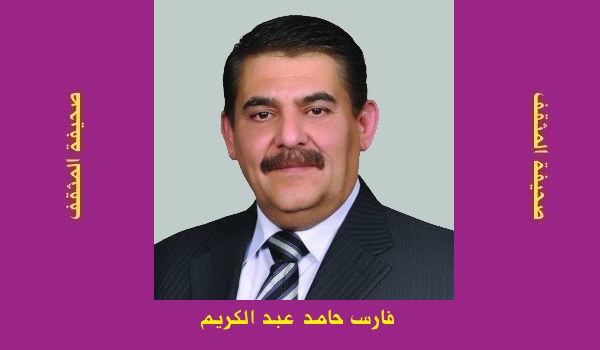قضايا
عدي البلداوي: الفلسفة بوصفها ثقافة ضرورية في عصر الذكاء الإصطناعي

يعدّ موضوع الإنسانية أعمق فكرة اشتغل عليها العقل البشري منذ بواكير وعيه بوجود الإنسان، وبعلاقته بالمجتمع والطبيعة. نتج عن هذه الفكرة العميقة، إستفهامات كثيرة ودقيقة، ارتبطت بكل ما له علاقة بطبيعة الإنسان. وأمام هذه الإستفهامات كان لا بد من إجابات يطمئن اليها الإنسان كي يستمر في حياته، وفي رغبته وعطائه. هكذا بدأت علاقة الإنسان بالمعرفة والبحث والتأمل، ثم مر الزمن على ثلاثية المعرفة والبحث والتأمل لتظهر الخبرة كلون أساسي يسهم في رسم صورة مطابقة للواقع، أو هي أقرب ما تكون لطبيعة الواقع. وفي رحلة التأمل والإستفهام والمعرفة والخبرة هذه، ظهرت الفلسفة، التي بدأ المرحوم الدكتور حسام الدين الآلوسي حديثه عنها في الفصل الأول من كتابه (الفلسفة والإنسان)، الصادر سنة 1990م بعبارة (لا يعلم أحدٌ متى بدأ التفلسف)، لكنه يرى ان التفلسف طبيعة إنسانية يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات الحية، ليصل بعد ذلك الى ان التفلسف ضرورة إنسانية.
عن تعريفها، قيل ان الفلسفة هي حب الحكمة. وانها من طرق البحث عن الحقيقية. وانها شكل من أشكال طهارة الروح وسعي النفس نحو الفضيلة في رأي (سقراط). وفي رأي (افلاطون) هي السبيل لفهم الجمال والخير. استخدمها (ديكارت) سبيلاً للوصول الى الحقيقة. وعدّها (ايمانويل كانط او كانت) حدّاً فاصلاً بين ما يمكن معرفته وما لا يمكن.
من التعريفات المعاصرة التي أراها قريبة جداً من لغة العصر وروحه، ما تناوله الدكتور حسام الدين الآلوسي في كتابه (دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي) الصادر سنة 1992م إذ يقول (تعني الفلسفة، حسب اشمل تعريف لها واكثره قبولاً عندنا : انها نظرة الى العالم، وشكل من أشكال معرفة الواقع، الذي هو الإنسان والمجتمع والطبيعة، وهي موقف يعكس الوعي الإجتماعي الى جانب الأشكال الأخرى التي يتمظهر فيها هذا الوعي الإجتماعي، وباعتبارها موقفاً إجتماعياً فهي ذات بعد ايدلوجي يعبر عن المصالح المادية للطبقات المختلفة.
وللتبسيط نقول إن الفلسفة موقف، سواء كان هذا الموقف، عن إدراك ووعي أو لم يكن، فموقف الإنسان الأول الذي يقدم القرابين للإلهة ويعتقد بوجود أرواح معينة، وحياة أخرى، هو موقف فلسفي بهذا المعنى أو ذاك، وكذلك موقف المؤمن العادي الذي لم يتجاوز مرحلة " التقليد" في إعتقاداته خالية من البراهين والأدلة العقلية، هو موقف فلسفي بهذا المعنى أو ذاك.... على ان للفلسفة معنى أدق، وهي انها التفكير الحر المنظم والمتناسق والواعي..).
بناء على ذلك، فهدف الفلسفة هو الإنسان، والثقافة في الفهم الانثروبولوجي هي دراسة طريقة حياة الناس وانماط سلوكهم. إذن العلاقة بين الفلسفة والثقافة علاقة مترابطة، محورها الإنسان والطبيعة. فإذا كانت الثقافة بحكم اسبقيتها التاريخية مقارنة بالفلسفة، قد بدأت مع حياة الانسان الفطرية، فيمكن القول إن الفلسفة بدأت مع حياة الإنسان المعرفية.
واذا كان للثقافة نصيبها الكبير في التعبير عن الواقع، فإن للفلسفة نصيب كبير في تغيير ذلك الواقع. فالثقافة تهيئ للفلسفة أدوات عملها، وبدورها تطور الفلسفة ادوات الثقافة. ولعلي استطيع القول ان الفيلسوف مثقف بالضرورة، والمثقف فيلسوف بالصيرورة.
يشهد العالم منذ بدايات القرن الواحد والعشرين تسارعاً مذهلاً لتطور العلم والتكنلوجيا، فهناك صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت البالغة 343 متراً في الثانية، ويتوقع في المدى القريب رؤية قطار يسير بسرعة تقترب او تصل الى سرعة الصوت. هناك سيارات ذاتية القيادة، واجهزة كهربائية منزلية ذكية. وهناك روبوت عالي الدقة، يتوقع له الخبراء في مجال الذكاء الإصطناعي أن يفوق قدرة العقل البشري في العقود القادمة الى الحد الذي يصعب أو يتعذر فيه التمييز بين العقل البشري والعقل الآلي. لذا على المثقف العربي اليوم إعادة النظر في حركة ثقافته، واعادة توجيهها بما يمضي بالحياة في إتجاه لا يرغم المجتمع على الإبتعاد عن هويته العربية الإسلامية، ولا يعرّض أفراده للتهجين الثقافي.
فهل هذا الأمر ممكن؟.
لا تخلو خطوات التجديد الثقافي من صعوبات جمّة، ومعوّقات كثيرة ، وتحديات كبيرة. لكن الإعتقاد بصحة فلسفة الفكرة يمنح أصحابها الإصرار على المضي في طريق التجديد وسيوظفون خدمات التقنية المتطورة لهذا الغرض، وسيوفرون سبلاً آمنة تبتعد بالناس عن الإصابة بالأعراض الجانبية لسوء إستخدام التقنية الذكية.
قد يبدو الكلام إنشائياً. لكن اذا علمنا ان له تطبيقات عملية فردية هنا وهناك، نجح اصحابها بوعيهم، في بلوغ هذا الهدف الذي بات مطلباً ملحّاً في عالمنا العربي الإسلامي، فهناك جهود كبيرة لكتاب ومثقفين على شكل كتب، ومقالات، وبحوث، ودراسات، ومحاضرات، وانماط سلوكية، ومناهج مهنية، وطرق حياتية، وعلاقات اجتماعية، من الضروري تعميم هذه المبادرات الفردية، لأن خطورة ترك الشارع العربي يتحرك بإتجاه التهجين، سيضع المجتمع العربي في محنة جديدة، ستفرض عليه اللجوء الى قوة اقتصادية، أو عسكرية، قادرة على ضبط إيقاع الإزدواج والإضطراب الذي سيحصل في الشخصية بين قبولها الإضطراري بالواقع المادي، وبين ميلها الإختياري الى الوجود الروحي أو الديني، وهذا ما يجعل المجتمع يتقبل وجود قوى مالكة للمال والسلاح في السلطة، وان كانت تلك القوى فاشلة. وهذا مؤشر خطير في مجتمع لم يشهد رخاءً إقتصادياً، ولا تمكناً ثقافياً، ولا إستقراراً أمنياً منذ بدايات القرن الواحد والعشرين حيث الإحتلال الأمريكي للعراق والربيع العربي في مصر وتونس وليبيا واحداث الإرهاب والإضطراب السياسي الذي تلوح به تصريحات دول كبرى ومسؤولين كبار هنا وهناك.
يقول الدكتور الآلوسي في صفحة 185 من كتابه (الفلسفة والإنسان) (ان الفلسفة موجودة في أي مجتمع في الأقل منذ بضعة آلاف من السنين، موجودة في الفرد بأي درجة من الوعي أو عدم الوعي، وموجودة في المجتمع بشكلين بشكل وعي منظم، وبشكل شعبي اعتيادي يفصح عنه مجموع ما تواضع عليه المجتمع او فئات منه، وفي التقاليد ومختلف أشكال الشعور والتفكير والعمل لدى الجماعة...).
بهذا التعريف السهل والمبسط الذي قدّمه الدكتور جمال الدين الآلوسي للفلسفة وفي ضوء توقعات خبراء الذكاء الاصطناعي وشركات انتاج التقنية من ان المستقبل التقني الرقمي سيوفر تطبيقات ذكية تخاطب حاجات النفس وميولها في المستخدم وتعفيه من التفكير بوجود ذكاء اصطناعي مستعد وفي كل الاوقات لتقديم اجابات ونصائح ومقترحات وحلول لكل ما يخطر على بال المستخدم او يعترضه في حياته اليومية. ومع ما يمكن ان تحمله هذه التقنية المتطورة من خدمة كبيرة جداً، فإنها ستشكل خطراً على الجانب الإبداعي في الذات الانسانية المرتكز على قدرة العقل على التفكير والابداع، فإذا تعطل او اهمل هذا الجانب الأنساني، اصبح الانسان كتلة بشرية اقرب الى الآلة الذكية منه الى الإنسان الحيوي المبدع المفكر، واذا اصبح الانسان كتلة بشرية، تحول المجتمع الى تجمعات بشرية. واذا تحول المجتمع الى تجمعات بشرية، فقدت البشرية حضورها الحياتي واستحالت الحياة الى روتين لا بد منه، والاستمرار فيها مرهون بدرجة تفاعل تلك الكتلة البشرية بمنتجات شركات التقنية الرقمية، فالتسوق سيضحى ميزة حياتية، وستصبح كثرة الاستهلاك مؤشراً حياتياً. عندها سيمكن تعليب المشاعر وتسطيح العقول، وفرض الفردية كحل للتخلص من الحاح الضمير على تفعيل الشعور بالمسؤولية، وفي الحرية الرقمية مجال لهذا. لذا سنكون بحاجة الى وجود الفلسفة كنمط حياتي يعيشه كل شخص، يعطيه الشعور بأنه كائن متفوق، لا يزال قادراً على العطاء والابداع بوصفه فيلسوفاً بالقدر الذي تمليه عليه معرفته ودرجة تعليمه ومدى فهمه لحياته وتصوراته للواقع. فالفلسفة تحث صاحبها على الاستفهام والاستعلام، وادوات التقنية تساعده في الحصول على نتائج الاستعلام. ومن مزج الاستفهام بالاستعلام سيتمكن المستخدم من تكوين تصور ولو بسيط عن مكانه على خارطة العالم اليوم، واتجاه حركته فيها، لكي يتمكن من توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة وعيه، وان لا يخضع لهذه التقنية المتطورة كونها حل سهل متوفر مقبول. وبوجود الاستفهامات التي يطرحها علم الانثروبولوجيا وهو يدرس ثقافة عصر الانسان، سيتمكن المستخدم العربي من رؤية حاضره رؤية مستقبلية متواصلة مع الماضي. لا من حيث التقليد، ولا من حيث التقييد. ولكن من حيث إعادة بناء الزمن لتغيير النفوس من اجل تحريرها من قبضة القوة المهيمنة على المشهد الحياتي في حاضره التي ربما تكون قوة غير صديقة للانسان والبيئة.
***
د. عدي عدنان البلداوي