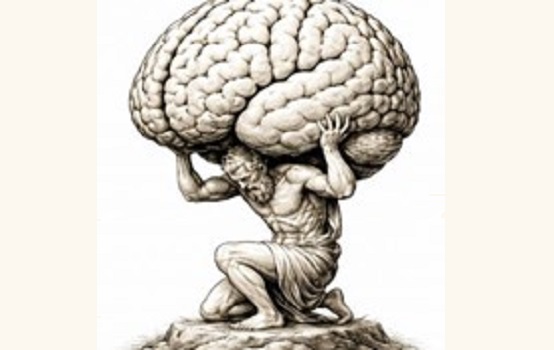قضايا
تماضر كريم: التجمعات الثقافية وصناعة الوعي

ثمة مؤشرات واضحة تشيرُ إلى إن إنشاء المجموعات سببه الخوف، مثل إنشاء المدن، والإتحادات غير بعيدٍ عن إنشاء الأحزاب والمنظمات، وربما الأُسر، وحتى الصداقات.
الخوف من الوحدة والمجهول، وهرباً منهما إلى دفء القطيع، والركون إلى الآخر أياً كان، ليستمر الوجود.
مواجهة القدر مستقلين هي درجة من درجات النضج الروحي، لم نتحصل عليها بعد، نحن لازلنا نحبو، لازلنا أطفالاً، تكسرنا عواطفنا الهشة، تكسرنا الطبيعة بتقلباتها الجبارة من عواصف وزلازل، وتغيراتها العادية من رياح وأمطار، تكسرنا أجسادنا برقتها أمام أي مرضٍ تافه، لذا نقترب من بعضنا ونشيد حضارتنا التي تؤمننا من الخارج الغاشم والوحشيّ.
لم تعد التجمعات تتشكّل بدافع الحصول على الأمان النفسي فحسب، لأنها ما عادت فطرية ساذجة، عاطفية بدائية، مع تعقد الحياة أخذت التجمعات منحىً جديداً يتسم بالتماثل، قومي، عرقي، ديني، قبائلي، مذهبي، ثقافي….
أقف قليلا هنا عند التجمعات الثقافية، الواقعية منها والألكترونية، حيث تم تشكيل العشرات منها، وشهدت إنضمام عدد هائل من الكتاب والأدباء، من أصحاب المواهب ومن أنصاف الموهوبين وحتى من عديمي الموهبة. لكن ما المشكلة؟ هل يثقلون كاهل الدولة براتب شهري مثلاً؟
لماذا لاندعهم يحاولون جعل العالم مكاناً أفضل برؤاهم العميقة أحياناً، والساذجة أحياناً أخرى، هكذا يقول البعض، رداً على القول بترهل التجمعات الثقافية على حساب إنتاج المعنى، وإحداث التغيير المطلوب على المستويين الثقافي والإجتماعي، لكن إجابةً من هذا النوع تبدو متهافتة أمام ما يتم توقعه من التجمعات الثقافية، لاسيما وهي بهذا الحجم، وإذا أخذنا بنظر الإعتبار الإقبال الكبير على الإنضمام لاتحاد الأدباء، فضلا عن تجمعات أخرى، فما هو المنتظر من هذا العدد الكبير من الشعراء والقصاصين والكتاب ضمن تجمع واحد، غير عقد الجلسات وإقامة المهرجانات، وهل تعد الجلسات والمهرجانات غاية بذاتها؟
إن نظرة سريعة على الجلسات التي تُعقد هنا وهناك تعطينا انطباعاً واضحا عن قلة الأعداد التي تحضر، ناهيك عن متوسط الأعمار الذي يشير بوضوح إلى أن أعمار الحاضرين غالباً بين٤٥-٧٥، أما المهرجانات فيمكن ملاحظة بوضوح تلك الفوضى المصاحبة لها من انتقادات ولغط حول توجيه الدعوات، وأمور أخرى تؤثر على رصانة المهرجان وتحقيق جدواه.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال وهو ماذا على الإتحادات الأدبية والثقافية أن تفعل لكي نحصل في الجلسة على حاضرين يشغلون نصف عدد المقاعد على الأقل بمتوسط أعمار من ٢٥- ٧٥، وكم من جهد ومهنية نحتاج كي تكون مهرجاناتنا فاعلة مؤثرة، دون أن يكون همُّ الأديب الوحيد وشغله الشاغل هو توجيه دعوة إلى فلان دون فلان، ثم إلى أي حد نحن قادرون على غرس ثقافة التفكير بالتجمعات الثقافية كمؤسسة هدفها إنتاج معنى وصناعة وعي؟
إنها تحديات كبيرة تواجه المؤسسة الثقافية برمتها، كوزارة واتحاد أدباء، وتجمعات أخرى تمتد على طول البلاد وعرضها.
برأيي أن الخطوة الأولى في صناعة الوعي، وتحفيز الشباب على القراءة ومتابعة الحركة النقدية، وبالتالي حضور الجلسات، وإبداء الرأي، والتفاعل مع المنتج الأدبي يتم أولاً عبر التنسيق بين وزارتي الثقافة والتربية، حيث سيكون على الوزارتين وضع خطة سنوية لتكثيف النشاطات التي تشجع الأطفال والناشئة على القراءة، مسابقات، دروس تدريبية، رحلات، مبادرات جديدة، وأفكار مثل استحداث فكرة الطفل القارئ، ولابأس بالإفادة من الممارسات المشابهة في الدول المجاورة أو البلاد الغربية التي عُرف عنها اهتمامها بخلق جو ثقافي مجتمعي عام.
إن الترهل في المؤسسة الثقافية من حيث عدد الأعضاء، يقابله ضعف عام في لإقبال على القراءة، وتدنٍ في الذائقة، ففي حين يتم إصدار عشرات الهويات لأعضاء جدد، لتكون صفة الأديب رسمية، يتراجع في الوقت ذاته محتوى المؤسسة بمعناه الأعمق والأشمل، لكن هل هي دعوة لتقليص الأعداد، عبر تعقيد عملية القبول؟ بالطبع لا، لكن ماذا لو لم تكن هناك صفة رسمية للأديب؟ هل سيظل قادراً على مواصلة الإبداع، وإحداث فارق؟ أظن نعم.
في بغداد وحدها عشرات التجمعات الثقافية، وهي بمثابة قناديل تضيء ما أفرزه تاريخ بغداد المتخم بالقهر والحروب من عتمة، لكن هذه التجمعات، وعلى رأسها الإتحاد العام في خطرٍ داهم من أن تتحول إلى دوائر رسمية يفتك بها الروتين، روتين الجلسات والمهرجانات الخالية من المعنى، والبعيدة عن الهدف الرئيس في بناء الإنسان ثقافياً وإنسانياً.
***
تماضر كريم – أديبة وكاتبة عراقية