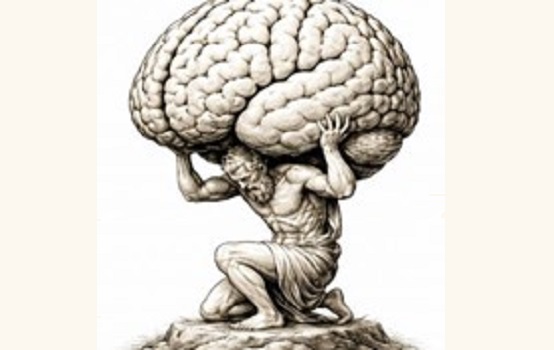قضايا
عبد الحسين شعبان: "الإسلاموية" و"العلمانوية"

ظلّ الجدل محتدمًا بين تيارين، كلاهما يزعم امتلاكه للحقيقة ويدّعي الأفضلية، بل يتعصّب لفكرته لدرجة يتم فيها "شيطنة الآخر"، التيار الأول - يطلق على نفسه اسم "الإسلامي"، وإن كان يمثل طيفًا واسعًا غير متجانس من الذين يندرجون تحت هذا العنوان؛ أما التيار الثاني - فيصف نفسه ﺑ "العلماني"، حتى وإن كانت مرجعياته الفكرية مختلفة، بل ومتناقضة.
يرى بعض الإسلاميين، وبشكل خاص الإسلامويين، أن العلمانية مصطلح غربي، وهي بالأساس وجدت لحل مشكلة في الغرب، حتى وإن كانت نتائجها إيجابية في سياق تاريخي، بفصل الكنيسة عن الدولة، إلّا أنه لا يمكن تطبيقها على مجتمعاتنا، لأن الأرضية مختلفة تمامًا، والإسلام "دين ودولة".
ومثل هذه المبررات تلقى هوىً كبيرًا لدى جمهور واسع، حيث يتم تصوير العلمانية بأنها فكرة مستوردة، أي أنها لا تمتّ إلى عالمنا الإسلامي بصلة، وهدفها التغريب وقبول الاستعمار الثقافي، خصوصًا حين يتم ربطها بالإسفاف وإشاعة الرذيلة والانحلال الأخلاقي والفساد القيمي، بل إنها ملازمة للكفر، وذلك في إطار الدعاية السياسية والمنافسة المجتمعية ضدّ العلمانية.
لكن ثمة آراء إسلامية منفتحة، تلك التي تعتقد أن لا وجود لمفهوم الدولة الدينية في الإسلام، كما يذهب إلى ذلك محمد عمارة، ويدعو السيد محمد حسين فضل الله إلى "دولة الإنسان"، وبهذا المعنى يقدم الإسلام شؤون المجتمع وسياسة الدولة وأمور الدنيا في الحياة، و هو ما فعله النبي محمد (ص) حين اضطر الهجرة إلى المدينة المنورة، فوضع دستورًا هو نواة أولى لدولة مدنية تحترم الأديان، بعد أن كان في مكة مبشرًا .
أمّا العلمانيون فإنهم أيضًا يحاولون "شيطنة" التيارات الإسلامية، ولا يفرقون أحيانًا بين الإسلاميين والإسلامويين، بل ويعتبر بعضهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، أن كل ما يمتّ إلى الدين بصلة هو متخلّف ورجعي، حتى وإن قصدوا بذلك بعض الطقوس والشعائر، التي تمارس باسمه، وتمثل درجة تطور الوعي الديني والمجتمعي في حقبة زمنية معينة، وهذه قد لا يكون لها علاقة بالدين، وإنما تندرج في خانة التديّن، وهكذا يتم الخلط بين الدين والتديّن، فتكال الاتهامات تحت هذه المسوّغات، في حين أن الدين منظومة قيم إنسانية وأخلاقية، تدعو إلى السلام والتسامح والعدالة والمساواة والشراكة والإخاء.
وقد حاول بعض العلمانيين الابتعاد عن المفهوم المبالغ فيه للعلمانية المغالية، "العلمانوية"، فتبنوا مفهوم "الدولة المدنية"، وهي حسب بعض تفسيراتها، تقف على مسافة واحدة من جميع المجموعات الثقافية الدينية والقومية واللغوية والسلالية، وتحمي جميع أفراد المجتمع. وقد يكون من المفيد استخدام مصطلح "الدولة القانونية" التي تقوم على المشروعية القانونية، بمعنى حكم القانون، وتتجسّد شرعيتها السياسية برضا الناس وتقديم المنجز لهم، فللدين حقله الروحاني والعقائدي والإرشادي، أما السياسة فهي ميدان للمصالح، وحتى لو اجتمعت العقيدة مع المصلحة، فلا بدّ من تكييفهما مع الواقع المتطوّر باعتباره هو الأساس والمتغيّر.
وإذا كان بعض الإسلاميين، والإسلامويين بشكل خاص، يميلون إلى "أدلجة" الدين وتسيسه بالضدّ من تعاليمه، بتبرير أعمال العنف والإرهاب، وهو ما قامت به تنظيمات القاعدة وداعش وأخواتهما، بحيث فقد طابعه الروحاني والأخلاقي والإنساني، فإن بعض العلمانيين يتنكرون للدين ودوره، كمرجعية للمجتمع. ويذهب محمد أركون إلى نقد العلمانية، التي كانت في بدايات عصر التنوير طاقة تحرريّة، لكنها ما لبثت أن تحوّلت إلى نوع من التسلط والهيمنة، كما هي العلمانية في ألمانيا النازية وفي الكتلة الاشتراكية وبعض نسخها العالمثالثية.
هكذا تفسخت العلمانية، خصوصًا عند استعمار أمم وشعوب، ونهب ثرواتها وخيراتها، بزعم تمدينها، إضافةً إلى دعم أنظمة استبدادية متخلّفة مفروضة عليها بفعل النظرة المركزية الأوروبية، التي ما تزال مهيمنة في النظر إلى شعوب البلدان النامية، وذلك لضمان مصالح الغرب، وخير مثال على ذلك، الموقف من حرب الإبادة على غزّة، حيث أصبح العقل دغمائيًا وذرائعيًا ومصلحيًا، وأصبحت العلمانوية دينًا جديدًا، لا يقل دغمائيةً عن دغمائية الإسلامويين أو المتأدينين، خصوصًا برفض التعددية أو العجز عن استيعابها، فضلًا عن احترام حقوق الإنسان وحريّاته الأساسية، ولاسيّما حقه في الحياة والعيش بسلام وتقرير مصيره بنفسه.
وإذا كان هناك علمانيون يميلون إلى قبول المرجعية الإسلامية للدولة المدنية، فإن بعض الإسلاميين أخذ بمصطلح العلمانية المؤمنة، أي غير الإلحادية ذات المرجعية الإسلامية، وهؤلاء ينفتحون على التيارات العلمانية، ولا يجدون ضيرًا في ذلك، في إطار مصالحة تاريخية ومبادرة شجاعة لجعل الدولة مدنية بامتياز، مع كون الإسلام مرجعيتها الحضارية بكلّ ما يحمل من معان إنسانية وأخلاقية سامية.
***
د. عبد الحسين شعبان