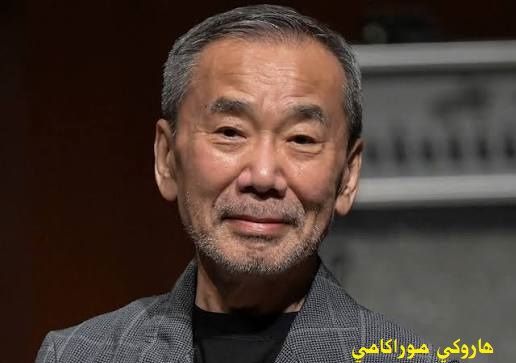نصوص أدبية
منذر فالح الغزالي: لوحةٌ ناقصة

في حيٍّ قديمٍ من ضواحي مدينة كولن، يقع منزلٌ من طابقين بطرازٍ تقليدي، مميّزٌ بنوافذه الخشبية الواسعة وجدرانه من حجر البازلت، وحديقته الكبيرة، بشجرة الكرز المعمّرة. ورثته إريكا شولتسه عن زوجها الذي توفّي قبل سنوات، وترك لها البيت وبعض المال، والكلب مولي؛ لكنّ أقسى ما ورثته كان الوحدة.
إريكا في أواخر الستينيات، مدرّسة رسمٍ متقاعدة، تعتني بمظهرها وبصحتها، يبدو على وجهها أثر جمالٍ قديم، تصفّف، بوقارٍ، شعرها الذهبيّ الذي غزاه خيطٌ رماديٌّ. ملأت وحدتها بأمرين: التعلّق بكلبها مولي، الذي رافقها منذ خمسة عشر عاماً، والحرص على أمسيات السبت الثقافية، التي تشارك فيها حلقةٌ ضيّقة من صديقاتها وأصدقائها من زمن الدراسة.
كان مولي رفيق إريكا الوحيد، يرافقها في كلّ مكان، يستلقي عند قدميها، وهي تقرأ في كتابٍ في المساء؛ تتحدّث معه عن تفاصيل يومها، عن ذكرياتها، عن ابنتها التي رحلت إلى هامبورغ ولا تزورها إلا نادراً. تقول له بمزاحٍ، وهي تلمس رأسه: "لو لم تكن هنا، يا مولي، لكنت تحوّلتُ إلى تمثالٍ من حجر".
منذ عامين فقط سكن عندها سامر، شابٌّ سوريٌّ في أواخر العشرينيات، نحيلٌ؛ لكنه مستقيم القامة، بجبهةٍ عريضةٍ، ولحيةٍ خفيفة، معتدٌّ بذاته من غير تبجّحٍ، جاء من دمشق بعد رحلة لجوءٍ طويلةٍ وشاقّة.
تعرّفت إريكا على سامرٍ بطريقةٍ غير متوقّعة؛ كانت، كلَّ مساء، تتنزّه مع مولي قرب ضفّة الراين، وكان يلفت نظرها ذلك الشاب الغريب الذي يجلس دوماً على المقعد الخشبيّ، يقرأ كتاباً بصمتٍ واستغراق.
ذات مساءٍ خريفيٍّ، والنسمة خفيفةٌ محمّلة برائحة النهر، كان سامر يجلس كعادته على المقعد الخشبي غارقاً في أفكاره، لا يهتمّ بما حوله، اقترب مولي منه، ومدّ أنفه نحو ساق سامر العارية، فانتفض سامر فجأة، ودفع ساقه بعنفٍ دون وعي، لتصطدمَ بأنف الكلب الذي انسحب يعوي نحو صاحبته. هرعت إريكا غاضبةً: "كيف تجرؤ على أن تؤذي كلباً مسالماً؟". ارتبك سامر، وراح يدافع عن نفسه: "لم أقصد. هو الذي فاجأني. لقد تحرّكت بلا وعي!". لكنّها لم تقتنع بدفاعه، ارتفع صوتها، وهدّدته بأنها ستستدعي الشرطة. كانت توبّخ سامر، بالقدر نفسه الذي تواسي فيه كلبها العزيز.
ظلّ سامر يكرّر اعتذاره، ويؤكّد إنه لم يقصد إيذاء الحيوان، حتى هدأ الموقف بعد جدالٍ طويل. في النهاية قبلت اعتذاره علـي مضضٍ، ولم تطلب الشرطة "رأفةً بحالك! لأنك لاجئٌ من الحرب، لن أزيد معاناتك بمشاكل مع الشرطة".
منذ تلك الحادثة، تغيّر كلّ شيء؛ صارت تجلس، أحياناً، إلى جوار سامر على المقعد الخشبي، تتحدّث معه بحذرٍ في البداية، ثمّ صارت تترفّق معه بالكلام مع مرور الأيام. عرفت قصة لجوئه والحرب في وطنه، لم تعد تخشى على مولي حين يقترب منه، بل لاحظت أنّ الكلب نفسه صار يأنس به. من هنا بدأت صداقةٌ صغيرةٌ بينهما، انتهت بعرضها له أن يستأجر الغرفة العلويّة في منزلها.
انتقل سامر للسكن في المنزل، توثّقت العلاقة بينهما. مع الوقت أصبح سامر جزءاً من يومها. لم يقتصر حضوره على دفع الإيجار، بل كان يشاركها في تفاصيل الحياة الصغيرة، يساعدها في قصّ عشب الحديقة، وتبديل مصابيح الكهرباء العالية، ويصلح ما يمكنه إصلاحه في البيت، وأحياناً يرافقها إلى مكتب البريد، أو يذهب معها للتسوّق، يحمل الأكياس الثقيلة، وصناديق زجاجات المياه. هذه التفاصيل جعلت وجوده مألوفاً بين ضيوفها وأصدقائها.
بالتدريج صار يشارك في أمسياتها الثقافية، وصارت إريكا تقدمه أمام ضيوفها بعبارةٍ نصف مازحة: "هذا سامر، ضيفي، ومثل ابني"، وبلباقةٍ وذكاء يصحّح قائلاً: "مثل أخيك.. أشعر أنك مثل أختي الكبرى"، تبتسم إريكا، وتضيف: "لقد صرتَ فرداً من عائلتي الصغيرة، أنا ومولي". يبتسم سامر بخجلٍ، متقبّلاً موقعه الجديد في تلك "العائلة الصغيرة".
كان سامر يشعر، أحياناً، أنّ وجوده في هذا المنزل هو تفصيلٌ رمزيّ، تكمل به إريكا لوحة حياتها، أكثر من كونه جزءاً أصيلاً من هذه الحياة؛ مع ذلك، تقبْل هذا الدور برضا وامتنانٍ عميق.
في إحدى أمسيات الشتاء، اجتمع الضيوف في صالة المنزل الدافئة. حيث انتشرت الشموع فوق الطاولة، تعكس ضوءها الخافت على الكؤوس الصغيرة، وعبق الجوُّ برائحة القهوة الطازجة. جلست إريكا بفستانٍ كحليٍّ، وقد زيّنت أذنيها بقرطين ثمينين من الفيروز، عزيزين على قلبها، ورثتهما عن والدتها. جلس مولي، كعادته، قرب قدميها كحارسٍ وفيْ صامت.
كان بين الحاضرين فولفغانغ أستاذ الفلسفة المتقاعد، وصديقتها القديمة إيزابيل، الممرضة المتقاعدة، وجارتها هيلغا، معلّمة مدرسة، بالإضافة إلى صحافي ألمعي يدعى رينيه، له مقالاتٌ في السياسة والهجرة.
بدأت الأحاديث كالمعتاد عن الفنّ والمسرح، وسرعان ما تحوّلت إلى السياسة. قال فولفغانغ وهو يحرّك كأسه: "أوروبا صارت مثقلةً أكثر من طاقتها... اللاجئون يزدادون، والأنظمة عاجزة عن دمجهم بشكلٍ حقيقي".
لم تعجب إريكا نبرةُ التذمر في كلامه، فبادرت بابتسامةٍ متماسكة: "أعترض قليلًا يا عزيزي، انظر إلى سامر مثلًا... يتحدّث بطلاقة، وليس، فقط، بمواضيع يومية، ألا يشكّل هذا إضافة؟"، ثم التفتت إلى سامر: "حدّثنا، من فضلك، قليلاً عن نفسك، وبلدك".
اعتدل سامر في جلسته، رفع كتفيه بتواضع، وقال بلغةٍ ألمانية، ببطء من ينتظر حضور الكلمة، وضبطها قواعدياً قبل نطقها: "كنت أحضّر بحث الماجستير في الأدب في دمشق. لدي شغفٌ بالأدب والتاريخ. لكنّ الحرب قطعت كلّ شيء. هنا أحاول العمل والتعلّم من جديد".
تدخّلت هيلغا بابتسامةٍ متردّدة: "المشكلة ليست مشكلة أفراد... مدارسنا صارت مكتظّةً بالتلاميذ من أبناء المهاجرين. أخشى أن نفقد هويتنا؟"
التقط الصحفيّ كلامها وتابع: "هل سار أحدكم في وسط كولن ليلاً؟ الشباب المهاجرون يملؤون الشوارع حتى منتصف الليل. متى كانت شوارع المدن أماكن للسهر؟ كولن لم تعد كولننا! مدننا بدأت تفقد هويتها. هذا إذا لم نتحدّث عن الأمان… من يستطيع أن يتأكّد من أيّ خلفية جاء هؤلاء؟".
ساد صمتٌ قصير. ارتسم القلق في وجه سامر، لكنه تمالك نفسه وتحدّث بلطف: "أفهم خوفك، يا سيدي. الحرب تجعل كلّ شيءٍ يبدو مضطرباً وغير آمن. لكن اسمح لي أن أقول: الشارع ليس هو مصدر القلق الوحيد على الهوية الثقافية. هل الإعلام بريءٌ من التأثير على الهويات الوطنية؟ على العموم، الهوية ليست شيئاً جامداً، إنها مثل نهرٍ بجري. حين تلتقي به جداول أخرى، يكبر ويصير أعذب؛ لكنه لا يغيّر مجراه".
رفع فولفغانغ حاجبيه وقال: "تشبيهٌ جميل... لكنّ النهر أحياناً يفيض ويغرق الأرض".
ابتسم سامر بخفّة: "صحيح؛ لذلك فالمجتمعات بحاجةٍ دائمةٍ إلى سدودٍ من العقلانية، والقوانين العادلة. أما أن نمنع الجداول عن النهر، فلن نتجنّب الفيضانات، بل سيجفّ النهر نفسه ويأسن".
تبادل الضيوف النظرات. لم يتكلم أحدٌ في الموضوع بعد ذلك، لكن كان جليّاً أنّ ردّه ترك أثراً واضحاً؛ ارتسمت الدهشة في وجه إريكا، ألقت نحوه نظرةً تفيض بالفخر، وبحركةٍ آليةٍ نزعت قرطيها ووضعتهما على منضدةٍ جانبية واسترخت في جلستها تربّت على شعر مولي المقعي بجانبها، متباهيةً باكتشافها: "ها أنتم سمعتم! مأساة هذا الشاب تذكّرنا بما نسيناه بعد سبعين سنةً من الحرب. نحن أيضًا كنّا لاجئين في زمنٍ ما".
ضحكت إيزابيل ثمّ علقت: "إريكا دائماً تحبّ تحويلَ النقاش إلى درسٍ إنساني!"
بعد ساعةٍ أو أكثر، كانت الضحكات تتلاشى حين بدأ الضيوف يغادرون. ظلّ سامر، زمناً، يساعد إريكا في ترتب الأكواب والأطباق. كانت سعيدةً بحضوره الذكيّ في الأمسية، وقبل أن تصعد إلى غرفتها، لاحظت أنّ أحد فرطيها مفقود، بحثت على الطاولات والمقاعد، وتحت السجادة الصغيرة بلا جدوى، ساورها شكٌّ ثقيل، حاولت أن تطرد الفكرة؛ لكنها عادت بقوة. تردّدت قليلاً، ثمّ اتصلت بالشرطة.
وصل ضابطان، أحدهما امرأة، فتّشا بدقة، صعدا إلى الغرفة العليا. ظلّ سامر صامتاً بذهول، يجيب باقتضاب، وقد صعقته الفكرة. نظر إلى إريكا، رأى في عينيها ارتباكاً وتردّداً، شعر بالخذلان، لكنه ظلّ يحيب عن أسئلة الضابطين بثقةٍ وهدوء. لم يجدا شيئاً. اعتذر الضابطان بأدبٍ وغادرا. جلس سامر على سريره يشعر أنّه تلقّى طعنةً في قلبه. كان يعرف أنّ الشكّ سيظلّ يلاحقه، حتى لو أثبت براءته، لكن ما يحزّ بنفسه أكثر، أنّ إريكا التي قدّمته كابنٍ لها، متباهيةً أمام أصدقائها، وضعته في دائرة الاتهام من أول تجربة.
جلست إريكا حزينةً على الأريكة، ركض نحوها مولي يتمسّح بركبتيها، لمحت شيئاً يلمع في ثنايا شعره، شهقت: "القرط!". انتزعته برفق: "يا مشاغب! أخذتَ كنزي الصغير؟!"، ضحكت من قلبها، ثم نظرت حولها ولم تجد من يشاركها الضحك سوى صدى الجدران. تذكّرت سامر في الطابق العلوي، وشعرت بوخزةٍ من الأسى، فكّرت أن تصعد لتعتذر، ثم عدلت عن ذلك، وقرّرت أن تدعوه في الصباح لتخبره كيف وجدت القرط، وتخفّف عنه ثقل هذه الليلة.
استمرّت الأمسيات في منزل إريكا؛ لكنّ شيئاً في أعماق سامر تغيّر. صار قليل الكلام، لا يشارك في النقاشات كما كان؛ يكتفي بابّتسامةٍ صامتة، أو جملةٍ مقتضبة. فضّل الاكتفاء بأعماله الصغيرة في المنزل: جزّ عشب الحديقة، وإصلاح إطار نافذة، أو مسح الغبار عن مصباحٍ مرتفع، وترتيب حطب المدفأة. أما إريكا، فلا تزال تناديه "ابني"، دون أن تلاحظ الشرخ العميق الذي حفرته تلك الليلة في داخله.
***
قصة: منذر فالح الغزالي
Wachtberg, 24.08.2025