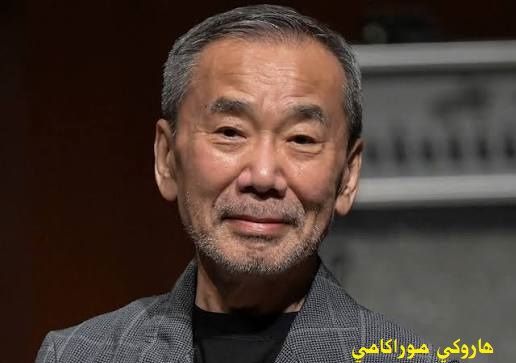نصوص أدبية
جميل حسين الساعدي: رحلة في أعماق الزمن

كان الوقت منتصف الليل، وقدْ خيّمَ السكونُ على القرية وأخذت الأنوار المنبعثة من كوى البيوت تنطفئ تدريجيا، إشارة إلى بدء وقت النوم إلا كوّة واحدة ظلّت ساهرة، يتسرّب عبرها ضياء ضعيف من مصباح نفطي ليلتقي بالضياء المنبعث من نجوم لا حصر لها، كانت تتألق في تلك الساعة على صفحة السماء الصافية.
لمْ يشعرْ الشاعر بحاجة إلى النوم، فقد كانت عيناه تتطلّعان إلى شعاع المصباح الصغير. أمّا أفكاره فقد كانت تطوف في عوالم بعيدة بُعْد َ تلك النجوم، التي توشك أن لا تدركها الأبصار لبعدها السحيق، وأحسّ على حين غفلة بصفاء جميل يغمر كيانه، وانبعث في أعماقه شعور قويّ بأنّهُ قد تحرّرّ نهائيا ً من الجسد، وبأنّ روحه اتخذت شكل طائر غريب له القدرة على اختراق المسافات والأزمنة بسرعة فائقة كلمح بالبصر.
وانطلقت روحه كالبرق تعبر بوّابات الأزمنة واحدا واحدا حتّى حلّقت أخيرا في سماء الزمان الأول. وعلى حين غرَة انبعثت فيها الأشواق البدائية الصافية في مراحل الخلق الأولى وغابت في جمال الإطلالة ألأولى للأشياء. فالأرض ما تزال في فرحها الطفولي تعيش بهجة الخلق الجديد، والكائنات الحيّة قد اتخذت مواقعها، التي أعدّها لها الخالق في خارطة الخلق: الطيور في الفضاء، الحيتان والأسماك في البحار، والوحوش الكاسرة في الغابات وهكذا دواليك.
حلّق الشاعر فوق السهول والوديان والمياه. كان كلّ شئ يجري مثلما أراد له الخالق، واستمرّ في التحليق بموازاة الأرض حتّى أبصر على مسافة غير بعيدة شبحين ضخمين، توقّف عن التحليق وهبط إلى الأرض ليستقرّ على ربوةٍ صغيرة وأخذ يراقب الشبحين، وفي هذه الأثناء سمع تغريداً جميلاً ينبعث من فوقه، رفع رأسه فلمح طائرين جميلين. كان الطائران يحركان أجنحتهما في إيقاع جميل ويطلقان أصواتا ً جميلة احتفاء ً بإطلالة اليوم الجديد. امتلأ قلبه بفرح ٍ صاف ٍ وأخذت بلبّهِ روعةُ المشهد، حتّى أنّهُ نسي كلّ شئ من حوله ِ وانتقلَ بأحاسيسهِ إلى دنيا من الالوانِ والأضواءِ تنبعث من أعماقها نغماتٌ تحملُ دفءَ وانسيابيّة الحياة البدائية وغاب في سحر تلك الدنيا واستغرقَ في متعها الجمالية، لكنّهُ سرعانَ ما انتزعهُ صراخٌ مروّعٌ من تلك الدنيا، وعاد ليجد نفسه فوق الربوة، وصوّب بصره في اتجاه مصدر الصراخ، فلمحَ أحد الشبحين ممدّدا ً على الأرض يلفظُ أنفاسه الاخيرة. أمّا الشبح الثاني فقد وقف عند رأس ضحيته يتأملها حتّى سكنَ فيها الحراكُ نهائيا. بعدها استدار ناحية الشرقِ وانصرف.
اقترب الشاعر من القتيل، تفرّس في وجههِ وفي أعضاءِ جسمه، فعرف فيه ذلك الإنسان، الذي تحدّثتْ عنه الكتب القديمة: هابيل الذي قتله أخوهُ قابيل حسدا ً.
في تلك اللحظة انطفأ سحر الوجود في نفسه وتحوّل العالم في مخيّلته إلى خرائب تعصف فيها رياح سوداء مجنونة. فقرر أن يغادر عالم الزمان الأول وعالم الجريمة الأولى، وهكذا عبر بوّابة الزمن الأول إلى الزمن الثاني. كان العالم في الزمان الثاني ما يزال جميلا لم يفقد من جدّته الكثير. تنقّل الشاعر من مكان إلى آخر يمتّع نظره بجمال الطبيعة الخلاّب، حتّى وجد نفسه أخيرا على سفح جبل، تلفّت حوله فأبصر عددا ً من الرجال، يحملون في أيديهم رماحا، يطاردون رجلا وامرأة. كان الرجل وزوجته يلتقطان الحجارة الصغيرة ويقذفان بها الرجال المهاجمين، وهكذا تمكّنا من مشاغلتهم بعض الوقت، حتّى خارت قواهما وهما على مقربة من كهفهما، فاضطرّا للإستسلام.
أمّا الرجل فقد ربطت يداه ورجلاه بحبال الجنّب بعد أن طرح ارضا. ثمّ أنهال عليه الرجال بالرماح طعنا وهو يصرخ ويستغيث إلى ان خمدت أنفاسه. أمّا زوجته فقد كانت تحاول أنْ تخلّص نفسها من أيدي الرجال، الذين امسكوا بها بقوّة. لكن من أين لها أن تنقذ نفسها من أيدي الكثرة المسلّحة وهي المرأة الضعيفة العزلاء من السلاح. وبسرعة فائقة تمّ الفصل الاول من الجريمة، ليبتدأ الفصل الثاني منها. كانت المرأة قد طرحت أرضا في الحال وهي تطلق صرخات حادّة، رددتها جنبات الجبل. كان الرجال يهمّون باغتصابها. إلا أنّها كانت تدفعهم عنها بيديها ورجليها، حتّى خانتها قواها فلم تعد قادرة على المقاومة. وهكذا اغتصب شرف الإنسان بعدما اغتصبت حياته. ذهل الشاعر لفظاعة ما رآه وقال في نفسه:
إنّ الزمن الثاني أسوأ بكثير من الزمن الأول. وجاءه الصوت من داخله:
لم ترَ بعد أيّ شئ. ما زلت في الأزمنة السعيدة. انّ هناك ما هو أسوأ بكثير.
وانطلقت روح الشاعر تعبر بوّابات الأزمنة على غير اتّفاق، حتّى وجدت نفسها في زمان لا يبعد كثيرا عن الزمن الحالي، تلفتت حولها، كان العالم قد تغيّر كثيرا. فقد خرج الناس من الكهوف وانطلقوا جماعات في مشارق الأرض ومغاربها، نقلوا الحجارة من الجبال، كسروها وشيّدوا منها القصور والقلاع الضخمة، فنشأت بذلك المدن وحكوماتها.
طاف الشاعر بمدن عديدة، فاسترعى انتباهه التفاوت الكبير القائم بينها. فمن مدنٍ غنيّة حدّ الفحش إلى أخرى فقيرة حدّ الإقداع، ومن مدن أسكرها الجبروت إلى أخرى أذلّها الضعف.
وقال الشاعر في نفسه:
نفس التقسيم الأزلي للعالم، نفس المعاناة ما زالت قائمة. وحلّقت روحه بعيدا، حتّى حطّت في آخر المطاف على أحد الأسوار المهدّمة، نظرت أمامها فانتابها الرعب من هول ما رأت: اجساد بشريّة تركت في العراء طعما لوحوش البرّ والطيور الجارحة، بيوت هجرها أهلها وسكن فيها الصمت، وحدّث الشاعر نفسه مرّة أخرى:
يا لها من مدينة بائسة، لم يترك فيها الجبروت أثرا للحياة. إنّها صورة عن حقيقة عالم المدن، الذي يسكنه هوس الحرب، فلأترك هذا العالم الى عالم القرى، ربما يكون الأمر مختلفا تماما هناك.
وفي غمضة عين وجد نفسه في سهل فسيح، ورمى ببصره محدّقا في المدى البعيد، فلاحت له على البعد مجموعة أشباح، لم يستطعْ أن يتبيّنها، فرأى أن يختفي في مكان غير بعيد عن طريق مرورها، ليتسنى له مراقبتها عن كثب. اقتربت الخطوات حتّى اصبحت على مسافة جدّ قريبة منه. رفع رأسه يختلس النظر فوقع بصره على أربعة رجال.. ثلاثة منهم يمتازون بمتانة البنية، أمّا الرابع فقد كان بيّن الهزال، فقرّر أن يتابعهم ليعرف ما هي قصتهم، وظلّ يقتفي آثارهم ساعات طوالا، وهم يجرون من مكان الى آخر ابتغاء صيد يظفرون به، إلّا أنّ كلّ محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح. وفي طريق عودتهم قرّر الثلاثة الأقوياء أن يقتلوا رفيقهم الرابع الضعيف ويتقاسموا لحمه فيما بينهم. أحاط الثلاثة بصاحبهم من كلّ جانب وسدّوا عليه منافذ الهرب، ثمّ جرّوه بشدّة إلى شجرة ضخمة، وربطوه إلى جذعها. كان المسكين يتوسل إليهم ان يتركوه، إلا أن مسامعهم كانت مغلقة في تلك اللحظة، التي استيقظت فيها الوحوش النائمة في أعماقهم مدفوعة بحمّى الإفتراس، فغرسوا حرابهم في جسده النحيل، واحسّ الشاعر وكأنّ تلك الحراب كانت تنغرس في جسده هو.
في هذه الأثناء مزّق السكون صراخ مروّع، انطلق من أحد البيوت في القريّة، والذي حمله النسيم من بيت إلى آخر، حتّى أوصله اخيرا إلى بيت الشاعر، الذي كان غارقا في تأملاته البعيدة. انتبه مذعوراً لدى سماعه الصراخ وقال في نفسه:
ماذا من جديد؟ أيتها السماء
***
جميل حسين الساعدي