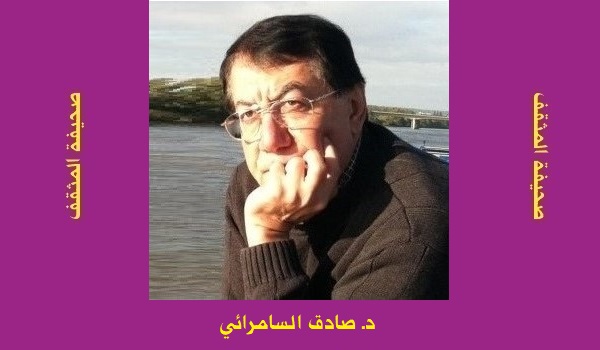شهادات ومذكرات
جوادالوبي نيتيل: الكتابة بالنور

بقلم: جوادالوبي نيتيل
ترجمة: د. محمد عبد الحليم غنيم
***
وُلدتُ ببُقعة بيضاء، أو ما يُسميه البعض "شامة خِلقية"، تغطي قرنية عيني اليمنى. لم تكن تلك البُقعة لتمثل شيئًا لو لم تمتد عبر القزحية وصولًا إلى البؤبؤ، الذي يجب أن يمر الضوء عبره ليصل إلى مؤخرة الدماغ. في تلك الأيام، لم يكن يُجرى زرع القرنية للمواليد الجدد؛ فقد قُدّر لتلك البُقعة أن تبقى لسنوات عديدة. وكما يمتلئ نفق غير مُهوَّى بالعفن ببطء، أدى انسداد البؤبؤ إلى إعتام عدسة العين. لم يكن بوسع الأطباء سوى نصح والديَّ بالانتظار: فعندما تكبر ابنتهما، سيكون الطب قد تقدم بما يكفي ليقدم الحل الذي لم يكن متاحًا حينها.
في غضون ذلك، أوصوا بإخضاعي لسلسلة من التمارين المزعجة لتنمية العين المعيبة قدر الإمكان. كان ذلك يتم عبر حركات العين... ولكن أيضًا - وهذا ما أتذكره جيدًا - عبر رقعة تُغطي عيني اليسرى لنصف اليوم. كانت قطعة قماش بلون البشرة... تُغطي جفني العلوي وصولًا إلى عظم وجنتي... كان ارتداء الرقعة يبدو لي ظالمًا وقاسيًا. كان صعبًا عليّ تقبُّل أن يُلزِموني بها كل صباح، وأن أي مكان للاختباء أو أي قدر من البكاء لن ينقذني من ذلك العذاب... مع الرقعة، كان عليّ الذهاب إلى المدرسة، والتعرف على معلمتي وأشكال أدواتي المدرسية، والعودة إلى المنزل، وتناول الطعام، واللعب لجزء من الظهيرة.
في حوالي الخامسة مساءً، كان أحدهم يأتي ليخبرني أن الوقت قد حان لخلعها، وعند سماع هذه الكلمات، كنت أعود إلى عالم الوضوح والأشكال الدقيقة. فجأة، كان كل شيء حولي يتغير. كنت أستطيع الرؤية بعيدًا، وأصبحت مفتونة بقمم الأشجار والأوراق التي لا تُعد التي تتكون منها، وبتفاصيل السحب في السماء، ولون الزهور، والتعرُّجات المعقدة في أطراف أصابعي. كانت حياتي منقسمة بين عالمين: عالم الصباح، المبني في الغالب على الأصوات والروائح، ولكن أيضًا على ألوان ضبابية؛ وعالم المساء، دائمًا ما كان مُحررًا، لكنه في الوقت نفسه، دقيقًا للغاية.
هذه هي البداية من كتاب "الجسد الذي وُلدت فيه"، الرواية التي تحكي عن طفولتي، طفولة حددتها أحداث عميقة: على المستوى الشخصي، كفاحي من أجل الرؤية بعينيّ، وعلى المستوى السياسي، نفي العديد من شعوب أمريكا اللاتينية هربًا من ديكتاتوريات السبعينيات.
إن التنقل بين هذين العالمين، عالم النور وعالم الظلال، علمني أن أندهش - كما أسرد في الكتاب - بأبسط الأشياء والأحداث اليومية، وأن أبحث عن زوايا مختلفة وغير متوقعة لها، وأن أعرف أن الظلال والأشكال لا تقل أهمية عن التفاصيل، وأن لا أثق أبدًا بالانطباعات الأولى، أو أعتبر أي شيء مُسلمًا به. لكل كاتب طريقته الخاصة في رؤية العالم، وفي طريقي، تلعب هذه التضادات بين النور والظل دورًا مهمًا للغاية. نظرًا لأنني لم أستطع أبدًا أن أرى بوضوح كبير، كان عليّ أن أكون حذرة للغاية في اختيار ما أريد تركيز نظري عليه.
وضع رقعة على عيني اليسرى والعَمى شبه الكامل في اليمنى جعلني - نفسيًا على الأقل - طفلة إن لم تكن منبوذة بشكل صريح، فهي على الأقل مختلفة. موقف زملائي في المدرسة، وكذلك معركة والديَّ المستمرة لمحاولة "إصلاحي"، جعلاني أشعر منذ سن مبكرة أنني وُلدت بشيء مكسور، بشيء معيب، بشيء يجب إصلاحه بأي ثمن. تتحدث رواية "الجسد الذي وُلدت فيه" عن الجهد الخارق الذي بذله والداي لدمجي فيما اعتبراه مجموعة "الأشخاص الطبيعيين". في الواقع، من روايتي الأولى (الضيف) وصولًا إلى أحدث أعمالي "ولادة ميتة"، حاولت أن أتساءل عن الأفكار التي يتبناها الناس حول ما هو "طبيعي" وما هو "غير طبيعي" - مفاهيم لا أؤمن بها أساساً - وأن أدعو قرائي إلى فعل الشيء نفسه.
لا أحد طبيعي عن قُرب"، كما يقول المثل البرازيلي، ولهذا السبب حاولت في جميع كتبي تقريبًا، من ناحية، أن أقدِّم صورةً مقرَّبةً لتلك "االشذوذات" المزعومة، التي تبدو لي جميلة، ومن ناحية أخرى، أن أسلط الضوء على الموضوعات التي يُفضِّل الناس إبقاءها في الظل، إن لم يكن في ظلام دامس - تلك الموضوعات غير المريحة، التي يعتقد الكثيرون أنه من الأفضل ألا ينظروا إليها أصلًا.
على سبيل المثال، عندما بدأت مسيرتي الأدبية في مطلع هذا القرن، كانت فكرة الجمال السائدة أكثر تجانسًا وتقليديةً مما هي عليه اليوم. الأجساد التي نسميها الآن "غير مطابقة للمعايير" كانت تُعتبر فاحشة، ومفهوم "تقبل الذات" لم يكن موجودًا بعد. في ذلك الوقت، كان الحديث عن هذا نادرًا، والأندر منه كان الاحتفاء بالجمال غير التقليدي، كما فعلت في روايتي "الضيف" ومجموعتي القصصية "بيزوار"، حيث شخصياتهما أفرادٌ يتمتعون بخصائص غريبة - جسدية أو نفسية - تجعلهم أحيانًا منبوذين. بالنسبة لي، لم تكن هذه الشخصيات مثيرة للاهتمام فحسب، بل كانت جميلة بتميُّزها. روايتي الأخيرة "ولادةميتة " تستكشف أيضًا موضوع الأجساد المتباينة، خاصة جسد إينيس، المصاب بإعاقة عصبية شديدة، ورغبة والديها في اكتشاف حقيقة ابنتهما، بعيدًا عن أي تشخيص طبي أو أحكام الآخرين. كما تتناول تجربة النساء اللواتي اخترن ألا يكنَّ أمهات - فئة ما زالت، في رأيي، ممثَّلة تمثيلًا ناقصًا في الأدب – والانتقادات الاجتماعية التي تلاحقهن أوتثقل كاهلهن.
في رواية "الضيف"، التي لم تُترجم بعد إلى الإنجليزية، يُفتتح النص باقتباس من جان بولان يمكن أن يصف أيًّا من كتبي:
"اعلم أن الأمر يتعلَّق بإنقاذ الذات بكاملها، بعيوبها، بتقرُّحاتها، بكل التناقضات واللامعقوليات التي قد يحملها الإنسان. كل هذا هو ما يجب أن نخرجه إلى النور: ذلك المجنون الذي بداخلنا."
في هذه الرواية الأولى، يُعد العمى أحد الموضوعات المركزية. آنا، البطلة الشابة، تعرف منذ طفولتها أنها ستفقد بصرها عندما تكبر. تدور القصة في مدينة مكسيكو، وهي بمثابة قصيدة غنائية للمدينة وسكانها، خاصة الفقراء الذين يعيشون بجوار ماكينات الصراف الآلي، أو في محطات المترو، أو تحت الجسور، أولئك الذين يلاحظوننا دائمًا دون أن نتوقف للحديث معهم، هؤلاء "الخفيون" الذين نلقي عليهم بظل آخر: اللامبالاة والازدراء. "الضيف"، و"بيزوار"، "وبعد الشتاء"، و"ولادة ميتة"، كلها نتاج محاولتي للتحديق فيما يؤلمنا، وفيما يجعلنا غير مرتاحين.
لنعد إلى طفولتي. العقد الذي وُلدت فيه، السبعينيات، كان مثيرًا للاهتمام أيضًا من الناحية التاريخية. كانت أمريكا اللاتينية تعاني تحت وطأة الديكتاتوريات العسكرية، مثل حكم أوجستو بينوشيه في تشيلي، وخورخي فيديلا في الأرجنتين، وخوان ماريا بوردابيري في الأوروجواي، أنظمة فاشستية قمعت المعارضين بالتعذيب والاغتيالات السرية. لقد عارض معظم الفنانين والمثقفين هذه الحكومات، ونفي الكثيرون منهم لإنقاذ حياتهم. فتحت المكسيك أبوابها لهؤلاء اللاجئين، وكنتُ محظوظة لأنني وُلدت وترعرعت في الحي الذي استقروا فيه. نشأت وأنا أسمع لهجات إسبانية مختلفة، واكتشفت أن الكوسا يمكن أن تُسمى "كالاباسيتاس" أو "زاباليتوس" أو "كالاباسينيس"، وتعلمت عادات ليست من ثقافتي، مثل شرب الماتيه أو كوب حليب في الرابعة عصرًا. إن العيش بين المهاجرين غرس فيَّ فضولًا تجاه الثقافات المختلفة، كما زرع فيَّ احترامًا عميقًا لأولئك الذين يُجبَرون على مغادرة أوطانهم والبدء من الصفر.
والبشر، كحال العديد من الكائنات الحية الأخرى، كائنات مهاجرة بطبيعتها. ووفقًا للمؤرخين، فقد قضى الإنسان العاقل وقتًا أطول في الترحال منه في الاستقرار. إن الحركة والقدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من البيئات مزروعتان في جيناتنا. إلا أنه في السنوات الأخيرة، لم تعد الهجرة سوى مشكلة يجب معالجتها. لقد نسينا تمامًا تعقيدها، وغضضنا الطرف عن الآثار الإيجابية التي يمكن أن تترتب عليها أيضًا. في مجموعتي القصصية الأخيرة: "المصادفات" استخدمت طائر النورس، هذا الطائر الجميل القادم من الجنوب، لتمثيل المنفيين من أمريكا الجنوبية الذين اضطروا لعبور مسافات شاسعة من أجل البقاء، ولكن أيضًا لتمثيل أولئك الذين، على الرغم من أنهم ليسوا مهاجرين، قد جرفتهم التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم من مسارهم المعتاد - مثل الأزمة الصحية العالمية التي مررنا بها في عام 2020 (والتي لا نزال نعاني من آثارها النفسية حتى اليوم)، وكل ما رافقها من أحداث سياسية دوّارة، إلى جانب مشاعر القلق وعدم اليقين التي تثيرها فينا أزمة المناخ.أعتقد أننا نتفق جميعًا على أننا نعيش لحظةً عصيبة في تاريخ البشرية. ففي السنوات الأخيرة، بدا وكأن العالم ينجرف نحو الظلامية، والسياسات السلطوية، والتحيزات القومية، والعنصرية، وغيرها من المواقف التي سبق وأن أدت، في الماضي، إلى كوارث كبرى مثل الحرب العالمية الثانية.
على الرغم من أنني كنت دائمًا أرى أن الفن والأدب غير ملزمين بخدمة أية قضية سياسية، مهما بلغت أهميتها أو إلحاحها - أي أن غايتهما الحقيقية الوحيدة هي أن يكونا فنًا وأدبًا - فإنني أؤمن أيضًا بأن لهما فاعلية خاصة في تصوير الأوضاع الاستثنائية، مثل الاضطهاد، والترحيل القسري، والجوع، والمنفى، والهجرة، و جعلنا - نحن الذين لم نعش هذه التجارب مباشرة - في مكان أولئك الذين عاشوها فعلاً. فالأدب، أكثر من الغالبية العظمى من النصوص الصحفية، وسيلة قوية لإثارة التعاطف. أفكر هنا في كتب مثل أهذا هو الإنسان؟ لبريمو ليفي، و"حقيبة من الجواهر الزجاجية" لجوزيف جوفو، و"المكالمة الهاتفية" لليلى جيريرو؛ و"موسم الأعاصير" لفرناندا ميلكور؛ و"بلد صغير" لجيل فاي، حيث يتم تناول تجربة الاقتلاع، ولا سيما عذاب الاضطهاد، بأسلوب بالغ الروعة والعمق.
على الرغم من أنني لا أعتقد أن الأدب ينبغي أن يكون له هدف سياسي، إلا أنني أؤمن بقدرته على أن يُمكننا من التخيل ورؤية جيراننا. إن القدرة على تخيّل الآخر، على وضع أنفسنا في مكانه، تُعد تعويذة قوية بشكل لا يُصدّق ضد التعصب. فالأدب يمتلك القدرة على أن يربطنا ببعضنا البعض، أن يجعلنا نرى أنفسنا خارج الأيديولوجيات والأحكام المسبقة، وأن يدخل بنا إلى منطقة من الألفة، إلى الحياة اليومية لأناس آخرين، من شعوب أخرى، لنشاركهم قصصهم، ومخاوفهم، وآمالهم، وتجاربهم الحياتية - أي أن نلقي الضوء على الآخر، بما يُتيح لنا أن نراه حقًا.
وعلى الرغم من أنني لا أعتقد أن للأدب غاية سياسية، فإنني أؤمن بقدرته على أن يجعلنا نتخيل الآخر ونراه عن قرب.
الاختلاف والهجرة، وتقبُّل البشر لبعضهم البعض، هي باختصار الموضوعات التي سعيتُ إلى معالجتها في أعمالي الروائية. لكن هناك جانبًا آخر من عملي أود مشاركته معكم. ولأجل ذلك، دعونا نعود للمرة الأخيرة إلى طفولتي. عندما كنتُ في المدرسة الابتدائية، تلك المدرسة المونتيسوري التي وصفتها في كتابي "الجسد الذي وُلدت فيه"، قمنا أنا وبعض الأصدقاء بإعداد نشرة إخبارية أسبوعية اسمها "النملة" كنا نعلقها على لوح حائط، ثم أصدرنا لاحقًا مجلة مصورة اسمها "الصوت". ومنذ ذلك الحين، أصبحت متابعة شغوف للمجلات الأدبية والثقافية. وبعد سنوات، عندما كنت طالبة في الجامعة، شاركتُ مع مجموعة مختلفة من الأصدقاء في تحرير مجلة للأدب الشبابي اللاتيني اسمها "سميسترال"، ثم مجلة أخرى اسمها "رقم صفر". في ذلك الوقت، ورغم أنه قد يبدو أمرًا لا يُصدق الآن، لم يكن هناك إنترنت بعد، وكانت المجلات تمثل منصةً عامة أساسية للشباب كي يقرأوا عن بعضهم البعض ويواكبوا ما يفعله أقرانهم في بلدان أخرى حول العالم. ففي صفحات هذه المجلات، تلتقي جهود أناس بقصص مختلفة وجهات نظر متنوعة. إنها تشكل فضاءً استثنائيًا للحوار من الضروري الدفاع عنه. بينما حصل بعضها لاحقًا على دعم مؤسسي، فإن هذه المجلات كانت تُنشر في البداية بأموالنا الشخصية وأموال أصدقائنا.
وبين عامي 2017 و2024، حالفني الحظ لتحرير "مجلة جامعة المكسيك"، التي تصدرها الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM). كان مشروعًا مثيرًا لأن الأمر تضمن أخذ منشور تاريخي وتحويله بطريقة تجذب الشباب مع الحفاظ على تقاليده. نُشرت المجلة إلكترونيًا ومطبوعًا، ووصل عدد قرائها حول العالم إلى 300 ألف قارئ. أصدرنا حوالي ثمانين عددًا خاصًا متعدد التخصصات، اجتمعت فيها العلوم والآداب والعلوم الإنسانية، وتناولت موضوعات مهمة مثل الهوية، والتغيرات المناخية، والعنصرية، والماء، والأسر، والانقراض، واجتثاث الاستعمار، والنسوية، والعنف، والمدرسة.
أعتقد أن كل كاتب يجب أن يجرب التحرير في مرحلة ما من مسيرته الأدبية. بالنسبة لشخص اعتاد الصمت والسكينة في مكتبه، وإيقاعات عمله الخاصة (التي غالباً ما تكون مرجعيته ذاتية)، يمثل التحرير تحدياً حقيقياً، وفرصة للخروج من الانعزالية والاهتمام بأعمال الآخرين، ليس بشكل أناني كما يحدث عندما نقرأ لتعزيز إبداعاتنا الخاصة، ولكن بروحٍ بهيجةٍ وكريمةٍ كتلك التي يتحلى بها من ينظم حفلةً. أثناء عملي في التحرير، أدركت أن المهمتين تشتركان في نقاط أكثر مما كنت أعتقد في البداية. فلتجميع كل عدد من المجلة، كان من الضروري أيضاً العثور على نغمةٍ وإيقاعٍ وترتيبٍ وتركيز. تماماً كما في الكتابة، يجبرنا التحرير على المرور بلحظات من النشوة واليأس.
أتاح لي إدارة مجلة ثقافية القيام بتغطية مواضيع سياسية لم أكن لأتمكن من مناقشتها بمفردي؛ باختصار، أتاح لي تسليط الضوء بقوة على أولئك الذين، بسبب أصولهم أو طبقتهم الاجتماعية، أو ببساطة لافتقارهم إلى اللغة اللازمة، لا يجدون دائمًا مساحة يُصغى إليهم فيها كما يستحقون - للمساهمة في عكس نورهم على صفحاتها.
لدينا في المكسيك حكمة تقول: "الحب يبدأ من العينين" أي أن "الحب يولد من النظرة". وهذا يعني أنه لكي نحب شيئاً أو شخصاً، يجب أن نراه أولاً. ينطبق هذا على الطعام وعلى الانجذاب بين الأشخاص، ولكن أيضاً على نوع آخر من الحب، هو التعاطف بمعناه اللغوي الأصلي، أي "الشعور مع الآخر"، وهو بالضبط ما تحتاج إليه مجتمعنا وكوكبنا أكثر من أي شيء آخر هذه الأيام.
وفي الختام، أود أن أقول إنني لا أعتقد أن في وسعنا، كأفراد، أن نُغيّر الكثير من المسار المعتم الذي سلكه العالم في السنوات الأخيرة، ذلك المسار الذي يعرّض هذا العدد الكبير من الأرواح البشرية للخطر. ما يمكننا فعله - وما أود أن أحثكم عليه - هو أن نعتني بنورنا الداخلي، تمامًا كما يعتني المرء بلهب شمعة، وأن نحافظ عليه متقدًا ومضيئًا، كي نتمكن، عندما تحين الفرصة، من تقديمه لمن حولنا ممن قد يكونون في حاجة إليه، ولكي نتمكن أيضًا، حين يحين الوقت، من أن نضيفه إلى أنوار الآخرين: أنوار الجماعات والمجتمعات التي لا تزال تؤمن بإمكانية قيام عالم أفضل، وتستعد لبنائه.
***
....................
* ألقت نيتل المحاضرة الرئيسية التالية بعنوان "Escribir con luz" (الكتابة بالنور) بالإسبانية، بالتناوب مع القراءة الإنجليزية التي قدمتها مترجمتها روزاليند هارفي.
الكاتبة: جوادالوبي نيتيل / Guadalupe Nettel تُعد جوادالوبي نيّتيل (مواليد 1973)، التي وُصفت بأنها "واحدة من أكثر الأصوات أصالة في الأدب اللاتيني المعاصر"، من أبرز كاتبات الرواية والقصة القصيرة في أمريكا اللاتينية. وهي مؤلفة روايات ومجموعات قصصية حائزة على جوائز تُرجمت إلى أكثر من عشرين لغة؛ وقد حُوِّل العديد من أعمالها إلى مسرحيات وأفلام. شغلت نيتيل منصب محررة في مجلات ثقافية وأدبية مثل "الرقم صفر" و"مجلة جامعة المكسيك". وصلت روايتها "ولادة ميتة" إلى القائمة النهائية لجائزة بوكر الدولية. في أبريل ٢٠٢٥، نشرت دار بلومزبري مجموعة "المصادفات"، وهي مجموعة قصصية جديدة من تأليفها ترجمتها روزاليند هارفي. تعيش نيتيل في باريس ككاتبة مقيمة في مركز الأفكار والخيال بجامعة كولومبيا.
روزاليند هارفي/ Rosalind Harvey مترجمة أدبية وكاتبة، تُدرّس في جامعة وارويك. ترجمت أعمالًا للعديد من الكُتّاب البارزين باللغة الإسبانية، منهم خوان بابلو فيلالوبوس، وإلفيرا نافارو، وإنريكي فيلا-ماتاس، وجوادالوبي نيتيل. هارفي زميلة في الجمعية الملكية للأدب، وزميلة في مؤسسة الفنون، وعضو مؤسس في شبكة المترجمين الناشئين.
(نقلا عن جريدة اخبار الادب – الأحد 27 يوليو 2025)
https://worldliteraturetoday.org/2025/july/writing-light-2025-puterbaugh-lecture-guadalupe-nettel