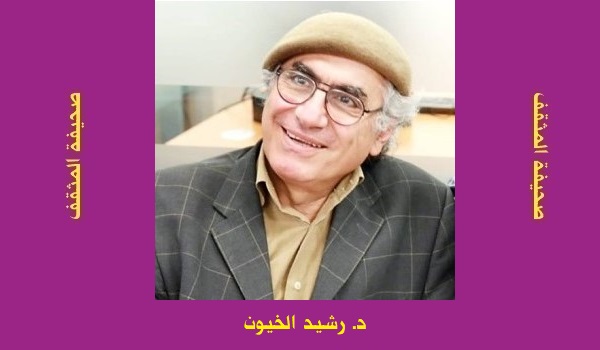أوركسترا
جوزفين كوين: فينيقيا المتخيلة

بقلم: جوزفين كوين
ترجمة: د. محمد عبد الحليم غنيم
لقد ادعى البريطانيون والأيرلنديون واللبنانيون جميعًا أنهم ينحدرون من الفينيقيين القدماء. لكن فينيقيا القديمة لم تكن موجودة أبدًا
لقد شكلت القومية الحديثة التاريخ كما نعرفه اليوم: ما نتعلمه في المدارس، وما ندرسه في الجامعات، وما نقرأه في المنزل، كلها تتأثر بشكل كبير بأشكال ومعايير دولنا القومية. فقد نقلت القومية الحديثة التاريخ من عالم الهواة الأثرياء إلى مجال أكثر احترافية وديمقراطية، من خلال التركيز على التعليم والإلمام بالقراءة. وفي المقابل، يُطلب من التاريخ أن يبرر القومية نفسها ووجود دول معينة؛ كما قال إريك هوبسباوم: "التاريخ هو للقومية مثلما الأفيون هو للإدمان على الأفيون." هذه الديناميكية تعطي القومية الحديثة قوة استثنائية لتشكيل، وأحيانًا لتشويه، فهمنا وتطبيقنا ليس فقط للتاريخ الحديث، بل حتى للعصور القديمة.
لنتأمل هنا الفينيقيين القدماء الذين تم تجنيدهم لدعم التواريخ القومية للبنان وبريطانيا وأيرلندا، وفي بعض الحالات تم تشويههم بشكل خطير من قبل هذه التواريخ. وعلى الرغم من ادعاءات العديد من أنصار القومية اللبنانية والبريطانية والأيرلندية بتجنيد الفينيقيين باعتبارهم أسلافهم القدماء، فإن الفينيقيين لم يكونوا موجودين قط كمجتمع واعٍ بذاته، ناهيك عن كونهم أمة ناشئة.
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، انهارت الإمبراطورية العثمانية التي حكمت الشام على مدى 400 عام. تصارعت القوى الأوروبية لتقسيم المنطقة وفقاً لنموذج الدول القومية الحديث نسبياً، تحت إشراف بريطاني أو فرنسي في البداية. شمل الانتداب الفرنسي على سوريا شريطاً من الموانئ المتوسطة الثراء يمتد إلى المرتفعات الريفية لجبل لبنان، موطن الموارنة التقليديين، وهم كاثوليك شرقيون على اتصال بالفاتيكان، والدروز، الذين تجمع معتقداتهم بين التعاليم الإسلامية وعناصر من تقاليد دينية أوراسية أخرى. كان لدى الموارنة والدروز تاريخ طويل من النزاعات ولا يجمع بينهما الكثير. ومع ذلك، منذ عام 1861، تم الحكم عليهم معاً تحت العثمانيين كمنطقة إدارية منفصلة عن المدن الساحلية بيروت وصيدا وصور، التي كانت تسكنها في الغالب أغلبية سنية.
في عام 1919، ومع وضع جميع الأراضي العثمانية على طاولة المفاوضات، أدركت مجموعة من رجال الأعمال والمثقفين المسيحيين المحليين الناطقين بالفرنسية فرصة لتوسيع هذه الجيوب الجبلية لتشمل الموانئ الثرية في دولة جديدة تحت اسم "لبنان الكبير". كان هؤلاء "اللبنانيون" يركزون على التوافق الطبيعي بين الجبل والساحل: بالنسبة لهم، كانت الدولة المقترحة بالفعل وحدة متكاملة؛ ما كان ينقصها هو تاريخ مميز يبرر استقلالها السياسي.
قد تكون الدولة القومية جديدة في الشرق الأوسط، ولكن كان اللبنانيون يعلمون أن الحركات الوطنية تحتاج إلى مشروعية تاريخية، ووجود ماضٍ مشترك لبناء كيان سياسي مشترك. وقد طرحت مرشحًا محليًا: الفينيقيون، التجار القدماء الذين أسسوا المدن الساحلية، وقطعوا طول البحر الأبيض المتوسط وما وراءه، وابتكروا الأبجدية التي نستخدمها حتى اليوم. من خلال تصوير الفينيقيين على أنهم رواد المبادرة الحرة، تمامًا مثلهم، جادل اللبنانيون بأن هذه الجذور الفينيقية القديمة منحت اللبنانيين هوية غربية ومتمركزة على البحر الأبيض المتوسط، مختلفة تمامًا عن الثقافة الإسلامية في المنطقة السورية الأوسع، والتي كانوا يرونها مزعجة وغير متحضرة. وكان من الجوهر في أيديولوجيتهم أنهم ليسوا عربًا: "لا توجد جمال في لبنان" كما يظل الشعار.
ولتوفير نموذج أولي مناسب وموازي للبنان الحديث، أصر هؤلاء اللبنانيون على أن الفينيقيين كانوا دائماً شعباً أو حتى أمة منفصلة، توحدها الجغرافيا والثقافة والدين والهوية المشتركة. وكما قال شارل قرم، الساحر والمغامر، فضلاً عن كونه الممثل الوحيد لشركة فورد للسيارات في سوريا، بصراحة في عدد يوليو/تموز 1919 من مجلته القومية القصيرة الأمد "المجلة الفينيقية": "نريد هذه الأمة، لأنها احتلت دائماً الأسبقية في كل صفحات تاريخنا". وقد نجحت الحجة: فمنذ عام 1920، أُدير لبنان الكبير كدولة منفصلة ضمن الانتداب الفرنسي. ولكن هل كان هذا صحيحاً؟
إن القومية الحديثة، التي تصر على الاستقلال السياسي لإقليم معين، وعلى تفوقه على غيره، ظاهرة حديثة للغاية. فقد كانت نتاجاً للتصنيع، ووسائل الاتصال الجماهيري، والثورات في فرنسا والولايات المتحدة، وبلغت أوجها مع التوحيد السياسي لألمانيا وإيطاليا في أواخر القرن التاسع عشر. ولكن لغة "الأمة" تعود إلى العصور الوسطى في أوروبا، إلى جانب أفكار الشخصية الوطنية ــ كانت قوائم الصور النمطية العرقية تُجمَع بالفعل في أديرة القرن الحادي عشر ــ والارتباطات الشخصية بأمم بعينها، والتي قد تشجع حتى على تبني أفكار الإبادة الجماعية.
لقد زعم بعض الباحثين في مجال القومية بأنه يمكننا تتبع مشاعر مماثلة إلى العصور القديمة. في كتابه الكلاسيكي أصول الأمم العرقية (1986)، قدم أنتوني د. سميث حجة بأن المجتمعات العرقية الواعية بذاتها قد وجودت منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وأن هذه الجماعات "تشكل النماذج والأسس لبناء الأمم" في العالم الحديث. على الرغم من أنها لم تكن أممًا بالمعنى الحديث بعد، فإن هذه الجماعات كانت تشترك في الروابط الثقافية والعاطفية، واسم مشترك، وميثولوجيا أصلية مشتركة، وذكريات تاريخية مشتركة وارتباط بإقليم معين. أحد الأمثلة التي قدمها سميث كان فينيقيا، حيث وجد إلى جانب "الولاء السياسي للمدينة-الدولة الفردية"، "تضامنًا ثقافيًا وعاطفيًا مع الأقارب الثقافيين، كما يُفسر من خلال الأساطير الحالية للأصل والنسب... استنادًا إلى إرث مشترك من الدين واللغة والفن والأدب، والمؤسسات السياسية، والملابس وأشكال الترفيه."
كانت كلمة "فينيقي" مجرد تسمية عامة اخترعها المؤلفون اليونانيون القدماء للبحارة الشوام.
كل هذا، بما في ذلك ادعاء سميث، كان من شأنه أن يفاجئ الفينيقيين القدماء، الذين كانوا مجموعة متباينة من المدن-الدول المجاورة وغالبًا ما تكون في حالة صراع، تفصلهم معظم الوقت وديان عميقة. لم يروا أنفسهم كجماعة عرقية واحدة أو شعب يمكن أن يشكل "الأسس" لأمة. لا توجد حالة معروفة أن أحد الفينيقيين قد وصف نفسه بأنه فينيقي أو استخدم أي مصطلح جماعي آخر. في نقوشهم، يصفون أنفسهم من حيث عائلاتهم ومدنهم الفردية. يبدو أنهم لم يمتلكوا ثقافة مشتركة أيضًا: لغاتهم تتوزع على مدى يرتبط بين المدن-الدول عبر فينيقيا وسوريا وفلسطين، وطور كل ميناء ثقافات مدنية وفنية منفصلة، مستندة إلى نماذج أجنبية وعلاقات مختلفة: فعلى سبيل المثال، كانت جبيل تميل إلى النماذج المصرية؛ وأرادوس إلى النماذج السورية؛ بينما استمدت عمارة صيدا تأثيراتها من كل من اليونان وفارس؛ في حين أقامت صور علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع القدس.
كان مصطلح "فينيقي" مجرد تسمية عامة ابتكرها المؤرخون اليونانيون القدماء للإشارة إلى البحارة الذين واجهوهم خلال استكشافاتهم البحرية في منطقة المشرق. على الرغم من أن بعض هؤلاء الكتاب اليونانيين يحملون تصورات نمطية عن الفينيقيين، حيث يعتبرونهم ماكرين أو خداعين إلى حد ما، إلا أنهم لا يستخدمون هذا المصطلح لوصف مجتمع عرقي ثقافي مميز. على سبيل المثال، يتحدث المؤرخ هيرودوتس عن الفينيقيين كثيرًا وبإعجاب كبير، لكنه لا يقدم وصفًا إثنوغرافيًا لهم كما يفعل مع مجموعات أخرى مثل المصريين والأثيوبيين والفارسيين.
وعلى هذا فإن سميث لم يخطئ في فهم الفينيقيين فحسب؛ بل إنه أخطأ في فهمهم تماماً. ذلك أن الفينيقيين لا يمثلون الأصول العرقية القديمة للأمم الحديثة، بل يمثلون الأصول القومية الحديثة لعرقية قديمة واحدة على الأقل.
تبدأ علاقة الفينيقيين القدماء بالوطنية الحديثة من بعيد عن لبنان في القرن العشرين. على جزيرة تُعرف الآن ببريطانيا العظمى، بدأت مساعي البحث عن الأصول الوطنية في العصور الوسطى تنقسم إلى مسارين: إنجليزي وبريطاني. كان المسار الإنجليزي أول من دافع عنه الموقر بيد في القرن الثامن، الذي ركز على ملوك الساكسون في البلاد. بينما بلغ المسار البريطاني ذروته في أعمال المؤرخ الويلزي جيفري من مونماوث في القرن الثاني عشر، الذي تتبع تاريخ ملوك بريطانيا بدءًا من برودوس الطروادي، حفيد إينياس. كان جيفري أيضًا أول مؤلف يقدم سردًا مفصلًا لإنجازات الملك آرثر، الذي يُفترض أنه هزم مؤقتًا الغزاة الساكسونيين لبريطانيا.
لقد هذه الأساطير البريطانية وجدت حياة جديدة بعد انفصال هنري الثامن عن الكنيسة الكاثوليكية، التي كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسكسونيين "الإنجليز" الذين قدموا الدين إلى الجزيرة في القرن السادس الميلادي. في تلك الفترة، كانت أصول الملوك التودوريين الويلزية تجعل الرؤية البريطانية الأكبر للأمة أكثر جاذبية، كما عززت طموحاتهم الإمبراطورية تجاه اسكتلندا.
في حوالي منتصف القرن السادس عشر، كتب مدرس وسياسي صغير يدعى جون توين كتابين من التعليقات اللاتينية على الشؤون الألبانية والبريطانية والإنجليزية. قدم توين هذه التعليقات كأنها مناقشة غداء استضافها جون فوش، آخر أبوت لدير سانت أوغستين في كانتربري قبل أن يحله هنري الثامن في عام 1538. نُشرت هذه التعليقات بعد وفاة توين في عام 1590، ورغم أنها كانت تحظى بتقدير عالٍ في وقتها، إلا أنها تُنسى الآن إلى حد كبير. وهذا أمر مؤسف، لأنها ممتعة للغاية، ويقدم الأبوت فيها حالة جديدة ومثيرة لجذور بريطانيا لضيوفه.
متجاهلا قصة جيفري مونماوث السخيفة عن أصول طروادة، يعلن فوش أن ألبون، ابن الإله نبتون، استوطن بريطانيا أولاً، ثم أسس سلالة من العمالقة الذين يسكنون الكهوف في الأرض التي أطلق عليها اسمه، ألبون. ولكن في الآونة الأخيرة، كان أول الأجانب الذين وصلوا إلى هذه الجزيرة هم الفينيقيون، الذين اجتذبتهم المعادن الكورنية. ويشمل دليله على هذا الادعاء "الزي البونيقي" الذي لا تزال ترتديه بعض النساء في ويلز، فضلاً عن "الأكواخ البونيقية" في تلك المنطقة؛ وعلاوة على ذلك، يشرح رئيس الدير، أن العادة البريطانية الشهيرة المتمثلة في طلاء الجسم بنبات الواد كانت بوضوح محاولة من جانب الفينيقيين لاستعادة بعض اللون الذي فقدوه على مدى أجيال عديدة بسبب الشمس. كانت فكرة النسب إلى الفينيقيين فكرة مبتكرة: فمن خلال رفض فرضية طروادة القديمة، قدم توين تاريخاً وطنياً جديداً لسلالة تيودور الجديدة، وهو التاريخ الذي حرص على ربطه على وجه الخصوص بويلز تيودور، وهو التاريخ الذي أعطى بريطانيا أسلافاً أكثر تحضراً وبطولة من المنحدرين من ما أسماه فوش "لاجئ مجهول وغامض".
ولكن في نظر توين، فإن الفينيقيين أنفسهم غير واضحين، فهو يكرر ببساطة ما يجده في النصوص القديمة. ويقال إن الفينيقيين كانوا تجاراً معروفين بالمكر والخداع. كما يؤكد توين على علاقاتهم بالشعوب الأخرى: فقد نشأوا في بابل، قبل أن يهاجروا إلى مجموعة متنوعة من الأراضي القديمة الراسخة الأخرى، بما في ذلك مصر، وإثيوبيا، وسوريا، واليونان، وأسبانيا، ثم وصلوا أخيراً إلى بريطانيا. ويتساءل توين: "من أين جاء الرجال على وجه الخصوص بعادة حلق اللحية باستثناء الشفة العليا، إن لم يكن البابليون؟". وكان هذا النهج يتناسب مع التفكير المعاصر بشأن الأمم، والذي لم يكن قائماً بعد على الحصرية أو المواجهة: وكان العنصر الحاسم في المفاهيم المبكرة لـ "الأمم" الأوروبية في الواقع هو فكرة النسب المشترك. وقد قدم لنا "جدول الأمم" في سفر التكوين خريطة تمكن العلماء من خلالها من تتبع شعوبهم من خلال عبر شجرة العائلة الأكبر إلى أبناء نوح.
يبدو أن الكلمات المشتقة من الفينيقية تشمل اسم كورنوال وكلمة البيرة
بحلول الوقت الذي نشرت فيه آيليت سامز كتابها "بريطانيا القديمة الموضحة"، أو "آثار بريطانيا القديمة المستمدة من الفينيقيين" (1676)، كان التفكير قد تغير. فقد تعززت نظرية سامز الفينيقية عن بريطانيا القديمة بالعمل الشعبي الذي قام به العالم الفرنسي صمويل بوخارت، الذي تتبع في كتابه "الجغرافيا المقدسة" (1646) انتشار أحفاد نوح في مختلف أنحاء العالم. وقد أولى بوخارت اهتماماً خاصاً بالفينيقيين، مشيراً إلى أنهم وصلوا إلى كل من بريطانيا وأيرلندا. وزعمت سامز أن الفينيقيين استقروا في جنوب بريطانيا، في حين استعمرت قبيلة سيمبري الألمانية شمالها.
كتب سامز أن الفينيقيين تركوا بصمة أكبر: "ليس فقط اسم بريطانيا نفسه، ولكن معظم الأماكن فيها ذات التسمية القديمة مشتقة تمامًا من اللغة الفينيقية، و... اللغة نفسها في معظمها، بالإضافة إلى العادات، والديانات، والأصنام، والمكاتب، والامتيازات القديمة للبريطانيين هي جميعها بوضوح فينيقية، وكذلك أدواتهم الحربية." بالنسبة لسامز، تشمل الكلمات البريطانية المشتقة من الفينيقية اسم كورنوال وكلمة "البيرة"، ومن بقايا الثقافة الفينيقية تشمل موقع ستونهنج. فيما يتعلق باللغة التي يعتقد سامز أن الفينيقيين تحدثوا بها، فهو لا يذكر تحديدًا في النص، ولكن من خلال التلميحات في تفسيراته، يمكن أن نستنتج أنه كان يعتقد أن الفينيقية كانت لغة أساسية تساهم في تشكيل اللغة البريطانية القديمة.
أكد سامز أن هجرة الكيمبري تفسر لماذا يتمتع الأسكتلنديون بجسم أكبر وأكثر شراسة من الإنجليز، وكذلك فوائد اتحاد التاجين في عام 1603. كتب: "اللغات والعادات والتقاليد المتنوعة ... ليست متعارضة مع بعضها البعض، ولكن من خلال اختلاط النبلاء، والاتحاد السعيد لهذه الأمة تحت حكم ملك واحد، تتجمع لتشكل أفضل مملكة متماسكة في العالم." يشير استخدام سامز لأصول المهاجرين المختلفة لشرح الأنواع البدنية الحديثة المميزة إلى علاقة نسب أو عرقية مشتركة بطريقة لم يكن يرويها سرد توين حول الاقتراضات الثقافية. كما يلتقط اتجاهًا جديدًا في الخطاب الوطني، الذي أصبح الآن يركز على الفرق بين الأمم أكثر من التركيز على الروابط بينها.
بالمثل، ورغم تأكيده على الأصول التكميلية لممالك بريطانيا، يميز سامز بشدة بين بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى. وبشكل خاص، هو معارض بشدة للمنافس الرئيسي لبريطانيا، فرنسا والفرنسيين. بالنسبة لسامز ومعاصريه، كانت فرنسا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالرومان، كدولة قارية إقليمية. وقد أبرز نسب البريطانيين المفترض من عدو روما التقليدي، القوة التجارية البحرية لقرطاج الفينيقية، الفروق بين الأمتين الحديثتين وفسر تفوق بريطانيا على البحر.
علاوة على ذلك، فإن معارضته الشديدة للفرنسيين تجعل من المهم بالنسبة لسامز أن تكون بريطانيا دائمًا جزيرة، وليس – كما كان في الواقع – شبه جزيرة من شمال أوروبا. كتب: "إذا تم الاعتراف بهذا المضيق، فسيبدو أنه من غير القابل للجدال أن الغالين هم من سكنوا هذه الأمة، وهو ما لا يمكن تصوره. يبدو أكثر مجدًا أن يكون هذا الجزء الممتاز من الأرض دائمًا أمة مستقلة بذاتها، بدلاً من أن يكون عضوًا تابعًا للأرض التي غالبًا ما منحتها القوانين." إنه سرد مختلف جذريًا لأصول القومية البريطانية مقارنة بتلك التي قدمها توين. في رواية سامز، كانت بريطانيا دائمًا أمة، ويطبق نفس المبدأ على سكانها البشريين الأصليين: فهو أول من يصف الفينيقيين كأمة، بل وحتى كدولة.
وفي أيرلندا، نشأت نسخة بديلة من القومية الفينيقية. وكان رودريك أوفلاهيرتي (رويدري أو فلايثبهارتيغ) المعاصر لساميس أول باحث أيرلندي يقترح في عمله المؤثر أوغيجيا (1685) أن الفينيقيين يشكلون جزءًا من الأصول الأيرلندية. وفي القرن الثامن عشر، أصبحت نظرية أوفلاهيرتي عن الفينيقيين باعتبارهم أسلاف الأيرلنديين شائعة للغاية بين البروتستانت المتفوقين وكذلك المثقفين الغيليين. وكان تشارلز فالانسي، الذي وصل إلى أيرلندا في عام 1756 كمساح في الجيش البريطاني، وظل هناك كعالم آثار محلي محترم، وعضو مؤسس في الأكاديمية الملكية الأيرلندية. كان اهتمام فالانسي بشكل خاص منصبًا على العلاقة بين اللغتين: حيث أعلن في إحدى دراساته المطولة العديدة حول هذا الموضوع أن اللغة الأيرلندية القديمة "يمكن القول إنها كانت، إلى حد كبير، لغة هانيبال، وهاميلقار، وأسدروبال".
تمامًا كما كان بإمكان القوميين البريطانيين استخدام الفينيقيين لتمييز أنفسهم عن الفرنسيين الأكثر "رومانية"، استخدم مؤيدو القومية الإيرلندية الماضي الفينيقي لتمييز الإيرلنديين عن البريطانيين الأكثر "رومانية". في هذا السياق، تم تصوير الاحتلال البريطاني لإيرلندا على أنه صراع عظيم بين قرطاج المتحضرة والنبلية، أي الفينيقيين-الإيرلنديين، وقوة روما المتوحشة، أي بريطانيا. في الوقت نفسه، كان فهم فالنسي لخصوصية الفينيقيين في العالم القديم غير واضح، ولم يميزهم بوضوح عن الشعوب القديمة الأخرى: فقد وصف الفينيقيين على أنهم امتصوا السكيثيين أثناء رحلاتهم، وخصص الأبراج الدائرية الإيرلندية في أوقات مختلفة للبناء الفينيقي والفارسي.
شجعت أيديولوجيات القومية المؤرخين على تبني فكرة الأمة الفينيقية القديمة
كان القومية الإيرلندية الانفصالية الحقيقية، حتى بين الكاثوليك، ظاهرة تعود إلى القرن التاسع عشر. بينما قد يكون فالنسي مخلصًا للثقافة والتاريخ الإيرلنديين، فإن عمله الرئيسي مكرس للملك الإنجليزي. احتفل المثقفون الإيرلنديون مثله بالفينيقيين كواحدة من مجموعة معقدة ومترابطة من الجذور القديمة، ولم يكونوا في تلك الفترة يسعون إلى مستقبل إيرلندي منفصل ووحيد. كانوا يقدرون أسلافهم الفينيقيين، لكنهم لم يكونوا يسعون إلى إنشاء أمة فينيقية.
وفى منتصف القرن التاسع عشر، أدى الاعتراف بأن عائلة اللغات الهندو أوروبية التي تضم الأيرلندية والإنجليزية كانت منفصلة تمامًا عن العائلة السامية التي تضم الفينيقية إلى جعل البحث عن الجذور الفينيقية المزعومة لهذه الدول الحديثة غير قابل للتصديق والصمود. كما كان الافتقار الواضح إلى الأدلة الأثرية على الاستيطان الشامي في أرخبيل شمال الأطلسي أمرًا غير مقبول. ولكن في الوقت نفسه، شجعت الأيديولوجيات الناشئة للقومية الحديثة المؤرخين على تبني فكرة الأمة الفينيقية القديمة، والتي اجتاحتها ما أسماه بول جيلروي في كتابه "الأطلنطي الأسود" (1993) أيديولوجية "الأمة ككائن متجانس عرقيًا"، فضلاً عن "التقاطع القاتل بين مفهوم الجنسية ومفهوم الثقافة".
لقد بدأت الكتب التي تتحدث عن "الفينيقيين" في الظهور، وكانت الفصول الموسعة مخصصة لحرفهم وثقافتهم. وبحلول ستينيات القرن التاسع عشر، عندما بدأ عالم الآثار الفرنسي (والذي تحول لاحقاً إلى منظِّر للقومية) إرنست رينان في نشر كتابه "بعثة فينيقيا"، والذي كان نتاجاً لعمليات التنقيب التي قام بها في لبنان، أصبح بوسعه أن يشير إلى الفينيقيين باعتبارهم "أمة". ووفقاً لرينان، كان الفينيقيون يتميزون بفنونهم وعمارتهم المميزة، وكانوا يشتركون في ميلهم العملي وذكائهم التجاري. وسرعان ما تحولوا إلى عِرق واحد: فوفقاً لجورج بيرو وتشارلز شيبيز في مجلد صدر عام 1885 عن الفن الفينيقي والقبرصي، "لقد قيل على نحو جيد للغاية إن الفينيقيين كانوا يتمتعون ببعض خصائص اليهود في العصور الوسطى، ولكنهم كانوا أقوياء، وكانوا ينتمون إلى عِرق لابد وأن نعترف بقوته وتفوقه في بعض النواحي".
ومع نهاية القرن التاسع عشر، اكتملت العملية، وتمكن جورج رولينسون من بدء الطبعة الثالثة من كتابه تاريخ فينيقيا بإعلان أن ساحل الشام "كان مأهولاً بثلاث دول، متميزة سياسياً وإثنوغرافياً": سوريا وفلسطين وفينيقيا. لقد نجحت ثلاثمائة عام من الدراسات القومية في ترسيخ مكانة الفينيقيين في بلاد الشام القديمة كأمة كاملة، وجدود مناسبين لدولة تحت إشراف إمبراطوري أوروبي.
***
........................
المؤلفة: جوزفين كوين / Josephine Quinn أستاذة مشاركة في التاريخ القديم في كلية ووستر، جامعة أكسفورد. أحدث كتاب لها هو "بحثًا عن الفينيقيين" (2017)