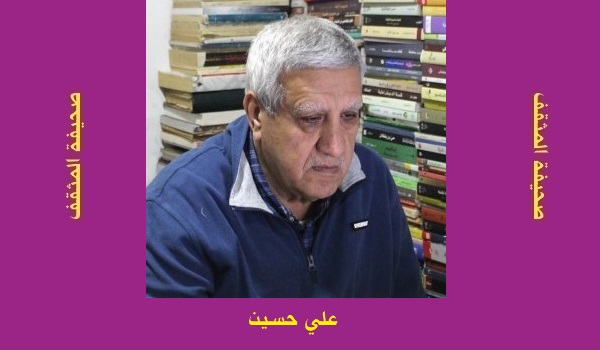كتب واصدارات
صدور كتاب "حسچه على ندوب الذاكره" للدكتور موسى فرج

صدر عن دار الرواد المزدهرة – بغداد كتاب جديد للدكتور موسى فرج بعنوان:
حسچه على ندوب الذاكره
يقع الكتاب في 368 صفحة.
يقول المؤلف في تعريفه لكتابه:
أردت من خلال هذا الكتاب رد الاعتبار للـ "الحسچه" أولًا، وهي طريقة في التعبير تختص بها –سابقًا- منطقة الفرات الأوسط من العراق "محافظات النجف والديوانية والسماوة" ولكن بتقدم وسائل الاتصال والتواصل باتت لا تنحصر في الفرات الأوسط ولا حتى بجنوب العراق فقط؛ بل امتدت لمعظم أنحاء العراق، وعن ماهية الحسچه فإنها: الكلام البليغ، الموجز، والمليح، الذي يحمل أكثر من معنى.
وبالرغم من أنَّ معظم العراقيين يحب الحسچه، وعندما يعجبهم الكلام قالوا عنه وعن المتكلم هذا: حسچه، إلا أنَّ الكثير منهم يحصل عنده اللبس بينها وبين اللهجة بمعنى المفردات الشائعة وطريقة نطق الحروف، فإذا كان اللبس بماهيتها يقع فيه بعض العراقيين، فكيف بالقراء من غير العراقيين...؟ وعليه؛ فقد أحببت أنْ أوجزها من خلال حادثة طريفة صادفتني شخصيًا:
ففي عام 1980-1981، كنت يومها ممثلًا لدائرتي "المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري" في لجنة وزارية في وزارة الحكم المحلي، يرأسها مدير الحكم المحلي العام زكي فيضي العلي، وكان إلى جانب كونه مسؤولًا حكوميًا كبيرًا بعثيًا وتكريتيًا، ويعرف أني من السماوة، هذا الرجل ما إنْ دخل الاجتماع حتى طلب من جميع الأعضاء توخي الحذر، قائلًا: دخل الحسچه خذوا الحيطة والحذر، وبتكرار ذلك سألته: هل تعجبك الحسچه يا أبا وائل...؟ قال: جدًا جدًا جدًا.
قلت: لكنها لا تعجبني، قال: كيف لا تعجبك وقد عشتها بنفسي يوم كنت محافظًا للنجف ومن ثم الديوانية و"أخيرًا السماوة"، وأعرفها جيدًا، ووجدت الناس هناك من أذكى مَن رأيت في العراق...؟
قلت: لكنها مثل العملة المعدنية لها وجهان، أحدهما كما تصفه والآخر لا أحبه، قال: كيف..؟
قلت: سأوصل الفكرة لك عمليًا من واقع حادثة، قال: تفضل: قلت: أيام زمان جاء للسماوة قائمقام من بغداد، وقبل أنْ يباشر بمهام عمله زار مدير الشرطة في مكتبه، ورجاه أنْ يشرح له معنى الحسچه، فقال له: سأريكها عمليًا، وطلب من حاجبه الشرطي الواقف على الباب أنْ يُدخل عليه أحد المراجعين، فدخل مواطن ستيني صاير طماطه من البؤس، رث الثياب، عليل الصحة، خائر القوى، لكن مدير الشرطة بادره لحظة دخوله صارخًا بوجهه: كلب ابن الكلب، كيف دخلت وعندي ضيف...؟ فردّ الرجل بهدوء: ليش تشتمني، آنا أبوك!... فأشار إلى الشرطي بإخراجه، والتفت على القائمقام قائلًا: هذه هي الحسچه... قال القائمقام: لم أفهم، فقد شتمت الرجل دون وجه حق وطردته...؟ قال له: ألم تسمعه يقول: أنا أبوك؟ يعني أنا "مدير الشرطة" كلب ابن كلب أيضًا! لكنه قالها بطريقة لا أستطيع فيها إقامة الدليل على أنه شتمني.
صاح صاحبي رئيس اللجنة "أبو وائل": أرأيت...؟ هل يوجد مَن هو أذكى من هذا الرجل الذي ردّ الشيمة بالشتيمة...؟ فأي وجه لا يعجبك فيها...؟
قلت: لو كنت مكانه وقال عليَّ ضابط الشرطة: كلب ابن كلب، فلا يرضيني إلا أنْ أقول له: أنت كلب ابن 16 كلب ...لكن المواطن بين حجرين، فكرامته عزيزة عليه، وبالوقت نفسه مغلوب على أمره شأن معظم المواطنين في تلك الأرجاء، فيبحث عن دهاليز ليرد الأذى عن نفسه دون أنْ يلام؛ لأنّ كلامه يحتمل الوجهين.
قال صاحبي: من هذه الناحية حقك...قلت: أرأيت ...؟
في هذا الكتاب، قلت الحسچه على أصولها وبطريقتي أنا، وليس بطريقة ذلك الستيني الواهن المغلوب على أمره، فالذي يستحق أنْ يقال له: "كلب ابن كلب"، أقول له: "أنت كلب ابن 16 كلب"، ولكن بطريقة بليغة مليحة تحمل أكثر من معنى.
في هذا الكتاب تكلّمت عن الفرات وطوفانه السنوي المحتوم الذي كان يومها يثير الهلع في نفوس الناس، ويكتسح قوتهم، فتطوف بيادر محاصيلهم تائهة فلا تجد جوديًا تستقر عليه...؟
وعن تدني الوعي المجتمعي لمديات غير معقولة، والذي كان يشكل الثنائي الرديف لطوفان الفرات لناحية التسبب بالفقر والحرمان، فيطحنان الناس طحن الرحى.
وعن سلطة شيوخ العشائر الذين كانوا بديلًا عن الدولة، ومخوّلين بجميع الصلاحيات الموروثة من العهد العثماني والإنكَليزي، وبعضهم غاشم وظالم، يسوم أبناء عشيرته الويل والثبور.
وعن الجانب الأشد ظلامًا في دوامة التخلف، وهو التعامل مع المرأة في الريف والزوجة على وجه الخصوص.
وعن الثقافة التي كانت تعتمد قناة معرفية واحدة هي: "المجالس مدارس".
وعن التعليم الذي كان مجاله الأوفر حظًا تعلم الـ "ألف بيه زير أن، ألف بيه زير إنْ، ألف بيه زير أون، ألف بيه دوبش أون".
وعن زيارتي الأولى للمدينة، والانبهار بالدفاتر والأقلام، وبنطلون قريبي القصير.
وعن العصيان في المدينة، والافتراق عن الأهل بغية تحقيق الحلم في التسجيل في المدرسة.
وعن كنه التنافس السياسي بين البعثيين والشيوعيين في مطلع ستينيات القرن الماضي، وميدانه الرئيس كسب تلاميذ المدارس سياسيًا، لتتحدد هوية التلميذ المستقبلية بعثيًا كان أم شيوعيًا منذ الصف الثاني أو الثالث ابتدائي...!
وعن أشد ندوب الذاكرة إيلامًا وقيحًا بحلول 8 شباط 1963 وتستمر على مدى 40 عامًا عجافًا، ما إنْ تغادر ندبة حتى تغرق في أخرى "سرمهر وأنكَس".
وعما أفضت بنا الأقدار في نهاية الأمر لنجد حالنا في قعر هوة لا قرار لها، ولا تشبه أي مما شهدناه من ندوب وحفر، فيها رأينا "َالنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ"، كل المفاهيم عندهم عائمة، الوطنية في عرفهم لوثة أخلاقية، والدين عندهم يحدد معالمه روزخون جاهل أو رادود مراهق، والمواطنة عندهم لغوًا لا يستحق التوقف عنده، الجنة في معتقدهم دهليز مثل أحد أنفاق يحيى السنوار في بابه يقف معمم ساذج ومضحك لكنه لئيم يقول لك إن هممت :" الجنه بس للشيعه!"، والسلاح المنفلت في منطقهم مقدس... الفساد عند أولي أمرهم عقيدة والنزاهة خصم، المرجع الأخلاقي عندهم شدّات الدنانير، والمرجع الديني عندهم "شاوروهن وخالفوهن"، والهاجس عند ساستهم الـ "مالات"، يومهم الوطني عائم وعلم الدولة والنشيد الوطني كلها تعابير عائمة تتطلب إثبات نسب...
قلت كل ذلك بـ الحسچه ولكن بطريقتي متوخياً الوفاء لصديقي الراحل د. حسين سرمك الذي كتب عني قائلًا: "من السمات الأسلوبية الأساسية والبارزة لموسى فرج هي سمة السخرية التي تتراوح من سخرية بيضاء بسيطة، إلى سخرية سوداء مريرة تجعل القارئ في حيرة هل يضحك أم يبكي؟ وهي أعقد أنواع فنون السخرية الكثيرة".
وأيضًا لأكون عند حسن ظن صديقي اللذيذ عبد المنعم الأعسم الذي كتب قائلًا: "مَن لم يقرأ ما يكتبه موسى فرج يخسر مرتين؛ مرة لأنه (وعلى مسؤوليتي) لا يجد نظيرًا لكتاباته من حيث جماليات الحسچه الفراتية المشحونة بالمعاني، وروح الوطنية العراقية النقية مثل دمع العين، وثانيًا، ستخلو حافظته من تنبؤات ما أحوجه لها، في السياسة وفي غيرها".
***
موسى فرج