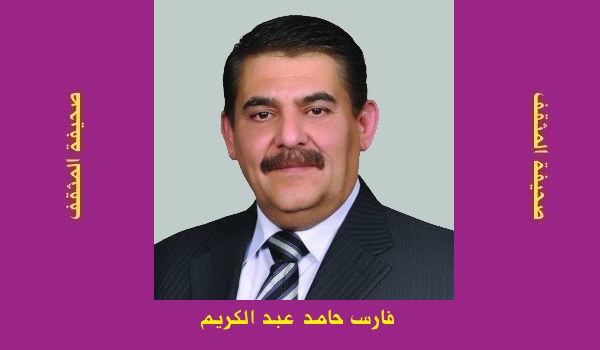مقاربات فنية وحضارية
سامي عبد العال: شفراتُ الحياةِ.. الفن ومعنى الإنسانية
 الحياة فن: دون الاهتمام بالفنون قد تخبُو روحُ الحياةِ لدرجة التلاشي، أي دونما علاماتها الابداعية التي هي أنتّ أيها الإنسان. فالفن يستقْطّرُ كثافةَ الحياة المتنوعة داخل شخصك المُفرد، فتبدو إنساناً ذا معنى قُبيل أيَّة مغادرةٍ لذاتك. سيفترضُ كلُّ فن أصيلٍّ كونّك هكذا، لأنَّ عالَّمك أصداءٌ لهذا الروحِ وسْماً وظِلالاً. والفنون إجمالاً ترسم عبر هذا الفائض الابداعي حدودَ العالم وزخمه الحاضر حتى في أدق التفاصيل. إنَّ لوحات الفنان التشكيلي الليبي" مرعي التّليْسِي" (1) تبرز ذلك الــ" أنت"، عاكسةً معانيه الزاخرة بالوجود. حيث ستنبض التواريخُ والأمكنةُ والأزياء والمواقف والظلال والأطياف بالواقع الحي. شُخُوصه التشكيلية ترْسِم فضائها الأثير، تدلُقه دلقاً بغزارةٍ دلاليةٍ أمام النظر والإحساس، وفي غير لوحةٍ، ربما تكون شخوصاً قريبةَ الشبّه لبعضها البعض، بيد أنَّها بالغةُ التعبير عمّا تحيا.
الحياة فن: دون الاهتمام بالفنون قد تخبُو روحُ الحياةِ لدرجة التلاشي، أي دونما علاماتها الابداعية التي هي أنتّ أيها الإنسان. فالفن يستقْطّرُ كثافةَ الحياة المتنوعة داخل شخصك المُفرد، فتبدو إنساناً ذا معنى قُبيل أيَّة مغادرةٍ لذاتك. سيفترضُ كلُّ فن أصيلٍّ كونّك هكذا، لأنَّ عالَّمك أصداءٌ لهذا الروحِ وسْماً وظِلالاً. والفنون إجمالاً ترسم عبر هذا الفائض الابداعي حدودَ العالم وزخمه الحاضر حتى في أدق التفاصيل. إنَّ لوحات الفنان التشكيلي الليبي" مرعي التّليْسِي" (1) تبرز ذلك الــ" أنت"، عاكسةً معانيه الزاخرة بالوجود. حيث ستنبض التواريخُ والأمكنةُ والأزياء والمواقف والظلال والأطياف بالواقع الحي. شُخُوصه التشكيلية ترْسِم فضائها الأثير، تدلُقه دلقاً بغزارةٍ دلاليةٍ أمام النظر والإحساس، وفي غير لوحةٍ، ربما تكون شخوصاً قريبةَ الشبّه لبعضها البعض، بيد أنَّها بالغةُ التعبير عمّا تحيا.
كلُّ وجه لدى التليسي ناضحٌ بأعماقه الغائرةِ، تبدو الوجُوه بصمات لأحوال السعادة، الحزن، الصمت، الجرأة، الكلام، البساطة، الحركة، التأمل، الفعل. وجميعها درجات مبهرة من المعاني الحرة، إذ تُسرب المفرداتُ همساً لونياً حول ما ترسِم. فليست أزمنتها دانيةً، إنما تتجلى مع انكشاف الحياة وجدل العلامات ضمن أغوار التشكيل. دوماً الزمن الفني مشحونٌ بأجواء إنسانيةٍ إلى ذروة الإدهاش، فاللوحةُ انطولوجيا المعيش عبر رؤية جماليةٍ تُكثف معاني الإنسانية. وكأنَّ هناك أناساً آخرين- بجوار الوجه الرئيس- تمتلئ بهم اللوحات رغم عدم وجودهم بشكل ملموس. يتضح ذلك مع نظر الوجود والملامح المعبرة عن الغائب بحكم أن اللوحات لا تستطيع نقل كافة جوانب الحياة.

ثمة معالم كهذه في لوحة " تّرْنِيمة لبلادي"، وهي تنقش هدفاً ضمنياً يلون تكوينها، هدفها هو الأمل المنشود للبلاد، للوطن (ليبيا التي أرهقتها الأحداث والأزمنة) في حياةٍ أفضل. لكن، لِمَ الحياة تحديداً رغم تنوع عناصر اللوحة؟ إنَّ المُعطى الدلالي وراء الأشكال يتجاوز النغم البسيط. حيث تتيح شفرات النغم والحياة توزيعهما الرمزي لأي لحنٍ آخر، وطناً كان أم إنساناً، أم عالَّماً متخيلاً.
ورغم كونِّها لوحةً واحدةً إلاَّ أنَّ" الترنيمة" تؤلف (فيما أرى) مجموعة لوحات فنيةٍ في إطار واحد. دوماً صيغة الجمع بارزة فيها لا نبرة الإفراد، لأن الحياة مهما دقت وصغرت ليست حداً مفرداً، بل قصاصات إنسانية انفصالاً وتقاطعاً. وسيغدو ثراء الصيغة آلية للتلقي، بل ستغوينا إلى داخلها دون إبطاءٍ. إنَّ الفنون مثلها مثل الحياة، لن تَحُول المشاهدةُ المتأملة من بعيد دون الغرق فيها. هكذا يعرفنا الفنُ التشكيلي فيما نعيش تلبيةً لإغواء النظر الحي، حيل الإمتاع الإنساني ومتعة الجميل، أليست العين هي نوافذ الرغبة، الحرية، الحب، الدهشة، الحنين، الاندهاش؟

(ترنيمة لبلادي)
إن الوطن هو أكبر حيلة جمالية حية لتجسيد وفتح جميع الأخيلة والنوافذ في التاريخ. كيف نفك شفراتَّ هذا التجسيد الفني؟ هل الترنيمة تراتيل للألوان والأشكال والواقع المأمول؟ هل سيبدو العالم (عدداً ونغماً) بإشارة الفيلسوف اليوناني فيثاغورث؟ كيف يجري ذلك مع الهدف الضمني للوحة المشار إليها تواً وفي غيرها؟
لعل خطورة الفن أنه يعبر برموز أوليّةٍ جداً عن قيم الجمال الأكثر تعقيداً وغنى. وهذا في الحقيقة ما يميز الفن الأصيل: أن تكون بساطة الأشكال معاني غائرةً حدَّ الإعجاز للإطلالة على المستحيل والعجيب. فالترْنيمةُ بفحواها الغنائي لدى التّليسي إيقاع دلالي لمقولة العدد والنغم. يظهر العددُ خلال رتم الزمن الذي لا يفتأ متجاوزاً بينما يسري النغم عبر إيقاع الحياة داخله. الاثنان (الزمن والحياة) يتماهيان ويخلعان على علاقات التشكيل الفني وشْماً ما. فهذه اللوحة البسيطة تحكي وتسرد تاريخاً من التحولات في الثقافة الليبية وتستحضر الغائب ولو كان مأمولاً.
 هناك أصداءٌ للترنيمة تتعلق بأسرار الحياة من جانبٍ، ومن جانبٍ آخر تقتحم الواقع المعيش راصدةً لآفاقه. إنَّ الترنيمة تختزل في حلمها المأمول للبلاد (ليبيا) أطيافَ الجانب الثقافي والمقدس والكوني (أي تُجدِّل الدنيوي واللاهوتي والوجودي). هي ترنيمة لطقس الحياة الذي يحتفل به الإنسان منذ حفرياته الأولى في الوجود، ويبدو أنه سيستمر في الاحتفال به حتى النهاية. لهذا ستقول كل ترنيمة من هذا النوع سياسياً ومعرفياً ما يتعذر قوله بأية وسيلةٍ غيرها. لا شيء تاريخي بإمكانه أن يحجبُ جسم العالم، لأن مفرداته ستكون (عارية ورمزية) في الفنون التشكيلية بأثرٍ رجعي وإنْ قابلتنا خلال الزمن الراهن.
هناك أصداءٌ للترنيمة تتعلق بأسرار الحياة من جانبٍ، ومن جانبٍ آخر تقتحم الواقع المعيش راصدةً لآفاقه. إنَّ الترنيمة تختزل في حلمها المأمول للبلاد (ليبيا) أطيافَ الجانب الثقافي والمقدس والكوني (أي تُجدِّل الدنيوي واللاهوتي والوجودي). هي ترنيمة لطقس الحياة الذي يحتفل به الإنسان منذ حفرياته الأولى في الوجود، ويبدو أنه سيستمر في الاحتفال به حتى النهاية. لهذا ستقول كل ترنيمة من هذا النوع سياسياً ومعرفياً ما يتعذر قوله بأية وسيلةٍ غيرها. لا شيء تاريخي بإمكانه أن يحجبُ جسم العالم، لأن مفرداته ستكون (عارية ورمزية) في الفنون التشكيلية بأثرٍ رجعي وإنْ قابلتنا خلال الزمن الراهن.
كلُّ فن حقيقي يعد مميّزاً في السرد الرمزي لعوالم الإنسان، لأنَّه يُفصِح عما يعجز سواهُ عن كشفه. يستحيل للفنون أن تتماثل لدرجة التطابقُ، نظراً لاستحالة استنفاد طرائق التجلي بينها إزاء موضوع واحدٍ. وهذا ما أعطى لـ (مخاض الحياة) في لوحات التليسي أولويةَ اللون، بكلمات أخرى أساسية الفعل اللوني، طالما تؤدي الألوان دوراً متفرداً في الفنون التشكيلية. واللافت للانتباه ليس تكوين لوحة ترنيمة فقط، بل مضامينها الثائرةِ صمتاً كذلك. ومن ثمَّ على المتذوق أن يتساءل: بأي اسلوب يعدُّ اللون غناءً وصدى ثورياً؟.
الترنيمة كمعنى في اللوحة هي عزف الألوان لتجارب الحياة بين العصور المختلفة اتصالاً برؤى الوطن المُنتظّر (ليبيا في المستقبل). وبالأدق هي سترسِم ذلك بتباين علاماتها داخل طيات وجغرافيا التشكيلات اللونية. إذا انتبهنا سنجد لوحة (ترنيمة) حواراً، جدلاً صامتاً يقدم نفسه بقوة بين الإطالة والمعاصرة، بين القديم والحديث، بل تعد انتقالاً مضمراً بين الصور الفرعيةِ (المعلقة يميناً وشمالاً) لأجل التحليق بعيداً؛ أي من حيث أنت تشاهد (فقط) إلى حيث الانطلاق وتحول المضمون. ليس عالمها المتخيلُ طقساً فورياً، فهناك أشياء أخرى كما عساك أن تراقب، كما أن هذا العالم ليس فراغاً بالمثل، لكنه سيناريو تاريخي للتعبيرات الفنية الدالة. لأنَّ الوظيفة الفنية للتشكيل تُولّد سكوناً وحركة بين مفردات اللوحة. وبالتالي ستُنوع الارتباط الشعوري والجسدي، المرئي والمتخيل، الوهمي والمتعين في التفاصيل، باعتبار الصور الفرعية لا تنتهي إحساساً، ولا تحدد فاصلاً لعالّمِها الخاص.
 فعلى اختلافها ستكون لصور الترنيمة في تلك اللوحة حركتان. إحداهما في ذاتها ككل (وبخاصة إذا نظرانا إلى اللوحة في تكوينها العام), حين تُشْعِر الصورةُ التي تجسدها الترنيمة أمام المتلقي باستقلالها، فهي شريحة لونية عامة منجزةٌ ضمن الأداء الفني. أمَّا الحركة الأخرى فتضعه في لقطةٍ تاليةٍ؛ أي نقرات واسعة النطاق لحوارٍ لم ينقطع والرسوم المجاورة (حين ندقق النظر في أزمنة وماهية الصور داخل هذه اللوحة العامة). ومن ثمَّ، لن ينعزل أي إحساس واحد عن سواه من أحاسيس. لأنَّ ما يلامسُ صوراً داخل الصورة الواحدة ليس التجاور إنما الصدى الزمني المُترّحل بين صورة فرعيةٍ وغيرها، أي الصدى المتقاطع مع لاوعي المشاهد، فالصدى يسير ناحية الانعتاق (ثورة الحلم بالبلاد) من مرحلة لأخرى.
فعلى اختلافها ستكون لصور الترنيمة في تلك اللوحة حركتان. إحداهما في ذاتها ككل (وبخاصة إذا نظرانا إلى اللوحة في تكوينها العام), حين تُشْعِر الصورةُ التي تجسدها الترنيمة أمام المتلقي باستقلالها، فهي شريحة لونية عامة منجزةٌ ضمن الأداء الفني. أمَّا الحركة الأخرى فتضعه في لقطةٍ تاليةٍ؛ أي نقرات واسعة النطاق لحوارٍ لم ينقطع والرسوم المجاورة (حين ندقق النظر في أزمنة وماهية الصور داخل هذه اللوحة العامة). ومن ثمَّ، لن ينعزل أي إحساس واحد عن سواه من أحاسيس. لأنَّ ما يلامسُ صوراً داخل الصورة الواحدة ليس التجاور إنما الصدى الزمني المُترّحل بين صورة فرعيةٍ وغيرها، أي الصدى المتقاطع مع لاوعي المشاهد، فالصدى يسير ناحية الانعتاق (ثورة الحلم بالبلاد) من مرحلة لأخرى.
بالطبع سنتابع داخل الترنيمة توليفاً جدلياً للنغمة الواحدة (صور مستقلة) والنغم ككل. وعليه سيتضح التوزيع لإيقاع داخلي حين نرى صوراً صغرى بعناصرها وبالإيقاع العام للرسم. كأنَّ الترنيمة الفنية رحلةٌ إلى " خارج هذا الداخل "، تقول للمتلقي: سِرْ حيث الأفق المفتوح إذ يترنّم المعنى، وبإمكانك أنْ تقطع عصوراً إلى حياةٍ جديدةٍ لن تتأخر. وهنا سيعلن الفنان التليسي عن حلم دول ليبا مرحلة الحداثة وبناء المجتمع بما يواكب العصر والحضارة.
كل هذا نراه في مفردات لوحة ترنيمة كما يلي: هناك فخار قديم معبر عن مرحلة غابره لها حثياتها التاريخية، وقد تهشم الفخار عن بكرة أبيه ولكنه ما زال يحمل بقايا عصره وأنَّ هذا الفخار أحد شفرات الحياة الماضية. لأنه من صنع الإنسان وكان محط رغباته سواء أكانت حسية أم غير ذلك. وكان الفخار يرتبط بنمط من العيش البدائي إلى حد بعيد. ثم هناك قدرات أخرى وفرتها الحياة من خلال الأطر الملقة في يسار اللوحة لكن المضمون المفترض وجوده لم يقبل التأطير المحدد له. لقد سقط آملا أن ينفتح على شيء مغاير... وهكذا يكون الجدل فاعلاً على الصعيد الزمني والفني. وهو النغم كما قلت بخصوص ترنيمة خارج الإطار وغير تقليدية وتنقل معها البلاد (ليبيا) إلى آفاق أخرى كما سأحلل تباعاً.
الحياة أنثى
 ربما يظن المرءُ أنَّ حياتَّه لوحةٌ بوسْم بارزٍ، سيكتشف أنَّها مطوية زمنية لا تُستنْفَد أشكالُّها. اللوحة والحياة كلمتان مؤنثتان، بالتالي ليس مصادفة ارتباطهما تأسيساً على المواقع الأنثوية للدلالة. هناك المرأة، الطبيعة، الجمال، الحياة... هل يوجد فرق بين تلك المفردات؟ الإحالة بينها ستسمح بأي دالٍ جديد: هناك البلاد، الدنيا، الرغبة، السماء، الثورة، الحرية، الخروج من الإطار.
ربما يظن المرءُ أنَّ حياتَّه لوحةٌ بوسْم بارزٍ، سيكتشف أنَّها مطوية زمنية لا تُستنْفَد أشكالُّها. اللوحة والحياة كلمتان مؤنثتان، بالتالي ليس مصادفة ارتباطهما تأسيساً على المواقع الأنثوية للدلالة. هناك المرأة، الطبيعة، الجمال، الحياة... هل يوجد فرق بين تلك المفردات؟ الإحالة بينها ستسمح بأي دالٍ جديد: هناك البلاد، الدنيا، الرغبة، السماء، الثورة، الحرية، الخروج من الإطار.
الأنثى نبعُ الفن المتجدّد في التاريخ، أعطته تأويلاته الثورية وشكلت كعلامةٍ مختلف أقنعة الحياة والوطن. الأنوثة هي الكثرة حين الوحدة، هي الطبيعي عند التحول، هي اللون في انغلاق الجوهر، هي الأطياف في مرايا الأسطُح، هي الالتقاء والافتراق جنباً إلى جنبٍ. وتلك الأعماق أصيلةٌ أصالة المواد الأولية للكون. فمنذ أنْ وُجد عالم إنساني امتزجت الأنوثة بالأشياء جميعاً، حواء كانت المصدر للحياة والموطن والأرض والاقدار والتواريخ.
على هذا الغرار ثمة مكون مهم في لوحة ترنيمة، إنّه الأنثى في نقطة المنتصف منها، فهي عمق التشكيل الفني. إذن بأي مغزى تطل امرأة أمام كثرةٍ من الأشياء الملقاة؟ الكثرة تجمع الطيني والرملي والهوائي تحت ظلال السماء، إنها عناصر أولية لعالم نابضٍ بالطبيعي والتلقائي. لا شيء يقف هناك وراء الرتوش ولا شيء يُغطّى بإهاب سميكٍ. ولئن تمَّ هذا، ستطرحه الدوال جانباً عائدةً حيثما كانت. عنصر الطين البارز في القلب من اللوحة يمثل ثباتاً على أرض أفقية؛ أي هو العنصر الترابي (الخَلْقي- من الخلق) بامتيازٍ لاهوتي وبشري، فوق ذلك يرمزُ إلى الخير والنماء والتطور نسبةً إلى الزراعة. ثم ينتأ التدرج المجاورُ لنرى الصحراء رمالاً منسابةً بين وهدةٍ وأخرى فيما وراء هذه العناصر. والطين هو الأصل كما أنه علامة تحول الرمال إلى أراض زراعية ثابتة تنبئ بمستقبل زاهر.
كأنَّ السير عمقاً يقفز بنا إلى فوقٍ بعيداً عما مضى، يرشقنا نحو غيمات السماء، ألوان القدّر المرتجى. لأنَّ الانتقال من الرمز الأفقي إلى الرأسي لن يتم صدفةً بين ليلة وضحاها. هو مقصور بتحليق الطائرة كرؤية هائمةٍ ستبقى عالقةً (وهنا رمزية الطائرة في اللوحة). فالطائرة بكيانها الفني فكرةً قيد الهواء، حياة سارية عقب تجاوز الوسط. وما أنْ ينظر الرائي إلى أسفل حتى تشده عالياً، كي يتسق النظر مع الوضع الأوفر مجالاً وحظاً بالمثل. لعلَّه انفتاحٌ الرؤية الذي يُباطّن حافته بابان أزرقان خفيفان أقل لونيةً زرقاء من الفضاء. والبابان يتركان باللوحة ظلين مشرّعين على السماء ومؤديين إليها في النهاية. أما اشتراك لون البابين (في اللون الأزرق) مع الفضاء فيعطيهما عمقاً فسيحاً، لأن الزرقة رمز الغموض سواء في السماء أو البحر أو الآفاق البعيدة. إنَّ المادةَ البصرية لا تُظْهِر أيَّ فارق إلاَّ في الدرجة. هنا ليس صعباً معرفة كون البابين طُرِحا للانطلاق، لأنَّهما في حالة انفتاحٍ دائمٍ، يردِّدان: السماءُ لا تنتظرُ أحداً، هي لا تُغلّق أبداً... فليكُّن تحْلِّيقُك بعيداً أيها الإنسان وألَّا تقف عند مرحلة دون أخرى.
 إذن هناك اجواء تمس أعيننا بإطلالة أنثوية مباغتةٍ. ذلك أمام كُتل السحب التي تشي ببكارة السماء القريبة. والأزرق يضم الصفاء ودلالة البحر وهو العنصر الآخر؛ أي الماء إضافةً إلى الترابِ والهواءِ. أما النار فهي طاقةُ الحركة حين تنفثها الطائرة، وهي أيضاً عين الأنثى إذ تعكس ابتسامة براقة. هذا على افتراض ارتباطهما بروحٍ هو الحياة وبوجه ساطعٍ لن يخلف دلالتَّه المغايرةَ. فالفضاءُ وعينُ الأنثى يرميان إلى تعليق النظر وجذب المتلقي لإشعال أنفاسه صوب السماء. إنَّها الاقلاع بالبلاد إلى المستقبل. فأغاني الحياة، بهجة الإنسان، غوايات الرؤية أكثر أثراً، يعضدها كون الأفق مفتوحاً بلا نهاية. كما أنّ الأنثى ترشق يدها تاركةً العمق بالداخل، إذن ماذا سيكون الأثر سوى العمق نفسه؟
إذن هناك اجواء تمس أعيننا بإطلالة أنثوية مباغتةٍ. ذلك أمام كُتل السحب التي تشي ببكارة السماء القريبة. والأزرق يضم الصفاء ودلالة البحر وهو العنصر الآخر؛ أي الماء إضافةً إلى الترابِ والهواءِ. أما النار فهي طاقةُ الحركة حين تنفثها الطائرة، وهي أيضاً عين الأنثى إذ تعكس ابتسامة براقة. هذا على افتراض ارتباطهما بروحٍ هو الحياة وبوجه ساطعٍ لن يخلف دلالتَّه المغايرةَ. فالفضاءُ وعينُ الأنثى يرميان إلى تعليق النظر وجذب المتلقي لإشعال أنفاسه صوب السماء. إنَّها الاقلاع بالبلاد إلى المستقبل. فأغاني الحياة، بهجة الإنسان، غوايات الرؤية أكثر أثراً، يعضدها كون الأفق مفتوحاً بلا نهاية. كما أنّ الأنثى ترشق يدها تاركةً العمق بالداخل، إذن ماذا سيكون الأثر سوى العمق نفسه؟
وعنوان اللوحة "ترنيمة لبلادي" دال لغوي فني متصل. صحيح حلم البلاد في غد أفضل لا يظهر بجلاءٍ، لكنه سيظل أملاً يرفرف كالعصافير في التفاصيل. وحين تمثله المرأةُ يغدو دالاً مُنتجاً لمدلولات التشكيل الفني. المرأة تحمل دلالتين: دلالة الرغبة في الحياة (ومشتقاتها الإنسانية الأخرى) ودلالة البلاد (ليبياً المستقبل بمعانيها المُشرقة)، ناهيك عن دلالتها الكونية كأنثى. بهذا القصد كانَ الدال الرئيس في لوحة ترنيمة لبلادي هو امرأةً عصرية تعبيراً عن الوطن. وعليه فالدال الأنثوي عالم يصوغ نتاجَ الدوال الفنية الأخرى. إنَّه المعجم السردي، الرتم الغريزي الحكَّاء الذي لن يتوقف عن قول ما لم ندركه. المرأة أصل الحياة، تهب الحياة للآخرين أطفالاً، رجالاً، مجتمعاً، إنسانيةً، كما تهب البلاد الحياةَ لأبنائها. أمَّا الابتسامة فإشراقة العين مع أعماق المرأة- الحياة؛ أي مستقبل البلاد بقوة البصر نفسه. ماذا ستسرد الأنثى، ماذا ستحكي اللوحةُ؟!

الحياة سرد
في واجهةِ اللوحة تبدو "الترنيمةُ" صورة كبرى تضم الأفق والعتبة وإطلالة المرأة، ثم لوحات بالجانبين. إذن يد المرأة هي يد الزمن المحكي، شفرة السرد كمفتاح. إنها تظهر كخيطٍ سيميائي ضمن علاقات التشكيل الفني والاجتماعي والسياسي بالتساوي. اليد ظاهرةٌ كرمز يربطنا مع الداخل والخارج، وبها ستصبح لدينا فاصلة فنيةٌ تنقلنا بين اللوحات على مساحة أوسع. لأنها يد الإنسانية فينا رغم كونها يد أنثى بالتحديد. وفي هذا لعلنا نلاحظ أناملها تأتي كمعطى خارج (الباب) الفُوّة الوسطى، وهي إشارة إلى الاتصال بالعوالم التاريخية المرسومة شمالاً ويميناً. بالتالي، فيدّ المرأة هي يد الحياة التي تفسر سيناريو الصور في مسلسل التاريخ من القديم إلى الحديث. يدعم ذلك المعنى ذيل طائر (أو ما شابه) على الضفةِ المقابلةِ بجوار الفخار، منعكساً هو الآخر في العمق.
واليد كفاصلةٍ حية تشعرنا بأوجه الاختلاف الموسوم فنيَّاً. وتُرهص كذلك بالزمن الآتي، وهو ترسُب الظلال على جميع وجه اللوحة. هنا يبدو التغيُّر الذي ينتظره الفنان لبلاده وشيكاً مع لوحة جانبية ملصوقةٍ بفعل فاعل. غير أنَّ الفاعل الفني (الفنان) يسمُ معانيها كأنَّها كُولاج collage له بصماته التعبيرية. ونحن إذ نرى لاصقاً ندرك وراءه بُعداً رمزياً، وما لم يكُّن واضحاً، فاللصق يعني بقايا الزمن. لا مفر إذن من لصق التاريخ على ما يبدو في التفاصيل الصغيرة، ولا سيما أنَّ باللوحةِ تمثالين لإنسانٍ (امرأة كذلك) ولغزال كإيماءة لوضع تراثي ماضٍ، كما أنَّهما لا يتحركان بموجب نحتهما البرونزي البيّن.
واللصقُ الواضح للصور الجانبية ينقل سكوناً فوق سكون، فمثلما لا يتحرك التمثالان، فإن لوحتهما الورقية تنْزع عنهما فتيل التأثير من أول وهلة. لأنهما أصبحا من تراث الماضي، مع ذلك تكمن كلُّ قيمة لهما في تاريخٍ نمر خلاله حتى نقابل عمقَ اللوحة الكبرى (عصر الحداثة والتطور). والمقارنة بين امرأة التمثال البرونزي وامرأة السماء (الأنثى الحية من لحم ودم) توضح: أنّ الأخيرة أكثر حداثةً، وتعيش عصرها الزاهر مع أناقة باديةٍ للعيان. ولن تُخطئ العين أن هناك سُترةَ عملٍ ترتديها كأنَّها ستقي صدراً (هو صدر الوطن) من غوائل الأيام، وتعدُّ في الوقت نفسه جزءاً من الحلم بتقدم الحياة. باعتبار أنّ حلماً هو البلاد المتطورة لا الحجرية التي تحمل قدرها متجمداً. وهو كل ما يرجوه الفنان لإنسان ليبيا ومجتمعها الواعد. ولا يجب الكف عن الحلم في هذا الاتجاه مهما تكن الإحباطات.

وفوق لوحةِ التمثالين في الترنيمة تُعلّق شقفةُ (كسرة) فخارٍ، ليست مكتملةً لكنها ترمزُ إلى عصرٍ قد ولى أوانُه. أداة الفخار تستدعي خلفية البلاد (ليبيا) كما كانت بداية الثقافة طيناً كمادة بسيطةٍ. والأداة تدل أيضاً على نمط من الحياة الإنسانية كان سائداً في زمنها الفائت. وتحرص اللوحة على أن تحتفظ بجزءٍ من الفخار، بينما أتي الزمن على الباقي كما أبلى أناسه القدماء. فالصلصال مادة مشتركة بين الفخار والإنسانِ، هو دينياً مادة خلق للاثنين.
أما شذرة ُالفخارِ فتحكي: مثلما أنَّ زمناً ينقضي ليترك آثاره على الأشياءِ، كذلك تآكلت مادةُ الإنسان الأُولى. إنَّه العامل المبدئي لتحول المجتمعات، الناس، الحقائق، إلى ظاهرةٍ في عمر الفناء المؤقت. وهي لا تعدو أنْ تكون مرحلةً ذهبت ليحل العصر المتطور والمأمول. وفنياً لم تُهمّل الشقفةُ (الكسرة) في ردهات اللوحة، إنما أخذت تتدلى تذكيراً بتاريخ المجتمع الليبي وأنه يجب عدم الانفصال عن التراث مهما أوغلنا في الحداثة وما بعدها. وأن مما يبقى منا سيظل مؤثراً طوال التاريخ وليس فقط زمنا يجُّبُ ما كان قبله دون رجعة.
على الجانب الأيسر من لوحة ترنيمة، نرى لوحةً ورقيةً سقطَ إطارُها الخارجي. واللوحةُ نائيةُ التفاصيل، غير أنَّ سقوطاً يعني دلالة الاهتراء، التحرر، التمرد. هي لوحة لم تثبُت في مكانها المعلق، انفلتت خارج الإطار، وهي كذلك لم تتسق معه وظلت غائمةً. ليس يسندها سوي علاقتها بالأفق الرحب لمتن اللوحة الكبرى. إذ ذاك ستبُوح الدلالة: إنَّها مرحلة اهترأت في عمر المجتمع الليبي سواء أكانت مرحلة سياسية أو اجتماعية تماماً كما انفصل الإطارُ وعُلِّق كرمز مصلوب على جدار الزمن. لأن الصلب رمز الخطيئة والخلاص كما في المسيحية.
ولئن غامت اللوحةُ الساقطة بحيث لم نر محتواها، فيبدو سقوطُها من الإطار مُريعاً. لينتقل المعنى إلى الوسط الأكثر جلاءً، هو منظر السماء والطائرة البارة في الخلفية. وعلى قرب الصورة الساقطة مقارنة بالعنصرين الأخيرين إلاَّ أنَّهما واضحان تمام الوضوح. أما تأرجُح اللوحة بلا مضمون بإطار فارغٍ، فيمثل دعوة لاعتبار كلَّ إطار قيداً ستنفصمُ عراه آجلاً أم عاجلاً. سيكون كل نظام سياسي واجتماعي (مهما كان مهيمناً على رقاب العباد) أثراً بعد عينٍ، ولن يعلن عن نفسه إلا كتذكارٍ حفري. ليس أدلّ على ذلك من أنَّ الإطار في اللوحة خاوٍ يتلاعب به الريح كيفما شاء. وحقاً الصورة الساقطة غامضة، غير أنَّ الإطار بلا محتوى حتى الاهمال. إذن لن يتصلّب إطارٌ اجتماعياً أو سياسياً دون انفصالِّه عما يؤطر له، ليؤكد فضاء اللوحة الكبرى على هكذا تحول تاريخي. وهو ما يدعمه الفنان بكل ما أو تي من دفق أبداعي في أسرار اللوحة من الاسم الخاص بها (ترنيمة) حتى التفاصيل البسيطة.
ولو تخيلنا الجانبين كأزمنةٍ، فقد آن الأوانُ بأفق الترنيمة لتعليقهما على هامش الحياة دون المركز. تعليقهما كآثار من زمن فائتٍ، قد يُتّجَاوَزهما العصر الحاضر لكنه لا يُنسى. في هذا يستوى كل فخار قديم بمعانيه البدائية مع الإطار بأي محتوى ايديولوجي أو غيره. وبالنسبة للأمل لم يعد ممكناً اتباع "ذهنية فخارية" ما فتئت لصيقة بالأرض. أيضاً ليس محتملاً الانحشار ضمن إطار يعاند تنوعَ الصور. فهو ليس قادراً على احتوائها ومواكبة تعقدها، فالحياةُ تتطور بسرعةِ الطائرة وعلى البلاد أنْ تخطُو إلى عالم أكثر حداثةً.
الحياة آفاق حرّة
في لوحة ترنيمة لم تنته الصورُ بالتجاور اللوني ولا بتوزيع الفضاء. لأنَّه نفسه التشكيل الفني الذي يعزف الإيقاع. إذا كانت اللوحةُ الكبرى منطويةً على صورٍ، فإنَّها تقطعُ طريقًا نحو الخروج. لوحة ترنيمة هي سِفْر الخروج بالبلاد الليبية من حالاتِ الفخار والاطار إلى عصر الانفتاح. وكأن الفنان كان يبشر بعصر من الثورة لمجتمعه والأخذ بأسباب التطور على طول الخط.
ولكننا مع تجول الرؤية بين المفردات اللونية، كدنا نفقد اتزاننا، حتى نسياً واقعاً حياً نحن فيه. ههنا سترتّد دلالة اللوحة إلى المتلقي عن قصدٍ فني، بل ستضعه كموضوع لدلالتها المباشرة. لعلَّها تمارس تمويهاً حتى يفقد يقينه الخارجي السابق (بأنه لا أمل في تغيير أوضاع المجتمع)، معتبراً ذاتَّه بمثابة اللوحة، وعليه أنْ يمثل آفاق الحياة، فهل يتقدم المتلقي، هل سيسير كما تدعوه؟ إنه نظراً لانفتاح مركز اللوحة، وتبعاً لإحالات الأنثى في العمق منها، مرة إلى الحياة وأخرى إلى البلاد وغيرهما إلى الزمن والحداثة، سيأتي التلقي والتذوق فعلاً تضامنياً مع فضاء الرسم. كل تكوين داخلي يفتح عمقُه درباً لمرور القادم إليه. وسيكون الوعي بالثورة على التقاليد الآسنة حاضراً حضور التحريض على التقدم والسبق نحو المستقبل.

إذ ذاك ستبدو لوحةُ ترنيمة لبلادي راصدةً للمتلقي إزاءها. أعني أنَّ اللوحة تقف- فعلاً- على (حامل داخلي) فترسم مسافة أماميةً بينها وبين أفُق النظر. كأنَّها تدعُو المتلقي ليأخذ خطوةً إلى الداخل من حضورها: ضّعْ إحدى قدميك كي تتأكد مما ترى بنفسك وبملء عينيك!!. والمسافة رغم اعتبارها بُعداً إلاَّ أنها نداء للاقتراب. في الفن التشكيلي المسافة قُرب لأجل التّوغُل من تفاصيل الباطن. لأنَّ المساحة التي تجسدها هي اكتشاف إلى الداخل من العمل الفني. وهذا معناه الاقتراب أكثر فأكثر، إنَّه استدراج دلالي سيرمي رغبةَ التلقي وراء رموز اللوحة. بحيث ينتقل معنى الألوان إلى خيال يتقاسمه الرائي والمرئي. وهو جانب تمثيلي خلال كل فنٍ يغوص بنا في الأعماق ريثما يرسم ما يريد.
الفن الأصيل عادة قد يأخُذك إلى حيث تعرف، لكنه دوماً سيُبهرك عندما يتجلى بواسطته ما لا تعرف. ربما يقف المتلقي لدى إطاره البراني، غير أنَّه حين يدرك لوحة جوانيةً أكثر عمقاً سيخطُو إليها. ومادام فعل ذلك لن يتوقف. بأشعار نزار قباني وصوت عبد الحليم حافظ " الموج الأزرق في عينيك يناديني نحو الأعمق...إني أغرق، أغرق، أغرق". لكن الموج (السماء) في لوحة التليسي ينادي نحو الخلاص من القيود ومما يثقل خطى بلاده نحو الحرية. ليست المماثلةُ بين زرقةِ السماء والبحر إلا حلمَ طائرٍ بجناح ترنيمةٍ. هكذا تترك الترنيمة اسمها مع الحياة والرغبة أملاً في كسر القيود. لينضُو الإنسان، وبالتالي المجتمع، عن ذاته واقعاً كئيباً لأجل التحرر الحقيقي. ودلالة الألوان الغامقة لا تفقد الانجذاب – كما الانجذاب الصوفي- بفضل اهتراء الواقع وضرورة المغامرة الإنسانية بلا أجنحة.
9
في كبد السماء من لوحة ترنيمة، جاءت الطائرةُ تخْليقاً لهذا الحلم، تجسيداً للعدد والنغم، فهي بيضاءٌ بياض الأمل وساميةٌ سُمو الرجاء. الباب إليها يودعه الجانبان الحملان للوحات يمينا وشمالاً. ولو كان ثمة اِغلاق لهما فسيقفل الفضاء لتظل الأنثى (البلاد) خلفه، وستخبو رغبة الحياة. أما وقد انفتح الجانبان فهناك فسحة الخيال، إحساس يقدَح نظرة أنثوية ببريق الأمل وبالعمق الأزرق.
وعلاوة عن التنوع الزمني للوحة، هناك تتابع في الرتم اللوني بين تحفيف حدة اللون حال البدء ثم كثافته المتدرِّجة كلّما أوغلنا، ثم انسلاله بكثافةٍ لونيةٍ لنشعر بالتخطي. وعلى ذلك يرتد الأفقُ كأنَّه بالخارج، كأنَّه بمثابة التلقي نفسه. لأنَّ الطائرة أساساً تجرى كعصر جديدٍ، كغد مُشرق، كحرية آتية بالهواء النقي للمجتمع والناس، وإذ تحلِّق عن كثب تُهمِّش التجاور اللوني للمكونات الأخرى، لكنها عوضاً عن هذا تطفُر بالمضمون إلى السطحِ الظاهر. كما أن خطوتها الأمامية تؤكد توجُهاً عكسياً للمعنى، فبدل الانغمار عمقاً، يُبادرنا العمقُ ليبسط الترنيمة حياةً جديدة للوطن القادم.
د. سامي عبد العال
............................
1- مرعي التّليسِي فنان تشكيلي ليبي معاصر، اهتم بالتصوير الفوتوغرافي وتصميم الجرافيك. اشهر أعماله لوحة " طائر الحلم" و"الشهادة أو النصر" و"سمر" و"حنين". حصل التليسي على جوائز محلية و دولية، جائزة لجنة التحكيم الخاصة ببينالي مالطا الدولي 1995وجائزة الجرولا دي أورو فينيسيا إيطاليا معرض البورتريهات 1995، جائزة معرض اتحاد حقوقي أفريقيا (للتضامن مع نيلسون مانديلا)، جوائز تقديرية من بينالي بغداد الدولي ومهرجان القيروان بتونس والعديد من شهادات التقدير. كما شارك في معارض على المستوى المحلي والعربي والدولي أيضاً.