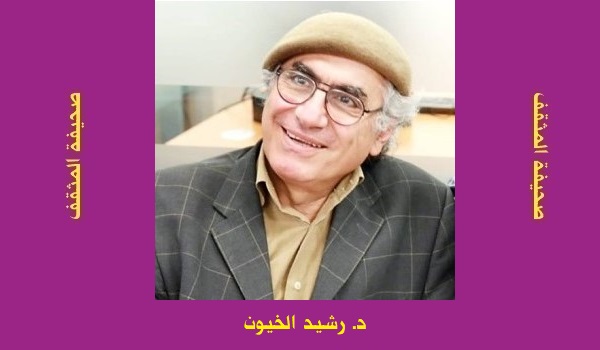أقلام حرة
عبد السلام فاروق: كيف نبعث الروح في المؤسسة الثقافية من جديد؟

في مطلع هذا القرن، بينما كان العالم يعدو بسرعة البرق، وقفت المؤسسات الثقافية وكأنها كائنات من زمن آخر. تخيلوا معي مشهدًا: كائن نبيل، حكيم، يحمل على كتفه أعباء قرون من التراث والفنون، يحاول أن يلتقط أنفاسه في عصر التويتر والتيك توك والذكاء الاصطناعي. كان المشهد يشبه جدًّا حكيمًا يحمل مخطوطات ثمينة في عاصفة رملية يحاول حماية كنوزه بينما العالم من حوله يتغير بشكل لا يعترف بالمخطوطات ولا بالحكمة التقليدية.
لطالما تحدثنا عن الثقافة ككائن حي، وهذا صحيح. الثقافة تتنفس، تنمو، تتألم، وتفرح. والمؤسسة الثقافية هي جسد هذا الكائن الحي. ولكن ماذا يحدث حين يصاب الجسد بالجمود؟ حين تصبح حركته بطيئة، وتفكيره متحجرًا، وعلاقته بالعالم من حوله أشبه بمن يتكلم بلغة قديمة لا يفهمها أحد؟
من الأرشيف المغلق إلى الفضاء الحي
كنت أزور ذات مرة مكتبة عريقة. كانت رائحة الكتب القديمة تعبق في الأجواء، والصمت الثقيل يخيم على القاعات، والموظفون يجلسون خلف مكاتبهم كما لو كانوا حراسًا لمقبرة معرفية. سألت نفسي: أين الحياة هنا؟ أين الضحك؟ أين النقاش؟ أين الاكتشاف؟
لقد تحولت العديد من مؤسساتنا الثقافية من "مساحات للحياة" إلى "متاحف للذاكرة". وأنا أحب المتاحف، لكنني لا أريد أن أعيش فيها. الفرق بين المتحف والبيت أن الأول يحفظ الماضي، بينما الثاني يعيش الحاضر ويستعد للمستقبل.
الأمل موجود. رأيته بعيني في تجارب هنا وهناك. في مكتبة تحولت إلى مكان للقاءات الأدبية وورش العمل وحتى عروض الأفلام. في مركز ثقافي صغير أصبح ملاذًا للشباب يمارسون فيه فنونهم بحرية. هؤلاء أدركوا حقيقة بسيطة: الثقافة ليست شيئًا يعطى، بل هي حوار. والمكان الثقافي ليس وعاء، بل فضاء للحوار.
أربعة مفاتيح للحل
الأول: إعادة تعريف الدور
لنتخيل معًا المؤسسة الثقافية كشخصية في رواية. لعقود، لعبت دور "الحارس الأمين" شخصية نبيلة لكنها جامدة. حان الوقت لتغيير الدور. ماذا لو أصبحت "المستكشف الشجاع"؟ أو "الحكيم الذي يتعلم من الصغار"؟ أو "الجسر بين الأزمنة"؟
المؤسسة الثقافية الجديدة لا تنقل الثقافة، بل تنتجها. لا تحفظ التراث فقط، بل تستنطقه ليفهمنا حاضرنا. هي ليست معبدًا للمعرفة، بل ساحة لعب للعقل والخيال.
التكنولوجيا كرفيق، لا كعدو
أذكر كيف كان والدي يخاف من "ذلك الصندوق العجيب" الذي دخل بيوتنا - التلفزيون. قال: سيفسد عقول الأطفال. ولكنه تعلم مع الوقت أن التلفزيون قد يكون نافذة على العالم.
التكنولوجيا اليوم هي نافذتنا الأوسع. المؤسسة الثقافية الذكية لا تخاف من هذه النافذة، ولا ترفضها، تتعلم كيف تفتحها على مصراعيها لتجلب النسيم العليل مع حماية البيت من العواصف.
التحول الرقمي ليس مجرد إنشاء موقع إلكتروني أو حساب على فيسبوك. إنه إعادة تخيل لكيفية عيش التجربة الثقافية. الأرشيف الرقمي قد يصبح لعبة اكتشاف، والمعرض الافتراضي قد يتحول إلى رحلة سحرية.
المفتاح الثالث: المال والاستقلال
هذه معضلة قديمة: كيف تمول الثقافة دون أن تفقد روحها؟ رأينا فنانون يبيعون أرواحهم للدعاية، ومؤسسات تتحول إلى مجرد أماكن ترفيه لجلب المال.
لكن هناك طريقًا وسطًا. طريق الشراكة الذكية مع القطاع الخاص، طريق المشاريع الإبداعية التي تجذب التمويل دون أن تفقد الجوهر، طريق المجتمع نفسه الذي يدعم ما يحبه.
المؤسسة الثقافية قد تتعلم من الشجرة: جذورها ثابتة في تراب الهوية، لكن أغصانها تمتد لتلتقط نور الشمس من كل الجهات.
المفتاح الرابع: لن نستيقظ وحدنا
لا تستطيع مؤسسة ثقافية واحدة أن تغير العالم. لكن شبكة من المؤسسات قد تفعل.
تخيلوا معي خريطة للعالم العربي، وعلى كل مدينة نقطة مضيئة تمثل مؤسسة ثقافية حية. ثم تخيلوا خطوطًا من الضوء تربط بين هذه النقاط – خطوط التعاون، تبادل الخبرات، المشاريع المشتركة. ستصبح الخريطة شبكة مضيئة من الإبداع تتجاوز الحدود السياسية التي قسمتنا.
عقبات على الطريق
طريق النهضة ليس مفروشًا بالورود، لكن بالأحرى مفروشًا بالأسئلة الصعبة والعقبات الملتوية. هناك وحش البيروقراطية ذلك الكائن الغريب الذي يحول الأفكار الرائعة إلى أوراق متراكمة، ويحول الحماس إلى ملل، والإبداع إلى روتين.
وهناك شبح النخبوية – ذلك الوهم بأن الثقافة للقلة فقط. كأننا نقول: الطعام للنخبة فقط، والهواء للنخبة فقط. الثقافة حاجة إنسانية أساسية كالهواء والماء.
وهناك تحدي اتساع المفهوم - فالثقافة اليوم لم تعد فقط الشعر والرواية واللوحة. الثقافة أصبحت تشمل العلوم، التكنولوجيا، البيئة، الرياضة، وحتى ألعاب الفيديو. المؤسسة الثقافية التي تتشبث بتعريف ضيق للثقافة تشبه من يصر على أن الموسيقى هي فقط عزف العود، بينما العالم يسمع سيمفونيات كاملة.
السؤال الأهم: هل نستورد النموذج الغربي؟ الإجابة: لا. لكن هل نغلق نوافذنا؟ أيضًا لا.
النموذج الذي نبحث عنه هو كالشاي العربي – نأخذ أوراق الشاي من هنا وهناك، ولكننا نصنعه بطريقتنا، بنكهتنا، وبكأسنا الخاص.
هذا النموذج يجمع بين أصالة الجذور وحداثة الأغصان. بين حكمة التراث وطموح المستقبل. بين هويتنا العربية وانفتاحنا على العالم.
النموذج العربي سيكون كالسوق القديم (الخان) – مكانًا للتجارة وللقاء، للبيع وللحديث، للمنتجات المحلية وللبضائع القادمة من بلاد بعيدة. مكانًا تسمع فيه لغات متعددة، لكنك تشعر أنك في بيتك.
إيقاظ المؤسسة الثقافية عملية مستمرة، كالتنفس تمامًا. نستيقظ كل صباح ونتنفس من جديد.
هذه الرحلة تبدأ بسؤال بسيط: لماذا نفعل ما نفعله؟ وتستمر بخطوة صغيرة: ماذا لو جربنا شيئًا جديدًا؟ وتتوج بتغيير جذري: أن نتحول من حراس للتراث إلى بناة للمستقبل.
في النهاية، الثقافة هي الحياة في أرقى تجلياتها. والمؤسسة الثقافية المستيقظة هي التي تدرك أنها تحمل ليس ماضيًا فحسب، بل مستقبلًا أيضًا. مستقبل أكثر جمالًا، أكثر إنسانية، أكثر إشراقًا.
هذه الرحلة قد بدأت بالفعل. أراها في عيون شاب يفتح كتابًا في مكتبة حديثة، في ابتسامة طفلة تلمس لوحة في معرض تفاعلي، في حوار بين أجيال في مقهى ثقافي.
الصحوة ليست مستحيلة. بل هي ضرورية. وكما يقول المثل: "من يظن أن الصحوة مستحيلة، هو في الحقيقة يصف حالته هو".
***
د. عبد السلام فاروق