أقلام فكرية
حيدر عبد السادة جودة: منظومة المنع والإبعاد والمراقبة الداخلية للخطاب
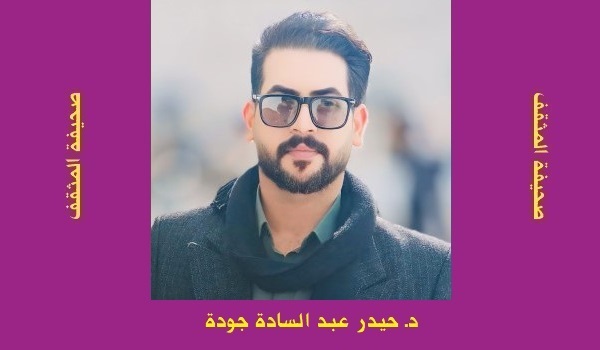
في مقالٍ سابق نُشر على صفحات جريدة الصباح، تكلّمنا عن الإجراءات الخارجية في مراقبة الخطاب، فينتهي فوكو من الإجراءات الخارجية التي تمارس الرقابة على الخطاب، ليؤسس بعد ذلك إلى منظومة أخرى ولكنها داخلية، أي تتعلق بالخطاب نفسه، وتمارس المراقبة عليه داخلياً، وتعمل هذه الاجراءات على شكل مبادئ التصنيف والتنظيم والتوزيع كما لو أن الأمر يتعلق هذه المرة بالتحكم في بعد آخر من أبعاد الخطاب: بعد الحدث والصدفة. وهي بحسب فوكو ثلاثة، مبدأ التعليق، والمؤلف، والفروع المعرفية أخيراً.
وأول ما يشير إليه فوكو في هذا المجال، هو التعليق. فيمارس كل مجتمع عملية انتقاء داخل الخطابات التي تكوّن الثقافة، فهناك الخطابات الظرفية التي تذهب وتضيع عندما تنطق، بينما هناك خطابات تتحول إلى نصوص يعاد قولها وإنتاجها، وهذه النصوص هي موضوع التعليق. ويذهب فوكو إلى أنه ليس هناك مجتمع لا توجد فيه محكيات كبرى يتم سردها وترديدها وتنويعها، ومجموعات من الخطابات التي اضيفت عليها ببعض الطقوس بحيث يتم سردها حسب ظروف جد محددة؛ وأشياء قيلت مرة واحدة واحتفظ بها، لأننا نتوقع أن فيها شيئاً هو أشبه ما يكون بسرٍ أو ثروة. وبإيجاز يشير فوكو إلى أنه يمكن أن نخمّن وجود نوع من عدم التسوية بين الخطابات، بصورة جد منتظمة في المجتمعات، الخطابات التي تقال عبر الأيام والمبادلات، والتي تذهب مع الفعل نفسه الذي نطق بها؛ والخطابات التي هي مصدر وأصل عدد معين من الأفعال القولية الجديدة والتي تعيد تناولها وتحولها أو تتحدث عنها، وهي الخطابات التي قيلت، بغض النظر عن صياغتها، وبشكل غير محدد، الخطابات التي تقال إلى الآن، وتظل قابلة لأن تقال. وإننا نعرفها ضمن منظومتنا الثقافية: أنها النصوص الدينية والقانونية، إنها أيضاً هذه النصوص المثيرة للانتباه عندما ننظر إلى هويتها، والتي ندعوها نصوصاً أدبية، وأيضاً النصوص العلمية إلى حد ما.
وبحسب فوكو، فإنَّ للتعليق وظيفتان، إحداهما تتمثل في تشكيل خطابات جديدة من خلال قابلية النص الأصلي لاتخاذ صيغة راهنة، والفجوات التي تفسح المجال لتعددية المعنى وخفاءه، مما يترك إمكانية مفتوحة للكلام. ومن جهة أخرى يلاحظ أن التعليق ليس له دور سوى أن يقول في الأخير ما كان منطوقاً به بصمت هناك. ومثار الإشكال الذي يطرحه فوكو يتمثل في أن هناك الكثير من النصوص الأساسية تتعتم وتختفي، وتأتي التعليقات أحياناً لتحتل المكانة الأولى. وبالتالي يشير فوكو إلى وجود نصوص أساسية ونصوص ثانوية، وإذا كانت العلاقة بينهما غير ثابتة ولا مطلقة، فإن المؤكد هو وجود تفاوت بين التعليق والنص المعلق عليه، مثلما هو الحال عليه في النص الأدبي. وينتهي فوكو إلى أن التعليق، من جهة أخرى، ليس له من دور-مهما كانت التقنيات المستعملة- سوى أن يقول في الأخير ما كان منطوقاً به بصمت هناك، فيتعين على التعليق، وفق مفارقة يغيّر هو موقعها دوماً، وإن كان لا يفلت منها أبداً يتعين عليه أن يقول لأول مرة ما كان قد قيل من قيل، وأن يكرر بلا ملل ما لم يكن قد قيل أبداً.
ينتقل فوكو بعد ذلك لمناقشة موضوع المؤلف، بوصفه مبدأ آخر للتقليل من الخطاب، ويكمل هذا المبدأ الأول؛ على أن المؤلف عند فوكو لا يعني الفرد المتحدث الذي نطق أو كتب نصاً، بل كمبدأ تجميع للخطاب، كوحدة وأصل لدلالات الخطابات، وكبؤرة لتناسقها. ولنا أن نتساءل، أين يكمن الإبداع، فهل جرّد فوكو الفرد من الإبداع، خصوصاً حينما قصد من المؤلف ما سلف ذكره؟. يقول فوكو: سيكون من العبث طبعاً أن ننكر وجود الفرد الكاتب والمبدع، ويذكر الزواوي بغورة أن فكرة إنكار المؤلف عند فوكو تعود إلى كونها تشكل اللحظة القوية للفردنة في تاريخ الفكر والمعارف والآداب، وفي تاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم.
وحين سئل فوكو عن إعلان نيتشه موت الإله، وإعلانه هو بموت قاتله، وتضمن موت الأخير بموت الأول، يجيب فوكو: إن الإنسان يختفي في الفلسفة، لا كموضوع للمعرفة، بل كذات تتمتع بالحرية والوجود.
ويعتقد فوكو أن فن الفرد الذي يشرع في كتابة نص يطوف حول أفقه مؤلف ممكن، فرد يتبنى لحسابه وظيفة المؤلف: فما يكتب وما لا يكتب، وما يرسم ولو على هيئة مسودة مؤقتة، وكمحاولة أولية لإنجاز مؤلف، وكذلك ما يتركه يسقط على شكل أحاديث يومية، فكل لعبة الفوارق هاته قد أملتها وظيفة المؤلف كما يتلقاها الفرد من عصره، أو كما يقوم بتحويرها بدوره، إذ أنه يمكن أن يقلب الصورة التقليدية التي كونّاها لأنفسنا عن المؤلف؛ أنه سيقتطع، انطلاقاً من الوضعية الجديدة للمؤلف، من بين كل ما كان يمكن أن يكون قد قاله، ومن ضمن كل ما يقوله كل يوم، وفي كل لحظة، سيقتطع الجانب الذي ما يزال مرتعشاً من عمله. وتجدر الإشارة إلى أن موقف فوكو من المؤلف، قريب من موقف رولان بارت الذي أعلن موت المؤلف باسم النص، فاللغة عند بارت هي التي تتكلم وليس المؤلف. وعلى أي حال، فإن الموقف من المؤلف سواء عند فوكو أم عند بارت أملته التأثيرات البنيوية ومفهومها للغة، وموقفها من الذات، ذلك الموقف الذي عبر عنه بقوة ليفي ستروس، والذي لقى استحساناً كبيراً عند فوكو في الستينات، إلا أنه عدله في دراسته الأخيرة حول تاريخ الجنسانية حيث بيّن تشكّل الذات وأكد على أهميتها.
وينتهي فوكو في كتابه نظام الخطاب ما قدّم له بالقول: كان التعليق يحد من صدفوية الخطاب بواسطة لعبة هوية ربما اتخذت شكل التكرار ونفس الشيء، أما مبدأ المؤلف فيحدُّ من هذه الصدفة بواسطة لعبة هوية تتخذ شكل الفردية، وشكل الأنا.
وبالإضافة إلى مبدأي التعليق والمؤلف، هنالك مبدأ ثالث يطرحه فوكو في كتابه نظام الخطاب، وهو: الفروع المعرفية.
ويقرر فوكو أن تنظيم الفروع المعرفية يتعارض مع مبدأ التعليق كما يتعارض مع مبدأ المؤلف كذلك؛ يتعارض مع الأخير لأن فرع المعرفة يتحدد من خلال مجال الموضوعات، ومجموعة من المناهج، ومتن من القضايا التي ينظر إليها على أنها قضايا حقيقية، ومن خلال شبكة القواعد والتعريفات والتقنيات والأدوات. إن هذا كله يشكل إلى حد ما منظومة مجهولة موضوعة تحت تصرف من يريد أو من يستطيع استعمالها، بدون أن يكون معناها أو صلاحيتها مرتبطين بذلك الذي تبين أنه مبتكرها. ومبدأ المعرفة يتعارض كذلك مع مبدأ التعليق، يقول فوكو: بخلاف الأمر في التعليق فإن ما هو مفترض في البداية ضمن فع معرفي ما، ليس هو معنى يجب أن يعاد اكتشافه، ولا هوية يتعين ترديدها، بل هو مطلوب لتكوين منطوقات جديدة؛ يتعين إذن –لكي يكون هناك فرع معرفي- أن تكون هناك إمكانية لصياغة قضايا جديدة، وبشكل غير محدود.
ويعمل هذا الإجراء على الحد من سلطة الخطاب، وذلك بفرضه لمجموعة من المعايير، على انتماء القضايا إلى حقله، أو إبعادها عن مجاله، فهو يعكس بصورة من الصور إرادة الحقيقة. فيشير فوكو إلى أنه لكي تنتمي قضية ما إلى فرع معرفي، فإنه يتعين عليها أن تسجّل نفسها ضمن أفق نظري معي، وبالتالي فليست الفروع المعرفية مدونة للحقائق التي تصاغ حول موضوع ما أو مجموعة من المواضيع، بل إنه الأفق النظري الذي يحدد مجال الحقيقة ومجال الخطأ، ويعين معايير المعقولية السليمة ويرمي في هامشه ما يعارض تلك المعايير.
ويناقش فوكو هنا مسألة الخطأ والصواب في دلالات الفرع المعرفي، ويسوق مثالاً عن عالم الوراثة الشهير (مندل) فيقول: كيف أمكن ألا يرى علماء النبات وعلماء الحياة في القرن التاسع عشر إن ما كان يقوله (مندل) كان حقيقياً، وعلة ذلك بحسب فوكو لا يرجع إلى أن ما يقوله ليس حقيقياً، بل إن (مندل) كان يتحدث عن موضوعات، وكان يستخدم مناهج، وكان يضع نفسه ضمن أفق نظري، وهذه موضوعات غريبة عن بيولوجيا عصره، وكان (مندل) قد حدد السمة الوراثية كموضوع بيولوجي جديد جدة مطلقة، وبالتالي فهو موضوع جديد يتطلب أدوات مفهومية جديدة، واسساً نظرية جديدة، وبالتالي فـ(مندل) كان يقول ما هو حقيقي، لكنه لم يكن واقعاً ضمن الحقيقي الخاص بالخطاب البيولوجي لعصره.
ويذهب فوكو إلى أن صياغة الموضوعات والمفاهيم البيولوجية لم يكن يتم تبعاً لمثل هذه القواعد؛ كان من اللازم إحداث تغيير كلي للسلم، واستخدام مستوى جديد من الموضوعات في البيولوجيا حتى يستطيع (مندل) أن يدخل ضمن إطار ما هو حقيقي، وحتى تبدو قضاياه صحيحة، فيمكن دوماً أن يقال ما هو حقيقي في مكان خارجي غير ملائم؛ ولكن المرء لا يكون واقعاً ضمن ما هو حقيقي إلا عندما يكون مستجيباً لقواعد فكرية يتعين عليه بعثها في كل خطاب من خطاباته. وبالتالي فلا يكفي قول الحقيقة كما هو الحال عند (مندل)، وإنما لكي يتحقق الخطاب وجب أن يتوفر على إرادة الحقيقة. الفرع المعرفي إذن، مبدأ لمراقبة إنتاج الخطاب، فهو يعين له حدوداً بواسطة لعبة هوية تأخذ شكل عملية بعث دائم للقواعد. ينتهي فوكو إلى أن هذه الثلاث، التعليق، المؤلف، الفرع المعرفي، منابع لا متناهية لإبداع الخطابات، قد يكون صحيحاً، ولكنها أيضاً مبادئ إرغام.
***
د. حيدر عبد السادة جودة







