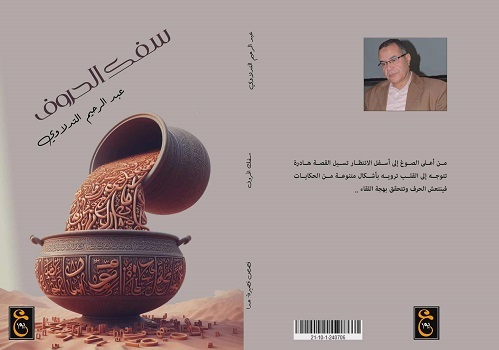أقلام فكرية
عدنان عويد: إشكاليّة النهضة في عالمنا العربي

في المفهوم: النهضة، أو كما تُعرف باسم اليقظة، أو حركة التنوير. هي جملة التحولات الفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، التي فرضتها أو تفرضها القوانين الموضوعيّة للتطور في مجتمع من المجتمعات أو دولة من الدول أو أمّة من الأمم. والمقصود بالقوانين الموضوعيّة هنا هي حالات الحركة المستمرة بالضرورة في بنية المجتمع من خلال تفاعل مكونات هذا المجتمع مع بعضهم من جهة، أو مع غيرهم من المجتمعات أو الأمم من جهة أخرى. فأثناء عمليّة الانتاج تتولد عمليات وعلاقات إنتاجيّة وفكريّة بين أفراد المجتمع الواحد، وبين هذا المجتمع والمجتمعات الأخرى باستمرار.
إن تطور قوى الانتاج (الآلة، أي وسائل الإنتاج عموماً، والإنسان ذاته وعمليات الإنتاج من حيث زياد الإنتاج وتبادله واستهلاكه). فسيرافق هذا التطور بعموم مفرداته، أو يسمى "البناء التحتي"، تطور آخر مرافق له في الوعي والفكر بشكل عام، أي ما يسمى "البناء الفوقي" بالضرورة وذلك عبر العلاقة الجدليّة التأثيريّة بين البنائين. ومن أبرز مظاهر النهضة في البناء الفوقي، هي تطور مفهوم الدولة ومؤسساتها، وانتشار مفاهيم دولة القانون، والحريّة، والعدالة، والمساواة، والمواطنة، والتعدديّة السياسيّة، وانتشار الطباعة، وظهور الصحافة ودُور النشر، والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات، وإحياء التراث وتحقيقُهُ، والنهوض باللغة، وتفاعلُ الأدب مع الآداب العالميّة بفعل الاحتكاك القسري أو الإرادي تفاعلاً عميقاً سيؤدى إلى ظهور فنون أدبية جديدة لم يكن لها وجودٌ من قبل، كالأقصوصة والرواية والمسرحيّة وغير ذلك من قضايا تهم حياة الإنسان وتطور وجوديّه المادي والفكري..
وقبل أن نبين قضيّة مشروع النهضة في عالمنا العربي المفوّت حضاريّاً، من الضرورة بمكان أن نشير ولو بشيء من العجالة إلى مشروع النهضة في أوربا لنتبين ذلك الفرق الواضح بين المشروع النهضوي الغربي، والمشروع النهضوي العربي.
مشروع النهضة في أوربا:
إن مشروع النهضة الذي مرّت به أوربا تاريخيّاً منذ سقوط القسطنطينيّة عام 1453 واكتشاف رأس الرجاء الصالح 1488. وانتقال طرق التجارة من يد تجار الشرق إلى يد تجار الغرب، وبخاصة في إيطاليا، قد ساهم بتشكيل ما عرف بالمرحلة الأنسيّة في إيطاليا منذ النصف الثاني للقرن الخامس عشر على يد الطبقة الجديدة من التجار ورجال الفن والأدب الذين آمنوا بالإنسان كسيد لقدره ومصيره. إن الارهاصات الأوليّة للمرحلة الأنسيّة راحت تمتد إلى معظم مناطق أوربا شيئاً فشيئاً، ومع ظهور عصر النهضة في إيطاليا ذاتها كامتداد للمرحلة الأنسيّة في أفكارها حتى القرن السابع عشر، قد جذرت في الحقيقة الصورةً الإيجابيّةً للإنسان وعقله وحريّة إرادته، باعتباره أرقى الكائنات الحيّة. ومن أهم توجهات الحركة الأنسيّة وعصر النهضة هي:
1- الاهتمام بمختلف العلوم والآداب والفنون.
2- الأخذ بالأساليب الحديثة في التربية والتعليم.
3- إحياء التراث القديم وخاصة التراث اليوناني والروماني والعقلاني منه بشكل خاص.(1).
4- وفي الوقت نفسه الذي قطع فيه العلماء والمخترعون في تلك الفترة خطوات كبيرة في فهم العالم الطبيعي، مع شخصيات مثل "نيكولاس كوبرنيكوس: وغيره من الذين قدموا مخترعاتهم التكنولوجيّة وعلومهم الطبيعيّة في الفلك وغيره التي أخذت تعيد النظر في المعتقدات الدينيّة السائدة آنذاك حول الكون وتشكله، ومهدت الطريق لاكتشاف القوانين الموضوعيّة المستقلة في الطبيعة والمجتمع، والتسلح بها وتوظيفها لمصلحة الإنسان. وبالتالي هذا ما يؤكد بأن ما قدمته الحركة الأنسيّة وعصر النهضة في أوربا، قد أسس ليس لنهضة ثقافيّة فحسب، بل كان أيضًا حافزًا للابتكار والاكتشاف الذي أرسى الأساس لعصر التنوير والعالم الحديث ومكانة العقل.
ثم تلا عصر النهضة الثورة الصناعيّة التي قامت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، والتي فتحت أبواب المعرفة على مصراعيها، وظهر عصر الفيزياء والكيمياء والرياضات والاختراعات التكنولوجية المختلفة في أهميتها ووظيفتها الإنتاجية، مثلما رافقها ظهور فلاسفة عصر التنوير في القرن ذاته الذين راحوا يبشرون بعالم جديد على كافة المستويات الاقتصاديّة منها والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة.
فعلى المستوى الاقتصادي: راح التوجه للعمل على الفسح في المجال واسعاً لاقتصاد السوق ووحدته في المجال الوطني والمجال الأوربي عبر طرح الشعار "المريكانتيلي" (دعه يعمل دعه يمر)، وبالتالي القضاء على النمط الاقتصادي في صيغته الاقطاعيّة التفتيتيّة القائمة على مشاريع "دول المدن"، وتثبيت دعائم النظام الرأسمالي.
وعلى المستوى السياسي: فقد توجهت الطبقة الرأسماليّة بعد انتصارها على الملك والنبلاء والكنيسة، إلى تطبيق المشروع الليبرالي، والقضاء على السلطة الاستبداديّة الممثلة بسلطة الاقطاع والملك والكنيسة آنذاك، وإعادة تشكيل برلمانات جديدة لا تقوم على التقسيم والتراتب الطبقي السابق، وإنما برلمانات خصصت فيها مقاعد تشارك فيها القوى العماليّة. كما راحت تجسّد على الواقع ما سمي بدولة القانون والمؤسسات واعتبار الشعوب هي الحاضنة للدولة ومؤسساتها وتحديد نظام الحكم فيها، واعتبار العلمانيّة والديمقراطيّة ودولة القانون أهم وسائل ضبط حركة الدولة والمجتمع.
وعلى المستوى الاجتماعي: فقد تم تجاوز للعلاقات الاجتماعيّة التقليديّة التي يتحكم بها الاقطاع والكنيسة والملك وصراعاتها الدينيّة المذهبيّة وحروبها الطاحنة، وتسسييد علاقات اجتماعيّة تتوافق وطبيعة العلاقات الانتاجيّة الجديدة، وهي العلاقات الرأسماليّة القائمة على اقتصاد السوق الحر، وعلى مفاهيم الحريّة الفرديّة والعدالة والمساوة والأهم المواطنة. واعتبار العقل والتجربة هما المرجعان الأساسيان في تقويم الواقع بكل مستوياته.
وعلى المستوى الثقافي أو الفكري: كانت الدعوة إلى تسييد العقل واعتباره سيد الأحكام في تحديد صحة المعارف أو عدم صحتها من جهة، مثلما تم التوجه نحو تحطيم سلطة الثقافة الغيبيّة الاستسلاميّة الامتثاليّة، والسماح لحرية الإرادة الإنسانيّة والعقل الإنساني أن يجوبا عوالم هذا الكون بحثاً عن الحقيقة. فتحطمت هنا أسس المدرسة "السكولائيّة / المدرسية" التي كانت تقدم المعارف جاهزةً للإنسان كما قدمتها الكتب الدينيّة المقدسة وشروحاتها من قبل رجال الدين من جهة ثانية. وعلى هذه التوجهات تحطمت أسس الفلسفة الميتافيزيقيّة واللاهوتيّة، والمثاليّة الذاتيّة، لتبدأ الفلسفة العقلانيّة تفرض نفسها شيئاً فشيئاً على مستوى الحياة الثقافيّة بشكل عام والفكريّة الفلسفيّة بشكل خاص.. فكانت صرخة ديكارت (أنا أفكر إذاً أنا موجود). بداية تأليه العقل والإنسان معا. ومع ثورة العقل وحريّة الإرادة، تم تجاوز وتحطيم العديد من المدارس والنظريات السابقة على المستوى السياسي والأدبي والفني، وخلق مدارس جديدة تتناسب مع روح العصر العقلاني الجديد.
أمام هذه التحولات البنيويّة التي حققها عصر النهضة في أوربا ممثلاً بحوامله السياسيّة والفكريّة الفلسفيّة والأدبيّة والفنيّة، وحتى الدينيّة ممثلة بالإصلاح الديني لـ" مارتن لوثر 1483 - 1546" في ألمانيّة، وفي سويسرا بزعامة (أولريخ زونجلي 1484م ـ 1531م ) وفي فرنسا وجنيف بزعامة (جون كالفن 1509م ـ 1564م). يظل السؤال المشروع يطرح نفسه علينا حتى اليوم وهو: أين نحن العرب من مشروعنا النهضوي؟.
المشروع النهضوي المفوّت في عالمنا العربي:
لقد عوّلت الشعوب العربيّة بعد التحرر من الاستعمار منذ منتصف القرن العشرين، على القوى السياسيّة الهجينة طبقيّاً في بنيتها من جهة، و(النخبويّة) من شرائح الانتلجنيسيا (المعسكر) أكثرها في طبيعتها من جهة ثانية، هذه القوى هي التي قادت حركة التحرر العربيّة ممثلة في أحزابها ومشاريعها الوطنيّة والقوميّة، بيد أن هذه القوى ظل معظمها مرتبطاً بالاستعمار بشكل أو بآخر، فإذا كان التحرر السياسي قد تحقق للبلاد بخروج القوت الأجنبيّة، فإن الاستعمار الاقتصادي والتخلف الثقافي ظلا قائمين ويمارسان نشاطاهما بحيويّة فاعلة في محيط الدولة والمجتمع اللذين راحت تسيطر عليهما بعد الاستقلال برجوازيّة "كومبرادوريّة" مرتبطة بالمستعمر، هشة غير واعية لذاتها، وبالتالي لم تستطع أن تعمل لا لمصلحتها ولا لمصلحة شعوبها، تساندها قوى شبه اقطاعيّة من شيوخ العشائر والقبائل، وهذا ما ساهم في فشل هذه القوى التي قادت البلاد بعد خروج المستعمر من تحقيق مهام النهضة التي عوّل عليهم قيامها. الأمر الذي أدى إلى ظهور قوى اجتماعيّة جديدة من داخل صفوف الشعب ولكن معظمها ينتمي للجيش رغم انتماء العديد منها لأحزاب سياسيّة لها طابع مدني، نعتت نفسها بالتقدميّة، وطرحت على نفسها وعلى شعوبها ضرورة تصفية بقايا الاستعمار ومن يتعاون معه من القوى السياسيّة التقليديّة الحاكمة، ووضعت في أجنداتها إقامة مشروع الدولة المدنيّة التي تهدف إلى إقامة دولة القانون والتعدديّة السياسيّة ودولة المؤسسات والديمقراطيّة والعلمانيّة والمواطنة وغير ذلك من مفردات الدولة المدنيّة. غير أن شهوة السلطة التي تحكمت بهذه القيادات التي ادعت التقدميّة، وأحزابها التي أكثر حواملها لاجتماعيّة من ضباط الجيش والطلاب والانتلجنسيا من دكاترة ومعلمين ومحامين وغيرهم من هذه الشرائح المتعلمة التي لا يظهر تلاحمها الطبقي واضحاً في تنظيمتها التي أطلقت على منتسبي هذه الأحزاب بـ (تحالف قوى الشعب العاملة)، كما هو الحال في مصر قيادة ثورة 23/ تموز/ 1952. وفي اليمن وليبيا وسورية والعراق. فمع وصول هذه القوى العسكريّة إلى السلطة، أغرتها شهوة السلطة فراحت تتحول إلى قوى مضادة لثوراتها وأهدافها المعلنة التي طرحتها قبل استلامها السلطة، حيث تحول معظمها إلى قوى برجوازيّة طفيليّة وبيروقراطيّة جعلت من مراكز تواجدها في السلطة مصادر ثروة غير مشروعة، كما أخذت تمارس نشاطات سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة وحتى اجتماعيّة بعيدة كل البعد عن مفهوم التقدميّة والمواطنة، إذ رحنا نجد معظمها عاد إلى مرجعياته التقليديّة من عشيرة وقبيلة وطائفة للبقاء في السلطة وتحويل الدولة إلى دولة (غنيمة) لهم ولأسرهم وأبناء عشائرهم وطوائفهم، بل أستطيع القول إنها قضت حتى على البذور الليبراليّة التي راحت تنتشي مع القوى الحاكمة السابقة لها من البرجوازيّة الكومبرادوريّة وأشباه الاقطاع.
إن من يتابع سياسات هذه القوى في الدول التي حكمتها، يجدها قد مارست تكريس الجهل السياسي والفكري، ومحاربة الفكر العقلاني التنويري النقدي الذي بشرت به الجماهير عند تشكل أحزابها ووصولها إلى السلطة، وذلك بغية إبعاد هذه الجماهير عن السلطة وعدم السماح لها بمشاركتها في قيادة الدولة والمجتمع، الأمر الذي أدى بسبب هذه السياسة الاقصائيّة إلى عرقلة تكوين فكر نهضوي وممارسة نهضويّة يساعدان على تجاوز الواقع المتخلف. بل رحنا نلمس أن الكثير من أبناء الجماهير الخاضعة لسلطتها التي وجدت نفسها مغيبة ومفقرة ومجهلة وعاطلة عن العمل وتُمارس عليها الوصيّة بالقوة، تندفع أكثر نحو الفكر الظلامي والسلفي التكفيري، وبخاصة الفكر السياسي الجهادي منه، كما وجدنا الانتماء الواسع للفكر الصوفي الطرقي المشبع بالوهم والكرامات والطبل والمزمار واللامعقول، وبالتالي فإن المنتمين لهذه التيارات الدينيّة ومنها الأصوليّة التكفيريّة والاقصائيّة، وجدوا أن خلاصهم من الفقر والجوع والبطالة، وتحقيق العدالة والمساواة تكمن في الدين وحاكميّة الله. ومن الطرافة بمكان، نجد أن القوى الحاكمة (التقدميّة) وغيرها من الحكام العرب بكل توجهاتهم وأشكال حكمهم راحوا يلعبون على وتر الدين وتوجيه الناس للسير في عالمه، مُسَخِرَةً مؤسساتها الدينيّة وتياراتها المدخليّة ممثلة بمشايخ السلطان لنشر قيم الفضيلة بين المواطنين الذين يعيشون في عالم نخر الفساد معظم أركانه، بيد أن الطريف أيضاً في هذا الأمر، أن هذا التوجيه السلطوي للشعوب نحو الدين، خلق قوى اجتماعيّة متدينة لم تعد الفضيلة التي أرادت السلطات الحاكمة دفع الناس لتبنيها، كافية لهم، وإنما راحت الدعوة إلى الحاكميّة هدفاً أساسيّاً لتوجهاتهم من أجل إسقاط الأنظمة الحاكمة التي نعتوها بالكافرة وراحوا يؤكدون فسادها هنا وهناك على مستوى مفاصل عمل الدولة وطبيعة العلاقات الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسيّة السائدة. وهذا ما كان وراء ثورات الربيع العربي، التي كانت ثورات ذات توجهات دينيّة، راح يبشر بها ويعمل معها الكثير من القوى المعارضة لهذه الأنظمة ممن تدعي التقدميّة أيضاً.
ملاك القول: مع تغييب الثقافة التنويريّة في الفن والأدب والمسرح والاعلام والمؤسسات الثقافية والمنظمات التابعة لهذه الأحزاب الحاكمة، راح يسود بالضرورة الفكر الظلامي المشبع بالجبر والاستسلام وتغيب العقول، والتمسك بكل ما يمت بصلة للدين، فالدين لم يعد صلاة وصوماً ورموزاً وقيماً أخلاقيّةً وعقيدةً سمحاء، بل أصبح عقيدةً وشريعةً ولغةً وأدباً وطموحاً ووسيلة تجاريّة بيد السلطة والمعارضة معاً. فالسلطات الحاكمة المستبدة الشموليّة راحت تتاجر به عبر مؤسساتها الدينيّة لتخدير شعوبها وإبعادهم عن السلطة بغية الحفاظ على مصالح الحوامل الاجتماعيّة لهذه السلطة، كما راحت المعارضة ذاتها تستغل الدين تحت ذريعة الحاكميّة لله من أجل تكفير السلطة وإدانتها وبالتالي إسقاطها عن طريق العنف.. نعم لقد أصبح الدين ثقافة ساهمت هذه الأنظمة ذاتها التي تدعي العلمانيّة في موضعتها داخل عقول ونفوس وعواطف ومشاعر وذاكرة وتطلعات شعوبها. وعلى أساس ذلك كانت داعش والنصرة ونهوض الإخوان من جديد وكل القوى السياسيّة الجهاديّة التي ثارت اليوم ضد هذه الأنظمة تحت ما سمي بالصحوة الإسلاميّة، وثورات الربيع العربي.
***
د. عدنان عويد - كاتب وباحث من سورية
.........................
1- الويكيبيديا – بتصرف.