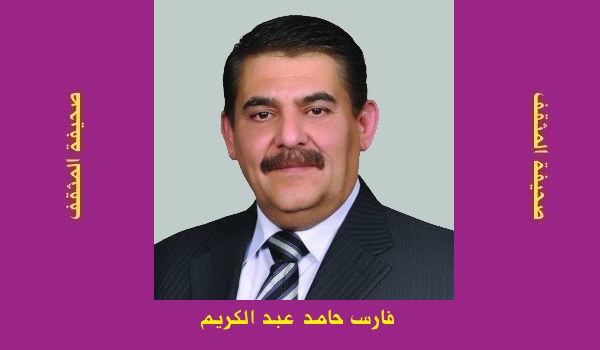أقلام ثقافية
حميد بن خيبش: الكتابة في مفترق

استكتب الأمير أحمد بن طولون جعفرَ بن عبد الغفار المصري، لكنه لم يستطع أن يؤدي عمله كما يجب، ومع ذلك احتمله ابن طولون. وقد سأله صديقه أحمد بن خاقان عن السر في ذلك، فقال له الأمير: "أنا أحتمله لأنه مصري".
فقال ابن خاقان: أراك أيها الأمير تفضل الكاتب المصري على الكاتب البغدادي!
قال: لا والله، ولكن أصلحَ الأشياء لمَن ملَك بلدا أن يكون كاتبه منه، وأن يكون شمل الكاتب فيه؛ فإنه يجتمع له في ذلك البلد أمور صالحة، منها أن يكون بطانة الكاتب وحاشيته في ذلك البلد.
**
حين لاحت بوادر الضعف على الخلافة العباسية، تزايد لدى البلدان الإسلامية شعور بالكيان الذاتي، والاستقلال بماضيها الحضاري، وإمكاناتها المادية والبشرية. هكذا نشأت إمارات ودويلات في الشام، ومصر، والحجاز، والأندلس. تبحث كل منها عن هوية خاصة، ولا تخضع لخلافة في بغداد إلا خضوعا شكليا، يتمثل في خطبة الجمعة ودفع الخراج.
ولأن الكتابة في جوهرها تعبير عن روح الأمة وتطلعاتها، فقد لقيت اهتماما متفاوتا من لدن الأمراء والولاة، سواء في شكلها الرسمي الذي تمثله دواوين الإنشاء، أو من خلال استقدام الكُتاب والمبالغة في إكرامهم لتأسيس ودعم شرعية الحاكم.
حرص أحمد بن طولون أمير مصر على أن تبلغ كتابة الرسائل الصادر عن ديوانه درجة عالية من الإتقان، فأنشأ ديوان" التصفح" لمراجعة ما يكتبه كُتاب الإنشاء. وتولى أمر الديوان كاتب بليغ فصيح هو محمد بن أحمد بن مودود المعروف بابن عبد كان. ويروى أن أهل بغداد كانوا يحسدون أهل مصر على بلاغته ويقولون:" بمصر كاتب ومحرر ليس لأمير المؤمنين بمدينة السلام مثلهما، ابن عبد كان الكاتب، وطَبطب المحرر".
اعتمدت كتابة الرسائل أو فن الترسل في هذه المرحلة على السجع في فقرات متفاوتة بين القصر والطول. واشتملت على عبارات رصينة، يتناسب فيها اللفظ الواضح مع المعنى، دون تفريط في ألوان الاستعارة والتشبيه التي تُكسب الصورة مسحة من الخيال. كتب ابن عبد كان في إحدى رسائله الإخوانية:" أطال الله بقاءك ففي إطالته حياة الأنام، وأُنسُ الأيام والليالي، وأدام عزك ففي إدامته دوام الشرف ونمو المعالي، وأتم نعمته عليك فإنها نعمة حلّت محل الاستحقاق، ونزلت منزلة الاستيجاب، ووقفت على ما تكره الآلاء مكانه، ولا تُنكر الفواضل محله.."
سارت الكتابة على نمط الأسلوب الذي وضع ابن عبد كان أصوله وخصائصه. أما في زمن الدولة الإخشيدية، فقد برز اهتمام الكُتاب بالمعاني أكثر من الاهتمام بالمحسنات البديعية إلا ما جاء عفوا دون تكلف من الكاتب. ويعد أسلوب إبراهيم النَّجِيرَمي الذي تولى الكتابة لدى كافور الإخشيدي، نموذجا للكتابة الميالة إلى البساطة في التعبير، مع تأثر واضح بالنحو والعلوم العربية الخالصة.
وفي العصر الفاطمي اهتم الخلفاء بفنيات الكتابة وقواعدها، وبالغوا في رعاية الكُتاب الذين يطورون أسلوبا راقيا، يدافع عن شرعية الخلافة الجديدة، ويُسخرون براعتهم لخدمة أغراض مذهبية. فكانت الكتابة سلاحا يخوض به الفاطميون غمار المواجهة مع مجتمع سني معارض، وضد أعداء الخارج.
اِلتزمت الكتابة زمن الفاطميين بالسجع، وصار تقليدا لم تتحرر منه إلا في العصر الحديث. واهتم الكتاب بالاقتباس المتزايد من القرآن الكريم، والشعر ومعانيه لتحلية كتاباتهم، وبالمبالغة في تشخيص المعاني. وكان ابن أبي الشخباء والقاضي الفاضل نموذجا لعودة أسلوب ابن عبد كان إلى الواجهة مجددا، مع تصرف يقتضيه فن الكتابة ومجريات العصر.
وباستقرار الأحوال في الأندلس، تزايد عدد الكُتاب الذين تُناط بهم مهام إدارية، وكان لابد للكاتب من تحصيل قدر كاف من الثقافة، والمعرفة. أما السمات العامة للكتابة آنذاك فقد اقتصرت على الإيجاز وإيثار المعنى.
لكن مع أواسط القرن الرابع الهجري، سيظهر كُتاب اهتموا بترسيخ قواعد للكتابة، تميل إلى الأصالة وعدم محاكاة كُتاب المشرق، كابن شُهيد، وابن دراج القسطلي، وابن زيدون، والجزيري، وغيرهم.
تميز أسلوب الكتابة الأندلسية بالاعتدال، وإيضاح الفكرة بعبارات بسيطة ودالّة، فلا نلمح في كتاباتهم عناية زائدة بالسجع، باستثناء حرصهم على التوازن في العبارة. جاء في رسالة لأبي المُطرّف، يعقد فيها أهل شاطبة الولاء للخليفة العباسي المستنصر:" الحمد لله الذي جعل الأرض قرارا، وأرسل السماء مدرارا، وسخّر ليلا ونهارا، وقدّر آجالا وأعمارا، وخلق الخلق أطوارا، وجعل لهم إرادة واختيارا، وأوجد لهم تفكرا واعتبارا، وتعاهدهم برحمته صغارا وكبارا".
غير أن الكتابة ستعرف في عصر الطوائف، حالة من الجمود الفني كما سماه الدكتور شوقي ضيف، تتكرر فيها الأساليب والعبارات مئات المرات، ولا جديد إلا ما يتصنعه الكاتب من مصطلح علمي، أو استخدام مثل أو لفظ غريب.
يعتبر لسان الدين بن الخطيب أحد أعلام الأدب والفن في القرن الثامن الهجري، وأبرع كاتب أخرجته الأندلس في عصورها الأخيرة. تميز أسلوبه بالانتقال من السجع إلى الكلام المرسل، واللجوء إلى الجناس بأنواعه. كما تفنن فيما يسميه الدكتور ضيف بالسجع المركب.
يقول على سبيل المثال في وصفه للعرب:" العرب لم تفتخر قط بذهب يُجمع، ولا ذُخر يُرفع، ولا قصر يُبنى، ولا غرس يُجنى. إنما فخرها عدو يُغلب، وثناء يُجلب، وجُزُر تُنحر، وحديث يُذكر، وجود على الفاقة، وسماحة بحسب الطاقة.."
استمر حضور الرسائل كقالب مهيمن للكتابة، مع سعي إلى تناول مواضيع وقضايا جديدة. وهكذا ازدادت عناية الكتاب بالرسائل الموضوعية التي تدور حول إفضاء الكاتب بما يدور في ذهنه حول قضية معينة، فكانت بذرة أولى لما سيُعرف لاحقا بفن المقالة. ولعل من أبلغ النماذج تفردا وإبداعا هي رسالة الغفران للمعري، والتي بناها على نمط من الخيال غير مسبوق.
وتميز العصر كذلك بظهور كُتاب مارسوا الكتابة إلى جانب صنعة الشعر، فتبنوا أسلوبا يمزج بين المنظوم والمنثور، ويحاول أن يوحد الخصائص الفنية بينهما. لذا شهدت الساحة الأدبية انقساما بين الفريقين، وظهرت مؤلفات تنتصر لهذا اللون أو ذاك، حيث تعصب ابن رشيق للشعر والشعراء في كتابه "العمدة"، بينما دافع ابن خلف في كتابه "مواد البيان" عن الكتابة والكُتاب.
في مقابل التفكك السياسي الذي شهدته الخلافة العباسية، واصلت الكتابة المشرقية حضورها في مختلف الأقطار الإسلامية. فكان ابن المقفع والجاحظ وبديع الزمان الهمذاني، ظلالا يلمح المرء حضورها في ثنايا مئات المصنفات في القاهرة ودمشق وقرطبة.
حضور يدين بالفضل للنبع والواحد، واللغة الواحدة، والملامح الأدبية المتقاربة، دون أن ننكر محاولات التجديد والإبداع التي أضفت على الكتابة في كل عصر وبلد خصوصية وذوقا متفردا.
***
حميد بن خيبش
........................
محمد كامل حسين: الحياة الفكرية والأدبية بمصر
محمد زغلول سلام: الأدب في العصر الفاطمي
محمد رضوان الداية: في الأدب الأندلسي.