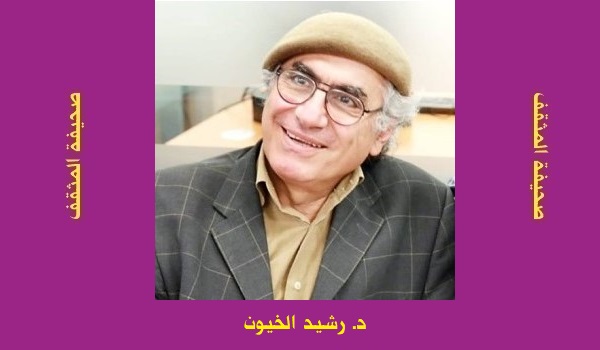أقلام ثقافية
لمى أبوالنجا: ما خلف القناع

في الواقع، أنني نسيتُ تاريخ هذا اليوم، ولا أبدي رغبةً في النظر إلى هاتفي لأعلم في أي يوم من الشهرِ نحن، ولا يهمني ذلك.
هناك فضاء زمني ووجداني بين الواقع، وبين إدراكي له.
لا شيء حقيقي، ولا قدرة لي على إظهار الأمور كما هي دون إدعاء الصلابة في لحظات الإنكسار، دون الضحك حينما أرغب في البكاء.
الواقع أمرٌ يصعب تقبله، لا يمكنك إدراك لحظة واحدة دون حلم أو حنين.
وفي اللحظة التي تعي فيها ذلك، ينتهي بك الأمر في عيادة نفسية.
تجلسُ أمام طبيبٍ محاولاً تلخيص عمرك، تجاربك، أفراحك وأحزانك على شكل نقاط في جلسة استماع، بينما تحاول الثبات وجمع شتاتك لتتحدث. يحدّق بك، ولا شيء آخر يفعله سوى التحديق بك ومشاهدتك ترتعش وتتلوى مثل سمكةٍ أُخرجت من المحيط إلى القارب، وتركت على السطح والصياد يترقب توقف نبضها.
لا يستطيع أي طبيب أن يصف لنا أقراصاً تعالجنا من ذكرياتنا، أو أن يخلصنا من تلك الصور التي تنطبع خلف أجفاننا عندما نغمضها لكي ننام أو نحلم، ونحن نضحك قبيل هبوط الخيبة.
الحياة إجمالاً عبثية فوضوية مثل هذا النص الذي أكتبه الآن، متكررة ككل العبارات التي استخدمتها هنا.
وفوق كل ذلك، غير عادلة، ولا يوجد ما هو عادل فيها سوى لحظة الولادة ولحظة الموت. أما جميع ما بينهما فهو مضطرب الإيقاع.
أنت لم تختار لحظة ولادتك، ولا اسمك، ولا هيئتك، ولم يكن لديك الخيار حتى في أن تكون أو لا تكون، فقد قذفت إلى وجودٍ ربما لا ترغبه لو خُيّرت فيه.
إنك تشقى في كل مراحل حياتك، الدراسة شقاء، والغنى شقاء، والفقر شقاء، وحتى خروجنا إلى العالم كان شقاءً، فأمك ذاقت الموت ألف مرة لتستقبلك.
لا شيء سهل ومثالي، حتى حلمك الذي تسعى إليه، عليك أن تخوض صراعات وتسقط مئات المرات حتى تصل.. تصل متعباً.. تصل شخصاً غريباً لا تعرفه.. وقد لا تصل أبداً.
حتى أولئك المتشبثين بالحياة، الملوثين بأحلامٍ يقبضون عليها كما لو كانت جمراً، فإنهم لا يعلمون متى ستنفلت قبضتهم عنها، ومتى سوف تنطفئ شعلتهم.
أتخيل دائماً اللحظة التي سوف يتحتم علي فيها أن أغمض عيني الإغماضة الأخيرة، عندما يستسلم جسدي لرحيلٍ ترفضه روحي. هل سأحظى بالنظرة الأخيرة في وجوه من أحب؟
أم أني سوف أعاقب بوحدتي التي قدستها كثيراً؟
أعتقد أن أقدس حضور هو حضرة إنسان يرحل في أوج اشتعاله، فهذه اللحظات الأخيرة هي صورة صامتة لحصيلة عمره وكل ما مر به من ركام.
هي لحظة مرعبة ومهيبة لأنها الشاهد الوحيد على الحقيقة.
(لماذا لا تكون الحياة هكذا؟).
(أن نولد في عمر الثمانين عاماً، ثم كلما تقدم بنا الزمن نتراجع سنة إلى الوراء: ثمانين، سبعين، ستين… وهكذا، حتى نصل في سن العشر سنوات ونحن لا نفهم الحياة كثيراً. وعندما تصبح أعمارنا صفراً، فإننا نرحل غير مثقلين بذاكرة ولا حنين!).
إنني لا أفهم مشاعري، حتى عندما أريد الحياة، أتحدث عن الموت.
عندما أريد أن أعيش اللحظة، أسأل عن معناها، وكيف أتت، وما هي ماهيتها.
أذكر حواراً دار بيني وبين صديقتي. قالت لي: "عندما أفكر بالوجودية وبمعنى الحياة، أعلم أنني سقطت في الاكتئاب." فأجبتها: "أما أنا على عكسك تماماً، عندما أكون سعيدة، أتساءل عن كل هذا العبث، وماذا لو لم أُخلق إنساناً؟"
فضحكت لاختلافي وللشقاء الذي أسببه لعقلي.
بل إنني دائماً ما أبحث عمن يشاركني هذه الهرطقات، وأشتاق إلى حديث معتّق فاخر، حوارات عميقة في أمور لا تجذب أحداً.
أحاديث أجريها في العتمة، في الظلام الدامس، ظلام يشبه ذلك الذي يقبع في أعماقي، يخيل إليّ به حديقة جميلة ساحرة، لكنها بعيدة جداً.. يضيئها القمر أحياناً، ويغيب عنها أحياناً أخرى.
عندما أخوض حديثاً بقدر من العمق، أتخيل كأني دعوت هذا الإنسان إلى حديقتي السرية، البعيدة، والمقدسة.
لا يصلها إلا من تطهر من الأقنعة، ولا يعتب أبوابها سوى أولئك الصادقون، الطفوليون، والعميقون جداً.
إنني ارتعش الآن.. الطقس دافئ، لكنني أعتقد أنه الصقيع في قلبي، أو مقاعد حديقتي الحديدية الفارغة.
***
لمى أبوالنجا – أديبة وكاتبة من السعودية
الخميس..