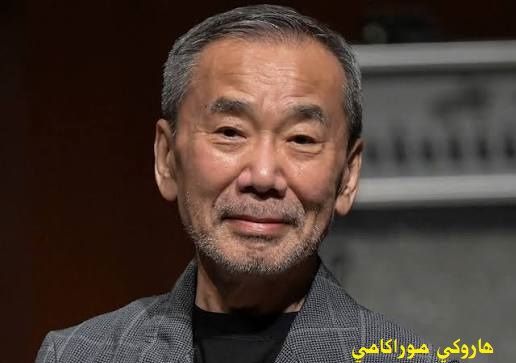ترجمات أدبية
الباب الوردي / ترجمة: صالح الرزوق

بقلم: غواديلوب نيتل
ترجمة: صالح الرزوق
***
في حياتي البالغة ستة وثلاثين عاما، لم يخطر لي أن أستعين بخدمات بغي مأجورة. وفي أسوأ الحالات، حينما كنت شابا، قدمت الجنس على سبيل الإحسان - مثل وجبة طيبة وسرير دافئ – وذلك حينما تجولت في أرجاء أوروبا وحقيبتي على ظهري. ويمكن أن تقولوا إن زوجتي ليلي زرعت بذرة في رأسي بعد كلام عابر فتح الباب لسلسلة طويلة من الأفكار والأفعال. في أمسية من الأمسيات، ونحن نتمشى في حارتنا باتجاه شوارع صغيرة مهجورة تجاور شارعنا، أشارت ليلي إلى شيء جديد، وهو في الحقيقة باب ضيق بلون العلكة الوردية، ويتخلله قلوب زرقاء وخضراء مرسومة بألوان الباستيل. وكان يبدو مثل باب غرفة نوم بنت مراهقة. كانت شمس المساء تتراجع، وتنير أرض الزقاق المرصوفة، وجدرانها الرمادية بضوء بنفسجي، حتى أنها جعلت لون الباب يتوهج بلون غير طبيعي. وأفترض أن هذه الإضاءة هي التي جعلتنا ننتبه له.
قالت زوجتي بحماسة ولد صغير: “هل شاهدت ما يجري هناك؟". وقفت على أطراف أصابعها لتحظى برؤية أفضل. رأيت في مكان مرتفع من الجدار، نافذتين صغيرتين وجذابتين مفتوحتين مثل جفنين ناعسين. وعوضا عن أن يسمح تصميمهما برؤية ما يدور في الخارج، كان عملهما على ما يبدو التهوية مع حرمان المارة من رؤية ما يجري في الداخل. وإذا بذلت جهدا، يمكنك أن تلاحظ أشياء قليلة للزينة ولكنها جعلت المكان محيرا تماما.
أشارت زوجتي إلى شمعدان بخرزات برتقالية من الزجاج – أو لعلها من البلاستيك؟ - وكان يتدلى من السقف. وعلى الجدار بالون أحمر له بريق معدني وبشكل كلمة إنكليزية هي "حب".
قالت ليلي لتوقظ فيني الفضول الذي انتابها: "يا له من مكان ضيق وغريب. هل وقعت عينك عليه من قبل؟".
“أبدا".
"أنت الذي تعود إلى البيت من هذا الشارع. ولا أصدق أنك لم تشاهده من قبل".
قلت لها بقليل من التعجب: "حسنا. نعم. ولكنه لم يكن هنا قبل الآن. وظهر فجأة في الليل. ولربما قاموا بطلائه في الأمس".
“إن كان الأمر هكذا، لا بد أن تفوح منه رائحة الدهان الجديد، أليس كذلك؟. وعلى الأرجح أنه كان هنا منذ أسابيع ولكننا لم نلاحظه".
غامرت بالقول: “ربما هي غرفة بنت غادرت بيتها لأول مرة". وكنت مطمئنا لهذا التفسير، لولا معارضة زوجتي.
أجابت بثقة عالية بالنفس: “لم أعرف امرأة كبيرة بالعمر وتترك بيتها والبالونات لا تزال معلقة في غرفة نومها. أليس الأرجح أنه لبغي أو لقوادها؟".
بالمقابل اقتنعت أنه لا يوجد للذوق الرديء عمر، وكنت متعبا ورغبت بالعودة إلى البيت، بأسرع ما يمكن، ولذلك اخترت أن أوافقها.
قالت زوجتي وكانت نصف جادة ونصف عابثة:" إياك أن تفكر بزيارة هذا المكان. هل تفهم؟". وأشارت لي بأصبعها.
تظاهرت أنني فقدت الاهتمام بالموضوع، ولكن الحقيقة هي العكس تماما. وفي ذلك الأسبوع فكرت بالمكان في عدة مناسبات. وفي أبعد الاحتمالات كان الباب الصغير يظهر في خيالي، ولكنه موارب، وكأنه يدعوني للدخول. وفي إحدى الليالي تخيلت أنني أدخلت رأسي، بما يسمح لي برؤية مالك الغرفة: طالبة، ذات بشرة ناعمة وسمراء، كانت تجلس بثيابها الداخلية، ومنحنية لتلمس طلاء أظافر أصابع قدميها. وتسببت لي التخيلات بحركة بين ساقي، كانت غير معتادة في هذه الأوقات، حتى أنها أدهشتني رغما عني، كان انتصابا قويا لم أمر به منذ سنوات. وكان بجانبي رأسها مدفونا في كومة من الوسائد، التي تشخر عليها زوجتي في الليل. نظرت إلى ساعتي: أشارت إلى منتصف الليل وخمس وعشرين دقيقة. فكرت أن أتسلل من البيت وأذهب إلى كالي ماريبوسا، ولكن فورا تذكرت صوت ليلي يمنعني حرفيا من الاقتراب من تلك المنطقة. وتساءلت متى آخر مرة مارسنا فيها الحب معا، ولكن لم أتذكر رغم ما بذلت من جهد.
سأكون كاذبا إن قلت إن ليلي ليست زوجة متحكمة. حتى قبل زواجنا، كان اتخاذ القرار بيدها كلما واجهنا شيء هام له علاقة بحياتنا العائلية. وهي من اختارت شراء البذة والحذاء ليوم الزفاف، واسم ابنتنا، والبيوت التي استأجرناها خلال أول عدة عقود عشنا فيها معا. ومرة وفرنا بعض النقود لشراء أرض، فاختارت هذا الحي وتحكمت تماما بكل عمليات البناء. وأنا لا أشتكي - فذوقها وذوقي كانا منسجمين، ويجب أن أقر أنه لسنوات كانت شخصيتها الحازمة تحميني من الصداع، ولكن هذا لا يمنع أنها جعلتني أشعر مرارا وكأن التيار يجرفني. وكانت استراتيجية البقاء عندي تتلخص في احتلال مساحات رمادية، تلك التقاطعات التي لا تغطيها اهتمامات زوجتي بسبب تفاهتها. أمور مثل اختيار نوع القهوة التي نشربها وكيف نعزل النفايات، وسمحت لي هذه السخافات أن أحتفظ بكرامتي، ولكنها لم تكن كافية لتمنحني قدرا محسوسا من الإقبال على الحياة، ولا أن تجنبني النفور الذي شعرت به لعدة عقود، لأنني لست سيد مصيري. وربما لهذا السبب، حينما اكتشفت الأثر الداخلي لذلك المكان، قررت أن أهمل أمر المنع وعدم الاقتراب، وذهبت بتمردي إلى آخر حد ممكن. ليس من السهل الاحتفاظ بهذا العزم. عدة مرات كنت أمشي في كالي ماريبوسا، آملا أن أخطو من فوق عتبة ذلك الباب الصغير، ولكنه كان مغلقا على الدوام. والنوافذ بالمثل مغلقة معظم الوقت، وجعل الجليد معرفة ما يدور في الداخل مستحيلا. أما الواجهة فقد تبدلت ولم تصمد. كانت الحجارة تبدو وكأنها منطوية على نفسها، وتغط بالسبات. وحتى لون الخشب، الذي أحببته، كان أكثر خمولا، كأنه تحلل بالماء.
كان ذلك في يوم الخميس 24 أيلول - أتذكره جيدا لأنه في ذلك اليوم، كانت كلارا، ابنتنا، ستبلغ الواحدة والثلاثين من العمر، ولكن حينها وقعت أول حادثة. كان المفروض أن تأتي كلارا في تلك الأمسية لتحتفل معنا. اتصلت بها في أول اليوم لأقول لها عيد ميلاد سعيد، وتحادثنا كيفما اتفق لعدة دقائق. ثم أنفقت عدة ساعات بالتركيز على مبلغ بوليصة تأمين توجب علي تسليمها إلى أحد زبائني. أضجرني العمل، وقررت أن أبتعد عن مقعدي. وجدت زوجتي في المطبخ وهي تبدأ بالعمل على الكيك الذي تخبزه لابنتنا في كل عام. وكانت خلاصة الفانيلا قد نفدت، وطلبت مني أن أذهب إلى السوبرماركت لأحصل على شيء قليل منها. بدلت ملامح وجهي كي لا أثير شبهاتها، ولكن في أعماقي سرني هذا المنفذ للخروج في ذلك الوقت من اليوم. كانت الشمس تغيب، ورأيت كالي ماريبوسا مطلية بلون بنفسجي مجددا. ورجل وامرأة يدردشان أمام الباب المفتوح. كان ظهر المرأة لي، ولذلك يصعب أن تقدم أي تفاصيل عنها، باستثناء أنها نحيفة وذات ورك عريض. ولها شعر أسود طويل، جمعته تحت قبعة بنفس لون بلوزتها. وكانت ثياب الرجل من طراز مماثل. وكما يظهر أنهما يعملان في السينما أو في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة. من مكان وقوفي أمكنني أن ألمح الغرفة خلفهما: الشمعدان البرتقالي لا يزال داكنا، واستطعت رؤية سرير بجانب جدار القرميد، وهو ما دعم نظرية زوجتي عن طبيعة العمل هنا.
فتح الرجل صندوق سيارة، وبدأ بتفريغ عدة علب من الورق المقوى، صغيرة، مثل التي تستعمل بنقل الكتب، مع أنني استبعدت أنها تحتوي الكتب. لم أود أن يشاهدوني وأنا أستمع، ولذلك استدرت وتوجهت مباشرة إلى السوبر ماركت. اشتريت مستخلص الفانيلا، وعدت إلى البيت بأسرع ما يمكن. لم يكن الرجل والمرأة بمكانهما، ولكن كان الباب نصف مفتوح. والنور يضيء في الغرفة، والبالون المعدني معلق بالجدار ويعكس نفس البريق المضيء الذي رأيته أول مرة. وفي غضون ذلك كان السرير قد اختفى. وحلت بمكانه كنبة، وأمامها، طاولة قهوة صغيرة. قال صوت عذب جدا وشعرت أنني مجبر على طاعته: “يمكنك أن تدخل إن أردت ذلك". وحينها رأيت هناك شخصا يجلس في مؤخرة الغرفة، أمام ما يجب أن يكون خزانة، أو بأبعد تقدير، باب الحمام. وكان الشخص بثياب مثل البقية: بنطال أسود، وصدرية حمراء، وقبعة. واستحال علي تحديد الجنس. وكان في حضنه علبة حلويات مثل التي يأتي بها باعة الحلويات الجوالون إلى السينما والمسارح قبل بداية العرض بقليل. ماذا جعل هذا الشخص هناك على أهبة العمل، كما لو أنه يوجد زبائن ليبيعهم بضاعته؟. المشتري المحتمل الوحيد، وعلى الأقل في هذه اللحظة، هو أنا. وللحظة من الوقت فكرت أن أسأل لمرة واحدة ما طبيعة هذا المكان، ولكن لم أفعل، ربما لأنه من الواضح أن الحلويات واجهة، والسؤال لن يكون مستهجنا فقط، ولكن سيضع كل أصحاب العلاقة في موضع الدفاع عن أنفسهم.
قلت: “عذرا، زوجتي بانتظاري لتجهز كعكة عيد الميلاد، وأسرفت بهدر الوقت كثيرا. سيزعجها ذلك. وإن لم أرجع إلى البيت حالا ستضعني في الفرن عوضا عن الكعكة".
رفعت مضيفتي نظراتها. كانت فتاة بشعر قصير، وبعينين واسعتين بنيتين، وقد ثبتتهما علي بتكهن.
قالت بصوت ناعم كالسابق وهي تمد يدها بورق سيلوفان في داخله قطعة سكاكر صغيرة الحجم:" خذ معك إحدى سكاكرنا، على الأقل - ستحلي طريق عودتك للبيت. هذه عينة. ولن أتقاضى ثمنها منك". لم أود أن أكون بليدا، فقبلت هديتها، ووضعتها في فمي. ومباشرة سال على لساني طعم كرات اليانسون. كنت أحب معظم الحلويات، ولكن بعضها يمتلكني، ومنها اليانسون. وحالما استمتعت بنكهتها، أسرعت بالمشي إلى زوجتي بعد أن سرقني الوقت. دخلت إلى البيت وأنا ألهث لتعلم أنني كنت أجري في الطريق إلى البيت، ولكن عوضا عن أن أجد ليلي أمام الموقد، ومئزرها مغطى بالدقيق كما تركتها تقريبا قبل أربعين دقيقة، رأيتها جالسة على الكنبة، وهي مندمجة مع واحدة من الأعمال الكوميدية التي أتسلى بها، مع أنها لم تشاركني بمشاهدتها على الإطلاق. في البداية قلت لنفسي، إنها قررت أن تستغني عن مستخلص الفانيلا، ولكن لم يكن هناك أي رائحة للكيك، ولم أجد أثرا في المطبخ يدل أنها كانت تخبز.
قلت بلهجة ندم مصطنع: “آسف يا عزيزتي. كان المتجر مزدحما حقا. متى ستأتي كلارا؟ وهل لديك وقت يكفي للانتهاء من تحضير كيك عيد الميلاد؟".
وحينها حولت نظرتها من التلفزيون، وتعبير عجيب على وجهها وقالت:" أعتقد أنك مرتبك. لا يزال أمام عيد ميلادها شهر آخر". كنت رجلا كثير الشرود، ولذلك سرني أن أقتنع أنني أخطأت بتقديراتي، لو لا هذه الفترة المسائية التي أمضيناها بالتخطيط لقائمة الطعام والتحضير لأطباق عشاء عيد ميلادها.
قلت متلعثما: “أليس اليوم هو الرابع والعشرون من أيلول؟".
"هو كذلك. ولكن عيد ميلاد كلارا في الخامس والعشرين من تشرين الأول. ألا تتذكر تاريخ ميلاد ابنتك؟".
طبعا أتذكره. وكتبته العديد من المرات على كل أنواع الوثائق الرسمية خلال حياتي، وأنا متأكد أنه ليس في تشرين الأول. سمحت لليلي أن تتابع مشاهدة فيلمها، وصعدت إلى غرفتي لأهاتف كلارا. من الخلف أمكنني سماع ضجيج مطار، وكان صاخبا، وتخلله ذلك الصوت المعدني الذي ينادي على المسافرين ليشرعوا بركوب الطائرة، ومن الواضح أنه لم يكن لديها أدنى نية بالقدوم في هذا المساء.
"هل يمكنني الاتصال بك بعد ساعتين يا أبي؟".
ولا بد أنها لاحظت الحيرة التي نقلتها عدة كلمات تلعثمت بها، لأنها سألت مباشرة: “هل من خطأ ما؟ هل أمي بخير؟".
"كل شيء جيد. فقط أردت أن أحييك".
ولكن استمر الاضطراب في بقية الليلة. وكلما تنحنحت واستدرت، كنت أتساءل إذا كنت لا أعاني من نوع من أنواع الخبل، مثلما كانت تلمح ليلي في مناسبات منتظمة، وإذا كان علي أن أرى طبيب أعصاب. عملت طيلة الصباح اللاحق، مع الحرص أن لا أفكر بأي شيء ليس ضمن نطاق الحسابات والاحتمالات، ولكن ما أن خفت حدة الحرارة وبدأت السماء تعتم، عدت أدراجي إلى كالي ماريبوسا، منجذبا لغموضه. كان الشمعدان مضاءا حين وصولي، ورأيت الباب نصف المفتوح. وكان عندي شعور أن أحدا ما بانتظاري. وفي هذه المرة لم تتوقف قدمي عند المدخل، ولكن على مبعدة أقدام منه. وكان رجل آخر يقف منتظرا عند الباب. ولم يكن ببذة. وكان يبدو مثل موظف في السينما، ويشبه أي جار من جيراني. وقبل أن يقرع الباب، رتب قبة سترته، ومسد بنطاله. وبالحال سمحوا له بالدخول. كان الشارع مهجورا، ولذلك جمعت فلول شجاعتي لمتابعة ما عزمت عليه، حتى أنني ووضعت أذني على الباب. وتمكنت من سماع أطراف حوار استنتجت أنه حميم، ولكن ربما كان مجرد تبادل أسرار. ولم أرغب أن يضبطني أحد وأنا أتجسس من أمام الباب، على هذه الغرفة، مهما كان هذا المكان. وعليه بدأت أتخبط في مسيري على طول هذا الشارع الفارغ. ماذا أملت أن أجد بالضبط؟. سألت نفسي هذا السؤال وأنا أتجول بعصبية حول الشارع. وأيقظت نظرية زوجتي الافتتان الغريب في داخلي، وكذلك انتبهت أنني منذ سنوات مشتاق ليس لعصيانها فقط، ولكن لارتكاب فعل يتجاوز الحدود. أن أجرب البغاء، وعلى بعد عدة أقدام من بيتي، كان بالتأكيد فعلا مشينا. ولكن هل هو مكان للبغاء؟. لم أكن مقتنعا. وإذا كان مبغى، لم أكن متأكدا أنني سأجرؤ على الإقدام عليه، مباشرة. ومجرد هذا الاحتمال حرك في داخلي، مزيجا من الخوف والاضطراب، الذي لم أمر به منذ مدة طويلة، وهو بحد ذاته عامل إضافي. استغرق الرجل أكثر من نصف ساعة بقليل، قبل ظهوره مجددا، وذلك حينما قررت أن أغادر. ولاحظت باهتمام السعادة المطبوعة على وجهه، وشعرت بشيء يشبه الحسد - وبنفس الوقت الإعجاب - لهذا الشخص، فهو أجرأ مني، مع أنني الأول الذي جمع فلول شجاعته لحل هذا اللغز في حينا. وربما كنت جاهزا لمقاطعة طريقه وسؤاله عما اكتشفه في الداخل، ولكن أردت أن أرى وأسمع بنفسي. وما أن فرغ الشارع مجددا، دفعت ذلك الباب بحرص، ولكن دون أن أتردد ولو لحظة واحدة. قال صوت من الداخل: “تعال. وتفضل بالجلوس. كنا بانتظارك". ثم رأيت الفتاة التي قدمت لي السكاكر الصغيرة.
منذ أيام صباي، كنت أواصل الكلام بلا انقطاع لأتغلب على الارتباك. وفي تلك الأمسية لجأت إلى هذا التكتيك بكل إمكانياته. أوضحت للبائعة أنني انتظرت فترة طويلة قبل أن أقرر المجيء، ولم أكن معتادا على مبارحة المنزل، وبلا شك شجعني أن هذا المتجر قريب جدا من مكان معيشتي، وحيث أعمل بصفة مقاول مستقل. وقلت أيضا - وندمت على ذلك - إن أحوال زوجتي لا تذهب بالاتجاه المبشر منذ عدة سنوات، وبعد تقاعدها، على وجه الدقة، كانت تنتظر في البيت دوما وهي تفرض علي ما يجب أن أفعل وما لا أفعل. ولأختم التفاصيل الطويلة، أكدت للبائعة أنني بحاجة لبعض العاطفة الإضافية، وفتحت عيني على وسعهما لاؤكد أن هذه حقيقة داخلية. كلما تذكرت ذلك اليوم، كنت أمنع نفسي من الشعور بالخجل، ومن النوستالجيا التي تغمرني. لأنه منذئذ تبدلت حياتي كلها.
أجابت المرأة الشابة: “لا تقلق. نحن هنا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك. هذا عملنا".
وتوقعت أنها ستقودني إلى مؤخرة المكان، أو في أسوأ سيناريو، ستنهض وتغلق الباب، وتبدأ بالتخلي عن ثيابها دون مزيد من الكلفة. ولكنها اكتفت بإخراج ملف للنماذج، نماذج من السكاكر. وقالت: “اختر واحدة". وهي تقلب الصفحات البلاستيكية الشفافة التي تعرض مجموعة المحتويات. وبنفس الإسهال اللغوي الذي عانيت منه، أخبرتها أن السكاكر المنكهة باليانسون والتي جربتها في الأمسية السابقة، كانت لذيذة، ويسعدني أن أختار منها، ولكن أتمنى في هذه المرة، أن تكون أكبر قليلا.
ابتسمت البائعة لي بسرور. وبأصابعها الطويلة والرقيقة، انتقت قطعة سكر من الملف ووضعتها في كيس شفاف يسمح بالرؤية.
وقالت:" هذه المرة ثمنها خمسمائة يا سيد مونكادا".
اعتقدت أن المبلغ هائل - ويغطي الخدمة التي أنتظرها منها، وإن لم يكن كافيا، فهو على الأقل يعادل ثمن خمس أكياس من السكاكر ويمكن الحصول عليها في السوبرماركت - ولكن علاقتي مع هؤلاء الناس كانت قد بدأت، ولم أود أن أترك لديهم انطباعا سيئا، ولذلك حاولت التستر على دهشتي.
سألت بما أمكن من اللهجة الطبيعية: “ماذا يتضمن هذا السعر؟".
قالت بحدة وهي تتبنى لهجة جادة تماما: “السكاكر وكل عواقبها. هل لديك عائلة أخرى يا سيد مونكادا؟ هل تشترك بحياتك مع أحد غير زوجتك، وهل من شخص مهم جدا بالنسبة إليك؟".
وحينها انتبهت للمعلومات التي سربتها لهذه المرأة الشابة، عن حياتي الشخصية، ولكن أن تكون كتوما شيء، وأن تسألني مختلف الأسئلة شيء آخر تماما. وفكرت باحتمال أنهم يودون تدمير سمعتي.
قلت بفظاظة:" لا. فقط أنا وهي".
وأنا أمتص السكاكر، شكرت البائعة وأسرعت بالهرب من البيت، عازما أن لا أعود إليه. ولدى الوصول إلى البيت، لم أشاهد سيارة زوجتي في المرآب. وكان باب المطبخ مغلقا، مع أننا نتركه دائما مفتوحا. وكانت كل أغطية النوافذ مقفلة، مع أننا لسنا في الليل، وكانت إنارة الشرفة مضيئة. في غرفة الطعام وجدت ملاحظة بخط يد ليلي تقول:" سأكون في المحكمة حتى السادسة. وسأعود للعشاء". مرت سنوات لم تعمل خلالها زوجتي على قضية، وأكثر من ذلك منذ أن ذهبت إلى المحكمة شخصيا. بدأ قلبي يدق، توجهت إلى المطبخ، وأخرجت من الثلاجة السمك والخضار، وبدأت بتحضيرها، كما اعتدت لسنوات، حينما كانت زوجتي تعمل خارج المنزل، وكانت تلك أسعد أيام حياتي. بعد ساعتين عادت ليلي. كانت التنورة الضيقة التي ترتديها تبدو مثالية. ولم يكن الوزن الذي فقدته وحده ما أذهلني: كان شعرها طويلا أيضا، ومقصوصا بطريقة أنيقة، وبدون شعرة بيضاء واحدة على رأسها. شكرتني على العشاء، وسكبت لنفسها أول كأس نبيذ، وكررت ذلك عدة مرات. وبدأت بالكلام والتوضيح حول المحاكمة وكل من قابلته في هذا الصباح، وكأنها متأكدة أنني مهتم بهذه التفاصيل، وبالتأكيد - لدهشتي البالغة - أنني شعرت بالاهتمام يتجدد في نفسي. وبعد ذلك فورا جلست ليلي في حضني، وبدأت بفك أزرار قميصي. رغبت بها أكثر من الرغبة التي كانت توقظها في داخلي حينما تعارفنا لأول مرة. وحينما كانت شفتاي تنزلقان على رقبتها، قلت لنفسي إن الخمسمائة بيزو مبلغ مضحك وقليل حقا.
بقيت هكذا لأسبوع، أستمتع بالوضع الجديد حتى أقصى حد. ليلي تذهب إلى المحكمة في الصباح، وأنتظر أنا في البيت وحدي، أعمل على أوراق الضمان في مكتبي، ثم أسترجع الحسابات في بقية أرجاء المنزل. في المساء أبذل كل طاقاتي لإعداد عشاء لذيذ، لأنتهي نهاية سعيدة، سواء في غرفة المعيشة أو غرفة النوم. من يحتاج للتفكير بمعاشرة امرأة غريبة بينما ليلي بأفضل حالاتها؟. والآن حددت مصدر كل هذه التبدلات، ولكن التفكير بها كان وراء حدود طاقتي. وقررت حتى لا أنشغل بها، أن أفترض أن الحياة هي هكذا دائما، وستتواصل هكذا دون نهاية. وعوضا عن العودة إلى متجر السكاكر في تلك الأمسية، استيقظت من غفوة طويلة، وتبددت سنوات الشقاء في زواجي وتحولت إلى حلم رديء. كانت حياتي مع ليلي على أتم وفاق حتى تلك النقطة، وتساءلت إن كان من الأفضل أن أدعها هكذا إلى الأبد. قرابة الأسبوع الثالث، بدأت أشعر بغياب شيء ما حاولت جهدي، منذ البداية، أن أعرفه.
سألت زوجتي في أمسية من الأمسيات قبل العشاء مباشرة: "هل سمعت من كلارا؟".
أجابت: “من هي كلارا؟".
لم أتمكن من الطهي في تلك الأمسية. حاولت أن أخفي على الأقل القلق الذي يقضمني من الداخل، فتركت كل شيء في المطبخ، دون أن أتخلى ولو عن مريولي، وذهبت إلى مكتبي وحبست نفسي فيه. بحثت بلا نجاح عن رقم ابنتي في جهاز الهاتف. لم أشاهد أي صورة لها أيضا. رفضت أن أصدق ذلك، وطبعت اسمها الكامل في حقل البحث في متصفحي، بمحاولة للعثور عليها، ولكن بلا نتيجة. تذكرت حواري مع بائعة السكاكر، وعنفت نفسي لأنني لم أخبرها بالحقيقة. لأنني وضعت كلارا خارج حكايتي، تم استئصالها من حياتي. وتشكل عندي إحساس أنني ضحيت بغباء بأغلى شيء عندي في العالم مقابل عدة سنوات من المتعة المادية. ذهبت للعثور على زجاجة ويسكي في المطبخ وجلست أبكي بغضب بكل طاقتي لبقية تلك الليلة. في اليوم التالي، عدت إلى كالي ماريبوسا، لأطلب منهم استعادة ابنتي.
قالت: "هذا فوق قدراتنا تماما يا سيد مونكادا. ولو بمقدورنا ذلك ليس من العدل أن نفعل: فهي غلطتك. أنت أخفيت عنا معلومات هامة حينما طلبناها منك. وإذا طلبت خدماتنا في أي وقت مجددا من الضروري أن تخبرنا بالحقيقة. وبهذه الطريقة يمكن تجنب هذه المشاكل".
بذلت جهدي للتأقلم مع حياتي، وأقسم بقبر أمي، أن ندمي لا حدود له. كنت أبكي كل الوقت، وفي كل ساعة من النهار أو الليل، وأمام نظرات زوجتي المندهشة. وكما لو أن هذا لا يكفي، فقد كنت بعمر سبع وخمسين عاما، وليلي تبلغ واحدا وأربعين، ولذلك كنت أبذل جهودا لم أتمكن من متابعة إيقاعها المطلوب مني. كل صباح أستيقظ متعبا مع الشعور أنني نزفت دمائي حتى جفت. وللتخفيف قليلا من متاعبي، بدأت أطلب الطعام المنزلي مرتين في الأسبوع. وفي حوالي الساعة 6 مساء كنت أخابر أحد المطاعم التي تفضلها زوجتي: سيسيليان تراتوريا، أو المطعم التايلاندي في إينسينوس. في البداية تقبلت الأمر، وبعد شهر بدأت تقلق من التكاليف.
قالت: "أنا أعمل كالكلبة وأنت في البيت. ألا يمكنك حتى الاهتمام بطهي العشاء؟".
وزاد الوضع سوءا حينما اعترضت على النكاح اليومي. وكلما كانت تزحف نحوي، كنت أبتعد عنها وأحبس نفسي في غرفة المكتب أو أنشغل بالتلفزيون. وأعلنت ليلي عن نفورها وكرهها لي بكل وضوح. ولم تكن تمتنع عن تحرشها بي. وفي بداية أحد الأيام هددتني بالفراق. أجبت بعصبية واضحة: “حسنا. اذهبي إذا. ربما سأنعم بعد ذلك بهدوء البال". ولكنها لم ترحل. وحملت حقيبتها وملفات عملها، وارتدت حذاءها، وغادرت البيت كما لو أنني لم أنطق بحرف. وعادت بعد الظهيرة من المحكمة جائعة وبنفس الإلحاح على الجنس. وتابعنا على هذا المنوال لعدة أسابيع إضافية، وبيننا حرب حول رغباتها ورغباتي. ورغما عنا كان يبدو كأن زوجتي مرتبطة بالبيت وبجسدي. وزال الضجر من حياتي، وتحولت إلى جحيم أرضي. ولم يبق عندي أي حل غير العودة إلى المتجر الصغير.
حيتني البائعة بطريقتها التجارية الغامضة قائلة:" كيف حالك سيد مونكادا؟ هل من خدمة أقدمها لك؟". ولكن هذه المرة رأيت أن حالها وكل أجوائها لا تحتمل. ومع أنني غير مدعو، جلست على الكنبة، ثم استلقيت عليها دون وقار. ثم بلا اهتمام، ودون اعتبار لتهذيبها الذي تأثر بموقفي، أخبرتها بالتفصيل عن وضعي العائلي. وقلت بالختام:" بيننا أنا وزوجتي فارق عمر كبير. ولكننا بحاجة لنفس المستوى من الجهد لنفهم بعضنا البعض". ثم سألتها وأنا أجلس:" هل بإمكانك أن تجعلي كلينا شابا؟".
نظرت البائعة في عيني كأنها تبحث عن حشرة مجهرية تحتمي في تلافيف حدقتي.
وقالت: "يمكنني ذلك يا سيد مونكادا، ولكن الشباب يأتي معه بعدد كبير من العيوب. ولست متأكدة أنك تعرفها".
أجبت:" وعدة فوائد. من ضمنها احتمال الدخول ببداية جديدة وتصحيح بعض أخطائنا".
قالت: “فكر جيدا بذلك يا سيدي. هل أنت متأكد أنك تريد ذلك؟ العودة من هناك ليس أمرا يسيرا".
قبلت بعناد دون الإصغاء لتحذيراتها. وكان الثمن هذه المرة عشرة أضعاف. دفعت بتحويل مصرفي، متوقعا تحسنا نسبيا في حياتي. وكانت هذه آخر مرة أجد فيها حسابي المصرفي بحالة صحية. على شرف الشيطان، قلت وابتلعت السكاكر، وحالما نهضت من الكنبة، شعرت بدفقة نشاط في جسمي لم أكن أتوقعها. في تلك الأمسية كنت أنا وليلي بعمر عشرين عاما، وحديثي الزواج. ومثل الأيام القديمة، بقي التاريخ كما هو، والبيت أيضا، باستثناء المفروشات كانت متواضعة جدا. من بعيد أمكنني سماع صوت مكنسة كهربائية. ووجدت في ثلاجتنا الصغيرة علبة بيض ودستة من علب البيرة. فتحت إحداها فورا وجلست في الكرسي أمام الباب الرئيسي، وساقاي مفتوحتان على وسعهما، بوضعية تناسب عمري الحالي. وبقيت هكذا لعدة دقائق، معجبا ببصري الحاد الآن. لم يكن في السماء غيمة واحدة، وغمرت الشمس كل شيء بضوء واعد. وحالا وصلت ليلي، وهي بالشورت مع قميص يكشف عن كل ظهرها. انتفخت ما بين ساقي بالرغبة، لدرجة شديدة، وكان من الصعب أن أتحكم بها.
قالت: "إذا انتهيت من كناسة المرآب، هل بإمكانك أن تكنس المطبخ، أيضا؟".
أجبت بلامبالاة:" إذا كنت أفكر بأي شيء فهو أنت".
وقطبت زوجتي وجهها.
قالت:"هل تعاطيت بعض المخدرات دون أن تخبرني؟ أنت تتصرف بشكل غريب".
أجبت وأنا أشرع بالضحك، مستغربا من جرأتي:" لم أشرب أي شيء، يا سكرتي. ما عدا سكاكر حصلت عليها من المتجر في كالي ماريبوسا".
قالت:" طلبت منك أن لا تقرب من ذلك المكان أبدا. ماذا لم تفهم من كلامي".
كان يسحرني رؤية كيف أن بعض الأمور التي نقولها أو نفعلها في المستقبل (لا أعرف كيف أشير للأزمنة الأخرى بسوى ذلك) لا تزال صالحة لفترة زمننا الجديد هذه.
قالت: "لا تجن يا صغيري. البنات ليس كما تتصور. هن شريرات بطريقة مختلفة". وأرسلت من عينيها نظرة تدل على القلق وتابعت مع المكنسة مجددا وهي تقول:" إذا أسرعت وأنهيت واجباتك سيكون لدينا وقت لنخرج ونأكل في السوق لاحقا".
تأثرت باقتراحها. لا يمكن لليلي البالغة واحدا وأربعين عاما أن توافق على تناول الغداء في مكان مثله، كثير البلبلة ومتواضع ولكن طعامه طيب المذاق. أقنعت نفسي أنني اتخذت القرار الصائب بالعودة إلى بدايتنا كزوجين، حين كان أمامنا الكثير لننقذه. وسريعا اكتشفت أن الأمر ليس بسيطا جدا. في هذه الفترة الجديدة، كانت ليلي متيقظة أكثر من كل المرات السابقة. كما لو أن هذا لا يكفي، كان لها مقاربة صارمة وخاصة لنواياها الإيروتيكية، كان علي أولا أن أستحم وأحلق. الجنس منحة تخلعها علي حينما أطيع الأوامر، أو ألبي طلباتها الدائمة بدون جدال ولا الدخول بمشاحنات. وكنت بحاجة لجسمها كما كنت في السابق بحاجة لدوائي المضاد للالتهابات وحبوبي المنومة. والآن وقد تزوجنا حديثا، كان هدفها، على ما يبدو، وضع سلسلة من القواعد الصارمة والواضحة جدا، لتحكم أوضاع حياتنا المشتركة: في هذا الوقت كان هدفي تصحيح كل أخطائي الغبية، التي اقترفتها في مسار فتراتي السابقة. ومجددا علقنا بحرب مستمرة. ولا أستطيع أن أنكر أنه في أكثر من مناسبة تبادر لذهني أن أعود إلى المتجر لأطلب سكاكر إضافية، ولكن لم يكن لدي النقود الكافية، لتغطية نصف تكاليف الإيجار. وحتى لو كنت قادرا على تدبير أمري، لست متأكدا أنني سأفعل: أي شيء يتبدل بسرعة بالغة - يمكنه التسبب بالإزعاج، والتعب، الذي لا يمكن التعايش معه.
في أحد الأيام كنت أمشي باتجاه كالي ماريبوسا، ورأيت مجددا الباعة ببذاتهم وكانوا يحملون علبا من الكرتون موجودة في شاحنة توصيل، وتذكرت عصر ذلك اليوم من شهر أيلول حينما اكتشفت أنا وزوجتي ذلك الباب الغريب.
لكن أين ذهبت ليلي، ليلي الحقيقية، التي عشت معها كل سنوات السعادة وقلة الحظ والضجر، أم الابنة التي عاشت واحدا وثلاثين عاما، والتي لا يمكنني أن أتكلم عنها مع أحد؟.
في تلك اللحظة، وبالرغم من كل تحفظاتي، لم أمنع نفسي من الدخول والتوسل للبائعة أن تعيدنا كما كنا قبل بداية الحكاية، وقبل أن تبدل تاريخ عيد ميلاد كلارا.
قالت: "لا شيء يتغير ويعود كما كان بالضبط، يا سيد مونكادا. أنت لا تدرك أن كل مرحلة تختلف حسب طريقة تذكرك لها. يمكنني أن اجعلك أكبر مجددا، إن كنت تريد هذا حقا، ولكن من يضمن أنك ستحب حياتك؟ وأعتقد، من صميم قلبي، أن هذا بعيد الاحتمال".
أوضحت للبائعة، مع أن جسمي قوي وأنا ابن العشرين، أشعر أنني مجهد ذهنيا. ووجدت في هذا العمر أنني أكافح بقوة لأنام على فراش قاس كهذا، وأن آكل البيتزا كل ثلاثة أيام مرة، وأن أنفق نهايات الأسبوع في نواد ليلية صاخبة، والأسوأ أنه تنقصني الحماسة الضرورية لأعيش أربعة عقود إضافية.
قالت: "لقد تبدلت كثيرا في فترة قصيرة للغاية، يا سيدي. دع عدة شهور تمر. وستستعيد طاقتك تدريجيا، حالما تنسى تاريخك وهويتك السابقة".
ارتجفت وسألتها:" وإن لم يحصل ذلك؟".
"حينها يمكنك أن تعمل معنا. أن تشاهد حياة الآخرين شيء مبهج، وليس متعبا، وسترى ذلك. ويمكنك أن تعيش هنا، إن أحببت".
أرعبني الاقتراح، ولذلك قطعت الحوار مباشرة، وأغلقت الباب الصغير ورائي، مصمما أن لا أضع قدمي في هذا المكان بعد الآن. مشيت في حي بالكاد أعرفه، وأنا أشعر بوزن الحنين على كاهلي. ومن نافذة بيتنا، رأيت ليلي منهمكة بقطع الخضار. وقفت أنظر إليها لعدة دقائق، دون أن أعلم أيهما تملكني أكثر، الإحساس بالغرابة أو الألفة. لكن الفتاة التي رأيتها لم تكن زوجتي بل مصغر منها، ولكنها هي بنفس الوقت - ولا يهم كم أعجبتني - وهو الشيء الوحيد الذي تبقى منها. وحينما رأتني من النافذة، ابتسمت بدهشة، وتركت سكينتها على الطاولة، وفتحت الباب. ما أن دخلت، حتى أحطت خصرها، وهناك عند باب المطبخ، أكدت لها أنني جاهز لتكوين عائلة. وأنني سأبذل جهدي، كي لا نحتاج لشيء، وسيكون لدينا في الخزانة دائما مستخلص الفانيلا.
***
.................................
* القصة من مجموعتها "المصادفات". منشورات بلومزبيري. نيسان 2025.
* غواديلوب نيتل Guadalupe Nettel: كاتبة مكسيكية.