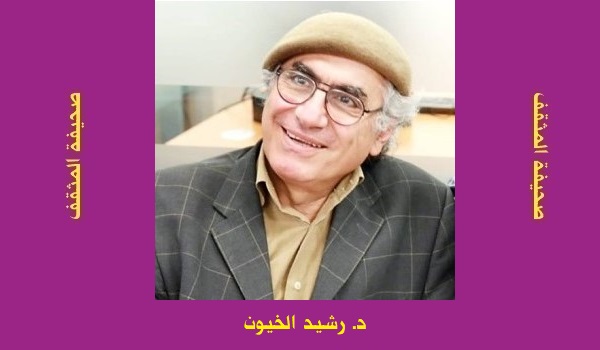دراسات وبحوث
عصمت نصار: المدينة الفاضلة بين التصور الحالم والواقع المفقود

أعتقد أننا في حاجة لتأمل دلالة مصطلح المدينة الفاضلة في الثقافتيّن الغربيّة ثم العربيّة قبل الشروع في مناقشة بنيّة مضمونه والمحاولات الجادة لتصوره على اعتبار أنه مشروع مستقبليّ أو واقع يجب إصطناعه أو تطبيقه في الحياة والثقافة المعيشة. وقد دفعني إلى ذلك في سيّاق حديثي عن فلسفة “الطاهر بن عاشور” هو تأثره الواضح بالمحاولات السابقة على مناقشته فكرة (الكمال الإنساني) وكيفيّة بناء المدينة الفاضلة في الثقافة العربيّة الإسلاميّة الحديثة، أي أنه أنطلق من مراجعات نقديّة للتصورات الغربيّة للمدن الفاضلة بدايةً من الطور الكلاسيكي إلى الطوّر اللاهوتي المسيحي وإنتهاءً بعصر النهضة، ثم أنتقل إلى الفكر العربي من منابت الفكرة حيث أحلام الشعراء ثم تصورات الفلاسفة وإنتهى به الأمر إلى مقاصد الشريعة الإسلاميّة التي استنبط منها دعوته الجادة لتقديم النموذج الإسلامي في تطبيق ذلك التصور الغائب على أرض الواقع مُقتديّاً بعصر النبؤة ومدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك للبرهنة على إمكانيّة تَحقُقّ ذلك المثال الذي طالما وُصف بأنه الفردوّس المفقود في زمان ومكان ومجتمع وحكومة ورئاسة وكيان اقتصادي وسياسي واجتماعي وأخلاقي وعقديّ وسط عالم من الأغيار الشاغل بالممالك المتبايّنة بالمعنى الحديث.
فقد عبرت الكتابات الغربيّة عن إستشراف الأدباء للعالم المثالي إنطلاقاً من شعور جمعي بتراجع قيمة الخيّر، السلم، العدالة، المساواة، الكرامة الإنسانيّة، الحُبّ، التعاون وغير ذلك من القيّم التي شعر بها الإنسان على أنها حقوق قد سُلبت منه أو حُرم منها رغم وجودها، وظهر ذلك في صور عديدة أبسطها القَصص والملاحم والأشعار التي تُعبر عن الشعور بالإغتراب ورفض الواقع المعيش أو الثورة على الأوضاع القائمة.
أمّا مصطلح (يوتوبيّا) فهو يُرد إلى أصل لاتيني يرجع إلى كلمتيّن إغرقيتيّن هما (Utopia) (أُو) و (طُوبوس) ويُقصد بهما مكان غير موجود (أي خيالي) وقد أُستخدم في المعاجم العربيّة بمعنى (مدينة أُسطوريّة) وعُبر عنه بـ (الطوباويّة أو أوطوبيّا أو الفردوّس)، أمّا في العصر الحديث فيُعد “توماس مور ١٤٧٨م – ١٥٣٥م ” أول من استخدمه في مطلع القرن السادس عشر بمعنى مدينة خياليّة نموذجيّة.
ويُعد “أفلاطون” أول من وضع تصوراً لبنيّة المدينة الفاضلة، باعتبارها المدينة المثاليّة في بنائها وبنيّة سكانها من كل النواحي المعيشيّة وذلك في (محاورة الجمهوريّة)، ثم هذبها في (محاورة القوانين) ولم يُحاكي هذا النموذج من الفلاسفة في الثقافة الغربيّة – على حد معرفتنا – سوى “القديس أوغسطين ٣٥٤ م – ٤٣٠ م” الذي ينتمي تصوره إلى الثقافة الرومانيّة، وذلك في كتابه (مدينة الله نحو ٤٢٦م) ثم جاء “توماس مور” وذلك في كتابه (يوتوبيّا ١٥١٦م)، وتلاه “توماس كامبنيلا ١٥٦٨ م – ١٦٣٩ م” في كتابه (مدينة الشمس ١٦٢٣م)، ويُعد “فرانسيس بيكون (١٥٦١ م – ١٦٢٦ م) آخر الفلاسفة المُحدثيّن الذين حاكوا المدينة الفاضلة الأفلوطنيّة، من حيث هي مجتمع يسعى إلى تحقيق السعادة والكمال لمواطنيه، وقد أستبدل مؤلفه المزحة الفلسفيّة المثاليّة التي أنتحلها “أفلاطون” والنَحلّة اللاهوتيّة التي أنتحلها “القديس أوغسطين”؛ والوجهة الإصلاحيّة الأخلاقيّة والسياسيّة التي أنتهجها “توماس مور”، و” توماس كامبنيلا” بوجهة علميّة لا سُلطة فيها إلا للعلم والواقع التجريبي والحياة المنطقيّة التي تُحقق السعادة الأرضيّة، وذلك في روايته الغير مُكتملة (أطلانطا الجديدة ١٦٢٧م)، ولا غَروّ في أن “ابن عاشور” قد أطلع على هذا التراث الغربي وقد كشفت كتاباته الموسوعيّة عن ذلك.
أمّا بنيّة مصطلح المدينة الفاضلة في الثقافة العربيّة فقد ظهر في صورة ثورة من المُستغربين والمُتمردين والرافضين للجُوّر الذي يلاقونه من مجتمعاتهم، وقد عبرت أشعار إمرؤ القيّس (٥٠١ م – ٥٤٤م) وحديثه عن (مملكة كِندة) المُتوّهمة التي يسودها الحب والعدالة والمساواة والخير والتسامح بين قبائلها، ثم في حكايات “أُميّة بن أبي الصَلتّ، المتوفى (عام ٦٢٦م) الذي تخيّل مدينته تَنعّم بالسلم والأمان والرحمة والتآخي في ظل (الديّانة الحنيفيّة) بمنئ عن الفُحشّ وعبادة الأوثان والإنحطاط الأخلاقي والظلم الإجتماعي،كما نَلمحّ تَصوّر تلك المدينة الخياليّة في أشعار زُهير بن أبي سُلمى (٥٢٠م – ٦٠٩م ) حيث المجتمع المثالي والفضائل الأخلاقيّة التي تُشكل دستور المواطنين في تلك المدينة.
أمّا أشعار الصعاليك التي انتشرت في الثقافة العربيّة نحو مطلع القرن السادس الميلادي فلم تخلُ هي الأخرى من الحديث عن الروح الثوريّة والصرخات النقديّة المُتمردة على إهدار حقوق الإنسان الوجوديّة في الحياة الكريمة المُطمئنة والمُطالبة بالعدالة والمساواة والحريّة من قيّد العبوديّة.
أمّا الأعمال ذات الطابع الفلسفيّ التي تأثرت بطريق مباشر أو غير مباشر بالتصور الأفلاطوني فنجدها عند (وهب بن منبه ٦٥٥م – ٧٣٨م ) في كتابه (المُلوك المُتوجّة من حميّر وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم) وقد انصبت حكمه وأقاصيصه وأمثاله وحكاياته حول أخلاقيّات تلك الممالك وعوائدهم ونُظمهم ومُعتقداتهم التي تُشكل مجتمعاتهم تَصوّراً للمدن الفاضلة.
أمّا أبو نصر الفارابي (٨٧٠ م – ٩٥٠ م) هو أول فلاسفة الحضارة العربيّة الإسلاميّة الذين حاولوا الجمع بين الرؤيّة الفلسفيّة والمدينة الفاضلة التي يرأسها الفيلسوف ويحكُمها العلماء في (جمهوريّة أفلاطون) والمدينة الإسلاميّة التي تَدينّ بالولاء والطاعة للنبيّ (صلى الله عليه وسلم) ثم من يَحذُوا حذوه ويسير على دربه من الحُكماء والعلماء والأتقيّاء، وقد حاول فيها الجمع بين كل محاسن المعقول الفلسفي بجانب المنقول الإسلامي الذي ينقل التصور من طوّر أحلام الفلاسفة إلى المدينة الإسلاميّة التي يَحكُمَها الدستور السماويّ، وسار على نهجه أبو العلاء المَعريّ (٩٧٣ م – ١٠٥٧ م) في (رسالة الغفران نحو ١٠٣٣م ) ثم “ابن سينا (٩٨٠ م – ١٠٣٧ م) في قصة (حيّ بن يقظان) التي كتبها في سنين الشباب، متأثراً بكتابٍ يونانيٍ مغمورٍ بعنوان (إيمن ذريس أي حافظ الناس) ويحويّ حكايات ومواعظ شعبيّة، ويبدو فيه ثقافة مؤلفه الجامعة لثقافتي الأفلوطنيّة والهرمسيّة، ثم “ابن طفيل حوالي (١١٠٥م – ١١٨٥م ) وقصته المعروفة (حي بن يقظان) وقد حاكى كلاهما (مدينة الفارابي) من حيّث تقديم الورّع على العلم والجمع بين الحكمة العقليّة والشريعة السماويّة.
ولعلّ الجامع بين الكتابات الفلسفيّة في الثقافة الإسلاميّة هو العنايّة ببناء الإنسان وقيّمه، وإعادة تشكيل عقله على نحو نقدي يُمكَنّه من السيّر وفق مشاعره الإيمانيّة وإستدلالته العقليّة وإحتياجته الماديّة، وجعل كُتاب المدن الفاضلة (الإنسان الكامل) على رأس المدينة التي تنشُد العدالة بأوسع معانيها والسلم بين سكانها وجيرانها، وتسعى للخيّر الأعم وتحقيق السعادة الأرضيّة والنعيم والخيّر الأبقى في الحياة الأُخرويّة.
وإذا انتقلنا إلى العصر الحديث لا نكاد نلمح من بين رواد النهضة العربيّة الإسلاميّة من تأثر بفكر “الفارابي” في اختلاق مدينة فاضلة تُعبر عن إغترابه الذي يُعاني من غيّبة الحريّة والعدالة والإنصاف والمساواة، فضلاً عن القيّم الأخلاقيّة والروحيّة سوى عمليّن كُتباً تحت مظلة الرمزية الأدبيّة أو إن شئت قُل فلسفة المقاومة أو الأحاديث المسكوت عنها بالتصريح، فأرتكنت إلى التلميح وإرتداء ثوب أدبي يخفي أغراضها أو مقاصدها الحقيقيّة، والعمليّن هما (مغامرات تِليماك ١٦٩٩م) لمؤلف فرنسي هو القس فينيلون (١٦٥١م – ١٧١٥م )، وقد عَربها رفاعة الطهطاوي (١٨٠١م – ١٨٧٣م) بين (١٨٥١م – ١٨٥٤م) أثناء نفيّة في السودان، وقد غيّر عنوانها إلي (مواقع الأفلاك في وقائع تِليماك) إمعاناً منه في الإخفاء والتعميّة حتى لا يُفطن المتربصون به لمِا تحتويه من أفكار وآراء ثوريّة ناقمة على سياسة الخديوي عباس حلمي الأول (١٨١٣م – ١٨٥٤م) وسكب فيها دوافع إغترابه وإنتقاداته للواقع المعيش في مجتمعه وأحلامه بِغَدٍ أفضل يَنعّم فيه البشر بالعدالة والإنصاف.
ومن أقوال “رفاعة” المسكوت عنها في هذا السيّاق: (إنه دوَّن كل كتاب مشحون بأركان الآداب، ومشتمل على ما به كسب أخلاق النفوس الملكيّة، وتدابير السياسات الملكيّة.. وعن الآداب اليونانيّة التي أنتجت هذه الملحمة يقول: أن الميثولوجيّا عند اليونان إنّما هي على بعض الآراء لها ظواهر وبواطن، فربما اشتملت على بعض إشارات ورموز.. وفيها من المعاني الحَسنّة مما هو نصايّح للسلاطين والملوك، وبها لساير الناس تحسين السلوك، تارة بالتصريح والتوضيح وأخرى بالرمز والتلويح.. وإن كان بحر جواهر ألفاظ هذا الكتاب لا يُدرك له في لغته الأصليّة قراراً إلا أنه معلوم عند أهل الصناعة أن بحر اللغة العربيّة يقطع على محيط بحار اللغات الأخرى التيّار، وإنه لدررها ولأليها غواص، ولسماء غيثها مدرار ولأدابها ومعارفها ميزان ومعيار، وكل شيء عنده بمقدار.. وليس كل من غَربّ أعربَ وأغربَ وأورد النفوس الزكيّة أعذب مشرب).
وإذا ما انتقلنا للعمل الثاني الذي حاك اليوتوبيّات الغربيّة في الإلغاز والرمزيّة والتعميّة والتعبير عن النقود التي عجز الكاتب عن البوّح بها هو عمل أدبيّ كتبه أحد تلاميذ “رفاعة الطهطاوي” وهو “عبد الله فكري ١٨٣٤م – ١٨٨٩م ” بعنوان (المقامة الفكريّة في المملكة الباطنيّة ١٨٧٢م) وهو عمل مُعرَّب أيضاً عن التركيّة لمؤلف مجهول ومضمونها غير معروف، وما جاء به ليس له مسئول – وذلك على حد تعبير المُعرب – وقد جاء فيها مضمونها أن المؤلف قد ساح وراح يتجوّل في مملكة في الواقع الإفتراضي يحكمها العقل الواعي المستنير وتدين بالأخلاق والدستور الروحي الورّع والمَكيّن، وقد صَوّر القيّم الماديّة والروحيّة في صورة بشريّة جمعها العقل الذي يُمثل حاكم المدينة للتشاور في تسييّس المدينة؛ وذلك لتبدو في صورة كاملة وفاضلة.
وحسبنا أن لا نستفيض في شرح هذيّن النموذجيّن فقد أفردنا له في مؤلفاتنا المكان المناسب، وذلك في كتاب (خطابات فلسفيّة في ثياب أدبيّة ٢٠١٩م ).
فالذي يعنينا من ذِكر المحاولات الرائدة لكتابة اليوتوبيّات أو المُدن الفاضلة في الثقافتيّن الغربيّة والعربيّة هو تأثر مُفكرنا “الطاهر بن عاشور” بنهوجها في صيّاغته لما أبدعه في هذا السيّاق.
فقد وضع “ابن عاشور” تصوراً للمدينة الفاضلة الإسلاميّة، فبدأ حديثه عنها بالإنسان وسماته وخِصاله وإستند في ذلك إلى ما ورد عن المُصطفى (صلى الله عليه وسلم) مُبيّناً أن أولى سمات هذا (الإنسان الكامل) الذي يستوطن المدينة الفاضلة هو المُستقيم الخالي من العوّج والإنحراف في سلوكه وأخلاقه أي برانيّه وجوانيّه، وهي الفِطرة التي جَبَلّ الله الأخيّار عليها، وأوائل المُصطفيين من البشر هم الرُسل الذين توالت بعثاتهم لأقوامهم مُرشدين وهادييّن ومُقومِين ما فسد ومُصلحين ما تلف، ومُبيّنين السبيل للتوبة والإستقامة بعد عصيان ونسيان؛ فالرجوع عن المعصيّة من أزكى خصال الفضلاء، وعليه يؤكد مُفكرنا أن المُؤمنين الطاعييّن هم المُزكون دوماً لسُكنّة المدن الفاضلة.
ولا يُنقص مُفكرنا من فضل الأنبيّاء والرُسل الذين اجتهدوا في تربيّة إنسان هذه المدن وجدانياً وأخلاقياً، ثم تهذيب سلوكه وتحليّة عوائده وتخليّة أعرافه من عَطب مُحاكاة الحيوانيّة والجَهَالة، وذلك كله بقدر طاقة الدُعاة وإستجابة المُكلفين.
والجدير بالإشارة في هذا السيّاق أن “ابن عاشور” قد وضع العلماء والفلاسفة في مصاف الأنبيّاء والمُصلحين، فذكر “هرميس (إدريس النبيّ) حوالي الألفيّة الرابعة قبل الميلاد”، و الحكيم اليوناني “بيّاس حوالي (٦٠٠ ق م – ٥٣٠ ق م ) الذي أُشتهر بالورعّ والإنتصار للحق، و”سولون حوالي (٦٤٠ ق م – ٥٦٠ ق م ) الأثيني صاحب التشريعات الشهير الذي يُرد إليه القواعد القانونيّة الغربيّة العادلة ونظام الشورى، ومن الفلاسفة الأكابر “سقراط” وتلميذه أفلاطون.
وقد صرح مُفكرنا بأنه قد حاكَ في ذلك الإنتقاء ما إرتائه “يحيي السهرورديّ (١١٥٤م – ١١٩١م )، و “قُطّب الدين الشيرازي (١٢٣٦م – ١٣١١م) في كتابتهم عن أفاضل الحكماء والعلماء، ولم يجد في ذلك حرجاً إستناداً على وصف الله للحكماء والعلماء بأنهم ورثة الأنبيّاء، ونستنبط من ذلك أن مُفكرنا قد رَغِب عن النموذج الثيوقراطي الذي جعله كهنة اليهود وقساوسة المسيحيّة نموذجاً للمدينة الفاضلة أي أنه رفض النموذج (الأوغسطيني) وفضل عليه عالم المُثل البشري (الأفلاطوني) الذي تحدث عنه في محاوراتي (الجمهوريّة والقوانين).
ثم يعود “ابن عاشور” ويؤكد أنه مع إعترافه بعِظم إجتهاد أولئك المُصلحين من أنبيّاء وعلماء وحُكماء في إيجاد المدينة الفاضلة على النحوّ الذي يليق بالمقاصد الإلهيّة من خلق البشر، فيرى مع ذلك أن جميعهم قد أخفق لصلف وقسوة قلوب عُمار المدن الذين حاولوا هدايتهم فكذبوهم وآذوهم ونسيّ القليل منهم ما تَعَلَمُه من الأتقيّاء والمُصلحين وراق لبعضهم تجديف شِرعة الله وتحريف رسالاته ومن ثم ضاع الدستور الحاكم لذلك (الإنسان الكامل) المرجو إعداده لتكوين مجتمع المدينة الفاضلة، ومن أقواله في ذلك (بقيّت المدينة الفاضلة مُرتسمة في خيّال الحكماء، فلم يزالوا يدعون إليها ويبتغون تأسيسها، ولكنهم لم يحصلوا على حاجاتهم المنشودة، ذلك أن المدينة الفاضلة يُلزم أن يكون رئيسها حكيماً صالحاً عارفاً وأن يكون أصحابه – أهل الحَلّ والعقّد فيها – حكماء مثل رئيسهم، وأن يكون سكانها أفاضل قابلين لسيّاسة الحكيم مُطيعين له، غير مُفسدين لما يُصلحه.. وإضطرب العالم عقب ذلك إضطرابات عامة في كل مكان، فلم يتأت إيجاد المدينة الفاضلة حتى جاء الإسلام).
وحسبي أن أوضح أن “ابن عاشور” لم يكن مُتحيّزاً للنبيّ الخاتم إذ وصف إياه بأنه ذلك النبيّ الحكيم الكامل الذي قَدَرّ بإجتهاده في تأسيس عُمد المدينة الفاضلة، وبدأ بإجتذاب الأتباع في أول الدعوة بمكة ثم أرسل من يحمل رسالته إلى جيرانه الذين مالت قلوبهم إلى دعوته، ولما تهيأت الظروف انتقل إليها وإعتَليّ مكانة الحكيم المُصلح الهادي، الذي أقنع بكمال حكمته عقول مؤيديه وطَبع في قلوبهم حبه وإخلاصهم له، لجميل طباعه ورحمة خصاله، فتأسست بذلك اللَبنّة الأولى لتلك المدينة الفاضلة المرجوّة التي تأسس دستورها على البِرّ والتعاون وإحترام القانون الإلهي الذي تَنَزّل في آياته بوحيّ يمتنع بطبيعته عن التبديل والتحريف، ومبدأ الشُورة الذي رَدّ لمواطن تلك المدينة حقه في البوّح والإختيّار والتقويم؛ وذلك ليتمكن من حمل الرسالة من بعده بوصفه مواطناً مُسلماً في خيّر أمة أُخرجت للناس فعالاً للبِرّ والمعروف دوماً وراغِب عن المُنكر والشرور بإرادة حُرة وبإلتزام جُوانيَّ وبإلزام عادل في قرآن محفوظ، وكيف لا وقد عُنيّ رسول الله بتربيّة البشر وتقويم خصالهم وتثقيف أفعالهم قبل تدبير الحَجّر و بناء الأسوار وتشييّد الحصون، فلم تكن عنايته بتصوّر مدينة بعيّنها، بل إيجاد أمة حريصة على حمايّة الحُبّ في قلوب أفرادها أكثر من حُب القوة الذي يُمكنّها من حمايّة الممتلكات والحدود.
وللحديث بقيّة عن تَصوّر “ابن عاشور” للمدينة الفاضلة الإسلاميّة الحديثة.
***
بقلم: د. عصمت نصَّار