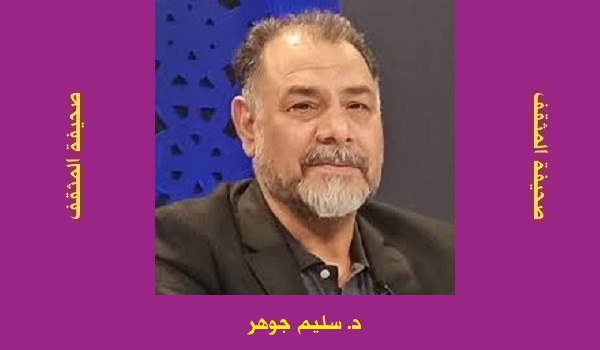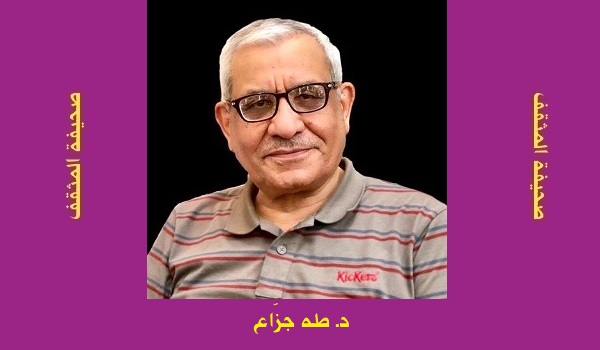قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: دراسة نقدية تحليلية لقصيدة "سَوْسَنان إليهِ هناك"

للشاعر السوري توفيق أحمد
تأتي قصيدة «سوسنتان إليه هناك» للشاعر توفيق أحمد بوصفها نصّاً ينتمي إلى الجغرافيا المركّبة للشعر العربي الحديث، تلك التي يتجاور فيها الوجدان الفردي مع الذاكرة الجماعية، ويتداخل فيها الحنين العاطفي بقلق الوجود، وتتجاور الرموز الحسيّة مع البنى العميقة للخطاب الديني والوطني. إنّها قصيدة تتّخذ من الصورة الشعرية بوّابة إلى معنى أبعد، ومن الجرح مدخلًا إلى معرفة الذات، ومن الانتظار حقلًا لصراعٍ بين الرغبة وإكراهات الزمن.
في هذه الدراسة، لا اتعامل مع النص على أنّه بنية لغوية جمالية فحسب، بل بوصفه شبكة دلالية متشابكة تستدعي قراءة هيرمينوطيقية تأويلية تَسبر المخبوء تحت سطح اللغة، وتستنطق ما يطفو وما يتوارى في الإيقاع، والصورة، والرمز. ولأجل هذا، تتّسع المنهجية لتشمل مقارباتٍ أسلوبية ورمزية وسيميائية — مع تطبيق نموذج غريماس — بما يسمح بتفكيك البنى السردية الكامنة في القصيدة، وتحديد مواقع الفاعلين والأدوار والعلاقات، وتتبّع حركة الرغبة وهي تتشكّل وتتعثّر.
كما تنفتح القراءة على مستوياتٍ أربعة: الانفعالي، التخييلي، العضوي، واللغوي، لتبيّن كيف يتوزّع المعنى بين الوجدان والصورة والجسد والبنية التعبيرية. وتستكشف الدراسة أيضاً ما تحت الجلد الشعري من نبضٍ نفسي وديني، وما تقترحه مفردات القمح والفضّة والجرح والسوسنة من امتدادات ثقافية ووطنية، في سياقٍ ينتمي إلى الذاكرة السورية التي تُملي حضورها على النص ولو بصمتٍ خافت.
بهذا كلّه، تُقدِّم هذه الدراسة مشروعاً تأويليًا يروم الكشف عن آليات اشتغال القصيدة، وعن تلك التوترات التي تُحرّكها بين الحضور والغياب، الحب والجرح، الزمن والانتظار، وصولاً إلى فهمٍ أعمق للشعر بوصفه ممارسة معرفية وجمالية تُعيد تشكيل الوجود عبر اللغة.
منهجية: هيرمينوطيقـيّـة تأويلية، أسلوبيّة، رمزيّة، جماليّة-وطنيّة، وسيميائيّة بتطبيق نموذج غريماس؛ مع غوصٍ في البُنى النفسيّة والدينيّة، وقراءةٍ في الأنساق المعرفيّة، وتفسير المفردات، ومقارنةٍ بين المستويات: الانفعالي، التخييلي، العضوي، واللغوي.
١. مقدّمة منهجيّة وسياقيّة:
تقدّم هذه القصيدة خطاباً شعرياً ينسحب بين التوّجه الوجداني والوعي التأمّلي؛ عنوانها (سوسنتان / إليهِ هناك) يحيلان فوراً إلى ثنائية: زهرة/حضورٍ أنثويّ، ومكانٍ بَعِيد أو ذهنيّ (هناك). سأقرأ النص بوصفه نصّ تأسيسيّ له مواقع أدوارٍ فعلية وسردية، وأطّبق على بنيته نموذجَ غريماس لاستخراج محاور الأدوار، ثم أتنقّل بين مستويات التحليل البلاغي والنفسي والديني والوطني لمعرفة ما «تحت الجلد» من نبضٍ وتوترٍ ورمز.
٢. قراءة نصّية مجملة (ملامح أولية):
القصيدة تنقسم إلى لقاطتين أو موقِفين: القسم الأول (مِن فِضَّة...) يعتمد صوراً طبيعية (الفضّة، القمح، النجوم) وتسلسلًا تأمّلياً حول الزمان والمرأة والوصال؛ القسم الثاني (يا داميَ القلب...) يزداد حوارياً ونبرة السؤال والنداء، ويختتم بإيحاءٍ ثوريّ/غزلي («سنشعل الأرضَ بالفوضى و"بالغزل"»). ثمة توترٌ بين الحضور والغياب، بين ما يُعطى (ورد، زمن، كتاب) وما يُنتظر (وصول، إجابة).
٣. المعجم والمفردات: دلالات وملاحظة اصطلاحية.
فضّة / سِلْسالُ هذا العمرِ: «فضّة» مادّة ثمينة، و«سلسال العمر» تركيبٌ يربط المادة بالزمن؛ الدلالة: الزمنُ كَزينةٍ وجَرَسٍ في آن، يلمع ويثقل.
قمح / شجن: قمح رمز للغذاء والحياة، وشجن رمز للشجن الحاضر؛ المزج يخلق ثنائية مادية-وجدانية.
سوسنة / امرأة / وصول: السوسنة رمز أنثوي تقليدي (جمال، نقاء، هدوء)، و«الوصال» هو موضوع الرغبة.
١- نجوم للعابرين: نجوم كهباتٍ عابرة، إضاءات مؤقتة؛ إشارة إلى ما يُعطى للمجتمعات أو المارة.
٢- ضمائر المخاطَب (كَ، لَكَ، إلخ): تُنفِشُ الخطاب بوجهٍ مخاطَب واضح: شخصٌ موجود «هناك» لديه بيت وشرفات واستقبال الزمان.
٣- كتاب/أجراس الحنين/الغزل/الفوضى: رموز للتسجيل والذاكرة والصيرورة والتمرّد؛ الكتاب هنا وسيط ومقدّمة للاحتواء والانتظار.
٤- ملاحظة لغوية: النبرة تجمع بين الفصحى الموزونة واللهجة الشعرية المعاصرة في تركيب مضمر ومحكم.
٤. الأسلوبية والبنيات البلاغيّة:
١- التصوير المركب: مزج عناصر حسّية (الفضّة، القمح، النجوم) مع مشاعر داخلية (شجن، وجد)؛ يعطي النص كثافةً تصويريّة.
٢- التكرار والإيقاع الداخلي: تردّد عناصر زمنية ــ «أزمنة/أيام/نهارك» ــ يشدّ الانتباه إلى البُعد الزمني كقضية محورية.
٣- السؤال الخطابي: «هل وصلت؟» «هل في البال أغنية؟» يفجّران حوارًا داخليًا ويحوّلان النص إلى طقس سؤال وانتظار.
٤- التباين الاستعاري: «رماكَ في يمٍّ من الأشواق» استعارةُ غمرٍ تؤكّد قوة الاشتياق وغموضه.
٥. الرمزية والدلالات الثقافية والوطنية.
السلالات الرمزية في النص ذات امتدادات وطنية محتملة: القمح كرمز للأرض والرزق (بُعد وطني/اجتماعي)؛ الكتاب رمزّ للذاكرة والهوية؛ النجوم للعابرين قد تشير إلى النازحين أو المارة في تاريخٍ جارٍ. النص لا يذكر الوطن صراحة، لكن بلالغته الرمزية يقترح أزمة حضور/غياب في زمنٍ متقلّب، ما يفتح الباب لقراءة وطنية تتصل بزمن الحرب والرحيل والحنين إلى الألفة.
٦. الغوص في البنى النفسية والدينية:
١- الحنين كقوّة نفسيّة محركة: الحنين يُعرّف النص؛ هو المرسل (أو الدافع) الذي يضع الشخص في حالة انتظار دائمة.
٢- الجرح/الدميّة القلبية: في القسم الثاني، «يا دامي القلب» و«أنا بصدرِكَ جرحٌ» يضعان الجسد كمكان للكتابة والجرح، وحيث أن الجرح لا يُعرف كم يغطّ ريشة اليأس بالأمل ــ هذه صورة نفسية عميقة عن الصراع الداخلي بين الاستسلام والأمل.
٣- البُعد الديني: مفردات مثل «نهارك» و«كتابك» و«أجراس الحنين» قد تُستعاد في هياكل دينية طقسية: الكتاب كمرجع، النهار كرمز للأنوار الإلهية، والأجراس كنداء روحي؛ لكن النص لا يتّجه مباشرة إلى الطاعة، بل إلى صيغة إنسانية أكثر توتراً.
٧. تطبيق نموذج غريماس: محاور الأدوار:
أطبق هنا نموذج غريماس لاستخراج الأدوار الستة الأساسية وتوزيعها داخل النص:
١- الفاعل / المبتغِي الفعلي): «الشاعر/الراوي» أو المتحرك العاطفي الذي يسعى إلى «الوصال/الوصول/الإجابة».
٢- المفعول به / الشيء المبتغى): «وصول المرأة/الوصال/إجابة السؤال» — حضور السوسنة أو المرأة، أو الكتاب كرمز للقاء.
٣- المرسل / المرسل): «الحنين/الزمن/الماضي» — الذي يبعث الحاجة والرغبة؛ أحيانًا «المرأة» ذاتها كمرسل عندما تحدد زمن وصولها.
٤- المتلقي / المستقبل): الشاعر نفسه، وربما القارئ؛ يتقاطع مع الفاعل في الكثير من المواضع.
٥- المساعد / الساعد): «القصيدة/النساء/النجوم/الكتاب» — عناصر تُيسّر مسعى الوصول؛ القصيدة وظيفة وساطة.
٦- المعاكس (المعارض): «الزمن الضبابي/السؤال الخفي/النسيان/الغياب» — عوامل تمنع الوصل.
ملاحظة بنيويّة: هناك تشابك في الأدوار: الحنين يعمل كمرسل ومُعاكس في آن، والكتاب يشتغل كوسيط ومُخَلِّف للأثر. هذا التداخل يشي بخاصية الوعي الشعري المعاصر: لا فصل واضح بين الدوافع والعقبات.
٨. البرنامج السيميائي (منظومة السرد بحسب غريماس):
الرؤية الوظائفية:
1. الرغبة (الشاعر يريد الوصول/إجابة).
2. المهمة (توزيع الكتاب، انتظار، السؤال).
3. المعوقات (ضباب الطريق، السؤال الذي أخفاكَ).
4. الوسائل (القصيدة/النساء/النجوم).
5. النتيجة المحتملة (وصول/لا وصول؛ إشعال الأرض بالفوضى/بالحب).
الخطاب التحويلي: التوتر بين الإمكان/اليقين: الشاعر يستخدم صيغة ترقب («هل وصلت؟») وصيغ إعلان («سنشعل الأرض»)، ما ينبّه إلى تحول احتمالي من الانتظار إلى عمل/ثورة (عاطفية أو اجتماعية).
٩. مستويات القراءة: مقارنةٌ منهجية:
أ. المستوى الانفعالي؛
القصيدة تستثمر انفعال الشوق والحنين؛ الانفعال موجّه ومباشر: نداءات وأسئلة ونبرة ألم حميمي (جرح، دامي القلب). تستفز القارئ لتبني موقف وجداني مع الشاعر/الناطق.
ب. المستوى التخييلي (الخَيالي):
صور مركبة (فضّة، قمح، نجوم) تولّد عالماً تخييليًا مماكناً بين المادة والرمز. التصورات تشكّل فضاءً بصريًا مكثفًا: بيتٌ يطلّ من شرفة، يمّ أشواق، مدارك لا تُرى... الخيال هنا يعمل كخريطة لاتجاه الرغبة.
ج. المستوى العضوي:
الجسد حاضر كمكان للجرح والحنين («بصْدِركَ جُرحٌ»، «يا دامِي القلب»). العضوية تترجم الانفعال إلى حسّ بدني: الدم، الجرح، القلب. هذا يجعل النص قريبًا من التجربة الحسية، لا مقتصرًا على مجاز فقط.
د. المستوى اللغوي؛
النص يستخدم لغة فصيحة مزخرفة، تراعي الوزن الإيقاعي الداخلي وبعض التلاعب البنيوي (قلب تراكيب، فجاءات محورية كسؤال «هل وصلت؟»). اللغة هنا جسر بين الحسي والمجازي، وتعمل على تضخيم الإحساس بالانتظار.
١٠. البنى المعرفية والمرجعيات الثقافية:
القصيدة تعمل داخل أنساق معرفية تتقاطع فيها: الأدب الغنائي العربي (الحنين والمرأة)، التراث الرمزي (القمح كأرض/حياة، الفضّة كزينة للزمن)، والخبرة المعاصرة للفراغ والانتظار (نتيجة تاريخية واجتماعية). لا يبدو النص ملتفًا حول مرجع ديني محدّد، لكنه يستحضر طقوسًا بشرية (الكتاب، الأجراس، الشرفات) ذات دلالات اجتماعية وروحية.
١١. مقاربة نفسية-رمزية: ما تحت الجلد الشعري:
الشاعر يعاني من ازدواجية: رغبة في الإمساك بالوجود (المرأة/الوصال) ووعيٌ بأن الزمن يسرق هذا الإمساك.
الجرح هنا ليس مجرد ألم؛ بل موقع للكتابة (القصيدة تُولد من الجرح).
الانتظار يتخذ صفة طقس مُبدع: الشاعر ينتظر ليستعيد ذاكرة أو لكي يتم إطلاقِ فعل (الغزل/الفوضى).
التوتر بين «الأمل/اليأس» مركزي: تغطّي ريشة اليأس بالأمل أو العكس، ما يشير إلى عملية دفاعية نفسية تقلب الألم إلى إبداع.
١٢. قراءات ممكنة على المستوى الوطني والاجتماعي:
لو ما قرأنا النص في ظلّ سياق سوري (مؤلف سوري): قد تَقرأ مفردات مثل القمح والنجوم والكتاب والشموع كرموز للذاكرة الجماعية، والبيت كشرفة للوطن، والرحيل كيمّة لعهد النزوح والانتظار. العبارات الأخيرة («سنشعل الأرض بالفوضى و"بالغزل"») قد تُفهم كدعوة لتغيير طقوسية: فوضىٌ تبديلية تُقابَل بالغزل، أي إعادة خلق للحياة عبر الحب أو الشعر.
١٣. عناصر الاستعصاء والتناقض داخل النص:
التناقض بين «فضّة» (لمعان) و«يمّ الأشواق» (غمر)؛ بين «أجراس الحنين» (رصانة) و«سنشعل الأرض بالفوضى» (ثورة).
التردد بين سؤال شغوف وحوارٍ مكتوم: السؤال الذي أخفاكَ يعني أن هناك سرًا أو عنادًا يعيق التواصل.
هذا التنافر هو ما يعطي القصيدة طاقتها الدرامية: لا مصالحة سهلة بين الرغبة والواقع.
١٤. الخلاصة التفسيرية:
القصيدة نصّ اشتياقٍ يمزج بين الصدق الجسدي (جرح، قلب) والدلالة الرمزية (سوسنة، كتاب، قمح). من خلال نموذج غريماس نرى شبكة أدوار متداخلة: الشاعر يسعى للوصول والموت في انتظار الإجابة؛ الحنين هو المرسل والمُعكِّس؛ الزمن والضباب هما العقبة. جمالية النص تكمن في توظيف صور يومية صارخة لتكوين فلسفة عن التحرّك البشري بين الخوف والأمل، الهشاشة والثبات. كما توفّر القصيدة مشهداً انتقالياً: من انتظارٍ قديم إلى قرار فاعل (إشعال الأرض بالفوضى/الغزل)، مما يشي بتحول شعري واستعداد للفعل.
١٥. اقتراحات:
1. تحليل مفرداتي معمّق: مقاربة دلالات «سوسنة/قمح/فضّة» عبر التراث والمتنّ الشعري العربي الحديث.
2. مقارنة نصّية: وضع القصيدة جنب أعمال أخرى لتوفيق أحمد لكشف ثيماته المتكررة.
3. تطبيقات سيميائية إضافية: بناء مخطط سببيّة لغريماس مفصّل مع اقتباسات موضوعة في العقد السيميائي.
4. تتبع السياق التاريخي: قراءة القصيدة في ضوء المأساة السورية كِردٍّ محتمل على التجربة الجماعية .
5. عرض مناقشات نقدية: جمع آراء قرّاء ونقاد ومقارنتها مع النتائج السيميائية.
١٦. أسئلة بحثية لورقة نقدية أعمق أو فصل آخر:
كيف يبني الشاعر «الجرح» كمصدرٍ للخطاب الشعري، وما علاقة ذلك بالهوية الجماعية؟
ما وظيفة «الكتاب» في القصيدة: توثيق أم فتنة أم وسيلة تواصل فاشلة؟
هل تُؤشر نهاية القصيدة إلى فعلٍ ثوري حقيقي أم هي استعارة للتجدد العاطفي؟
كيف تتقاطع الأدوار الغريماسية مع البنيات النفسية للشاعر توفيق أحمد ؟
١٧. خاتمة:
«سوسنتان إليه هناك» قصيدة تنزّ في العمق: ليست مجرد حنينٍ إلى امرأة، بل استدراجٌ لأسئلة عن الزمان والذاكرة والهوية والقدرة على الفعل. بتطبيق الهرمينوطيقا والأسلوبية والرمزية وغريماس، نُجلي شبكة علاقاتٍ تكشف أن الشعر هنا وسيلة لتأطير الجرح وتحويله إلى فعل معرفي وجمالي، فتصير القصيدة مقاماً لتوحيد الشعور والفعل والمعنى.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين
.......................
سَوْسَنَتان..
إليهِ هناكَ ...
شعر: توفيق أحمد
- ١ -
مِنْ فِضَّةٍ سَلْسالُ هذا العُمْرِ
مِنْ قَمْحٍ ومِنْ شَجَنٍ
بِكَ وجْدُ مجنونٍ وحِكْمَةُ سوسَنةْ
بِكَ أَزْمِنَةْ
نَسِيَتْ على شُرُفاتِ بيتِكَ لُعْبَةَ الأيَّامِ
وانْسَكَبَتْ بِصَدْرِكَ أَنْجُماً للعابرينْ
حَدَّدْتَ لامرأةٍ زمانَ وصولِها
وسَأَلْتَ: هل وَصَلَتْ؟
فأخفاكَ السؤالْ
ورماكَ في يَمٍّ من الأشواقِ
واسْتَبْقَاكَ خَلْفَ أُنوثةِ التكوينِ
تَبْحَثُ عَنْ مَدارٍ لا تَراهُ سوى مَدارِكْ
هي فُرْصَةٌ لأقولَ شيئاً ظَلَّ مختبئاً بِصَدْري
وارْتَقَيْتُ إليهِ أَقْبِسُ فيهِ جُرْحاً مِنْ نهارِكْ
إنَّ القصيدةَ والنِّساءَ ومايُوزِّعُهُ الحنينُ
على كتابي بانتظارِكْ .
-٢-
يا داميَ القَلْبِ هَلْ في البالِ أُغنيةٌ
لمْ نَكتَشِفْها بقاموسِ الحنينِ؟ قُلِ
*
أنا بِصَدْرِكَ جُرْحٌ لَسْتُ أعرفُ كَمْ
أَغُطُّ ريشةَ يأسي فيهِ بالأملِ
*
نَحْنُ اخْتَصَرْنا حكاياتٍ وأزمنةً
وحَسْبُنا أننا سِرْنا ولم نَصِلِ
*
كانَ الطريقُ ضَباباً كيف تسألُني:
ماذا تَرَكْتَ لأجراسِ الحنينِ ولي؟
*
وزِّعْ كتابَكَ .. يومَ الوجْدُ يُطفِئُنا
سَنُشعِلُ الأرضَ بالفوضى و " بالغَزَلِ"