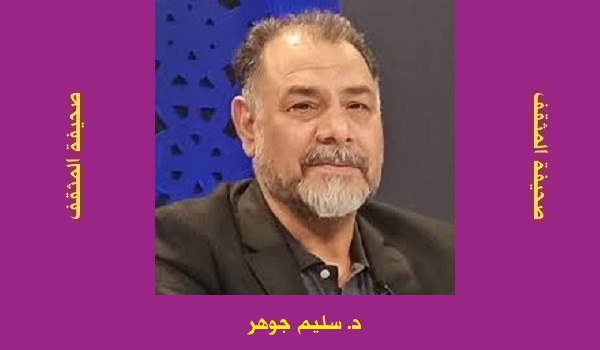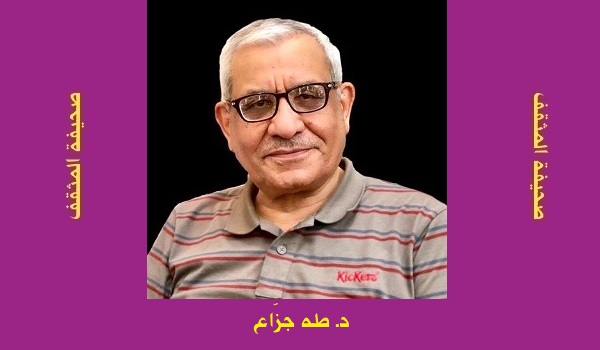قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: دراسة نقديّة تحليلية مُوسَّعة لقصيدة "حبر الغياب

للشاعرة التونسية بهيجة البعطوط
تنهض قصيدة «حبر الغياب» للشاعرة التونسية بهيجة البعطوط على بنيةٍ رمزيةٍ مشحونةٍ بكثافةٍ روحيةٍ ولغويةٍ تُحيل القارئ إلى فضاءاتٍ من التأمل والوجد والانخطاف الوجداني. إنها نصٌّ يكتب ذاته في تخوم الصمت والانتظار والحنين، حيث يتجلّى الغياب لا بوصفه فقداً بل حضوراً مغايراً، يفيض بدلالاتٍ روحيةٍ وعاطفيةٍ مركّبة، تمتزج فيها أنوثةُ النداء بقداسة الوحي، والحنين الإنساني بتجربةٍ أقرب إلى الطقس الصوفي.
يُعيد هذا النص ترتيب العلاقة بين المقدّس والعاطفي، وبين الكلمة والسكوت، وبين الحضور والغياب، مستعيراً من المعجم القرآني إشاراتٍ أنطولوجيةً عميقة، من مثل: "زكريا"، "مريم"، "الوحي"، و"المحراب"، ليمنح التجربة الفردية بعداً كونيّاً وروحياً. إنها قصيدة تتكئ على التناصّ المقدّس لتعيد صياغة الذات الأنثوية في حالتها القصوى: العشق المتعالي الذي يتحوّل فيه الغياب إلى رحمٍ للانتظار والكتابة.
تسعى هذه الدراسة إلى قراءة القصيدة وفق المنهج الهيرمينوطيقي التأويلي، للكشف عن تعدّد مستويات المعنى، والوقوف على ما تحت الجلد الشعري من نبضٍ ورمزٍ وتوترٍ صوفيّ. كما سأطبّق أدوات المنهج الأسلوبي والرمزي والسيميائي، مع توظيف منهج غريماس البنيوي الدلالي في تحليل محاور الأدوار (الفاعل/المفعول/المرسل/المتلقي...)، للكشف عن دينامية الخطاب الشعري وطاقته التخيلية.
وسأعمل على مقاربة النص أيضاً من خلال مستوياته الانفعالية، التخييليّة، العضويّة، واللغويّة، في محاولةٍ لفهم الكيفية التي يتحوّل فيها الحنين إلى طقسٍ لغويّ، والكتابة إلى صلاةٍ تُدوَّن بالحبر الغائب والحضور الموحى.
إنها قراءة تتقصّد الغوص في أعماق القصيدة لا لشرحها، بل لتأويلها بوصفها نصاً كاشفاً لتجربة وجودية وأنثوية ودينية متداخلة، حيث يتحوّل "الغياب" من حدثٍ شعوريّ إلى نظامٍ دلاليٍّ كامل يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والكتابة والقداسة.
1. مقدِّمة:
قصيدة «حِبْرُ الغِياب» نصٌّ وجدانيّ يتحرّك بين البوح العاطفيّ والتأمّل الروحيّ؛ عنوانها نفسه يُفرِضُ معادلةً دلاليّةً: الحِبر كفعل كتابةٍ ووعاءِ أثرٍ، والغياب كموضوعٍ/متحفِّزٍ للكتابة. هذه المفارقة تَضعُ النصَّ في خانة الشعر الصوفيّ–الوجداني الذي يستثمرُ الرمز الدينيّ والخطاب البشريّ العاطفيّ. مَن قرأ دراسات نقديّة سابقة أشار إلى هذا التقاطع الرمزيّ والدينيّ في نصوص الشاعرة بهيجة البعطوط.
2. قراءة هيرمينوطيقيّة - تأويليّة (المعنى العميق):
١- تكوين المعنى: القصيدة تبدأُ بمشهدٍ سماعيّ/روحيّ (إيحاءٌ لزكريا بألا يكلم الناس إلّا همساً)، ثم تنتقلُ إلى تجربةِ انقياد وجدانيّ يقودُ المتكلِّمة إلى «كهف الصمت». هذا التحوّلُ يقرِئُ المكانة الوجوديّة للحبِّ/الغياب: ليس فقط غيابَ الحبيب، بل حالةُ انسحابٍ تأمّليّ تستدعي الصلاةَ والذكرى.
٢- البنية التأويلية الدينيّة: الاستدعاءان النصّيان (زكريا، ومريم بنت عمران بالإيحاء) يحوِّلان البوحَ العاديّ إلى خطابٍ مُقدَّس، يجعل من عاشقةٍ إنسانيةٍ قريبةٍ من سيرةٍ نبوية/مريمية؛ وهنا تتداخلُ حميميّة الحبِّ مع طقوس الذّكر والتقديس. هذا التأويل يفتحُ النصّ على بعدٍ صوفيّ: الغيابُ يصبح امتحاناً وصياغةً للترتيل الداخليّ.
3. القراءة الأسلوبيّة والرمزيّة (اللغة والصورة):
المفردات المحورية وشرحها:
١- الوجد: حالةُ اشتعالٍ وجدانيّ تقودُ المتكلّمة إلى «لهفةٍ» و«انقياد»؛ هي المحركُ العاطفيّ المركزيّ.
٢- كهف الصمت: رمزٌ مزدوجٌ (حِمايةٌ/سجن)؛ الحماية لأنّه مكانٌ للترتيل؛ السجن لأنّه عزلةٌ عن العالم.
٣- تراتيل الهمس: تركيبٌ بديع يملأ الصمتَ بصوتٍ داخليّ، يربطُ بين الطقوسيّة (تراتيل) واللّطافة (همس).
٤- محْراب الذكرى: استعارةٌ تعبديّة تُقدّس الذاكرةَ كشكلٍ من العبادة.
٥- حِبْرُ الغِياب (العنوان): الحبر هنا ليس مادّة الكتابة فقط، بل أثرُ الغياب الذي يُسجل على صفحة الوعي.
٦- الأسلوب: اللغة فصيحةٌ عالية، مشحونةٌ بمفرداتٍ تعبديّةٍ وإيقاعيّةٍ؛ التكرار الفعلي (أحمِلُك، أتوجّع، أتألم) يُنَمِّي إيقاع الانفعال الداخليّ ويخلقُ موسيقىً داخل النصّ. هذا ما لاحظه نقّادٌ في قراءات سابقة.
4. تطبيقُ نموذج غريماس السيميائي:
أُطبّق هنا مُركَّبَ المحاور الأساسيّة بغريماس لاستخراج الأدوار داخل النص:
١- الفاعل/الموضوع:
٢- الموضوع: «الوصال/الحضور» أو استرداد الحبيب (أو الشفاء مِن الغياب).
٣- الفاعل/المطلِب: المتكلِّمة/الراوية التي تُريدُ استعادة الحضور والدفء الروحيّ.
٤- المرسِل/المُرسَل إليه:
٥- المرسل: الصوت الشعريّ ذاته — أحيانًا النصّ يتضمّن توجيهًا إلى زكريا (إيحاءٌ كتابي/ثقافي) أو إلى الذات/القارئ.
٦- المتلقي: الحبيبُ الغائب، وأيضًا ذاتُ الشاعرة الداخلية، وربما القارئ/المؤمن.
٧- المساعد/ المعارض:
المساعدون: الذكرى، التراتيل، الرمزُ الدينيّ الذي يمنح الحضورَ تبريراً ووسيلةً للتماسك.
المعارضون: الغيابُ نفسه، الصمتُ الاجتماعيّ (الورى)، وربما الزمنُ/المحن.
٨- الوظيفة: العنوان والحوار الداخليّ يعملان كقناةٍ تُحوّل الافتقاد إلى كتابةٍ (الحبر).
هذا التتبُّع يُظهر أن النصّ ليس مجرد سيرةِ شوق، بل مسرَّدٌ سيميائيّ متكامل تُحرِّكه قوى وتأثيرات معنويّة ودينيّة.
5. البُنى النفسيّة والدينيّة:
١- البنية النفسيّة: المتكلّمة تمرُّ بما يمكن وصفه بـ«فصامٍ وجدانيّ مؤقّت» بين التعلّق والانسحاب: اشتعالُ الوجد يقابله انسحابٌ إلى كهف الصمت. الهمسُ والتراتيل تعملان كآلياتِ تكيُّفٍ نفسية تُقَنين الشوقَ في شكلٍ تعبديّ.
٢- البنية الدينيّة: الاستعارات والمراجع (زكريا، مريم، المحراب، التسبيح) تُحوِّلُ الوجدَ العاطفيّ إلى فعلٍ عباديّ؛ الحُبُّ يصبحُ نوعًا من الذكر والاستغراق الروحيّ، ما يجعله قريبًا من تجربة العاشق الصوفيّ الذي يعبدُ محبوبَه عبر الذكر والانتظار.
6. المقارنة على المستويات المطلوبة:
١- المستوى الانفعالي: نصٌّ شديد الانفعال مُشبَعٌ بالشوق والوله. الانفعال هنا ليس صرخةً بل ترتيلٌ داخليّ، ما يضبط العاطفة ويحوّلها إلى بصيرةٍ وحضورٍ باطنِيّ.
٢- المستوى التخييلي (الخيالي): الخيالُ يعملُ عبر صورٍ دينيّةٍ/أيقونيّة (المحراب، الكهف، التراتيل) ويمنح النصَّ بعدًا أسطورياً، ففيه تتحولُ العلاقَةُ إلى طقس.
٣- المستوى العضوي (التجريبي-الجسدي): الجسد هنا مُشارٌ إليه بعباراتٍ مثل: «امتَلأ قلبي»، «فأخذ الوجد بيدي»، «تُمطر المقلتان على وجنتَيّ» — أي أن العاطفة تُظهرُ أثرها العضويّ والبدنيّ (الدموع، الخفقان)، فتتداخلُ النفسُ والجسد في أداء الشعور.
٤- المستوى اللغوي: مستوى فصيح راقٍ، استعمال معطوفاتٍ تعبديةٍ، تكرارٍ بنائيّ، وتوظيف صورةٍ بلاغيّةٍ كثيفة تجعل من كل كلمةٍ حاملَ وزنٍ دلاليّ. المصادر النقديّة أشارت إلى هذا الاتساق الأسلوبي.
7. ما تحت الجلد الشعريّ — نبض، توتر ورمز:
١- النبض: إيقاع التكرار والحركة من النشوة إلى الانكسار (من «أخذ الوجد بيدي» إلى «صِرْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا») يعطي النصّ نبضًا درامياً يحبس القارئ/المتلقي.
٢- التوتر: التوترُ قائمٌ بين التعلّق (الاشتياق) والرغبة في التقديس (التحوّل إلى صورةٍ مريمية). هذا التوتر هو المحرِّك الدراميّ للنصّ.
٣- الرمز: الرموز الدينيّة/المريمية تعمل كخيوطٍ تربط الشعر بحقلٍ ثقافيّ/روحيّ أوسع، فتجعل النصّ يتخطى الحكاية الشخصيّة إلى مستوىٍ جماعيٍّ/مقدَّس.
8. أمثلة تفسيرية لبعض المفردات المفتاحية (توضيحات نصّية):
«ألا يُكلم الناس ثلاث ليالٍ إلا همسًا» — قد يكون استعارةً لامتصاصِ طاقة الكلام العام وإدخالها في تواضعٍ داخليّ؛ ثلاث ليالٍ رمزٌ للامتحان/الكتابة/اقتراب الوحي.
«كهف الصمت» — ليس مجرد مكان عزلة، بل فضاء للاختبار النفسيّ والروحيّ؛ الكهف مكانُ تأمّلٍ في التراث الدينيّ (أمثال الغار) وفي مشاهد الصوفية.
«حِبر الغياب» — الكتابة بوصفها أثر الغياب؛ غيابُ الحبيب يترك حبرًا يكتب به الشاعر/الشاعرة قصة حيادٍ منسيّ.
9. ملاحظات وطنية/سياقية (المقام الثقافي):
الشاعرة بهيجة البعطوط تنتمي إلى فضاءٍ تونسّيّ أدبيّ نشط، ونصوصها تُنشر في منابرٍ أدبيّةٍ عربية، وتستثمرُ الحسّ القوميّ/الوجدانيّ بما يُقربُ الشعر من طقوس الجماعة والذاكرة الثقافية. لذلك يمكن قراءة النص أيضًا كنتاجٍ أدبيّ يُفعِّل ذاكرةً دينية/أدبية في المشهد العربي.
10. خاتمة توصيفية نقدية:
«حِبْرُ الغِياب» نصٌّ متكامل البناء يدمجُ العاطفة بالقداسة، واللغة بالفعل الطقسيّ. استخدام الشاعرة للرمز الدينيّ لم يطفُ خِلالَ المشهد الشعريّ فحسب، بل شكّلَ وسيلةً لتقنينِ الوحشة وتحويلها إلى كتابةٍ مُقدَّسة. تطبيقُ نموذج غريماس يبيّن أن القوىَ في النص ليست فقط داخلية (وجد)، بل هي علاقاتُ فعلٍ وسلطةٍ (غياب/حضور، مرسل/متلقي، مساعد/معارض) تُحرِّك دالّاته. من ناحيةٍ أسلوبيّةٍ، اللغة رفيعة، والإيقاع داخليّ، والتراكيب مأثورة بصبغةٍ تعبديّةٍ تجعل القارئ يشعر بأنّه أمام نصٍّ يجمعُ بين الخطاب الدينيّ والخطاب العاطفيّ.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين
..........................
حِبْرُ الغِياب
كَمَا أُوحِيَ لِزَكَرِيَّا
أَلَّا يُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا هَمْسًا،
أَخَذَ الْوَجْدُ بِيَدِي وَلَهًا،
وَقَادَنِي إِلَى كَهْفِ الصَّمْتِ،
فَغَدَا صَوْتِي تَرْتِيلَ هَمْسٍ،
وَامْتَلَأَ قَلْبِي بِكَ صَبَابَةً،
حَتَّى صَارَ الْفُؤَادُ عَصِيًّا.
*
يَسْجُدُ خَافِقِي خُشُوعًا،
وَيَهْجَعُ بِمِحْرَابِ الذِّكْرَى هُجُوعًا،
فَتُمْطِرُ الْمُقْلَتَانِ عَلَى وَجْنَتَيَّ.
*
فَانْتَبَذْتُ مِنَ الْوَرَى مَكَانًا قَصِيًّا،
كَمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ،
أَحْمِلُكَ فِي الْحَشَا شَوْقًا وَلَهْفَةً،
وَبَيْنَ أَسْرَارِ الذِّكْرَى أَتَوَجَّعُ،
وَبِمَخَاضِ السِّنِينَ أَتَأَلَّمُ.
*
كَالرَّجَاءِ بِحِبْرِ الْغِيَابِ
أُنَادِيكَ؛
أَهُزُّ جِذْعَ الْحَنِينِ،
أَنْتَظِرُ وَصْلَكَ رُطْبًا جَنِيًّا،
فَلَا يَعُودُ إِلَّا صَدَى صَوْتِي،
وَصِرْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا.
***