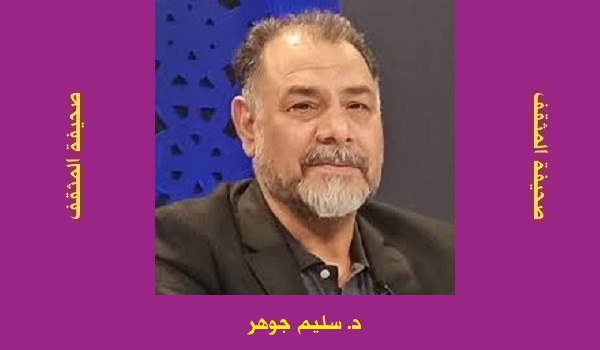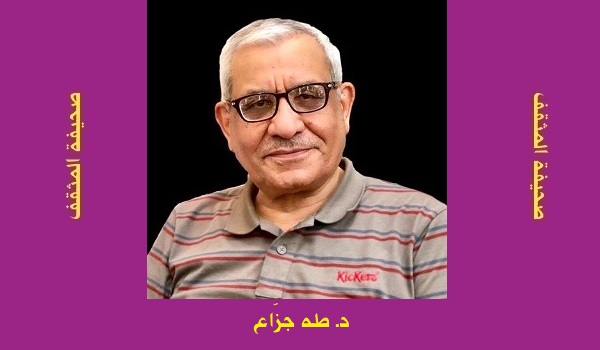قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: قراءة في قصيدة الشاعر أيمن معروف

دراسة نقدية متكاملة تجمع بين التحليل البنيوي، الدلالي، الرمزي، والصوتي — مع قراءة في الأسلوب والرؤية.
في فضاء الشعر العربي المعاصر، حيث تتنازع القصيدة بين فوضى التجريب وانحسار الرؤيا، يجيء صوت أيمن معروف ليعيد إلى اللغة صفاءها الأول، وإلى الشعر جلاله الوجوديّ، وليجعل من الكلمة معراجاً للروح لا وسيلةً للقول فحسب. إنّ قصيدته التي بين أيدينا تمثّل ذروةً من ذُرى الشعر التأمّليّ العربي، بما تحمله من شفافية لغوية، ورهافةٍ روحية، وعمقٍ دلاليّ يستدعي قراءةً تتجاوز ظاهر المعنى إلى جوهر الرؤيا.
يكتب معروف قصيدته بوعيٍ جماليّ يزاوج بين بلاغة التراث وقلق الحداثة؛ فهو يستدعي صيغ المديح والرثاء القديمة ليُفرغها في قالبٍ جديدٍ تنبض فيه الحياة والموت معاً، وتتعانق فيه المفردة مع الصمت، والذات مع الممدوح في وحدةٍ رمزية تذكّرنا بالتصوّف اللغويّ عند ابن عربي وبالصفاء الشعريّ عند السيّاب وأدونيس.
القصيدة ليست خطاباً عن الآخر بقدر ما هي تأملٌ في المصير الإنسانيّ عبر الآخر، ولا تنحصر في المدح أو الرثاء بل تتخطّاهما إلى تأسيس رؤية وجوديّة للشعر ذاته، بوصفه كياناً يبكي ويُبكي، ويكشف في لحظة الكتابة عن التوتر الأزلي بين الفناء والخلود.
من هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البنية الجمالية والفكرية في القصيدة، من خلال قراءة متكاملة تتناول مستوياتها اللغوية والإيقاعية والدلالية والرمزية، وتكشف عن حضور النزعة الصوفية والرؤيا الفلسفية في نسيجها، بوصفها نصّاً يعيد تعريف العلاقة بين اللغة والمطلق، بين الشاعر والزمن، بين الإنسان ومعناه.
تمثل قصيدة الشاعر أيمن معروف نموذجاً فائق النضج لما يمكن أن نسمّيه القصيدة الفصحى ذات الطابع الصوفيّ التأمّليّ، الممزوج بروح الرثاء الرفيع واللغة الباذخة.
- العنوان الغائب ودلالة الحضور اللغوي:
القصيدة لم تُعنون، وهذا غيابٌ مقصود يمنح النصَّ انفتاحه الدلالي، ويترك للغة أن تكون العنوانَ بذاتها. فـ"هنا لغة تشفُّ كما الصلاة" ليست افتتاحية فحسب، بل هي إعلان بيانيّ عن طبيعة القصيدة كلّها: اللغة فيها ليست أداة، بل كيانٌ روحيّ، ووسيلة تَعبُر نحو المطلق. الشاعر يقدّم اللغة كصلاةٍ، ككيمياء شفّافة بين الروح والمطلق، بين الشاعر وذاته، وبين الكلمة وغايتها الأولى.
- أولاً: البنية اللغوية والموسيقى الداخلية.
1. الإيقاع:
القصيدة مبنية على نظام تفعيلة موزونٍ يحافظ على نسق موسيقي عالٍ دون أن يقيّد التدفق التأمّلي للصور. التكرارات في القوافي مثل الذات، المكرمات، النيرات، الممات، الباكيات، الدائرات… تولّد جرساً متصاعداً يُشبه الطواف حول فكرة السموّ والمآل.
2. اللغة:
لغة أيمن معروف عالية التوهّج، تقوم على الترصيع والتماثل والتوازي.
مثلًا: "إذا حام الكلام فأنت سمعٌ / وإن طاش السكوتُ، فمفرداتُ"
تقوم الجملة هنا على الطباق الصوتي والمعنوي بين "الكلام" و"السكوت"، ليجعل من المخاطَب مبدأَ الوجود اللغويّ كلّه — هو السمع في حضور القول، وهو المفردات في غيابها.
اللغة تُشبه في كثير من مقاطعها محراباً لفظيّاً، تُرفع فيه المفردات كقرابين، وهذا يتجلّى في كثرة الألفاظ النورانية والروحية: الصلاة، الصفصاف، النسيم، النيرات، القناة، العلياء، السماء، الشهُب.
- ثانياً: البنية الدلالية والرمزية.
1. من الخطاب إلى المخاطَب:
القصيدة تميل إلى نبرة الرثاء أو التمجيد، إذ يخاطب الشاعر شخصيةً رفيعة المقام، روحية أو فكرية، قد تكون رمزاً للمعرفة، للشعر، أو لإنسانٍ راحلٍ تتماهى فيه القيم العليا.
يتجلّى هذا في النداءات المتكرّرة، يقول:
"سليل المكرمات أراك ترقى"
"أبا العلياء مسكاً في الأعالي"
"صديقَ الشعر إنّ الشعر يبكي"
"كليمَ النّون"
كلها صيغ نداء رمزيّ تُحيل إلى المكرَّم المتعالي، وتُخرجه من الواقع إلى الأسطورة اللغوية.
2. ثنائية الحياة والموت:
في البيت التالي:
"ألا، إنّ الممات أمرّ أمراً / وأقسى من مرارتِه، الحياةُ"
تتجلّى المفارقة الوجودية؛ فالموت لا يُقدَّم كضدٍّ للحياة بل كمرآةٍ تُظهر قسوتها. إنّه تأمّل صوفيّ في جدلية الفناء والبقاء، حيث يصبح الوجود نفسه اختبارًا للألم.
3. رمزية الضوء والعلو:
تكرّر مفردات النور، النيرات، العلياء، الشهب، السماء يدل على نسقٍ رمزيّ متعالٍ يجعل من الشعر وسيلةَ تساميٍ لا وصف.
العلو في القصيدة ليس مكانياً، بل معرفيّ – روحيّ، فالمخاطَب هو "سليل المكرمات"، و"إمام الشاردات"، و"حليف النيرات" — أي من ارتقى بمعناه قبل أن يرتقي بمقامه.
ثالثاً: البنية الفكرية – الشعر كمعرفة وجودية
القصيدة ليست مدحاً في ظاهرها فحسب، بل تأملٌ في جوهر الشعر والوجود معاً.
ففي قوله:
"صديقَ الشعر إنّ الشعر يبكي / وتبكيكَ الدفاترُ، والدواةُ"
يتحوّل الشعر من أداة تمجيد إلى كائنٍ حيٍّ يبكي الفقدَ، لتتجاوز القصيدة حدود الإطراء إلى مساحة الحزن الكوني.
وفي قوله:
"كبا شعري وبادَ القولُ حتّى / استحالتْ في لديه، الممكناتُ"
تبلغ القصيدة ذروة الميتاشعرية؛ فالشاعر يعترف بعجز اللغة أمام ممدوحٍ صار التجلي ذاته، حتى الممكنات اللغوية استحالَتْ في حضرته.
- رابعاً: البنية الأسلوبية والجمالية
1. الترصيع والتوازن:
كل مقطع قائم على ثنائيات صوتية ومعنوية: بانٍ وبانتُها، نواة؛ حياة/ممات؛ شعر/دفاتر؛ كلام/سكوت.
هذا البناء الثنائي يخلق تناظراً هندسيّاً يعكس اتزان الرؤية الشعرية.
2. الاستعارة الكثيفة:
القصيدة تمتح من الحقل النباتي (صفصاف، بان، نواة) والضوئي (النيرات، الشهب، العلياء) لتشييد شبكة رمزية متكاملة، تجعل من الكون مرآةً للذات الشعرية.
3. الضمير المخاطَب:
الضمير "أنتَ" يحضر كمرآةٍ للذات الشاعرة نفسها، فكل صفات الممدوح يمكن قراءتها كصفاتٍ للـ"أنا الشاعرة" في لحظة تطهّر لغويّ، مما يجعل القصيدة رثاءً مزدوجاً: للآخر وللشاعر في آن.
-خامساً: البنية الصوفية – الشعر كطريق نجاة.
في البيت التالي يقول:
"لزمتَ البيتَ جِدّاً، أيُّ جدٍّ / يكون لمن مطامحُه النّجاةُ"
نرى البعد الصوفي واضحاً: البيتُ هنا بيتُ الروح، والنجاةُ غايةُ السالك. الشاعر يُحيل إلى تجربة زهدٍ روحيّ، وإلى التماس الخلاص بالمعنى لا بالزمن.
والقول:
"عطفتَ على الزمان وظلتَ حيّاً / فقل لي: ما الحياة، ومالمماتُ"
هو سؤال وجوديّ يذكّر بفلسفة المتصوّفة والمتكلمين، حيث الحياة ليست استمرارًا للزمن بل حضورًا في المعنى.
سادساً: الرؤية العامة
القصيدة من الناحية الجمالية والفكرية تنتمي إلى المدرسة الشعرية الرؤيوية الحديثة، التي تجمع بين فصاحة التراث وعمق التأمل الفلسفي.
فيها أثرٌ واضح من روح المتنبي في المديح السامي، ومن حسّ الصوفيين في تطهير اللغة، ومن حداثة أدونيس في تخييل اللغة بوصفها كونًا موازٍ للوجود.
- خاتمة تقييمية:
قصيدة أيمن معروف نصّ رفيع المقام في تشكيل اللغة وإعادة قدسيتها الشعرية.
إنها ليست رثاءً ولا مديحاً فحسب، بل تسبيحٌ لغويّ في معبد الشعر، حيث تتماهى الذات والممدوح، الحياة والموت، الكلمة والسكوت.
تقوم بنيتها على الارتفاع: من اللغة إلى الشفافية، ومن المعنى إلى المطلق، ومن الإنسان إلى الشعر الذي يبكي ثم يُنقذ.
***
بقلم: عماد خالد رحمة- برلين.
....................
هنا لغةٌ تشفُّ، كما الصّلاة،
فتعبقُ بالشّفافيةِ،
الصِّلاتُ
*
هنا روحٌ كما الصفصاف تحنو
على بانٍ وبانتُها،
النّواةُ
*
أراها اليوم، تدلجُ في سراها،
فتدلجُ في تأمُّلِها
اللّغاتُ
*
خدينَ العالياتِ عليكَ شعّتْ،
من الأفقِ المشعِّ
العالياتُ
*
فذاتُكَ من شفيفِ الطبعِ مسكٌ
وتشرقُ في الطبائعِ منك
ذاتُ
*
كذاك، الذّاكياتُ، تكونُ لمّا،
تمرّ على نداها،
الذّاكياتُ
*
سليل المكرمات أراك ترقى،
إذا عُدّتْ هناك،
المكرماتُ
*
أتيتَ كما النسيم وكنتَ حرّاً،
أبيَّ النفسِ تحسدُه،
الأُباةُ
*
لزمتَ البيتَ جِدّاً، أيُّ جدٍّ،
يكون لمن مطامحُه
النّجاةُ
*
حليفَ النّيّراتِ، ومن إليه،
لتسعى في سراها،
النّيّراتُ
*
إذا حام الكلامُ فأنت سمعٌ
وإن طاشَ السكوتُ،
فمفرداتُ
*
ألا، إنّ الممات، أمرُّ أمراً،
وأقسى من مرارتِه،
الحياةُ
*
صديقَ الشعر إنّ الشعرَ يبكي
وتبكيكَ الدفاترُ،
والدّواةُ
*
أُواربُ ميتتي والكأسُ حولي
وتلمعُ في ذؤابتِها،
الرّفاتُ
*
قناةَ مُزَيِّلٍ، والدهرُ جِدٌّ،
يحايثُ أن تلينَ له،
القناةُ
*
قرينَ الوجهتين عليك نبكي
وتبكي في مشارفها،
الجهاتُ
*
وتبكي المفرداتُ عليك حبراً
وتسهبُ في القريضِ،
الباكياتُ
*
غلابٌ، هكذا، الدنيا غلابٌ،
وقد دارتْ عليها،
الدّائراتُ
*
أبا العلياء مسكاً في الأعالي
لك العلياءُ والشُّهُبُ
القُصاةُ
*
تركتَ قلائداً وسماءَ فصحى
وحرزاً في تمائمِه،
المَهاةُ
*
رواةُ الشعرِ من برديكَ فيضٌ
متى ملكتْ أعِنّتَه،
الرُّواةُ
*
نديمَ اللّام، والأسرار شقْرٌ،
تجيئُكَ والقصائدُ،
ساهراتُ
*
كبا شعري وبادَ القولُ حتّى
استحالتْ في لديه،
الممكناتُ
*
سمائي من سمائكَ، غير أنّي
بلا نجمٍ، وشهْبُكَ
طالعاتُ
*
كليمَ النّون، والآفاق غيبٌ،
وتدنو من رؤاكَ،
الغامضاتُ
*
عطفتَ على الزمان وظِلْتَ حيّاً
فقل لي: مالحياة،
ومالمماتُ
*
طموحُ السالكين سلافُ نجوى
وعشقُهما الوسيلةُ
والأداةُ
*
إمامَ الشارداتِ عليكَ عطفاً
من الملأ الشفيف
الشارداتُ
*
صرفتَ العمرَ في تصريفِ شأنٍ
على نهوندِه منكَ
التفاتُ
*
وهندُ الليل يكشفُ شأنَ ليلى
وليلى حول هندِكَ
والثّقاتُ
***