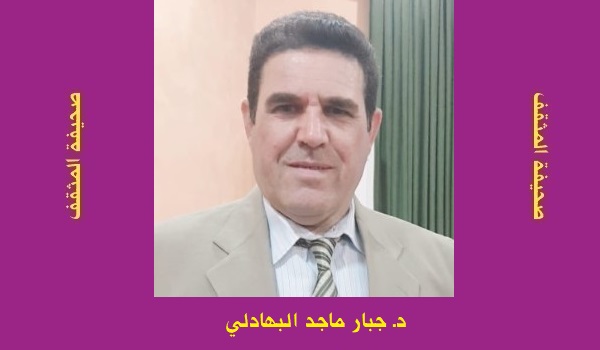قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: دراسة نقدية تحليلية موسّعة لقصيدة "تُفَّاحَةٌ من حجر"

للشاعرة الفلسطينية شادية حامد.. قراءة هيرمينوطيقية، أسلوبية، رمزية، جمالية، وطنية، وسيميائية
تُعَدّ قصيدة «تُفَّاحَةٌ من حجر» للشاعرة شادية حامد نموذجاً متفرّداً للنصّ الشعريّ الذي يتجاوز حدود البوح الذاتي إلى أفق فلسفيّ وجماليّ مفتوح، يُقارب سؤال الإنسان في زمن الحداثة المتأخرة، حيث تتقاطع التقنية والمقدّس، والجمال والخراب، والحرية والزيف. إنّها ليست قصيدة في المكان أو في المدينة الحديثة بقدر ما هي تأمّل في مصير الكائن داخل العالم المعاصر؛ الكائن الذي تحوّل من ذاتٍ فاعلة إلى رقمٍ في نظامٍ مبرمج، ومن روحٍ مبدعة إلى حجرٍ يلمع على واجهة الحضارة.
لقد أصبح الشعر المعاصر، في تمظهراته الجديدة، مختبراً فلسفيّاً للوجود، يُعيد مساءلة القيم والمعاني التي صاغتها البشرية عبر قرون، ثم فقدت بريقها تحت ضغط الآلة والافتراض والتمثّل الرمزي للحرية. وفي هذا السياق، تتجلّى تجربة شادية حامد بوصفها صوتاً أنثويّاً وجوديّاً يسعى إلى إعادة اكتشاف العلاقة بين الكلمة والعالم، بين الذات والآخر، وبين الجمال والألم، عبر لغةٍ مشحونةٍ بالرموز، تنبض بوعيٍ نقديٍّ عميق، وتستبطن رؤيةً فلسفيةً تُقارب في كثافتها رؤى شعراء الوعي المأزوم من طراز أدونيس، أنسي الحاج، وسيلفيا بلاث.
إنّ هذه الدراسة تنطلق من افتراضٍ أساس، مفاده أنّ قصيدة «تُفَّاحَةٌ من حجر» لا يمكن قراءتها وفق منظورٍ واحد، لأنها نصّ متعدّد الطبقات والدلالات؛ تتداخل فيه الأسطورة بالدين، والرمز بالواقع، والأنثوي بالكوني، والبعد السياسي بالميتافيزيقي. لذلك، سيُصار إلى مقاربتها من خلال مناهج متشابكة:
١- المنهج الهيرمينوطيقي التأويلي لفهم البنية العميقة للمعنى في النص.
٢- والمنهج الأسلوبي للكشف عن الإيقاع الداخلي وتشكيل الصورة،
٣- والمنهج الرمزي والسيميائي لتفكيك شبكة العلامات والأيقونات التي تشكّل البنية الثقافية للنص،
٤- إلى جانب القراءة النفسية والجمالية والوطنية التي تُضيء المسافة بين الذات الشاعرة والعالم الذي تتمرّد عليه.
بهذا المعنى، لا تتعامل هذه الدراسة مع النص بوصفه منتجاً لغويّاً فحسب، بل بوصفه خطاباً وجوديّاً يعبّر عن مأزق الإنسان الحديث أمام تحوّل الحرية إلى شعارٍ أجوف، والجمال إلى سلعة، والمعرفة إلى حجرٍ صقيلٍ بلا دفء. فـ«التفاحة» هنا ليست ثمرة الخطيئة، بل رمز المعرفة التي تحجّرت، والمعنى الذي تجمّد في رماد المدن الكبرى.
إنّ تحليل هذا النصّ يهدف إلى الكشف عن الجدل بين الوعي الجمالي والوعي النقدي في تجربة الشاعرة شادية حامد، وعن كيفيّة تحويلها الشعر إلى أداةٍ فلسفيةٍ للإنقاذ من موت المعنى. فالشاعرة، وهي تتأمّل مدينة الأضواء، لا تكتب عن نيويورك، بل تكتب عن الإنسان الذي ضلّ طريقه بين ناطحات السحاب والرموز، لتُعلن عبر لغتها الكثيفة والرمزية أنّ المعرفة حين تفقد روحها، تتحوّل إلى تفّاحةٍ من حجر.
أولاً: المدخل التأويلي (المنهج الهيرمينوطيقي):
قصيدة «تُفَّاحَةٌ من حجر» ليست نصاً شعرياً فحسب، بل هي تجربة تأويلية مفتوحة تنطوي على شبكةٍ من الرموز والتماثلات الثقافية، تتجاوز البنية اللغوية إلى استدعاء تاريخي وحضاري وروحي معقّد.
تبدأ الشاعرة من سؤال الوجود في مدينة الحداثة، تقول:
"سرداب وراء سرداب / لا نافذة، ولا باب"
هنا، تتجلى صورة الإنسان المنفي داخل سرداب العزلة التقنية، في مدينة تفتقد النوافذ، أي: الانفتاح على الروح والسماء.
هذا الغياب للنافذة والباب هو غياب للمعنى، وهو في التأويل الهيرمينوطيقي رمز لانسداد الأفق الوجودي الذي تعانيه الذات الشاعرة أمام العالم المادي، حيث تتحول الحرية إلى تمثال، والروح إلى ريشةٍ في مهب الرماد.
إنّ الشاعرة تتخذ من نيويورك فضاءً رمزيّاً لـ"الحضارة الإسمنتية" الحديثة، لكنها تقرأها بعين الشرقي الذي يرى في بريقها كسوفاً للمعنى لا انتصاراً للنور. فـ"التمثال" الذي كان رمزاً للحرية في المخيال الغربي، يتحوّل لديها إلى أيقونة من زئبق ومطاط، أي إلى حرية زائفة، مرنة، متقلبة، بلا جوهر.
---ثانياً: القراءة الأسلوبية:
أسلوب الشاعرة مشبع بالتناوب بين الجملة الخبرية والإنشائية، بين السردي والتأملي، وهو ما يُنتج إيقاعاً هارمونيّاً متقطّعاً يوازي التوتر الداخلي للنص.
نلاحظ توظيفها المتقن للوقفة الشعرية والسطر المفصول، تقول:
"ها هنا، حتى أدقّ المشاعر والأفكار من إسمنت"
"العقل جدار رقمي / اللغة جدار آخر"
هذه التوازيّات الأسلوبية تشكّل ما يمكن أن نسمّيه جدار اللغة داخل النص، أي أن البناء الأسلوبي نفسه يعكس دلالة النص المضمونية: كل شيء جدار، حتى اللغة.
كما أنّ التكرار الإيقاعي لـ«ها هنا» و«هناك» و«أهذي» يمنح النص بعداً طقوسيّاً، أشبه بتراتيل استنطاقية للعالم، حيث تتحول القصيدة إلى نشيد وجودي ساخط على فقدان المعنى في زمن العولمة.
ثالثاً: القراءة الرمزية:
العنوان نفسه «تُفَّاحَة من حجر» هو مفتاح رمزي بالغ الكثافة:
١- التفاحة ترمز إلى المعرفة، الإغواء، الخطيئة الأولى في الموروث الإبراهيمي.
٢- الحجر يرمز إلى الجمود، المادية، القسوة، والموت المعنوي.
وبذلك يصبح العنوان تعبيراً عن تقدّم حضاري مفرغ من الروح؛ معرفة بلا ضمير، وحرية بلا إنسانية.
وفي قولها:
"كأنها هي، ولكن تلك بأنامل من قصب، وهذه بقلب من إسمنت"
تُجسّد الشاعرة الصراع بين الروح الأنثوية (القصب، الليونة، الطبيعة) والصلابة الذكورية التقنية (الإسمنت).
إنها مواجهة رمزية بين الطبيعي والمصطنع، الإنساني والآلي، الأنثوي والحداثي المتوحش.
رابعاً: البنية الجمالية والفضاء الشعري.
من الناحية الجمالية، تتشكل القصيدة عبر مفارقة فنية كبرى: جمال الخراب.
تصف الشاعرة الخراب بلغة مبهرة، وتحيل القبح إلى لوحة ميتافيزيقية.
تغدو الصور الفنية كأنها لوحات سوريالية، فتمثال الحرية «حمامة من السماء وطاووس من الأرض» يحمل أجنحة الزئبق، أي حرية مراوغة، براقة، لا تُمسك.
يتبدّى الجمال في المفارقة بين الخارج والداخل:
١- الخارج: مدينة الأضواء، الحضارة، التكنولوجيا، الزحام.
٢- الداخل: فراغ روحي، عزلة، رماد، فناء المعنى.
بهذا تصبح الجمالية في القصيدة جمالية التناقض والتشظي، لا جمالية التناغم أو الانسجام.
خامساً: القراءة الوطنية والإنسانية
يتحوّل نص شادية حامد إلى مرآة لوعي عربي منكسر أمام الغرب.
هي لا تهاجم الغرب، بل تكشف الخلل في الشرق القديم الذي نام على الأساطير والأوهام. تقول:
"هكذا نحن في شرقنا القديم، حين ننام وحين نصحو..."
تسائل الشاعرة حضارتين في آنٍ واحد:
١- الغرب الذي صنع الحرية من إسمنت وزئبق.
٢- والشرق الذي صنع من المجد أسطورة ومن الوعي سباتاً.
بهذا تتجاوز القصيدة الموقف الأيديولوجي إلى وعي كوني مأزوم، يرى في "الإنسان المعاصر" – سواء في الشرق أو الغرب – كائناً ضائعاً في ليل التقنية والسلع.
سادساً: القراءة السيميائية:
السيمياء هنا لا تقتصر على الرموز الكبرى، بل تشمل الإشارات الحضرية واللغات الثقافية داخل النص:
١- التمثال: رمز السلطة الرمزية للحضارة الغربية.
٢- الرماد: رمز ما بعد الحداثة، لما تبقّى من الإنسان بعد الاحتراق.
٣- الفنجان و«الهُنود الحمر»: رموزٌ لثقافات مفقودة وذاكرات مسحوقة.
٤- القطار و«المحطة» و«مانهاتن» و«التوقيت» هي إشارات إلى الزمن الصناعي، في مقابل الزمن الميتافيزيقي في الشرق القديم.
تُمارس الشاعرة لعبة العلامات بدقةٍ حداثية؛ فهي تستعمل رموز الغرب لتفكيك أسطورته، وتجعل من اللغة ساحة مواجهة بين المعنى والفراغ.
سابعاً: البعد النفسي والديني
في البنية النفسية، تتبدّى الشاعرة كذات ممزقة بين انتماءين:
١- انتماءٌ ديني روحي يبحث عن الصلاة والسكينة.
٢- وانتماءٌ وجودي عالق في عالمٍ فقد إيمانه، تقول.
"أريد أن أُصلّي... ولكن هذه كنيسة التراتيل فيها سوداء والقس أبيض"
إنها مأساة الإنسان المؤمن في عالم ما بعد المقدّس، حيث تذوب الفوارق بين الإيمان والمسرح، بين العبادة والعرض.
وهذا التوتر بين الروحي والمادي، بين الإلهي والآلي، يولّد ما يمكن تسميته بـالاغتراب الأنثوي الوجودي: امرأة تبحث عن صلاةٍ نقية في عالمٍ تلوث بالخراب الجمالي.
ثامناً: الدلالات الختامية – ما تحت الجلد الشعري
تحت جلد القصيدة ينبض نبض الغضب النبيل: غضب الإنسان الشاهد على سقوط العالم في الإسمنت.
اللغة، رغم ما فيها من زخرفة، تنضح بصرخة وجودية، فكل صورةٍ تُطلّ من رحم ألم.
إنّها ليست قصيدة في نيويورك، بل قصيدة في موت الإنسان الحديث، حيث تتحول التفاحة – رمز الحياة – إلى حجر، أي إلى موتٍ صلبٍ ومصقولٍ بيد الشيطان نفسه، كما تقول:
"أصغر تفاحة فيه لا يفوح منها أي أثر… منحوتة بإزميل أعظم فنان: الشيطان."
تاسعاً: خاتمة تحليلية
قصيدة «تُفَّاحَة من حجر» نصّ يزاوج بين الأسطورة والواقع، الفلسفة والشعر، الدين والسياسة، وتُقدّم الشاعرة فيه نموذجاً لشعرٍ كونيٍّ ذي بصيرة أنثوية نافذة.
إنها تُعيد إنتاج العالم بمنظورٍ نقديٍّ يلتقط جوهر المأساة الإنسانية: أنّ الإنسان المعاصر صنع لنفسه جنة من إسمنت، لكنه نسي أن يبني فيها قلباً.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين
........................
تُفَّاحَةٌ مِنْ حَجَرْ
شادية حامد
"نِيرَانٌ دَائِمَةٌ تَرْقُدُ غَافِيَةً عَلَى أَحْجَارِ الْصُوَّان"
لوركا
سِرْدَابٌ وَرَاءَ سِرْدَاب.
لَا نَافِذَةَ،
وَلَا بَاب.
أَهَذِهِ نيُويُورْك؟
أَمْ هَذِهِ حَفِيدَةُ إِرَمَ ذَاتَ الْعِمَاد؟
إِذَنْ،
مَاذَا تَفْعلُ الْمَلائِكةُ
فِي هَذِه الْبِلاد؟
*
كَأَنَّهَا هِيَ.
وَلَكِن تِلْكَ بأَنَامِلَ مِنْ قَصَبٍ
وَهَذِه بِقَلْبٍ مِن إسْمَنْتْ.
طُوبَى لِلإسْمَنْتْ.
*
هَا هُنَا،
حَتَّى أَدَقُّ الْمَشَاعِرِ وَالْأفْكَارِ مِنْ إِسْمَنْتْ.
الْعَقْلُ جدَارٌ رَقَمِي.
الْلُّغَةُ جَدَارٌ آخَر.
وَالْرُوحُ، بَيْنَ بَيْن، رِيشَةٌ.
مُجَرَّدُ رِيشَةٍ
فِي مَهَبِّ الْرَّمَاد.
يَا أيُّهَا الْرَّمَاد!
فِي أَيِّ قَارُورَةٍ كُنْتَ إلَى حَدِّ الْآن؟
الْصَّيْفُ ذَهَبَ َوعَاد.
وَأَنْتَ مَا تَزَالُ هَا هُنَا،
فَوْقَ رُؤُوسِنَا ,
تَتَأَوَّه.
*
هَا هُنَا،
تَحْتَ الْرَّمَاد،
تَحْتَ أَجْفَانِ مِيدُوزَا،
وَفِي غَفْلَةٍ مِنْ سَيْفِ بِيرْسْيُوس،
أَنَّى لي أَنْ أُحِيطَ بِأَشْلاءِ الرَّمْز،
وَأَضْغَاطِ الْمَعْنَى؟
*
هَا هُنَا،
مُنْذُ مَا لا يُحْصَى مِنَ الْحُرُوب،
وَالْمَجَاعَاتِ،
وَالْأَعَاصِير،
وَالْزَلَازِلِ،
تِمْثَالٌ لِلْحُرِيَّةِ،
مِنَ الْسَمَاءِ كَالْحَمَامَةِ
وَمِنَ الْأَرْضِ كَالْطَاوُوس،
بِأَجْنِحَةٍ مِن زِئْبَق.
وَشِفَاهٍ مِنْ مَطَّاط.
حَوْلَ الْرَّأْس سَبْعُ مِسَلّات.
كِتَابٌ فِي الْيَمِين.
وَمِشْعَلةٌ فِي الْيَسَار.
قَد اخْتَلَطَ الْلَّيْلُ بِالْنَّهَار
وَمَا عَادَتْ حَتَّى اِيمَا لازَارُوس تَتَذَكَّر مَا كتَبَتْ
هَا هُنَا،
عِنْدَ قَاعِدَةِ الْتِمْثَال
*
هَا هُنَا،
بِاسْمِ الْحُرِيَّة، يَصْنَعُ الْحَجَرُ مَا يَصْنَع:
لِنَفْسِهِ،
فِي وَقْتِ الْقَيْلُولَةِ،
أُرْجُوحَةً زَرْقَاء.
لِيْ
- أَنَا الّتِي لَسْتُ لَا سيدة أَعْمَالٍ،
وَلَا عَارِضَةَ أَزْيَاء –
أُغْنِيَةً سَوْدَاء.
*
لِأمْثَالِي
قُبَّعَاتٍ مِن تِبْن.
ولِلْبَاقِين مَخَابِئَ
تَحْتَ الْأَرْض.
*
هَا هُنَا،
كَمْ رِيشٍ مُخْتَلِفِ الْأَلْوَان،
كَمْ حَضَارَةٍ،
كَمْ لُغَةٍ،
كَمْ لِسَان ْ،
وَلَكِن بِالْله عَلَيْكْ، أيُّهَا الْطَاوُوس الْحَجَرِي
مَاذَا أَدرَكْتَ مَنْ بَحْرِ الْظُلُمَاتْ؟
مَاذَا تَرَكْتَ لِي فَوْقَ ضَرِيحِ الْمَعْنَى؟
وَمَاذَا تَرَكْتَ لِلْهُنُودِ الْحُمْر
فِي قَرَارَةِ الْفِنْجَان؟
*
هَا هُنَا،
- حَوْلَ الْفِنْجَان –
صَعَالِيكٌ،
غَجَر،
بشرٌ يأْكُلُهُم بَشَرْ،
أَحْفَاد لُورْكَا،
زِنْجٌ،
وَإفْرِنْجٌ،
وَإغْرِيقٌ،
وَأسْبَان،
وَرُومَان،
قَيَاصِرَة،
وَجَبَابِرَة.....
لَكِنَّهُم أَحْرَار.
*
بِالْمُقَابِلْ:
هُنَالِكَ، فِي شَرْقِنَا الْقَدِيم،
مُنْذُ أَنْ كُنَّا وَخَيْرٌ عَمِيم
تَجِيءُ مِنْ أَقْصَى الْغَرْبْ:
قَنَاطِيرُ قَمْحٍ يَتَقَاسَمُ رَيْعَهَا
الْسَلَاطِين،
وَالْسَمَاسِرَة،
وَشُيُوخُ الْقَبَائِل
أَكْيَاسُ مِلْحٍ فَاسِدٍ،
طَوَاحِينُ هَوَاء،
ذُبَابُ خَيْلٍ تَلِيهِ أَرْتالٌ مِنَ الْنَّمْلِ الْمُجَنَّح:
دَائِمَاً،
بِاسْمِ الْحُرِيَّة
مِنْ أَجْلِ سَحْقِ الْحُرِيَّة.
*
هَا هُنَا،
فِي شَرْقِنَا الْقَدِيم:
الْقَيْلُولَةُ الْطَويلَةُ،
وَالجَدَل الْعَقِيم.
بَيْنَمَا هُنَالِكَ، مِنَ الغربِ إِلَى الْغَرْب:
صَخَب ٌ،
زِحَامٌ،
نَاطِحَاتُ سَحَاب،
سِرْدَابٌ وَرَاءَ سِرْدَاب،
وَقْتٌ يَقتُلُ الوَقْت،
فِي عُجَالَةٍ،
وَمِنْ غَيْرِ أَدْنَى نَدَم،
أَوْ عِتَاب.
*
أَهَذِهِ وَاحَةٌ؟
أَمْ هَذَا سَرَابْ؟
هي ذي Manhattan
دُونَ تَوَقُفٍ،
وَدُون اسْتِرَاحَةْ،
هِيَ ذِي، ثَانِيَةً وَثَالِثَةً وَرَابِعَة
كَأَنّهَا قِلَادَةٌ مِنْ فَوَانِيسَ
فَي صَحْرَاءَ شَاسِعَة.
كَأنّمَا نيُويُورْك بُسْتَانٌ أَشْجَارُهُ مِنْ حَجَر
وَأَصْغَرُ تُفَّاحَةٍ فِيهِ
لَا يَفُوحُ مِنْهَا أَيُّ شَيْء،
أَيُّ أَثَر،
غَيْرَ أَنّهَا مَنْحُوتَةٌ بِأِزْمِيل أَعْظَمِ فَنَّان،
أِزْمِيل جَدِّ الْبَشَر،
الْشَيْطَان!
*
وَاحِد.
اثْنَان.
ابْتَعِدَا عَنِ الْسِكَّة،
بَعْدَ قَلِيلٍ يَنْطَلِقُ الْقِطَار.
هَا هُنَا،
فِي
MADISON SQUARE
يَنْطَلِقُ مِنْ مَحَطَّة Penn
في كُلِّ عُشُرِ ثَانِيَةٍ،
قِطَار.
*
قِطَارٌ وَراءَ قِطَارْ
نَحْوَ الْحَاضِر.
نَحْوَ الْمُسْتَقْبَل.
نَحْوَ كُلّ مَا هُوَ طَارِئٌ وَمُفَاجِئٌ وَجَدِيد
هَكَذَا، مَحَطةً مَحَطّة،فِي بِلَادٍ بَارِعَة
فِي صَهْرِ كُلِّ شَيْء
الْطَبِيعَةِ وَالْثَقَافَة.
الْحَدِيدِ وَالْجَلِيد.
الْحَدِيدُ يَؤُولُ إلَى
حِلي حَوْلَ جِبَاة الْنَاس وَأَعْنَاقِ الْمُدُن.
وَالْجَليدُ إِلَى أساوٍر حَوْلَ أَقْدَام عُمَّالِ الْمَزَارِع،
وَأَحْدَاقِ بُنَاةِ الْسُفُن.
*
NO COMMENT
قِفْ وَرَاءَ ظَهْرِ تِمْثَالِ الْحُرِيَّة
ثُمَّ اجْلِس عَلَى رُكْبَتَيْك
وَشَغِّل الْكَامِيرَا
*
هَكَذَا هُمْ،
بَيْنَمَا نَحْنُ: كَمَا نَحْنُ
نَقْبَعُ فِي بِلَادِ الْذَهَبْ
قُرْبَ كَوَانِينِ الْحَطَبْ.
قَاطْ،
عَرَقْ،
نَارْجِيلَة،
ثُمَّ هَاتِ، أَيُّها الْحَكَوَاتِي
مَا فِي جُعْبَتِك:
قَصَصْ،
وَخُرَافَاتْ،
وَأَسَاطِيرْ،
عَنِ الْأَنْدَلُس،
وَأَلْفِ لَيْلَة وَلَيْلَة،
وَالْسِنْدِبَاد،
وَخَزَائِنِ ثَمُود،
وَعَجَائِبِ عَاد.
إلَى مَا لَا نِهَايَة،
أَوْ إلَى أَنْ يُرَنِّقَ الْنَوْمُ عُيُونَ الْصِغَار.
هكذا نحن في شرقنا القديم،
حين ننام،
وَحِينَ نَصْحُو،
وَحِينَ يَنْطَلِقُ مِنْ مَحَطَّة Penn
فِي أَقَلَّ مِنْ عُشُر ثَانِيَة
مِلْيوُن قِطَار وَقِطَار.
*
هَارْلِمْ!
يَا هَارْلِم!
كَم الْسَاعَة الْآن بِالْدَقيِقَة َ والَثَانِيَة؟
أَزِفَ الْوَقتُ وَهَا أنَا الْآنَ فِي هَذِه ِالْمَحَطَّةِ
بَيْنَمَا أَقْدَامِي فِي مَحَطَّة نَائِيَة.
*
هَارْلِم!
يَا هَارْلِم!
قَلْبِي عَلَيْكِ.
قَلْبِي عَلَى الْوَجَع الْطَاعِنِ فِي غَيَاهِبِ الْجَاز،
فِي سَحَائِبِ الْكُوكَايِين،
وَفِي مَقَالِبِ الْمَجَاز.
يَا أَنْكَى الْكُلُوم وَالْكَلِمَة،
هَارْلِم!
يَا هَارْلِم!
يَا أَوَّلَ وَأَطْوَلَ صَيْحَة مُؤْلِمَة!
*
أُرِيد أَنْ أُصَلِّي.
وَلَكِن هَذِه كَنِيسَة ٌ
الْتَرَاتِيِل فِيهَا سَوْدَاء
والْقِس أَبْيَض.
كِيْفَ أُصَلّي،
بِأَي لُغَة،
بِأي سِفر،
وَخَلْفَ مَن:
خَلْفَ أبْرَاهَام لينكلن،
أَمْ خَلْفَ رُعَاة الْبَقَر؟
*
SOS
هَذَا وَقْتٌ غَيْر الْوَقْت.
وَهَذَا مَكَان غَيْر الْمَكَان.
هَا هُنا، قبل تَقَاطُع بْرُودْواي والْجَادَة السَابِعَة
في ميدان Times Square
زُحَام،
ضَوْضَاء،
أَشْرِطَة أخْبَار،
لَافِتَات عِمْلاقَةٌ تَُنَاطِح الشَّمْس،
أَيَّتُهَا الشَّمْس،
يَا مَكْتَبَةً أَيْنَ مِنْهَا مَكْتَبَةَ الْكُونْغْرِس
وَلَكِن بِلا كُتُب،
وَلا رُفُوف
قَدْ بَانَ الْمَعْنَى
أَهَكَذَا يَبْدُو الْخُسُوف؟
أَمْ هَذِه فَقَط فَتْرَة مَوْسِمِيَة
يَكُون فِيهَا الْمُحِيط فِي سُبَاتٍ،
بَيْنَمَا الْمَرْكَز فَوْقَ نَار قَوِيَّة؟
أَيَّتُهَا الشَّمْس! لا مَنَاص.
وَأنْتَ، يَا شَبِيهي، احْتَرِس!
هَا هُوَ أَوَان الْكُسُوف
قَدْ تَخْلَع نَظَّارَتَك السَوْداء
قَد يَخْدَعَكَ النَّظَر.
وشَظَايَا البشر
فيِ مَرَايَا هيئة الأمم
قَدْ تَنْسَى، وَقَد تَحْسَب، تَحْتَ تَأثِير النِيُون
أَنَّ لَثْغَتَكَ لَم تَعُد مَرْئيِّة.
أَو أنَّ بَشْرَتَك قَدْ صَارَت - مَعَ الْوَقْت – بَيْضَاء.
حَذَارِ.
احْتَرِس.
فَأَنْتَ مِنَ الشَّرْق.
وَأَبْنَاء الشَّرْق لَيْسُوا كلّهم
مِنْ أَبْنَاء السَّمَاء.
*
أَنَا كذلك مِنَ الشَّرْق.
ومِثلي مَنْسِيَّة مِنَ الْمَتْن
كَيْفَ لِي أَنَ لَا أُجَن؟
وأنا أُجيل النَّظَرَ فِي أَرْجَاء
METROPOLITAN MUSEUM OF ARTS
زَخَارِف مِنْ مِصْر،
مَصَاحِف مِنَ الْقُوقَاز،
مُنَمْنَمَات مِن أَصْفَهَان،
أَرَابِيسْك،
قُدُور مَنْحُوتَة،
نُقُوش هِيرُوغْلِيفِية،
وأَلْوَاح آشُورِيَّة.
*
أَحَقاً هَذَا؟
أَمْ أَنَّه عَلَيَّ أَنَا أَيْضَاً
أَنْ أُعِيدَ النَّظَر:
فِي لُغَتِي،
وَإِثْنِيَّتِي؟
***
شادية حامد