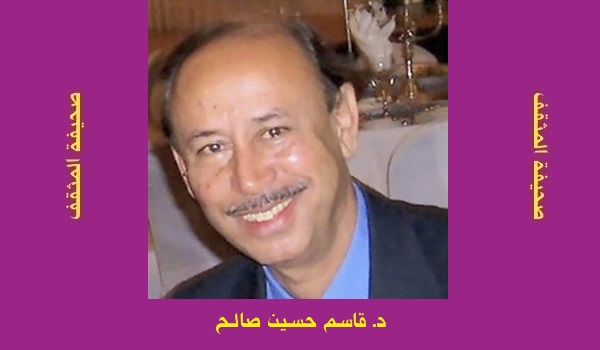قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: سيميولوجيا الشعر.. العلامة، الدلالة، وانبثاق المعنى الجمالي

تمثّل السيميولوجيا ـ في أصل تكوينها الفلسفي ـ بحثاً في جوهر العلامة، كما صاغ ملامحها الأولى أفلاطون في جدلياته حول المحاكاة، ثم جاء أرسطو ليُحكِم بنيتها النظرية عبر ربط العلامة بالخطاب والبرهان. غير أنّ التبلور المفهومي الحاسم وقع في أعقاب المناظرة الشهيرة، قرابة عام 300 ق.م في أثينا، بين الفلاسفة الرواقيين والفلاسفة الأبيقوريين، حيث تمّ ترسيخ التصور الثلاثي للعلاقة العلاماتية: الدال (signifiant)، والمدلول (signifié)، والوظيفة القصدية التي تربط الأول بالثاني في سياق تواصلي.
وفي العصر الحديث، استعاد منظّرون كبار، مثل أندريه مارتينيه، برييطو (Prieto)، وجورج مونان (Mounin)، جوهر هذا المبحث، مؤكدين أنّ العلامة لا تُختزل في بعدها اللساني، بل تمتد لتشمل أنماطاً غير لغوية: كعلامات المرور، والرموز الأيقونية، والإشارات الطقسية، لتشكل جميعها نسيجاً من الرموز المتداخلة التي تُسهم في إنتاج المعنى.
- المربع السيميائي: من التضاد إلى التوليد الدلالي:
اعتمد غريماس (A.J. Greimas) في مشروعه السيميائي على ما يُعرف بـ المربع السيميائي، وهو الأداة المنطقية التي تُفكّك البنية العميقة للخطاب، عبر كشف علاقات التضاد (contradiction)، والتقابل (contrariety)، والتضمين (implication). بهذا المعنى، فإنّ النص الشعري ليس مجرد رصف من الكلمات، بل هو شبكة من التوترات الدلالية التي تتحرك وفق نسق عقلي وجمالي معقد، يشتغل على ثنائية الحضور/الغياب، والامتلاء/النقصان، والحياة/الموت.
- سيميولوجيا الشعر: البنية والوظيفة:
حين تنتقل السيميولوجيا إلى ميدان الشعر، فإنها تواجه خطاباً يتجاوز وظيفته الإبلاغية المباشرة ليصير فعلَ خلقٍ جمالي يُعيد تشكيل العالم. فالشعر ـ كما يرى بول فاليري ـ «لغة في لغة»، أي أنه يقيم داخل النظام اللساني لكنه يخلخل قوانينه من الداخل، لينشئ نظاماً فرعياً تُهيمن عليه الإيحاءات والانزياحات.
وهنا تبرز ضرورة التحليل على مستويات متعددة:
- المستوى الصرفي: حيث تُدرس بنية الكلمة وتحولاتها الإيقاعية.
- المستوى الصوتي: الذي يكشف عن الدور الموسيقي للأصوات، بما يحمله من رمزية باطنية.
- المستوى الدلالي: حيث تُستقصى الحقول المعجمية والتشابكات الرمزية.
- المستوى التركيبي: في شقيه النحوي (ترتيب الجملة) والتناصي (حضور نصوص أخرى داخل النص).
- المستوى البلاغي: بما يتضمنه من استعارات وكنايات وصور شعرية.
- الشعر كمنظومة علاماتية:
يرى رولان بارت أن النص الشعري هو «نسيج من الاقتباسات»، وأن كل علامة فيه تنفتح على علامات أخرى، مما يجعل القراءة السيميولوجية فعلَ تنقيب لاكتشاف الدلالات الكامنة خلف ظاهر الكلام. كما أن جاك دريدا يذهب أبعد حين يؤكد أن العلامة «لا تحضر أبدًا حضورًا كاملًا»، إذ يظل المعنى مؤجَّلًا دومًا (différance)، وهذا التأجيل هو ما يمنح الشعر طاقته الإيحائية التي لا تنضب.
- الوظيفة الجمالية للعلامة الشعرية.
في سيميولوجيا الشعر، لا تُفهم العلامة إلا بوصفها حدثًا جماليًا، أي أنها لا تُحيل على شيء خارجها فقط، بل تبني عالَمها الذاتي. فالبيت الشعري قد يوحي بالحب، أو الموت، أو الوطن، لكنه في الآن ذاته يخلق حبّه الخاص، وموتَه الخاص، ووطنَه الخاص، عبر تشكيلات صوتية وصورية ولغوية فريدة. وهذا ما يجعل الشعر، بحسب هايدغر، «إقامة الإنسان في العالم على نحو شعري».
- الشعر بين الحرية والدلالة:
يُمارس الشعر حريته عبر كسر النمط المألوف للغة، لكنه في الوقت ذاته يظل منضبطًا بضرورات التشكيل الجمالي. فكل خروج عن القاعدة في الشعر، إنما هو خروج محسوب يخضع لقوانين داخلية يفرضها النص نفسه. وهنا تتضح أهمية المقاربة السيميولوجية في كشف التوازن الدقيق بين الفوضى المبدعة والنظام الخفي.
- خاتمة
إنّ سيميولوجيا الشعر ليست مجرد منهج نقدي، بل هي أفق فكري وجمالي يتيح لنا قراءة النصوص بوصفها عوالم من العلامات المتداخلة. هي دعوة إلى الغوص في أعماق الكلمة، لا لاستخراج معناها المباشر فحسب، بل لتلمّس اهتزازاتها وظلالها وإيحاءاتها. فالشعر، في نهاية المطاف، هو لغة تتجاوز ذاتها، وعلامة تبحث عن علاماتها، وصوت يسعى إلى الإنصات إلى صمته الداخلي.
تطبيق سيميولوجي على مقطع شعري.
لنأخذ بيتًا للشاعر أبي الطيب المتنبي:
إذا غامرتَ في شرفٍ مرومِ **فلا تقنعْ بمـا دونَ النجومِ
1. المستوى الصرفي
الفعل "غامرت" يشي بالفعل الإرادي المقرون بالمخاطرة، وهو اختيار صرفي يحوّل المعنى من مجرّد طلب إلى فعل وجودي.
- كلمة "النجوم" جاءت جمعًا، بما يحيل على الكثرة والامتداد، لا على نجمٍ واحد، فيتسع فضاء الطموح.
2. المستوى الصوتي:
التكرار الصوتي لحرف الميم في "مروم" و"النجوم" يخلق انسجامًا موسيقيًا يوحي بالعلو والامتداد.
- المدود الطويلة (غامرت، مروم، النجوم) تمنح البيت انفتاحاً إيقاعياً يناسب دلالته.
3. المستوى الدلالي:
"الشرف المروم" علامة على القيمة المثالية التي تُطلب رغم صعوبتها.
- "النجوم" علامة رمزية على أقصى الغايات، وهي هنا تُجسّد السمو والعلو الميتافيزيقي.
4. المستوى التركيبي.
الجملة الشرطية ("إذا... فلا") تخلق علاقة سببية دلالية: الطموح إلى المجد يقترن برفض القبول بالقليل.
- البنية الثنائية (غامرت/لا تقنع) تقيم تضادًا بنائيًا يزيد التوتر الدلالي.
5. المستوى البلاغي والتناصي
استعارة النجوم غنية الحضور في التراث الشعري العربي، لكنها هنا جاءت ضمن سياق فلسفة المتنبي عن الذات البطولية.
البيت يشتغل على تضاد ضمني بين الأرض/السماء، بين الممكن والمستحيل، ليحيل في النهاية إلى دعوة وجودية للارتقاء.
بهذا التحليل نرى كيف تعمل سيميولوجيا الشعر على تفكيك البنية الشعرية إلى طبقات من العلامات، كلٌّ منها يسهم في إنتاج المعنى الكلي. فالمتنبي لم يكتب دعوة مباشرة للطموح، بل نسج منظومة علاماتية تتضافر فيها الأصوات، والصيغ الصرفية، والرموز الثقافية، لتنتج نصًا مفتوحًا على التأويل.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين