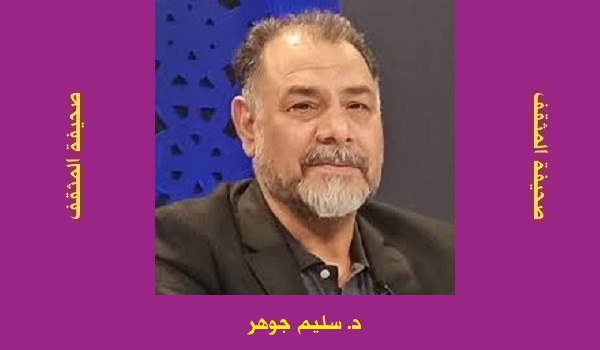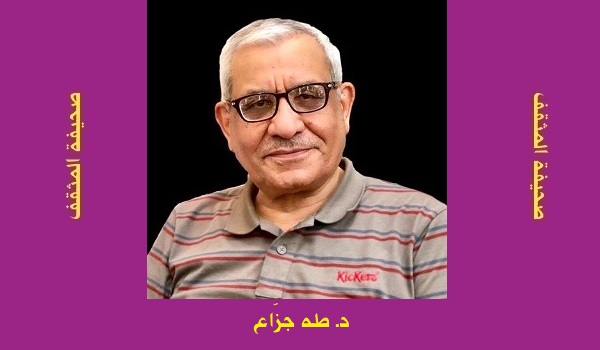قراءات نقدية
أمجد نجم الزيدي: الكتابة، الجدار، المدينة.. جدلية النص والفضاء

ظهرت الحاجة الملحّة إلى اختراع أدوات تعبير تتجاوز البُعد النفعي المباشر، منذ اللحظة التي تشكّل فيها وعي الإنسان، وبدأ يحاور وجوده ضمن سياق كوني غامض ومترامي الأطراف، لتلامس جوهر تجربته الحيّة في مواجهة الوجود، هذا الإنسان، الذي وجد نفسه في صراع دائم بين الافتتان بالمجهول والخوف منه، لم يتأخر في إنتاج أشكال من التعبير البصري على جدران الكهوف، فحوّل الفضاء الصخري الخام إلى سطح دلالي قادر على حمل تجلياته الأولى، وانفعالاته العميقة، وأسئلته البدئية.
كانت تلك الرسوم والنقوش، التي قد يُظنّ في ظاهرها أنها محاولات توثيقية بدائية، في حقيقتها انبثاقاً أولياً للغة رمزية لا تقل عمقاً عن النصوص الشعرية المعاصرة؛ إذ عملت على تثبيت علاقة الإنسان بالعالم من خلال وسيط بصري مفتوح على التأويل، وهذا ما تؤكده قراءات حديثة لفن الشارع والغرافيتي، إذ يُعرّف مؤلفا كتاب (الغرافيتي وفن الشارع: القراءة والكتابة وتمثيل المدينة)، أفراميديس وتيسيليمبونيدي، هذه الممارسات بوصفها (أفعالاً مادية وممارسات ثقافية في آنٍ معاً، تجمع بين ما هو مرئي وما هو رمزي)، وتمنح الجدران طاقة تواصلية تتجاوز مجرد الجماليات إلى التفاعل الاجتماعي والسياسي.
وقد شبّه الشاعر السريالي ليو ماليت جدران المدينة بأنها (حقل غير محدود من التجليات الشعرية)، تماماً كما كانت جدران الكهوف الأولى تجلّياً لصوت داخلي يسعى لإعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان والعالم، وهذا ما يُلمح إليه أحد الكتّاب حين يقول (الغرافيتي قصيدة تكتبها المدينة لنفسها)، في إشارة إلى أن فعل الكتابة على الجدار ليس منفصلاً عن النسيج الحضري، بل ينبع من داخله ويعيد تشكيله من جديد.
لذا تصبح هذه الكتابة مرآة للذاكرة الجمعية والهويات المهمّشة، إذ (تتناقض غالباً مع السرديات المهيمنة) كما يذهب مؤلفا كتاب (الغرافيتي وفن الشارع)، فهي تعكس التوترات الكامنة في الفضاء الحضري، فالجدار ليس مجرد حامل للنص، بل (أرشيف بديل) يوثق اللحظات التاريخية والسياسية التي لا تُلتقطها السجلات الرسمية.
وهكذا، يتلاقى وعي الإنسان الأول، وهو يحفر مشهد الصيد على جدار كهفه، مع وعي الإنسان المعاصر وهو يكتب قصيدة احتجاج أو حب أو انتماء على جدار مدينة أوروبية، فكل كتابة على الجدار هي، في جوهرها، لحظة شعرية تسعى إلى الإمساك بما يتفلّت، وإعادة تمثّل الذات في مرآة العالم.
يُعتبر كتاب (ضدّ أفلاطون- قصائد على حيطان المدن) ترجمة وتقديم ناصر مؤنس، شهادة شعرية معاصرة تكشف عن الحضور الرمزي والبصري للجدران بوصفها فضاءات تعبير إنساني، تتحول فيها المادة الصمّاء إلى حامل للمعنى، ووسيط ثقافي يعكس جدلية العلاقة بين الإنسان والكون، والذي يصف فيه مؤنس شعوره بالخيبة، أنَّ مدينته التي ولد فيها وهي بغداد (على الرغم من عمقها الحضاري إلا أنها لا تريد أن تحتفظ بالأثر، أرادت أو (أريد لها) أن تمحو التراث الحضاري الضارب في عمق التاريخ وتتزامن مع العدم) ربما عكس المدينة الأخرى التي تمثل الوطن البديل؛ مدينة (ليدن الهولندية) والتي (يحتل الأثر حضوراً لافتاً في تشكيل هويتها)، حيث مثلت (القصائد المكتوبة على الجدران) أحد أثارها، والتي يضعها هذا الكتاب في مواجهة مباشرة مع التاريخ الأدبي الرسمي، مؤكّداً أنها ليست محض كتابات عابرة، بل رسائل شعرية عميقة تعيد تعريف الفضاء العام، وتُضفي على الجدران دلالة مغايرة، ففي (صفحة 6) من الكتاب، نقرأ مشهداً افتتاحياً دالاً على هذه الرؤية، إذ يصف لحظة لقائه بقصيدة عربية مرسومة على جدار في مدينة ليدن الهولندية، وهي لـ(جبرا إبراهيم جبرا)، لذا يتساءل (هل هي حاضرة هنا من دون معاونة أحد، هل هي حاضرة من أجلي، هل جاء بها بياض هذا اليوم الثلجّي، هل كتبت نفسها كتعويذة حارسة؟ يا لوهج الشعر في وعي من يعاني من ثقل وطأته)، هذا التساؤل الاستبطاني لا يكتفي بتمجيد أثر الكتابة، بل يمنح الجدار بُعداً شعرياً يوازي المخيال الأول الذي شكّل الرسوم الصخرية عند الإنسان البدائي.
وفي ضوء هذه الرؤية، يتحول الجدار إلى عنصر مركزي في إنتاج الوعي الجمالي والرمزي، فـ(الجدران هي شهود المدن، والغرافيتيا تدعونا إلى رؤية نوع جديد من الفضاء العام في المدينة المعاصرة… يدعونا هذا القول إلى اعتبار المدينة نصّاً يحمل بلاغته البصرية وسلطة خطابه)، هنا تُعاد صياغة المدينة نفسها بوصفها نصاً مفتوحاً، تتشكل معانيه من تفاعلات متعددة بين النص والمكان، بين الكلمة والحائط، بين المارّة والقصيدة، بما يشبه العلاقة الجدلية الأولى بين الإنسان وجدران الكهوف التي عبّرت عن ذهوله أمام الطبيعة.
يتقاطع الكتاب كذلك مع أطروحة "الفضاء الرمزي" التي أشرت اليها سابقاً، فكل جدار يُقرأ هنا لا كحامل فيزيائي للكتابة، بل كبنية دلالية مشبعة بأبعاد سردية، رمزية، وتاريخية، إذ (تختلف القصيدة الحائطية عن القصيدة المنشورة في كتاب فهي ليست عملاً أدبياً فحسب بل مدونة دالة على حوار بين "الحائط والمدينة" "الشعر والحياة" "الرسم والكتابة" إلى جانب دلالاتها الإبداعية هي وثيقة تكشف عن الجانب "الثقافي- الاجتماعي" للمدينة)، هذا الوعي بوظيفة الجدران كمرآة ثقافية يتجاوز التصور التقليدي للمكان، ليقارب ما يمكن تسميته بـ"أنسنة الجدران"، أي تحويل الفضاءات الباردة إلى حوامل لحرارة التعبير الإنساني وقلقه وحيرته الوجودية.
أما من حيث العلاقة مع الإنسان ككائن يسكن الرموز، فإن هذا كتاب يطرح بوضوح البعد الأنطولوجي للقصيدة الحائطية، إذ يصرّ مؤنس في أكثر من موضع على أن هذه النصوص لا تنتمي إلى المؤسسة الأدبية الرسمية، بل إلى الهامش، إلى الرفض، إلى ما يشبه "الصرخة" ضد العالم الحديث الذي بات عصراً رقمياً، يفخر قراءه (بتلك القطيعة الإبستيمولوجية مع روح الاساطير والملاحم الشعرية والفنون الشعبية والخيالات التي تعيش في وفاق تام مع محيطها)، هنا وبهذا المعنى تتماهى الجدران مع الكهوف الأولى، حين كانت الحجارة أول مرآة لانعكاس الذات، وتحوّلت يد الإنسان إلى وسيلة لترسيخ حضوره الهشّ أمام هيبة الكون.
يقدم هذا الكتاب خطاباً نقدياً بصرياً حول الجدار بوصفه حيزاً حيّاً، يتحول فيه النص الشعري من ممارسة فردية إلى فعل اجتماعي، ومن تعبير شخصي إلى تمثيل رمزي لذاكرة المدينة، وكأن كل حائط يصبح في ذاته "وثيقة وجود"، وهو ما يعيدنا إلى أن الجدار، ومنذ البدء، كان وسيظلّ تجسيداً لانبثاق الوعي الإنساني الأول، وتحوّله من الكينونة الغريزية إلى الكينونة الرمزية، التي تتوسل الفن والشعر لقول ما لا يُقال.
***
أمجد نجم الزيدي
........................
* ناصر مؤنس (ترجمة) ضدّ أفلاطون: قصائد على حيطان المدن، دار مخطوطات، 2024.