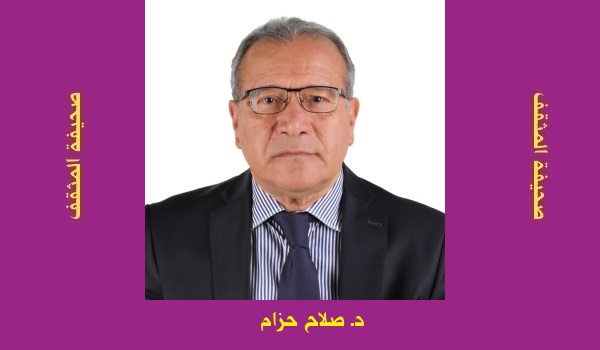قراءات نقدية
طارق الحلفي: قراءة في قصيدة "برج بابل" للشاعر جمال مصطفى (4)

"من باب توأمة البصيرة والبصر..."
كنت قد كتبت في المدخل الى هذه القصيدة المثيرة وفي الفقرة الأخيرة.. باننا "سنبحر مع الشاعر جمال مصطفى في قراءة "بانوراميته" ... بالتفصيل.."، واليوم نبدأ بالمقاطع من (21ـ 30)..
"حين تكون القصيدة مفتوحة كأفق وملمومة كقطرة ماء"
القسم الرابع: من باب توأمة البصيرة والبصر..." (4)
لغزُ الجمال وسِرُّ الأبدية
(21)
"مِن بابِ لُغْزى في الكتابِ
بأنها عذراءُ ساحِرةٌ جميلَةْ
في البرجِ حُجْرَتُها تُطلُّ على الفراتِ،
يَفُضُّها مَن يستطيعُ لِلُغْزِها حَلّاً
ولكنْ
لَمْ يَفُزْ أحَدٌ فَعاشَتْ هكذا في البرج
عذْراءً وساحرةً جليلةْ"
الطهارة والسحر:
يتوهّجُ هذا النص بإشراقاته الرمزية، حيث تتشابكُ الأسطورة بالتاريخ، والدين بالفكر، ليشيّد الشاعر معمارًا لغويًا مدهشًا، يحتضن أبعادًا فلسفية وإنسانية عميقة، مستنطقًا سِرَّ الأنوثةِ المتعالية، والحكمةِ التي تستعصي على الامتلاك.
ففي قلب البرج، المطلِّ على الفرات، تستقرُّ العذراءُ الساحرة، جميلةٌ في حضورها، مهيبةٌ في صمتها، وكأنها تجسيدٌ لسرٍّ أزليٍّ لا يُدرك إلا بالمكاشفة الروحية. إنها ليست مجرد امرأة، بل كيانٌ ميثولوجيٌّ ينهلُ من عوالم المعرفة السرّانية، من "باب لُغزى في الكتاب"، حيث يتماهى وجودُها مع النصوص المقدّسة، لتظلَّ لغزًا يُغرِي العقول، ويستفزُّ التوقَ الإنساني نحو الإدراك..
البرجُ هنا ليس مجرّد حصنٍ منيع، بل استعارةٌ للسموّ المعرفي، للعزلة التي لا تُبتَر، لحقيقةٍ لا تُفضّ إلا لمن يملك مفتاح الفهم العميق. "يَفُضُّها مَن يستطيعُ لِلُغْزِها حَلّاً"، لكن أحدًا لم يفلح، فبقيت العذراءُ في سموِّها، تتأرجحُ بين الجمال والغموض.. بين الإغواء والنقاء.. بين الانكشاف والاحتجاب، كأنها طيفُ الحكمةِ المتجلّية، تظلُّ بعيدة المنال، خالدةً في برجها، حيث لا يطولها إلّا مَن أدرك أسرارَ الوجود..
فاللّغز الذي يطرحه النصّ ليس مجرد أحجية أدبية، بل استعارة كبرى للصراع الإنساني مع المعرفة، وللمعركة الأزلية بين الطموح الإنساني والقدر المحتوم.
جدلية البراءة والانفتاح على التجربة
(22)
"عن نَحلَةٍ في البُرْجِ
إنَّ صديقَها فَرَسَ النَبي
كانَتْ لهُ في البُرجِ شِبْهُ جُنَيْنَةٍ
فيها مِن الخَشْخاشِ ما يَكفي
تَعالي جَرِّبي "
نحلة البرج:
الانزياحات الرمزية المكثفة في هذا المقطع تجمع بين الطبيعة والمقدّس، البراءة والتجربة، العزلة والانفتاح، في مشهدٍ تتداخل فيه الكائنات والأزمنة لتشكل عالمًا شعريًا مدهشًا.
يبدأ الشاعر برسم صورة: "نَحْلةٍ في البُرْجِ"، في مشهد يوحي بالتناقض، إذ يجمع بين الكائن الحرّ الطليق والمكان المغلق الذي يحمل في ذاته معاني العزلة والسموّ. لكن هذه النحلة ليست وحدها، بل ترتبط بعلاقة فريدة مع "فَرَسَ النبي"/ السرعوف.. ربما أراد الشاعر من هذا الكائن/ الحشرة ان يحمله دلالات دينية او رمزية استنادا الى ورود كلمة " النبي".. فيمنحه ما يُذكِّر بالصبر والزهد والعلاقة الخاصة بالسماء. هذه الصداقة تخلق جسرًا بين الأرضيّ والروحيّ، بين الفطريّ والميتافيزيقيّ، حيث النحلة رمزٌ للعمل الدؤوب والتلقيح والخصوبة، بينما فرس النبي رمزٌ للتأمل والانتظار المهيب.
ثم يفتح الشاعر نافذة على المكان كجنّة صغيرة، فيقول: " كانَتْ لهُ في البُرجِ شِبْهُ جُنَيْنَةٍ"، حيث يتجاوز البرج كونه مجرد بناء حجري، ليصبح مكانًا حيًّا، نابضًا بالطبيعة، ومساحةً تجمع التناقضات في تناغمٍ خفيّ. ويعمّق الشاعر هذه الفكرة بذكر "الخشخاش"، وهو نبات ارتبط تاريخيًا بالراحة والنسيان والسموّ الروحي، مما يضيف بُعدًا صوفيًا، وكأنه دعوة للانغماس في حالة من التأمل والانفتاح على التجربة الداخلية.
ويأتي النداء الأخير: "تَعالي جَرِّبي"، ليفتح باب الدعوة إلى الآخر.. النحلة او سواها.. المخاطَبة المجهولة، ليكون الختام تحفيزًا لاستكشاف هذا العالم السحري والتفاعل معه، وكأن الشاعر يهمس: "البرج ليس سجنًا، بل تجربة، جنة مخبّأة تحتاج لمن يكتشفها".
البصيرة في مرايا العمى
(23)
"في حُجْرةِ العمْيانِ لو دخلَ البصيرُ
يَصيرُ أعمى،
هيَ كُلُّ ما فيها مَرايا
لا يَرى العمْيانُ صورَتَهُمْ ولكِنْ
ما عَداها يُبْصِرونْ
فيها جميعَ وكُلَّ ما قد يَشتَهونْ"
حجرة العميان:
يأخذنا هذا المقطع الشعري إلى فضاءٍ فلسفي عميق حيث تتداخل الرؤية والعمى.. البصيرة والوهم.. الإدراك والحقيقة، في صورةٍ شعرية مدهشة تتلاعب بالمفارقات ببراعة.
يبدأ الشاعر بتقديم مشهد مهيب: "في حُجْرةِ العمْيانِ لو دخلَ البصيرُ يَصيرُ أعمى"، حيث تتجلّى أولى مفارقات النص.. فالعجز عن الرؤية لا يعود مجرد عطبٍ جسدي، بل هو حالة مكتسبة، يفرضها المكان وقوانينه. إننا أمام قلبٍ جذريٍّ للمفاهيم، حيث تتحوّل البصيرة إلى عمى بمجرد دخول عالمٍ تحكمه قوانين أخرى، وكأن المعرفة والجهل يتبادلان الأدوار حسب السياق.
ثم يكشف الشاعر سرّ هذه الحجرة: "هي كُلُّ ما فيها مَرايا"، وهنا تبلغ الرمزية ذروتها. فالمرآة رمزٌ للرؤية، لكنها أيضًا سجنٌ للوهم، وفخٌّ للذات الباحثة عن صورتها. غير أن المفارقة الأدهى أن العميان لا يرون أنفسهم، لكنهم يبصرون كل شيء آخر، في مشهد يذكّرنا بمفهوم الحقيقة في الفلسفة الأفلاطونية، حيث الرؤية ليست دائمًا إدراكًا، والعمى ليس دائمًا فقدانًا للمعرفة.
وأخيرًا، يأتي السطر الختامي: "فيها جميعَ وكُلَّ ما قد يَشتَهونْ"، ليكشف عن البعد الإنساني العميق للنص؛ إذ لا شيء ينقص العميان سوى رؤية أنفسهم، وكأن إدراك الذات هو الغياب الأشدّ وطأة، وهو العمى الحقيقي الذي لا يُعوَّض برؤية أي شيء آخر.
بهذا، يقدّم الشاعر تأمّلًا فلسفيًا عن الإدراك والوجود، حيث لا يكون العمى في فقدان البصر، بل في فقدان رؤية الذات في مرايا الحقيقة.
طقوس الماء والنظر
(24)
"في الصيْفِ في السَنةِ الكبيسةِ
يومَ مَوْلِدِ عشْتَروتَ وعرْسِ بابِلْ
في مهْرَجانِ الليْلة البيضاءِ أو سَهَرِ العنادِلْ
قبْلَ الغروبِ،
البرجُ تَصعدُهُ النواظيرُ التي حَملَ الرجالُ
رجالُ بابلَ كُلُّهُمْ أوْ جُلُّهُمْ عندَ المساءْ
لِيُشاهدوا غَسْلَ العريسِ البَدْرِ
يَسبحُ في الفراتِ معَ النساءْ"
بابلُ تحت ضوء البدر:
إلى عالمٍ طقوسيٍّ مهيب، يأخذنا هذا المقطع حيث تتلاقى الأسطورة والتاريخ وفي مشهدٍ يحتفل بالحياة والماء والنظر.. إنّه نصٌ يفيض بالرمزية والإيحاء، إذ يحشد الشاعر فيه دلالات دينية، اجتماعية، وفلسفية، ويعيد صياغتها في لوحةٍ شعريةٍ فاتنة.
الأسطورة والتاريخ: الزمن المقدّس
يبدأ النص بالإشارة إلى "الصيف في السنة الكبيسة"، حين يلتقي الزمن الدنيوي بالزمن المقدّس، في لحظةٍ استثنائيةٍ تتقاطع فيها الولادة (مولد عشتروت) مع الاتحاد (عرس بابل). وهنا، عشتروت، إلهة الحب والخصب، ترمز للولادة الجديدة، في حين أن بابل تمثل الحاضرة الكبرى، بكل ثقلها التاريخي والأسطوري.
الليلة البيضاء: الطقوس والرموز في برج بابل
يأخذنا هذا المقطع الشعري إلى عالم الاحتفالات المقدسة، والطقوس الغامضة، حيث يتشابك الزمن الأسطوري بالتاريخي، والروحاني بالحسيّ، في مشهدٍ يموج بالحياة والرمزية العميقة.
الرؤية والنظر: سُلطة الرجال وسحر النساء
يكتسب المشهد بعدًا بصريًا طاغيًا، حيث: "البرجُ تَصعدُهُ النواظيرُ التي حملَ الرجالُ" النواظير هنا ليست مجرد أدواتٍ للرؤية، بل رمزٌ لسلطة المراقبة الذكورية التي تتحقق في احتشاد "رجال بابل: " عند المساء، يترقبون طقسًا لا يخلو من الدهشة والمهابة: "لِيُشاهدوا غَسْلَ العريسِ البَدْرِ يَسبحُ في الفراتِ معَ النساءْ.. الماء هنا فضاءٌ للتطهير والانبعاث، لكنه أيضًا ساحةُ الانكشاف، حيث يتجلى العري الطقوسي كجزءٍ من الطهر والاحتفال.
المرأة والماء: ثنائية التطهير والانعتاق
يحمل الماء في هذا المشهد دلالة مزدوجة، فهو وسيلة التطهير الطقسي، لكنه أيضًا مساحةٌ للتحرر والذوبان. إنّ اختلاط البدر بالماء، وغسله في حضور النساء، مشهدٌ يُعيد إلى الأذهان طقوس الإخصاب القديمة، حيث تلتقي السماء بالأرض، ويستعيد الإنسان صلته بالكون الأولي.
الرمزية العميقة: ولادة الضوء في الماء
في النهاية، يمكن قراءة هذا المقطع كقصيدةٍ تحتفي بولادة الضوء في الماء، وبإعادة صياغة العلاقة.. بين الذكر والأنثى.. بين المقدس والمدنس.. بين الرؤية والانكشاف. كل شيءٍ في النص يبدو محكمًا ومتداخلًا في شبكةٍ من الرموز العريقة التي تجعل منه قصيدةً طقوسيةً تُعيد إحياء ميثولوجيا بابل برؤية حداثية آسرة.
ارتقاءٌ من اللوح إلى القلب
(25)
"يا بابَ أبوابِ الكتابِ اللوحِ
والمُغْني عن
الأبراجِ،
والأعشابِ أجْمَعَ،
والأطِبَّةْ
يا بابَ (حَيَّ على المَحَبَّةْ)"
بابُ المعرفة والمحبة:
قدرات الشاعر الإبداعية والفكرية تتجلى بالاستناد إلى لغة خصبة ورمزية تنضح بالدلالات الصوفية والتأملات العميقة. حين يستهل خطابه بنداءٍ احتفائي إلى "باب أبواب الكتاب اللوح"، وكأن الشاعر يُخاطب أصل المعرفة، وجوهر الحكمة الأولى (وبهذا فهو يعيدنا الى النص الأول من البارانوما: " قد جاءَ في ديباجةِ اللوحِ الكتابِ بِأنّهُ.. ").. هذه العبارة تحمل ثِقَلًا دينيًّا وفلسفيًّا، حيث يلتقي الكتاب الإلهي باللوح المحفوظ، في صورةٍ تعيدنا إلى مركزية الكلمة كمنبعٍ للمعرفة والوجود.
الكتاب واللوح: المعرفة الكونية
يمنح النصُ البابَ صفةَ التجاوز، فهو "المُغني عن الأبراجِ، والأعشابِ أجْمَعَ، والأطِبَّةْ". هنا، يبدو الشاعر وكأنه يضع المعرفة المقدّسة في مقام أعلى من العلم الدنيوي، حيث يصبح "الباب" رمزًا للخلاص الكلّي، مغنيًا عن الحاجة إلى الوسائل البشرية التقليدية للبحث عن الحقيقة أو العلاج.
البعد الصوفي: المعرفة بوصفها محبة
يصل النص إلى ذروته العاطفية والروحية حين يقول: "يا بابَ (حَيَّ على المَحَبَّةْ)". هنا يتحول الباب من كونه مدخلًا للمعرفة إلى بوابةٍ للحبّ، في إشارةٍ تمزج بين الدلالة الدينية والإنسانية. فكلمة "حَيَّ" تستدعي الأذان الإسلامي، لكنها تتجاوز النداء التقليدي للصلاة نحو دعوةٍ أسمى، حيث تكون المحبة هي الغاية العظمى للوجود.. وهو الامر الذي نراه منعكسا كنفحة في طريق الوجد الصوفية..
الرمزية العميقة: بين الدين والإنسان
يُعيد النص تشكيل العلاقة بين العقل والقلب، بين المعرفة والمحبة، ليضع المحبة في قمة الهرم الروحي، باعتبارها الغاية النهائية التي تتجاوز كل وسائل الفهم الأخرى. بهذا المعنى، يكتسب الباب بعدًا رمزيًا يتجاوز كونه مدخلًا للحكمة، ليصبح رمزًا للخلاص العاطفي والروحي.
إنه نصٌ يتوهّج بالدلالات العميقة، حيث تتضافر الرمزية الدينية والفلسفية مع أبعادٍ إنسانية صافية، ليصبح "الباب" مدخلًا للحكمة، لكنه أيضًا دعوةٌ مفتوحة للحبّ، باعتباره أسمى أشكال المعرفة.
رحلة الهبوط إلى الذات
(26)
"في سرّةِ البُرجِ البليغِ وأنتَ تَصعدُ:
حُجْرةُ الفُصْحى هناكَ، بَناتُها مِن حَوْلِها
سَبْعٌ وسبعونَ انغماسةَ لثْغةٍ
في ريقِ مَرْشَفِها الذي فَتَن الإلهْ
يا بُلْبُلاً قد عَلَّقَتْهُ على حبال غرامِها حتّى اعتَراهْ
طَرَبُ الهبوطِ الحُرِّ
مِن
آهٍ
لِ آهْ
يا بُعْدَ سدْرةِ مُنْتَهاهْ"
آهات البرج:
تتجلى هنا قدرات الشاعر الإبداعية والفكرية، حين يستند إلى لغة خصبة.. ورمزية تنضح بالدلالات الصوفية والتأملات العميقة.. فهو يبدأ بمشهد صعودي إلى: "سرّة البرج البليغ"، وهو مكانٌ مهيب.. إذا اخذنا بانزياحات مفهوم السرة وعلاقتها بالحبل السري، الذي يستمد منه الجنين حاجاته المادية، فمعناها هنا هو السمو في الترقية الروحية أو الفكرية..
وفي حجرة الفُصحى، يلتقي الصعود بالهبوط، وما ترمز اليه الفُصْحى من قمة التعبير اللغوي وأسمى درجات الفهم لقداسة اللغة، حيث تمثل هذه الحجرة موطن الفصاحة والبلاغة، ثم يأتي ذكر: " بَناتُها مِن حَوْلِها سَبْعٌ وسبعونَ انغماسةَ لثْغةٍ" ليرمز إلى الأجيال التي حملت لواء اللغة عبر الزمان.. فالرقم سبعٌ وسبعون يتناغم مع طقوسٍ مليئة بالتكرار واللذّة اللغوية. (وقد يعني بها اللهجات المحلية وذائقتها المتجلية بفرادتها ولذاذتها وامتلاء مفرداتها بالدلالات.. راوية حكاية الاندغام والتشابك في المعاني والإنزياحات). ويُختتم الشطر بتفسير هذه الفصحى التي فتن بها الاله: "ريق مرشفها الذي فتن الإله". هذه الصورة تعكس تأثير اللغة بوصفها سرًا إلهيًا خفيًا لا يدركه سوى التأمل العميق.. حيث يبدو أن اللغة تتجاوز عالم البشر لتغدو وسيلة تواصل بين الإلهي والإنساني، كقوة تأثير شعورية ومعنوية على الذات، بما في ذلك التمرد على الأطر الثابتة للواقع..
ثم يتحول النص فجأة إلى صورة شعرية مع "البُلْبُل" الذي يبدو فيه كرمز للحب الأسير الذي يعاني لذة السقوط الحر في بحر الشوق الإلهي.. ليحكي عن الألم والنشوة. هذا التحول يشير إلى التوتر بين الحرية والمأسَاة.. الطرب والدمار.. بين النشوة والشجن.. الذي ينتهي بموال „آهٍ لِ آهْ" الذي يشكل تكرارًا موسيقيًا يخلق نوعًا من التموج الشعوري بين الطرح الفلسفي والوجداني، او تكملة للإيقاع الموسيقي/ العروضي.. كالمواويل المتنوعة، التي ترد في اغانينا التراثية والتي تمنح المرء لحظة حبور وتهلل.. لا تضاهيها اية لحظة سوى عويل المسرة.. وكأن المستمع اليه يفز من سبات المّ به او حلم راود يقظته.. انها الرحلة الوجدانية التي لا تنتهي، لينبثق أخيرًا "يا بُعْدَ سدْرةِ مُنْتَهاهْ"، مذكّرًا بالحدود النهائية للعقل البشري في بحثه عن المعرفة، وهي رمز للحقيقة النهائية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بالتسامي الروحي.
الرمزية في النص تضيء العلاقة بين الكلمات والمشاعر.. الصعود والهبوط.. الحب والخيانة.. النثر والشعر، مما يجعل البرج مجازًا للوصول إلى درجات عالية من الوعي، لكن في الوقت ذاته يَكشف عن الصراع الداخلي في التذبذب بين الغبطة والأسى.. بين الفرح والألم..
ضيق الاختلاف وسعة اللامحدود
(27)
"هيَ حجرةٌ للأنبياءْ
زرْقاءُ: سُرّةُ ما وراءْ
يَتَجادلونَ على طبيعَة ذلك المعبودِ رَبّا
سرعانَ ما ضاقتْ بهِمْ:
كُلٌّ يُريدُ مِن المُهندسِ حُجْرةً
قالَ: ابشروا سعَةً ورَحْبا"
حجرة الأنبياء:
بمشهد مهيب وغامض يمزج هذا المقطع بين الأبعاد الفكرية والرمزية والدينية، ليقدم رؤية عميقة تأملية تعبر عن صراع البشر الأزلي مع المفاهيم الإلهية والوجودية. استهلال النص بعبارة "هيَ حجرةٌ للأنبياء" يرمز إلى مكان مقدس، حيث تتلاقى العقول المستنيرة بالنبوة في مساحة فكرية وروحية، مما يشير إلى وجود فضاء معرفي مخصص للبحث عن الحقيقة المطلقة.
ثم ان وصف حجرة الأنبياء "زرْقاءُ: سُرّةُ ما وراءْ" يضفي بعدًا كونيًا على هذا المكان، فهو رمز لما هو أبعد من الإدراك الحسي، اللون الأزرق، لون الغيب الذي يلفّ الكون بأسراره.. رمز السموّ واللامحدود.. ولكنها "سرّة ما وراء"، أي مركز ما يتجاوز المحسوس والمعروف، وكأنها بؤرة تجمع الغيب والتأويلات المفتوحة.. حيث تبدأ التساؤلات الفلسفية حول طبيعة الإله.. وبتعبير الشاعر "يَتَجادلونَ على طبيعَة ذلك المعبودِ رَبّا" عاكسًا النزاع الفكري العميق الذي يعيشه الأنبياء والبشر، بحثًا عن إدراك ماهية الإله.
هذا المشهد يحاكي تاريخ الفكر الديني والفلسفي، حيث يتنازع المفسرون والمفكرون حول الجوهر الإلهي، كلٌّ يبحث عن حقيقة تستوعب رؤيته. لكن سرعان ما تتحول الحجرة إلى رمز لضيق".. الاختلاف".. ضيق الإنسان تجاه تعددية الآراء وتفسيراته المحدودة للعالم الروحي، الذي "سرعانَ ما ضاقتْ بهم"، وكأن التأويلات لا تتسع للجميع رغم اتساع المعنى المطلق.
ولكن الشاعر يلخص الحل من خلال المهندس "كُلٌّ يُريدُ مِن المُهندسِ حُجْرةً"، حيث المهندس هو رمز للحكمة الإلهية التي تسع الجميع وتمنحهم الأمل في التوافق من خلال التعددية في الأفكار والرؤى.. أو ربما للإنسان نفسه، الساعي إلى إيجاد فضاء تتسع فيه الرؤى المختلفة.. "ابشروا سعَةً ورَحْبا" حيث يتحول الضيق إلى رحابة للفهم
ان النص يحمل عمقًا فكريًا ودينيًا بشكل لا يخفى عند المتأمل المتأني، لأنه يتناول إشكالية الاختلاف داخل الوحدة.. والصراع بين المطلق والنسبي، كما يُبرز التناقض البشري بين البحث عن الحقيقة والرغبة في امتلاكها، في لغة ترميزية كثيفة ومشحونة بالدلالات الفلسفية واللاهوتية.
الحكمة الطائرة بين الأرض والسماء
(28)
"هيَ قُبّةٌ فَلَكيّةٌ أمْ مَكْتَبَهْ؟
إدريسُ حُجْرتُهُ تَطيرُ كَمَركبَهْ!
ويُقالُ: شُوهِدَ مَرّةً يَمشي
وسطحُ البرجِ لا أحَدٌ عليهِ سواهُ حتى
ويُقالُ والأقوالُ عن إدريسَ شَتّى:
الحُجْرةُ انتُهِبَتْ وأُفْرِغَتْ الرُفوفْ"
إدريس ومركبته:
يتسم هذا المقطع بجماليات لغوية وصوفية عميقة، حيث ينفتح على تساؤل يحمل بعدًا معرفيًا وكوزمولوجيًا: "هي قبةٌ فلكيةٌ أم مكتبة؟"، ليضع القارئ أمام تأرجح رمزي بين العلم السماوي والتدوين الأرضي.. ليُبرز بشكل رمز، فكرة المعرفة والارتقاء الروحي في إطار فلسفي وديني.. بين الفلك بوصفه لغة الكون.. والكتاب بوصفه لغة الإنسان.. هذا التساؤل يعكس التداخل بين المعرفة الدنيوية والحكمة الكونية، في إشارة إلى إدريس، النبي الذي رفع إلى السماء، والذي يُنسب إليه الكتابة والعلم والخط والصناعة، فيتحول إلى جسرٍ بين الأرض والماوراء..
الحجرة التي يسكنها إدريس ليست حجرة جامدة، بل كيانٌ متحرك، مركبةٌ تطير.. "إدريسُ حُجْرتُهُ تَطيرُ كَمَركبَهْ!"، فإننا نرى صورة ديناميكية، حيث تتحول الغرفة إلى مركبة، في إشارة إلى سفر إدريس بين العوالم المادية والروحية، مما يعكس قدرة العقل المستنير على التنقل بحرية بين الأفكار والرؤى.. أنها تجسيد للمعرفة في حالتها القصوى، حيث لا تسجنها جدران ولا تحدها المسافات.. بين العوالم الكونية والعقلية.. ليُبرز أن الفضاء ليس مجرد موقع مادي، بل هو مكان معرفي يتجاوز الأبعاد الفيزيائية. اما حين يقول الشاعر: "ويُقالُ: شُوهِدَ مَرّةً يَمشي وسطحُ البرجِ لا أحَدٌ عليهِ سواهُ" تحمل دلالات عميقة حول العزلة التي تميز الباحثين عن الحقيقة المطلقة، فإدريس هنا رمزي لمن يسير على درب المعرفة منفردًا، عابرًا الحدود بين الأرض والسماء.
لكن الجانب المأساوي يظهر في المفارقة، التي تكمن في أن هذه الحجرة قد "انتُهِبَتْ وأُفْرِغَتْ الرُفوف"، وكأن الحكمة السماوية قد سُرقت أو تلاشت، أو أن المعرفة التي كانت تتوهج قد طُمست بفعل الزمن أو النسيان.. او أن الشاعر يشير هنا إلى ما فقدته الحضارة الانسانية أو المعرفة العظيمة التي كانت يوما ما تزخر بها البشرية، نتيجة الحروب والصراعات (ولنا ان نتذكر ما فُعل في بغداد على يد المغول وما حصل لمكتبة الإسكندرية وسواهما).. مما يعكس الألم الإنساني المرتبط بضياع الحكمة.
النص يحمل رمزية عميقة تتجاوز الحدث الظاهري، فهو يتأمل في مصير المعرفة، في ارتباطها بالزمن، وفي تحول الحكيم إلى أسطورة، محاطًا بأقوالٍ "شتى" قد تُزيده حضورًا أو تُلقي به في ضباب الحكايات.. بلاغيًا، تتراقص الأبيات بين الإخبار والتأمل.. بين الحركة والثبات.. بين الغموض والوضوح، مما يجعلها تنبض بجدلية الوجود والمعرفة والمصير الإنساني.
" الفراغ المضيء بين الإيمان واللاإيمان
(29)
"هيَ حجرةُ البوذا صغيرهْ
ليستْ مؤثَّثةً
إذا دخَلَ المُريدونَ الحُفاةُ تَرَبّعوا:
بِاللهِ تُؤمِنُ؟ يَسألُ الكُفّارُ بوذا
أيْ نَعمْ كانَ الجوابْ
بِاللهِ تُؤمِنُ؟ يسألُ العُبّادُ بوذا
لا ولا كان الجوابْ
هيَ حجْرةُ البوذا منيرهْ"
حجرة بوذا:
تأخذنا هذه الأبيات إلى حجرة بوذا الصغيرة، لكنها رغم صِغَرها، تتسع لمفارقات كبرى تتعلق بالوجود والإيمان والتناقضات الظاهرية في الفكر البشري. فهي "ليست مؤثثةً" وكأنها تجسد الزهد المطلق، والفراغ الذي يحمل الامتلاء الروحي في طياته، مما ينسجم مع مفهوم التخلي الذي يميز تعاليم بوذا، حيث الفراغ ليس نقصًا بل فضاءً للتحرر من الماديات.
ثم تتجلى أعظم الجدليات حين تتقاطع أسئلة الإيمان واللاإيمان، ليكون بوذا نفسه مرآةً تعكس التناقضات البشرية. حين يسأله "الكفار" إن كان يؤمن بالله، يجيب: "نعم". وحين يسأله "العُبّاد"، تكون الإجابة: "لا ولا". هنا يكمن التلاعب العميق بالثنائيات التقليدية، فبوذا لا ينتمي إلى يقين محدد، بل يتجاوز الفهم الضيق للإيمان والإنكار، مما يجعل إجاباته صدى لحكمة تتجاوز التصنيف القاطع.. فالحقيقة الإلهية في الفلسفة البوذية ليست مطلقة، بل مرنة، وهذا يعكس تباين الرؤى حول الله والوجود.
رغم الحيرة التي يثيرها هذا التعارض، فإن حجرة بوذا تظل "منيرة"، وكأنها تُعلن أن الحقيقة ليست في الجواب، بل في النور الكامن في السؤال ذاته. إنها حجرة التأمل المطلق، حيث تتلاشى ثنائية الإيمان واللاإيمان، ليبقى النور وحده الحقيقة الوحيدة.. لأنه نور الحكمة الداخلية والمعرفة الروحية المتحررة من الظلام الداخلي.
معجزة الشفاء وزهرة الثالوث
(30)
"هيَ حجْرةٌ ليسوعَ
تَعرفها لأنَّ أتانَهُ بالبابِ واقفةٌ
وتعرفها لأنَّ قبْلَكَ أعرَجاً
شاهدْتَ يَدخلُها ويَخرجُ غيرَ أعرجْ
هي حجْرةٌ لِيسوعَ تَعرفها
لأنَّ قلادةً مِن زهرة الثالوثِ
ألطَفَ زهرةٍ روحاً بِعائِلةِ البَنفسجْ
تُرِكَتْ هُناكَ مُعَلَّقَه"
حجرة يسوع:
يتجلى في هذا المقطع الشعري بعدٌ رمزي عميق يتشابك فيه اللاهوتي بالإنساني.. والمعجزي بالطبيعي، في مشهد متخم بالدلالات الروحية والفلسفية. فالحجرة التي تُنسب إلى يسوع ليست مجرد مكان، بل فضاء ميتافيزيقي تتجسد فيه المعجزة، ويُضاء فيه المعنى من خلال الرموز الموحية بالشفاء والتطهير الروحي.
يبدأ النص بتأكيد هوية المكان عبر العلامات:
"هيَ حجرةٌ ليسوعَ / تَعرفها لأنَّ أتانَهُ بالبابِ واقفةٌ".
يثير شعورًا بالتقديس والرهبة، فتلك "الحجرة" ليست مكانًا عاديًا، بل رمزًا للمكان المقدس الذي تتجلى فيه معجزاته.. وأتانه هنا ليست مجرد دابة، بل إشارة قوية إلى المسيح بوصفه انسانًا وديعًا ومتواضعًا، كما في دخوله أورشليم، حيث كان الأتان رمزًا لحكم الرحمة لا القوة.. والبساطة مع العمق الروحي. ثم تأتي المعجزة مضمرةً ولكنها حاضرة بقوة:
"لأنَّ قبْلَكَ أعرَجاً / شاهدْتَ يَدخلُها ويَخرجُ غيرَ أعرجْ".
هذا المرور السريع على معجزة الشفاء، دون تفاصيل، يعزز أثرها العجائبي من خلال الإيحاء لا التصريح، بان التحرر من القيود الجسدية والروحية لا يمثل الا تجربة التحول الداخلي، وكأن الحجرة هي مكان الانبعاث الروحي والتحرر من الألم.. وكأن القارئ يشارك في اكتشاف السر الكامن في الحجرة.
لكن الإشارة الأكثر عمقًا تكمن في "قلادةً مِن زهرة الثالوثِ / ألطَفَ زهرةٍ روحاً بِعائِلةِ البَنفسجْ / تُرِكَتْ هُناكَ مُعَلَّقَه"
زهرة الثالوث، تلك الزهرة البنفسجية التي ترمز في المسيحية إلى التواضع، الحزن، الفداء، او الثالوث المقدس (الآب والابن والروح القدس).
ان لون البنفسج هنا ليس مجرد تفصيل، بل يشير إلى الألم المختلط بالأمل، وإلى الصفاء الداخلي المستمد من التجارب الصعبة. الزهرة "معلّقة" هناك كأنها أثر مقدس، مما يعزز الطابع الصوفي للنص.
إنها هدية مقدسة، أثرٌ من يسوع، وعلامة على بقاء الروح حتى بعد الرحيل. فالزهرة المعلقة في الحجرة كأنها صلاة صامتة، أو ذكرى من عالم الغيب، أو بقايا نور لم يخبُ بعد.
النص ينسج بعدًا فلسفيًا واجتماعيًا وإنسانيًا عبر الغياب والحضور.. المعجزة والرمز.. المادي والروحاني، ليجعل حجرة يسوع ليست مكانًا مغلقًا بل مزيجًا متوازنًا من العمق الروحي والرمزية الدينية، وفضاءً مفتوحًا على الإيمان والتأمل والتجدد والدهشة.
***
طارق الحلفي
......................
* رابط القصيدة
https://www.almothaqaf.com/nesos/971491
* رابط المدخل
https://www.almothaqaf.com/readings-5/979452
* رابط القسم الاول
https://www.almothaqaf.org/readings-5/979564
* رابط القسم الثاني
https://www.almothaqaf.com/readings-5/979680
* رابط القسم الثالث//
https://www.almothaqaf.com/readings-5/979779