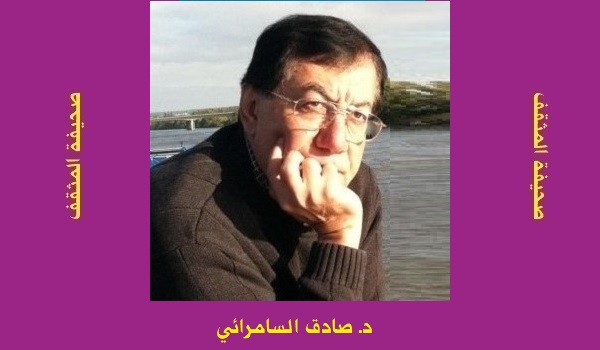قضايا
مراد غريبي: ما بين فنّ الكتابة ومعنى القراءة!

قد تبدو الكتابة، في اكتشافها المباشر، مجرّد فعل لغوي؛ يمسك إنسان بقلم أو لوحة مفاتيح، فتجود أنامله ما يجول في خاطره في سطورٍ قابلة للقراءة. بينما خلف هذا الاكتشاف البسيط تستّتر تجربة أعمق بكثير؛ تجربة تُسائل معنى أن يكون الإنسان كائنًا ناطقًا، متكلّمًا، ومقيمًا في فضاءات الكلمة. في المقابل، تتكشف القراءة غالبّا نوعًا من تلقي النصوص واستيعاب مضامينها، غير أنّها، عند التعمق الفلسفي، فعلٌ يطال بنية الذات نفسها، إذ تعيد من خلاله تشكيل علاقتها بالعالم وبذاتها في آن.
عليه بين الكتابة والقراءة علاقة تتجاوز التراتب التقليدي القائل بأن الأولى إنتاج والثانية استهلاك. إنهما منجزان متكاملان داخل أفق واحد هو أفق المعنى الذي تحمله الكلمة؛ حيث لا يعود النصّ شيئًا يُلقى من فكر على فكر، بل فضاءً مشتركًا تنشأ فيه الذات وتُختبر، ويتجدد فيه حضور العالم في الوعي الإنساني. من هنا جاءت هذه السطور بوصفها محاولة للتأمل في فنّ الكتابة ومعنى القراءة، لا كمهارة أو تعليم، وإنما كخبرة أنطولوجية ومعرفية، تتشابك فيها الفلسفة مع الأدب والعلم، ويتداخل فيها التأمل العقلي مع الشعور الجمالي والوجداني.
عند مقاربة "الكتابة" في جوهرها الأعمق، ليست نقلًا لما هو حاضر في الوعي إلى حيّز اللغة، بل هي لحظة تشكّل للوعي نفسه في رحاب اللغة. لما يشرع الكاتب في كتابة نصّ ما، فإنّه لا يفرغ مخزونًا جاهزًا من الأفكار فحسب، بل يدخل في اختبار جديد مع ذاته ومع العالم: يتوقف، يختار، يستبعد، يعيد الصياغة، يتردد، ثم يمضي. هذا النسق لا يكشف عن مسار تقنية فنية فقط، بل عن مسار داخلي يختبر فيه الكاتب حدود ما يمكن قوله وحدود ما يظل ممتنعًا عن القول. اللغة هنا لا تظهر كأداة طيّعة تمامًا، بل كأفق يتيح ويمنع، يكشف ويحجب في آن واحد.
من هذه الزاوية، تتبدّى أن الكتابة نوع من “السباحة” عبر تيارات اللغة؛ فالكاتب لا يقف خارجها ليتحكم فيها من أعلى، بل يتحرك داخلها في عمقها، يخضع لقوانينها وإيقاعها ومجازاتها، ويمنحها في الوقت نفسه سببًا جديدًا للحياة. إنّ كلّ نصّ حقيقي هو شكل من أشكال الإبحار في بحر من الكلمات؛ يخوض غماراته صاحبه، لكنه يكتشف، كلما تقدّم بين أمواجه وأعماقه، أنّ البحر يعاندّه هو نفسه، وأن الكيان الذي يخرج من النصّ لا ينفصل عن الكيان الذي يخرج منه الكاتب وهو يكتب.
ومن زاوية أخرى، يمكن النظر إلى الكتابة بوصفها رياضة إصغاء مستدامة. فالكاتب الذي يتعامل مع اللغة بجدّية يدرك أن الكلمة لا تولد من فراغ، وأن الجملة الجيدة لا تأتي بقرارٍ إراديّ محض. في لحظات الكتابة الحقيقية، يكون هناك شيء أعمق من الإرادة يتحرك: حدس مبهم، نداء خفي، أو “صوت” جواني لا يتبدى بصورة حرفية، بل يتجلى في شكل توترٍ بين ما نريد قوله وما نشعر أنه يجب أن يُقال. حينئذٍ، يصبح فعل الكتابة إصغاءً لهذا التوتر، ومحاولة لإعطائه تمثلاً لغويًا.
عبر هذا المعنى، لا يكون الكاتب “مالكًا” للمعنى، بل شاهدًا على تشكّله. الكلمات تتقدّم أحيانًا كما لو أنّ لها منطقها الخاص، والكاتب يتبعها ويجرّبها ويختبرها، حتى تستقر على شكلٍ ما. هنا يكمن سرّ شعور كثير من الكتّاب بأن نصوصهم تذهب أبعد ممّا كانوا يخططون له، وتبوح بأمور لم يكونوا واعين بها تمام الوعي. إنّ الكتابة، في أحد أوجهها، تكشف للإنسان ما يجهله عن نفسه بقدر ما تفصح عما يعيه.
أما القراءة من هذا الأفق، يتضح أن اختزالها في “فهم المعنى” لا يكفي. كونها ليست فعلًا يستقبل به القارئ رسائل جاهزة، بل هي بدورها نسق تَشكّل؛ تَشكّلٍ للذات في غمرات النص. فحين يواجه القارئ نصًا أدبيًا أو فلسفيًا أو دينيًا، فإنّه لا يتعامل مع كتلة جامدة من الكلمات، بل مع مسارات ومقتضيات محتملة، تفتح أمامه إمكانات مختلفة للفهم والتأمل والتخيل. إنّ النصّ، مهما بدا محدودًا في عدد صفحاته، يحتوي على “مسارات” فهم كثيرة لا تظهر دفعة واحدة، بل تنكشف في ضوء تجربة القارئ، وسياقات المعنى لديه، وأفق النص.
هذه الرؤية تجعل من القراءة حركة مزدوجة: من الخارج إلى الداخل، ومن الداخل إلى الخارج. من الخارج، لأنّ القارئ يتلقى كلمات وصورًا وأفكارًا لم تصدر عنه؛ ومن الداخل، لأنّ هذه العناصر لا تكتسب معناها إلا حين تمر عبر خبرته الخاصة، وتتقاطع مع ذاكرته وألمه وآماله وهواجسه. وبهذا يمكن القول: إن القارئ لا “يفهم” النص وحسب، بل “يعاشره ويستضيفه”، يعيش معه زمنًا، ويتعرّف من خلاله إلى جزء من ذاته لم يكن قد رآه من قبل.
من هنا تنشأ أهمية القراءة كفعل حرية ومسؤولية في الوقت نفسه؛ فالقارئ يستطيع أن يقرأ قراءة سريعة، سطحية، لا تبقي أثرًا عميقًا في ذاته، كما يستطيع أن يقرأ قراءة متأنية، تتوقّف عند العبارات والمفاهيم والإشارات، وتسمح للنص بأن يعمل فيه عملًا حقيقيًا. النوع الأول لا يغيّر القارئ بتاتا وإلا قليلاً، والنوع الثاني يعيد تشكيل رؤيته للعالم ولذاته، وربما يبدل وجهة حياته كلها. لهذا لا تُقاس القراءة بعدد الكتب، بل بنوع العلاقة التي نقيمها مع ما نقرأ.
في ضوء هذا كله، يغدو من المشروع أن نستفهم: ما موقع التجربة القرآنية في هذا الأفق الواسع للكتابة والقراءة؟ فالوعي الإسلامي تشكّل، في جانب كبير منه، حول نصّ مؤسس هو القرآن الكريم؛ نصّ لا يُنظر إليه على أنه كتاب من بين الكتب، بل كلمة إلهية للإنسان، نزلت “ قلب النبي” و”قرأها اللسان” في آن واحد. إنّ أول ما يلفت الانتباه هنا هو افتتاح الوحي بكلمة ذات دلالة قصوى: «اقرأ» .
هذا الأمر ليس مجرّد دعوة إلى الثقافة أو الحثّ على التعلّم، بل هو تأسيس لعلاقة مخصوصة بين الإنسان والكلمة. القراءة هنا ليست فعلاً عرضيًا، وإنما هي من صميم الوجود الإنساني كما يُراد له أن يكون: وجودٌ قائم على التأمل والتذكر والتفكر. كما أن تسمية النصّ المقدّس بـ «القرآن» تعيد التأكيد على هذا المعنى؛ فالاسم نفسه يحيل إلى الفعل: إلى القراءة، وإلى التلاوة، وإلى إعادة النطق بالمعنى في الزمن، بحيث لا ينقطع الحوار بين الإنسان والوحي.
من هذا المنطلق يمكن فهم أنّ النصّ القرآني لا يُعرَّف فقط بما هو مكتوب في المصحف، بل بما هو مقروء في حياة المؤمن، أي بما يثيره من أسئلة وما يفتحه من آفاق للفهم والعمل. فالقراءة القرآنية ليست قراءة “محايدة”؛ إنها فعل تديّن، وفعل تأويل، وفعل تزكية للنفس أيضًا. القارئ لا يكتفي بأن يفهم اللغة، بل يسعى إلى أن يدخل النص في قلب حياته، وأن يقرأ ذاته والعالم من خلاله لذلك جاء في التراث الحديثي قول أم المؤمنين السيدة عائشة (رض) عندما سئلت عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قالت: "كان قرآنا يمشي بين الناس".
هكذا لابد أن يلتقي البعد الروحي بالبعد الفلسفي: القراءة تتحوّل إلى تجربة حياتية وجودية، يعاد فيها تعريف الإنسان لذاته في ضوء كلمة يعتقد أنها تتجاوزه وتُقصيه عن مركزية ادعاء المعرفة المطلقة.
إذا جمعنا هذه الخيوط معًا، بدا أن فنّ الكتابة ومعنى القراءة يشكلان معًا جدلية دقيقة بين الإبداع والإنصات. الكتابة، من جهة، فعل إبداع وابتكار؛ يبتكر فيه الإنسان نصوصًا لم تكن موجودة قبل أن يخطّها، يضيف بها إلى العالم “معنى” آخر، في شكل قصص وأفكار ونظريات وخطابات ورؤى. بهذا المعنى، تتحقق للإنسان عبر الكتابة قدرةٌ على المساهمة في صياغة الذاكرة الثقافية للبشرية، وعلى ترك أثرٍ يتجاوز زمنه الفردي. غير أن هذا الإبداع لا ينشأ من فراغ، ولا يتم في فضاء الرؤية المطلقة؛ فالكلمة التي يُبدعها الكاتب هي أيضًا ثمرة إنصات طويل للغة والتاريخ والروح والواقع والإنسان والحياة والله..
ثم القراءة، من جهة أخرى، فعل إنصات عميق، ليس للكاتب فحسب، بل لما يتجاوز الكاتب في نصّه. هي إنصات للكلمة وهي تكشف عن طبقاتها المتعددة من المعنى، وإنصات لما يتولّد في داخل القارئ من أسئلة وأحاسيس واستجابات. لكن القراءة ليست إنصاتًا سلبيًا؛ إنها تشارك في الإبداع أيضًا وتلتحق بقافلته بمعية الكتابة، إذ إن كل قارئ يضفي على النص لونًا خاصًا من الفهم، وبصمة خاصة من التأويل، فيخلق بذلك “نصّه” هو داخل النص الأصل. وهكذا تصبح القراءة ضربًا من إعادة الكتابة الصامتة، وتغدو الكتابة ضربًا من القراءة الأولى للعالم.
في هذا الجدل بين الكتابة والقراءة تتأسّس مسؤولية الإنسان في تعامله مع الكلمة. فالكاتب مسؤول عن اللغة التي يطلقها في العالم: هل تفتح آفاقًا للفهم والنقد والبناء، أم تعمّق الخداع والتسطيح؟ هل ترتقي بالذائقة وبالوعي، أم تكرّس الابتذال والعنف الرمزي؟ والقارئ كذلك مسؤول عن الطريقة التي يستهلك بها النصوص أو يثمرها: هل يكتفي بالمرور السريع عليها، أم يمنحها من نفسه ما يجعلها تتحول إلى تجربة داخلية مؤثّرة؟
من هنا يمكن القول إنّ المجتمعات لا تُقاس فقط بعدد الكتب التي تُنشر فيها، بل بنوع العلاقة التي تنسجها مع الكلمة؛ بنوعية الكتابة السائدة، ونوعية القراءة الممكنة. مجتمع يزدهر فيه فنّ الكتابة بمعناه العميق، ويتربّى فيه الناس على قراءة جادة، متأنية، ناقدة، سيكون لا محالة مجتمعًا أكثر قدرة على التفكير في مصيره، وعلى مراجعة مساراته، وعلى ابتكار مستقبله.
يتبدّى أنّ فنّ الكتابة ومعنى القراءة، في أفقهما الأقصى، ليسا فصلين من فصول الثقافة فحسب، بل هما من أسس الوجود الإنساني ذاته. نحن لا نكتب لكي نملأ الفراغ، ولا نقرأ لكي نقتل الوقت؛ نحن نكتب لكي نفهم ونُفهِم، ونقرأ لكي نرتقي بفهمنا إلى ما بعد حدود خبرتنا الضيقة أمام فضاءات الخبرات الإنسانية. وبين لحظة يمسك فيها إنسان بقلم، ولحظة يفتح فيها آخر كتابًا، تتشكّل قصة الحضارة كلها: قصة الكائن الذي اختار أن يسكن الكلمة، وأن يبحث فيها عن معنى نفسه ومعنى العالم ومعنى ما يتجاوز العالم، هنا تلتقي اقرأ بنون والقلم وما يسطرون..
***
مراد غريبي