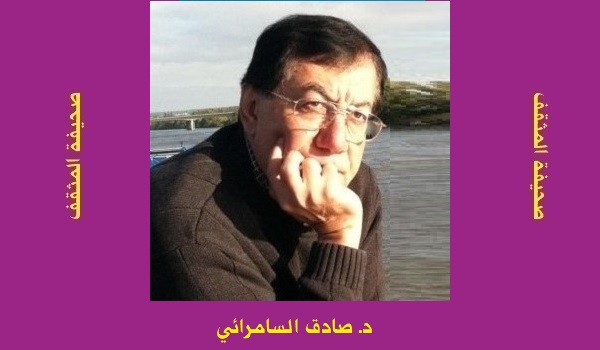قضايا
حمزة مولخنيف: الفن والسياسة

هل الجمال يظل مستقلا في عالم يهيمن عليه الصراع والاقتصاد؟
ظلّ سؤال العلاقة بين الفن والسياسة من أكثر الأسئلة إلحاحا في تاريخ الفكر الإنساني، لا لأنه سؤال نظري صرف، بل لأنه يتقاطع مع التجربة اليومية للإنسان بوصفه كائنا حسّيا اجتماعيا واقتصاديا ورمزيا في آن. فالفن منذ رسومات الكهوف الأولى لم يكن مجرد زينة أو ترف جمالي، بل كان تعبيرا عن وضع إنساني محدّد داخل عالم تحكمه علاقات القوة والخوف والأمل والهيمنة. والسياسة من جهتها لم تكن يوما منفصلة عن الرموز والصور والتمثيلات، لأن السلطة كما نبّه ميشيل فوكو، «لا تُمارَس فقط عبر القوانين والمؤسسات، بل عبر الخطابات والأجساد وأنماط الرؤية». وهنا يصبح سؤال استقلال الجمال في عالم يهيمن عليه الصراع والاقتصاد سؤالا عن إمكان الفن ذاته وعن حدوده وعن مصيره في زمن تحوّل فيه كل شيء إلى سلعة وكل قيمة إلى وظيفة.
إنّ الفلسفة الجمالية الكلاسيكية منذ أفلاطون كانت واعية بهذه المعضلة، وإن اختلفت طرق معالجتها. أفلاطون الذي كثيرا ما يُستدعى بوصفه عدوّ الفن، لم يكن في الحقيقة رافضا للجمال في ذاته، بل كان يخشى قوته السياسية والأخلاقية. ففي “الجمهورية”، حين يطرد الشعراء من المدينة الفاضلة، فإنه يفعل ذلك لأن الفن في نظره يحاكي الظاهر لا الحقيقة، ويؤثّر في النفوس قبل العقول، ويحرّك الأهواء بدل تهذيبها. إنّ هذا الموقف على ما فيه من صرامة ميتافيزيقية، يكشف وعيا مبكرا بأن الفن ليس بريئا، وأن الجمال ليس محايدا، وأن الصورة قد تكون أداة حكم بقدر ما تكون أداة إمتاع. ولذلك يقول أفلاطون إن «أشد الأخطار على الدولة تأتي من الفنون حين لا تخضع للعقل».
غير أنّ أرسطو وهو يختلف مع أستاذه لم يقطع الصلة بين الفن والسياسة بل أعاد صياغتها. ففي “فن الشعر”، يجعل من التراجيديا أداة للتطهير، لا بمعناه الطبي فقط، بل بمعناه الأخلاقي والسياسي، لأن الفن في رأيه يدرّب الإنسان على فهم العواطف الإنسانية، ويعلّمه التمييز بين الفعل النبيل والفعل الدنيء. ومع ذلك فإن هذا التصوّر يظل مشروطا بوظيفة، أي أن الجمال ليس مستقلاً استقلالا مطلقا، بل هو منخرط في أفق المدينة والعيش المشترك. إن الفن هنا لا يُختزل في الدعاية، لكنه لا ينفصل عن سؤال الخير العام.
مع الانتقال إلى الحداثة، يتخذ سؤال استقلال الجمال بعدا أكثر تعقيدا. فكانط، في “نقد ملكة الحكم”، يعلن بوضوح أن الحكم الجمالي حكم “غير متحيّز”، وأن الجميل هو ما يُرضي “بلا مصلحة”. هذا المبدأ الكانطي شكّل ولا يزال أحد الأسس النظرية لفكرة استقلال الفن عن الأخلاق والسياسة والاقتصاد. فالجمال بحسب كانط لا يُقاس بالنفع ولا بالغاية، بل بالانسجام الحرّ بين المخيلة والفهم. غير أن هذا الاستقلال على عمقه النظري يظل هشا أمام واقع اجتماعي لا يعترف بما هو “بلا مصلحة”. ولذلك فإن سؤالنا اليوم ليس هل يمكن التفكير فلسفيا في جمال مستقل؟ بل هل يمكن لهذا الاستقلال أن يصمد داخل بنى اقتصادية وسياسية تسعى إلى توظيف كل شيء؟ .
هيغل الذي انتقد كانط من داخل التراث نفسه، يرى أن الفن لا يمكن فهمه خارج “الروح الموضوعية” لعصره. ففي “محاضرات في علم الجمال”، يصرّح بأن «الفن هو أحد الأشكال التي يتجلّى فيها المطلق تاريخيا». وبذلك يفقد الجمال براءته المجرّدة، ويصبح مرتبطا بحركة التاريخ وبصراعاته وبأنماط وعيه. الفن عند هيغل ليس خارج السياسة، لأنه تعبير عن روح شعب وزمن. ومع ذلك فهو ليس مجرّد أداة سلطوية، بل مساحة يظهر فيها التوتر بين الحرية والضرورة. إن هذا التصوّر الهيغلي يسمح بفهم الفن بوصفه مجالا للصراع الرمزي، لا مجرد انعكاس سلبي للبنية السياسية.
لكن التحوّل الجذري في العلاقة بين الفن والسياسة سيأتي مع صعود الرأسمالية الصناعية، حيث لم تعد السلطة سياسية فقط بل اقتصادية، ولم يعد الصراع يدور حول الحكم وحده، بل حول الإنتاج والاستهلاك والمعنى. هنا تبرز أطروحات كارل ماركس الذي وإن لم يضع نظرية جمالية مكتملة، إلا أنه قدّم مفاتيح حاسمة لفهم اغتراب الفن. فماركس يلاحظ أن العمل حين يتحوّل إلى سلعة يفقد معناه الإنساني، والفن ليس استثناءً من هذه القاعدة. يقول في “المخطوطات الاقتصادية والفلسفية”: «إن اغتراب الإنسان عن عمله هو اغترابه عن جوهره». وإذا كان الفن أحد أشكال العمل الإنساني الأسمى، فإن اغترابه يعني فقدان الجمال لاستقلاله وتحوله إلى منتج يخضع لقوانين السوق.
هذا الوعي النقدي سيتعمّق في مدرسة فرانكفورت، خصوصا عند أدورنو وبنجامين وماركوز. فأدورنو في “نظرية جمالية”، يدافع بشراسة عن فكرة استقلال الفن، لكنه يفعل ذلك لا بوصفها واقعا قائما، بل بوصفها مقاومة سلبية. الفن في نظره، يكون سياسيا حين يرفض أن يكون أداة سياسية مباشرة. يقول عبارته الشهيرة: «الفن لا يلتزم بالقضايا إلا بقدر ما يحافظ على شكله». إن استقلال الجمال هنا ليس ترفا، بل شرطا نقديا يسمح للفن بأن يكشف زيف العالم القائم. غير أن هذا الاستقلال مهدّد دائما بما يسميه أدورنو “صناعة الثقافة”، حيث يُفرغ الفن من قدرته السالبة ويُعاد إنتاجه كسلعة ترفيهية.
أما والتر بنجامين فيتناول المسألة من زاوية مختلفة، حين يتحدّث عن “زوال الهالة” في عصر الاستنساخ التقني. فالفن حين يفقد فرادته يصبح أكثر قابلية للتسييس، لكنه في الوقت نفسه يفقد استقلاله الجمالي. بنجامين لا يحنّ إلى الماضي الأرستقراطي للفن، لكنه يحذّر من تحويل الجمال إلى أداة دعاية، كما حدث في الفاشية التي “تُجمّل السياسة بدل أن تُسيّس الفن”. هذه المفارقة البنجمينية تضعنا أمام سؤال مركزي، هل فقدان الاستقلال الجمالي يعني بالضرورة خيانة الفن، أم أنه شرط لدخوله التاريخ من باب الفعل؟.
في السياق نفسه، يذهب هربرت ماركوز إلى أن الفن يحتفظ بإمكانه التحرّري طالما ظلّ قادرا على تخيّل عالم آخر. ففي “البعد الجمالي”، يؤكد أن «الفن يحرّر الحساسية ضدّ عقلانية القمع». غير أن هذا التحرّر مشروط بعدم ذوبان الجمال في المباشرة السياسية. فالفن حين يتحوّل إلى شعار يفقد قوته التخيلية. وهنا تظهر المفارقة العميقة،الجمال يكون سياسيا بقدر ما يرفض أن يكون سياسيا على الطريقة السائدة.
إذا انتقلنا إلى الفكر المعاصر، وجدنا أن ميشيل فوكو وجاك رانسيير قد أعادا صياغة العلاقة بين الجمال والسياسة بلغة جديدة. فوكو لا يتحدّث عن الفن مباشرة، لكنه حين يحلّل السلطة بوصفها شبكة علاقات، يفتح المجال لفهم الفن كممارسة مقاومة. أما رانسيير فيرى أن السياسة ليست فقط صراعا على السلطة، بل هي صراع على “توزيع المحسوس”، أي على ما يمكن رؤيته وقوله وتخيّله. وفي هذا المعنى يكون الفن سياسيا حين يعيد ترتيب الحواس، لا حين يرفع الشعارات. يقول رانسيير: «السياسة والجمال يلتقيان في إعادة تنظيم ما يُرى ويُسمع».
غير أنّ كل هذه الأطروحات تصطدم اليوم بواقع اقتصادي كوني يجعل من السوق مرجعا أعلى. ففي عالم النيوليبرالية، لم يعد السؤال، هل الفن مستقل عن السياسة؟ بل: هل يمكن للفن أن يكون مستقلا عن الاقتصاد؟ فالجمال اليوم يُقاس بعدد المشاهدات وبقيمة المزادات وبقابلية الترويج. وكما يقول بيير بورديو، فإن الحقول الثقافية مهما ادّعت الاستقلال، تظل خاضعة لعلاقات القوة ورأس المال الرمزي. إنّ استقلال الفن في سياقنا هذا ليس معطى بل رهان دائم.
من هنا يتّضح أن سؤال استقلال الجمال ليس سؤالا بسيطا يُجاب عنه بنعم أو لا. إنه سؤال عن التوتر، عن المسافة، عن الهشاشة. فالجمال لكي يظل جمالا، يحتاج إلى مسافة من السلطة، لكنه في الوقت نفسه لا يوجد خارج العالم. إنه كما يقول بول ريكور، «يقول أكثر مما يقصد، ويقصد أكثر مما يقول». وفي هذا الفائض الدلالي تكمن قوته، كما تكمن هشاشته.
لقد تنبّه غي ديبور مبكرا إلى هذا التحوّل حين تحدّث عن “مجتمع الفرجة”، حيث لا تعود الصورة تمثيلا للواقع، بل تحلّ محلّه. في هذا المجتمع يقول ديبور، «كل ما كان يُعاش مباشرة أصبح يُعاش على نحو تمثيلي». الفن داخل هذا الأفق يفقد وظيفته بوصفه كشفا أو إزاحة، ويتحوّل إلى عنصر ضمن سلسلة لامتناهية من الصور التي تُنتج الاندماج بدل المسافة، والتماهي بدل النقد. هنا لا يُلغى الجمال بل يُفرَّغ من توتّره ومن قدرته على الإزعاج ومن طاقته على قول “لا” في وجه العالم.
وهذا ما يجعل سؤال السياسة اليوم مختلفا عمّا كان عليه في القرن العشرين. فالفن لم يعد يُستدعى أساسا كأداة أيديولوجية مباشرة، بل كوسيط رمزي يُنتج القبول ويُطبع الحساسية ويعيد تشكيل الرغبات. يقول فريدريك جيمسون إن «المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة هو محو المسافة بين النقد والتسلية». وفي هذا المحو تكمن خطورة قصوى، لأن الفن حين يفقد قدرته على خلق مسافة، يفقد جوهره الجمالي نفسه. فالجمال كما لاحظ نيتشه، ليس ما يُريح بل ما “يُكثّف الإحساس بالحياة”، حتى في بعدها التراجيدي.
إن نيتشه في هذا السياق، يقدّم مفتاحا بالغ الأهمية لفهم العلاقة بين الفن والقوة. فالفن عنده، ليس زينة أخلاقية ولا خطابا إصلاحيا، بل تعبير عن إرادة الحياة في أوج توترها. وحين يكتب في “مولد التراجيديا” أن «الفن هو النشاط الميتافيزيقي الحقيقي لهذه الحياة»، فإنه لا يفصل الجمال عن الصراع، بل يجعله شكله الأسمى. غير أن هذا التصوّر على راديكاليته، يختلف جذريا عن تحويل الصراع إلى فرجة، وعن تحويل الجمال إلى سلعة. فالفن النيتشوي لا يُهادن، ولا يطلب الرضا العام، بل يضع الإنسان أمام هشاشته وقدرته في آن.
لكن عالم اليوم وقد أُعيد تنظيمه وفق منطق السوق الكوني، لا يتيح بسهولة هذا النوع من التجربة. فالفن لكي يوجد يحتاج إلى تمويل ومنصات عرض واعتراف مؤسسي. وهذه الشروط كما يبيّن بورديو ليست محايدة بل تفرض ذوقا معيّنا، وتُكافئ أشكالا من التعبير على حساب أخرى. الاستقلال الجمالي في هذا المعنى، ليس سوى استقلال نسبي داخل حقل تحكمه قواعد غير معلنة. ولذلك يقول بورديو إن «أشد أشكال الهيمنة فعالية هي تلك التي لا تُدرَك بوصفها هيمنة».
هذا الوعي النقدي لا يقود بالضرورة إلى التشاؤم المطلق، لكنه يفرض إعادة تعريف معنى المقاومة الجمالية. فالفن لا يقاوم اليوم فقط عبر المضامين السياسية الصريحة، بل عبر الأشكال والإيقاعات والاختيارات الأسلوبية التي تُربك منطق الاستهلاك. إن قصيدة غامضة أو لوحة صامتة أو عملا سينمائيا بطيئا، قد يكون أكثر سياسية من خطاب مباشر، لأنه يرفض الخضوع لإيقاع السوق. وهنا يمكن استحضار قول موريس بلانشو إن «الأدب يبدأ حين يصبح الكلام غير نافع». فاللا-نفع هنا ليس عجزا، بل موقفا.
ويزداد هذا المعنى وضوحا حين ننظر إلى العلاقة بين الفن والهوية في السياق المعاصر. فقد تحوّلت قضايا الهوية العرقية والجندرية والثقافية، إلى أحد ميادين الصراع الرمزي الأساسية. والفن هنا يجد نفسه ممزقا بين مطلب التعبير والاعتراف، ومخاطر الاختزال والتسليع. فحين تتحوّل الهوية إلى علامة تجارية، يفقد التعبير الفني عمقه الوجودي، ويصبح جزءا من اقتصاد التنوّع. تحذّر جوديث بتلر في سياق آخر، من أن «السياسة التي لا تنتبه إلى شروط ظهورها قد تعيد إنتاج ما تعارضه». وينطبق هذا التحذير على الفن حين يُختزل في تمثيل مباشر للهوية دون مساءلة الشروط التي تجعل هذا التمثيل ممكنا ومطلوبا.
من جهة أخرى، يفرض التحوّل الرقمي أسئلة جديدة حول معنى الجمال والاستقلال. فالفن وقد أصبح متداولا عبر الشاشات، يخضع لمنطق الخوارزميات التي تُحدّد ما يُرى وما يُهمَل. هنا لا يعود الرقيب دولة أو مؤسسة، بل نظاما غير مرئي من الحسابات الإحصائية. يقول برنار ستيغلر إن «الخطر الحقيقي اليوم هو فقدان الانتباه بوصفه قدرة إنسانية». والفن الذي يفترض فيه أن يدرّب الانتباه، يصبح مهددا بالذوبان في تدفّق لا نهائي من الصور. إن استقلال الجمال في هذا السياق يصبح مرهونا بالقدرة على إبطاء الزمن، على خلق فجوة داخل التسارع العام.
لكن هل يعني هذا أن الفن محكوم بالفشل أو التلاشي؟ ليس بالضرورة. فالتاريخ يعلّمنا أن الفن غالبا ما يجد منافذه في الهوامش، وفي المساحات التي لا تلتفت إليها السلطة مباشرة. يشير إرنست بلوخ إلى أن «الأمل يسكن في ما لم يتحقّق بعد». والفن بوصفه ممارسة تخييلية يحمل هذا البعد اليوتوبي لا بمعناه الساذج، بل بوصفه انفتاحا على الممكن. إن الجمال لا يغيّر العالم مباشرة لكنه يغيّر شروط الإحساس به، وهذا تغيير سياسي عميق، وإن كان غير قابل للقياس.
إن استقلال الجمال لا يعني الانفصال عن العالم، بل الحفاظ على توتّر خلاّق معه. فالفن الذي ينعزل تماما يتحوّل إلى لعبة نخبويّة، والفن الذي يذوب كليا في السياسة أو السوق يفقد روحه. بين هذين الحدّين، تتشكّل إمكانية جمالية نقدية تدرك شروطها ولا تتوهّم براءتها، لكنها ترفض في الوقت نفسه الاستسلام. وكما يقول بول فاليري: «ليس للفن أن يكون واضحا، بل أن يكون دقيقا». وهذه الدقة هي ما تمنحه قدرته على الاستمرار.
لعلّ ما يلوح في أفق هذا التأمّل لا يرقى إلى مرتبة الحسم، لأن السؤال ذاته عصيّ على الاستقرار. فهل يظل الجمال مستقلا في عالم يهيمن عليه الصراع والاقتصاد؟ الجواب، إذا أُريد له أن يكون فلسفيا، لا يمكن إلا أن يكون مركّبا. نعم، يظل الجمال مستقلا بقدر ما يخلق مسافة ويقاوم الاختزال ويحافظ على قدرته على الإزعاج. ولا يظل مستقلا إذا فُهم هذا الاستقلال بوصفه عزلة أو تعاليا على التاريخ. فالجمال كما يعلّمنا تاريخ الفن والفلسفة، لا يعيش إلا في المفارقة، مفارقة كونه حرا ومشروطا كونيا ومحلّيا ذاتيا وسياسيا في آن.
ولعل القيمة الأعمق للفن اليوم تكمن في كونه يذكّرنا بأن الإنسان ليس كائن إنتاج واستهلاك فقط، بل كائن معنى وحساسية. وفي عالم يُقاس فيه كل شيء بالقيمة السوقية، يظل الجمال حين ينجح في الإفلات من هذا القياس، أحد آخر أشكال المقاومة الهادئة. ينبه أدورنو في خاتمة “نظرية جمالية”: «الفن هو وعد بالسعادة لا يفي به». لكن هذا الوعد حتى وهو غير مُنجَز، يظل ضروريا، لأنه يفتح أفقا يتجاوز ما هو قائم، ويذكّرنا بأن ما هو كائن ليس قدرا، وأن ما يبدو طبيعيا ليس إلا تاريخيا، وأن الجمال في هشاشته نفسها، يظل شاهدا على إمكانية عالم أقل قسوة وأكثر إنسانية.
***
د. حمزة مولخنيف