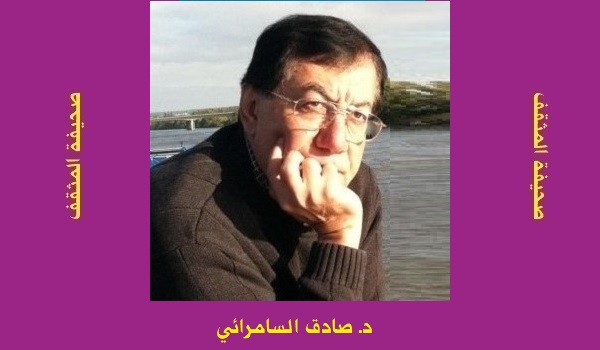قضايا
بدر الفيومي: نحن وثوة المعلومات

لم يعد الإنسان اليوم يتعامل مع المعرفة كما كان يفعل أسلافه، فقد تغيّر المشهد تغيّرًا واسعًا بفعل تدفق المعلومات المستمر، حتى صارت حياتنا غارقة في كمّ هائل من البيانات التي تبدو أقرب إلى ثروة رقمية لا تكفّ عن النمو. غير أن هذه الثروة تُقاس بالعدد والانتشار أكثر مما تُقاس بالعمق والفهم، وهو ما صنع مفارقة واضحة بين الثراء المعرفي وثروة المعلومات.
فالثراء يقوم على النوعية والدقة والسياق والترابط، أي على المعلومة التي تُنير العقل وتستفز التفكير. أما الثروة فليست إلا تراكمًا متتابعًا لبيانات مشتتة لا يجمعها رابط، فتتحول عند غياب التمحيص إلى ضباب يحجب المعنى ويُربك القدرة على التمييز. ومع هذا التحول الكبير، وجد الإنسان نفسه ممزقًا بين حاجته الداخلية إلى الفهم والطمأنينة، وبين عالم خارجي يفرض عليه تدفقًا لا ينقطع من المعلومات.
فمنذ قرابة عقدين نعيش حالة دائمة من الانكشاف المعرفي، أشبه بسوق مفتوحة لا تهدأ فيها الأصوات ولا تُتيح لأي عابر فرصة للتأمل أو التوقف. ومع تضاعف الأخبار والدراسات والتحليلات عبر الشبكات الرقمية، بدا الوصول إلى المعرفة وكأنه بلا حدود، لكنه لم يمنح الإنسان فهمًا أعمق بقدر ما زاد من سرعة الإيقاع إلى حدّ يفوق قدرته على المتابعة؛ فأصبح يعيش في زمن وفرة هائلة تُقدّم كل شيء تقريبًا، لكنها لا تمنحه تلقائيًا القدرة على إدراك ما يعترضه إدراكًا حقيقيًا.
وبسبب هذا الغمر المستمر للمعلومات، كثيرًا ما يجد الفرد نفسه في حالة من التيه، غير قادر على التمييز بين الصحيح والزائف، أو بين المهم والهامشي، أو بين المصدر الموثوق وما يُضلل. فغدت علاقته بالمعرفة أشبه بوقوف شخص على شاطئ مفتوح تضربه الأمواج من كل جانب؛ لا يبحث عما يقرأ بقدر ما يحاول النجاة من كثرة ما يُفرض عليه من قراءة ومشاهدة وتأويل.
ومع أن التاريخ شهد ثورات معرفية كبرى، من اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر إلى انتشار الصحف في القرن التاسع عشر، ثم البث الإذاعي فالتلفزيوني، نجد أن كل تلك التحولات لم تُحدث هذا القدر من التشويش الذي نعيشه اليوم، ولم تغيّر طريقة تلقي الإنسان للمعرفة كما فعلت الثورة الرقمية المعاصرة. فمع ظهور الهواتف الذكية بعد عام 2007، انتقلت البشرية إلى ساحة مختلفة كليًّا. ولم يعد الإنسان مستقبلًا للمعلومة فحسب، بل صار يعيش حالة تعرض دائم أشبه بإنسان يسير في سوق صاخب طوال اليوم دون خيار الانسحاب.
وفي عام 2011، حين انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، ولا سيما مع أحداث الربيع العربي، ظهر لأول مرة الشعور الهائل بأن المعلومة لم تعد شيئًا خارجيًّا، بل جزءًا من نبض حياة الناس، يرفعهم ويخفضهم، يثير مخاوفهم ويغذي آمالهم، ويعيد تشكيل رؤيتهم لأنفسهم وللعالم.
هذا التناقض بين وفرة الثروة المعرفية والفراغ الداخلي يكشف عن أزمة عميقة تدفعنا للتساؤل: لماذا لا تتحول هذه الوفرة المعلوماتية إلى معرفة حقيقية؟. وكيف لعصر يمتلك موارد المعرفة كلها تقريبًا أن ينتج عقلاً فارغًا معرفيًا بهذا الحجم؟. هل يكمن الخلل في الإنسان ذاته أم في طبيعة هذه الثروة التي تتضخم دون أن تثمر وعيًا؟.
هذه الأسئلة ليست مجرد تفكير نظري، بل هي انعكاس مباشر لحالة يعيشها الجيل المعاصر، إذ أصبح فقيرًا بالمعنى وغنيًا بكمّ هائل لا قيمة له من المعلومات، تتلاشى فيها المعايير التي تمنحها الوزن والاتجاه.
والأمر الذي يقودنا إلى فهم هذه المفارقة هو إدراك أن وفرة المعلومات لا تعني بالضرورة المعرفة، بل إن بيئة نشرها وأساليب التحكم في تدفقها وأدوات التوجيه الرقمية كلها تساهم في إنتاج حالة من التيه المعرفي المتعمد. ويتجلى ذلك بالنظر في المعلومات التي تصل إلى الإنسان اليوم، حيث لا تُعرض جميعها على قدم المساواة، بل يتم اختيارها وترتيبها، بل وحتى تضخيمها أو تشويهها وفق مصالح معينة، سواء كانت تجارية أو سياسية أو ثقافية.
كل ذلك يؤكد أننا أمام تعمية متعمدة، ليست مؤامرة مغلقة بالمعنى التقليدي، بل شبكة معقدة من آليات تجعل الفرد يعيش وسط بحر من المعلومات المتضاربة، بحيث يصعب عليه استخلاص معنى متماسك أو حقيقي، وتختلط أمامه الحقيقة بالزيف، ومن ثم يتفتت العقل الجمعي، ويصبح غير قادر على التماسك أو الوصول إلى وضوح وفهم.
وإذا ما تأملنا هذه الظاهرة من زاويتها النفسية والمعرفية، سنجد أن الإنسان المعاصر يعيش حالة دائمة من الإرباك الذهني؛ فالعقل البشري لم يُخلق ليستقبل هذا السيل المتواصل من البيانات التي تنهال عليه يوميًا. فقبل هذه الظاهرة، كان العقل يعتمد على آليات واضحة للاختيار والتركيز والتحليل، وهي الآليات التي تجعل المعلومات تتحول إلى معرفة قابلة للفهم.
أما اليوم، فقد أصبح هذا العقل محاصرًا بموجات متلاحقة من معلومات متناقضة، تُشتت انتباهه وتستنزف قدرته على الاستيعاب، حتى يغدو عاجزًا عن بناء رؤية ساقبة أو معنى متماسك وسط هذا الضجيج المستمر.
وإذا ما نظرنا إلى جيل العصر الرقمي، نجده على الرغم من اطلاعه الدائم على كل جديد واتصاله المستمر بشبكات عالمية، لا يزال يعيش في قلب التيه المعرفي نفسه. فكثرة ما يستهلكه من بيانات يوميًا لا ترافقها بالضرورة الأدوات النقدية التي تمكنه من التمييز والتحليل، ومن ثم تحويل ما يعرفه إلى معرفة راسخة.
وقد أسفر هذا الواقع المقلق عن وعي سطحي قائم على الانطباعات السريعة واللحظية، يدفع الفرد إلى الاعتقاد بأنه ملمّ ومتابع، بينما هو غارق في كمّيات متناقضة من المعلومات تمنعه من بناء فهم عميق أو رؤية واضحة. وهذا الوضع ليس مصادفة، بل نتيجة مباشرة لبيئة رقمية صُممت لخلق التشويش والتحكم في انتباه الفرد، بحيث يصبح أسيرًا للمحتوى الذي يُقدَّم له، لا للمحتوى الذي يسعى إليه بوعي واستقلالية.
وبهذه الطريقة، يتحول النقاش العام إلى سلسلة من ردود الأفعال السريعة والانفعالية، تُعاد توظيفها عبر وسائل الإعلام الرقمية والمؤسسات التجارية والجهات السياسية بما يخدم مصالحها، فتتحول وفرة المعلومات إلى أداة لتوجيه المجتمع وصياغة وعيه. أما من الناحية الفلسفية المعرفية، فإن الإنسان يفقد القدرة على العودة إلى ذاته، وهو ما تؤكده دراسات علم النفس المعرفي منذ عام 2015، التي ربطت بين كثرة التعرض للمعلومات وتراجع القدرة على بناء رؤية متماسكة للحياة.
وقد لاحظ فلاسفة غربيون مثل ميشيل فوكو العلاقة بين السلطة والمعرفة وكيفية تشكيلها، إلا أن ما نراه اليوم يتعدى سلطة مركزية لتصبح البنى الرقمية اللامركزية هي المسيطرة، ما يصعّب على الفرد التمييز بين الحقيقي والمختلق.
وفي السياق العربي، أشار عبد الله العروي إلى أن المعرفة تتحقق فقط عندما يتمكّن المتلقي من تمثّلها داخليًا، لكن هذه التمثلات اليوم تتشتت بفعل ضوضاء المعلومات المتعمدة، وتفقد قدرتها على الاستقرار في العقل الجمعي. والإنسان اليوم لم يعد قادرًا على الاعتماد على مصدر واحد أو مجموعة محددة، فكل مصدر أصبح موضع شك أو خاضعًا لعمليات توجيه وانتقاء، ما يُعرف بـغيبة الاطمئنان للمعلومة، تلك الحالة التي يشعر فيها المتلقي بأن الحقيقة لا تصل إليه كاملة، بل مجتزأة أو منحازة أو مشبوهة.
ويظهر هذا على مستويات متعددة؛ من المنصات الاجتماعية التي تمزج الأخبار العاجلة بالترفيه والدعاية، مرورًا بمحركات البحث التي تقترح النتائج وفق خوارزميات غير شفافة، وصولًا إلى المقاطع الصوتية والفيديوهات المتداولة في المجموعات المغلقة.
وكل ذلك يصنع فيضًا من المعلومات، لا يزيد المعرفة بقدر ما يعمّق شعور الفرد بالارتياب، ويضاعف شعور الإنسان بالضغط، خصوصًا في العالم العربي حيث يُطلب من الفرد متابعة كل ما يجري حوله، من الأخبار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وسط أزمات معيشية متكررة. هذا الضغط لم يكن معروفًا بهذا الشكل قبل سنوات قليلة، فقد كان الإنسان يملك فسحة بين الحدث ورد فعله، أما اليوم فاختفت تلك الفسحة تمامًا؛ فالخبر يصل قبل أن يستقر الحدث، والرأي يتشكل قبل اكتمال الفهم، والزمن ينفلت من اليد بسرعة تفوق قدرة الفرد على المواءمة.
ومن ينظر إلى جيل التسعينيات يدرك الفرق؛ فقد كان آخر جيل تعلّم القراءة قبل التصفح، وآخر من اعتاد البحث الصبور قبل التعود على التمرير السريع. أما الجيل الحالي، فقد نشأ على التلقي الفوري، وتعلّم التمرير قبل القراءة، واستسهل الوصول بدلًا من التأمل العميق.
لذلك لم يكن غريبًا أن تتغير أنماط التدين، وأنماط التفكير الأخلاقي، وحتى رؤية الإنسان للعالم؛ إذ أصبحت أغلب ردود الفعل اليوم قصيرة وغير متروية، تحل محل التأملات الطويلة التي تمنح العمق والاتزان. ولذلك، فنحن بحاجة ماسة إلى أدوات واضحة تعيد بناء الجسر المقطوع بين الفرد والمعلومة، أدوات تمنح العقل الجمعي القدرة على ضبط هذا التدفق الضاغط الذي لا يتوقف. فعند ذلك فقط يتحول موقع الإنسان من مستهلك سلبي ينجرف مع السيل إلى مشارك يقظ، قادر على التمييز والتحليل، وعند هذه النقطة تستعيد المعرفة معناها الحقيقي، بدل أن تبقى مجرد ثروة رقمية مشبعة بالكمّ وفارغة من الاتجاه والروح.
وكل ذلك يتحقق بما يعرف بالغربلة المعرفية؛ أي الأدوات التي تمكّن الفرد من غربلة المعلومات، والتمييز بين الحقائق والمغالطات، وبين ما هو أساسي وما هو هامشي.
وغياب هذه الغرابيل يترك الإنسان في حالة من ارتباك داخلي مستمر، ويدفعه إلى الشعور بالتيه وسط بحر لا نهاية له من البيانات، حتى يغدو يعاني فراغًا عميقًا، رغم أنه يعيش في عالم يُفترض أنه الأكثر معرفة في التاريخ.
للحديث بقية...
***
بقلم: د. بدر الفيومي