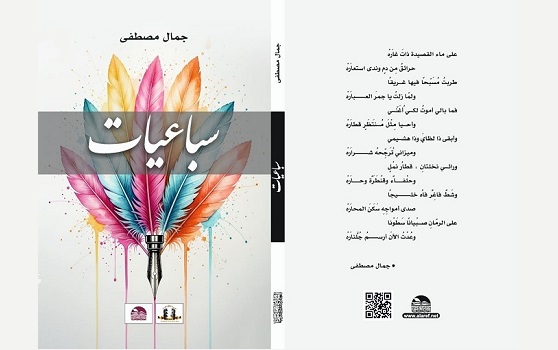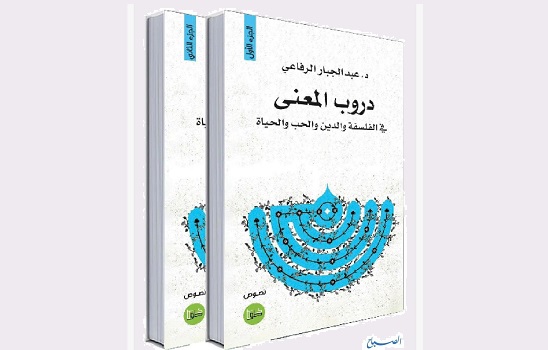قضايا
نجوى لزرق: العولمة.. الانفتاح والهوية

تغدو العولمة في مطالع هذا القرن الحادي والعشرين أكثر من مجرد ظاهرة آنية أو سياق اقتصادي متحوّل؛ إنها مشهد كوني بالغ التعقيد، يعيد رسم خرائط الوعي والثقافة، ويهزّ أسس الهوية على نحوٍ لم تشهده المجتمعات من قبل. ولعل أول ما يستوقفني هو المفارقة المضمرة في المصطلح ذاته؛ إذ يوحي ظاهره بالانفتاح والاتصال والتكامل، لكنه يُخفي في عمقه حمولات تاريخية وسياقات قوى لم تكن دوماً عادلة أو حيادية.
العولمة، في تعريفها الاصطلاحي، تُحيل إلى سيرورة شاملة يتم من خلالها توسيع نطاق التفاعلات الإنسانية، لتشمل العالم بأسره، سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الثقافة أو المعرفة. وهي مشتقة من الجذر اللاتيني globus الذي يعني "الكرة" أو "الكرة الأرضية"، ومن هنا جاءت مفردة "globalization" بالإنجليزية، والتي دخلت التداول الأكاديمي بشكل لافت منذ سبعينيات القرن العشرين، مع بروز نظم الاتصال الحديثة، وتسارع حركات السوق العابرة للحدود. إلا أن جذور العولمة أعمق من ذلك، إذ يمكن تتبع مظاهرها الأولى منذ بزوغ عصر الاكتشافات الجغرافية في القرن الخامس عشر، حين بدأت أوروبا تمدّ جسور تجارتها وثقافتها صوب ما وراء البحار، متبوعة بعصور الاستعمار، ثم الثورة الصناعية، وصولاً إلى حقبة التكنولوجيا الرقمية والإنترنت.
مقتضيات العولمة كثيرة، ولكن أبرزها يكمن في إلغاء الحدود التقليدية، وتسريع التبادل المادي والرمزي بين الشعوب، وإحداث تحوّل نوعي في مفاهيم السيادة والثقافة والاقتصاد. فبفضلها، باتت المعلومة تنتقل في أجزاء من الثانية، وأصبحت الأسواق تتداخل، واختلطت أنماط الحياة، وتشابهت المدن الكبرى في عمرانها، ومظاهرها، وخطابها الاستهلاكي. غير أن هذا الانفتاح لم يكن دائمًا ذا طابع متكافئ؛ فقد رافقته موجات من الاختراق الثقافي، وتفكيك الخصوصيات، وهيمنة خطاب أحادي يسعى لتسويق نموذج حضاري معيّن باعتباره "العالمي"، بينما يتم تهميش البدائل الأخرى، لا سيما المنبعثة من السياقات الثقافية غير الغربية.
وهنا تتبدى إحدى أهم المفارقات التي أفرزتها العولمة؛ فهي تدّعي الكونية، لكنها في كثير من تجلياتها تعكس مركزية ثقافية واقتصادية صارمة. ففي الوقت الذي تعلن فيه شعارات التعدد والانفتاح، نجدها تنزع نحو التجانس المفرط، وتُفرغ الثقافات من مضامينها العميقة، لتستبدلها بأنماط استهلاكية سطحية. وليس أدلّ على ذلك من سيادة اللغة الإنجليزية في مجالات العلم والإعلام، وتراجع استخدام لغات أخرى في التداول العالمي، مما يشير إلى اختلال في ميزان القوة الرمزية. كما أن العولمة، بينما تَعِدُ بإتاحة الفرص للجميع، كثيرًا ما تُعمّق الفجوات، وتُعزز التبعية الاقتصادية والسياسية، وتُضعف القدرة المحلية على التحكم في المصير التنموي والثقافي.
وبوصفي باحثة في الحضارة العربية، فإن موقفي من العولمة ينبع من وعي نقدي يُثمّن فرص التفاعل الحضاري، لكنه يتحفّظ إزاء الانبهار غير المشروط، والذوبان اللاواعي في ما يُسوّق كونه "المعيار العالمي". إن الحضارة العربية، بما تحمله من إرث معرفي وروحي وإنساني، ليست نقيضًا للعولمة، بل يمكنها أن تُسهم فيها إن تمكّنت من استعادة ذاتها، وتحديث أدواتها، ومساءلة موقعها من العالم بلغة الندية لا التبعية. فالعولمة لا تُلغى، ولكن يمكن تفكيك خطابها، وإعادة تشكيله على نحوٍ يُنصف التنوع، ويعترف بثراء التواريخ والهويات.
وفي هذا السياق، ينبغي التمييز بين "العولمة" كواقع تقني وتاريخي لا مفر منه، و"التموضع" داخله كخيار حضاري يستوجب الوعي والتخطيط. فنحن لا نختار أن نكون داخل العالم، لكننا نختار كيف نكون فيه. والمستقبل ليس حكرًا على الأقوى، بل على الأوعى: الأوعى بجذوره، والأنضج في تعامله مع متغيراته.
في الختام، تظل العولمة مرآة عاكسة لحالة الإنسانية المعاصرة: متقدمة في التقنية، لكنها في كثير من الأحيان تائهة في المعنى. وبينما تسير البشرية نحو مزيد من الاندماج، فإن الحاجة إلى صوت حضاري متزن، قادر على استحضار القيم دون الجمود، والانفتاح دون التنازل، تبقى أشدّ إلحاحًا. فالعولمة، كما أراها، ليست نهاية للتاريخ، بل بداية لسؤال جديد: كيف نبني عالمًا مشتركًا لا يُلغي أحدًا، ولا يستثني أحدًا، بل يحتفي بالاختلاف بوصفه ثراءً، لا تهديدًا.
***
نجوى لزرق