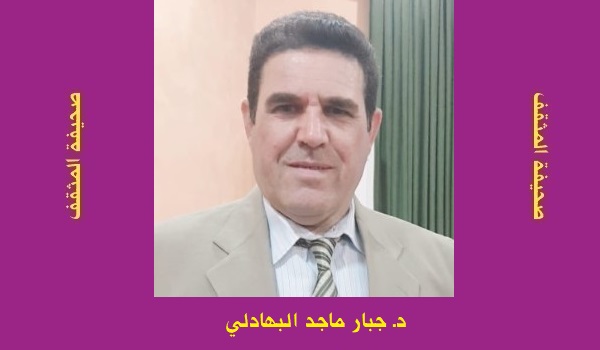قضايا
محمد رزيق مبارك: انتشاء "على صهوة الكلام"

تُكلِّمُ الناسَ مشافهةً أو رسْماً؛ وأنت تتقَصَّد الإيضاحَ والتأثيرَ من خلال الأسلوب الذي تنهجه وتكتب به، تحاول جهدَك إبرازَ أفكارك وترجمةَ عواطفك، وما يجول بخَلدك وخاطرك، تختار الألفاظ وتؤلِّف بينها بالصنعة التي تتقِنها. فكان النغم والرقص، وكان الرسم والنقش، وكان الشعر والنثر... وتلك كلها أساليب تعبيرية اختلفت أشكالها واتفقت غاياتها ومراميها. وقد انزوى كل ضرب من ضروب الإبداع وفنونه مُتحصِّناً في بُرجه، جاعلاً لفضائه حدودا معلومة، وقواعد لا ينبغي الزيغان عنها، فأضحى كل منتمٍ لفضاءٍ مختصّاً فيه، مُنافحاً عن حِماه. فأبدعواْ وبرعواْ وتفنّنواْ في الصّنوف الأدبية والإبداعية عبر كل العصور، وفي كل الحضارات. وصار الكلام رافديْن: شعراً ونثراً، واجتهد محترفوه في صقله وتبيانه، فنشأت الكتابةُ حرفةً، وتماهى العربي مع لسانه، فكان لسانُه أيامَه وديوانَه مما ينْظُمُه أو ينثُرُه. وازدادت نشْوتُه لما تقدّس هذا اللسان بالوحي من السماء، فراح ينتشي بتحديد قَدِّه وقِوامِه، أو تعديل حوَرِه، وتهذيب فلَجِهِ، فكان البيان والبديع والمعاني. لكن الحدود بين المملكتين الحصينتين – الشعر والنثر – ظلت مصونة ومحفوظة وإلى عهد قريب، إذ شرعت أرقام هاته الحدود تتكَسَّر وتغيب معالِمُها، فعُدّ ذلك الخروج والتجاوُز لوناً إبداعيّاً استساغته حضارتنا اليوم.
تزخر الساحة الإبداعية اليوم بأشكال إبداعية متنوعة، ولكل شكل قواعد. واحتضنت، كل شكل إبداعي، مدارس تتباين مناهجها وقواعدها؛ والتي بدورها عرفت تجاوزاً وتخطِّيّاً لضوابطها، فلم يعد الروائي العربي مقيدا بالبناء السردي التقليدي، ذلك أنه انفتح على ضروب فنية أخرى يؤثث بها عمارته. كما أن النص الأدبي تم تكسيرُ بنياته؛ وهو الشأن الذي دأب عليه الشاعر والمبدع اللبناني بول شاوول (1942م)؛ ذاك الذي قدّم لنص «على صهوة الكلام» للمفكر والروائي المغربي عبد الإله بلقزيز، علماً أن بول شاوول يشْغَب على الكتابة أيّاً كان مصدرها، وينْبِش في الهوامش الحياتية، وكتاباته، التي يعتمدُها، مشوبةٌ بقلق ملازم لفعلها وبأسئلة تستفيضُ عن المكان. وإذ يقدِّم لنص رصينٍ ومصنوعٍ بكل دقة وعناية، فمَبْعَثُ ذلك عائد إلى التقاطع مع صاحب هذا النص، إن في المعنى أو في الشكل.
شغب «على صهوة الكلام»
أحسب أن بول شاوول يتقاطع مع عبد الإله بلقزيز في الانزياح نحو النص المفتوح؛ انزياح يرتبط بنزعة تمرُّديّة على الجنس الأدبي الرتيب، والذي يتحصَّن بقوانين ويتخندق خلف قواعد لا يزيغ عنها. قواعد تمَّ التوافق والتواضع عليها؛ تُغلِّقُ الأبواب على من اقترب من هذا الجنس أو ذاك. وإذْ يتمرّدُ بول شاوول على قواعد الكتابة الكلاسيكية وعبد الإله بلقزيز، فمردُّ ذلك إيمانهما بأن التجريب يفسح المجال للنص لكي يمتح من جمالية مفتوحة؛ كما يسمح التجريب بالعبور من فضاء إبداعي إلى آخر، ويخلق النظرية العابرة لا الثابتة. فالتجريب هو مستقبل الكتابة وهو المجهول والسؤال، بينما النظرية هي المعلوم والجواب. من هنا يأتي شغب بول شاوول المتواصل على الكلام حين يتكلم أو يكتب، وهو المعتاد على النبش في الهامش الحياتي، يكتب بتقنية تسمح له بطرح أسئلة مصحوبة بقلق يرافقه في عملية الكتابة؛ يأتي المكانَ بعدما تمُرُّ العاصفة وقد دمّرت ومزّقت وقتّلت... ليقوم هو بإعادة البناء ويردم الصدع ويُحيِي الصورة من جديد، في هدية يقدمها للذين يموتون خلف أعمارهم. بناء يعجّ بكثافة المخزون البصري الذي توفره جغرافيا المكان، أو يستخلصه مما تقذفه دواليب المطابع من قصاصات أخبار وأحداث تصنعها أيادٍ آثمة بالوطن العربي، والقضية الفلسطينية في مقدمة هذه القصاصات.
أعمَلَ بول شاوول النظر في نصّ بلقزيز، فوَشّاهُ بتقديم تحت عنوان «السيرة ولعبة الكلام العالي»، حيث طوى في بِضْع صفحات كل ما سمح به البوْحُ في نصّ «على صهوة الكلام». وقد اعتبر فعل الكتابة أيّاً كانت سيرةَ صاحبِها: «أو ليست كل كتابة سيرة؟ هنا السيرة، مساكن مهجورة، بمواصفات محظورة، أو فائضة، أو خبيئة»[2]. لفَّ حول النصّ فاستوعبه، وقدَّمه في هذه الصفحات موجزاً، مع إحساس بأن النص يتفلّت ويجْمَح على أن يُتحكّم فيه بالرّسَن واللجام، الأمر الذي حدا بشاوول إلى سياسته والتهدئة من روْعه بعلامات ترقيم تكاد تنعدم في المتن المقدّم له وأخصّ نقط الحذف. استعمل نقط الحذف بمعدل علامتين في الصفحة؛ وللحذف في النص وظائف، من أهمها: السكوت عن كلامٍ نتعفّفُ أن نخدش مسامع القارئ به، أو اعتقاداً منّا أن الكلام المحذوف معروف لدى المتلقي، أو لفسح المجال للقارئ أن يعمل مخيلته في الموضوع ويتفاعل مع النص وأحداثه... وبول شاوول وظّف اسلوب الحذف لاستعصاء القبض على النص، هذه واحدة، أما الثانية، فيُحيل القارئ على المتن ليمْتَع بقرائته. كما أنه وظّف، للغاية نفسها، الجملة المكثفة في أقصى صورها من قبيل: «وعند عبد الإله فقدان مضاعف. لا أب. أو أم. بل ما يعوض عنهما: الجدة، الخالة...الحنان كأنما حقيقة الطفولة، وردم العزلة، والخسران»[3]؛ أو من قبيل: «إنها المعاني بامتياز. السيرة معنى. والجدة معنى. والشعر معنى. والموت معنى. لأنها سؤال»[4]. فكل مقطع من هذه المقاطع يمكن نشره في فقرات وصفحات. كما استعمل العلامات الثلاث: الفاصلة، والفاصلة المنقوطة، ثم النقطة. تهذيباً لسرعة القراءة، وإضفاءً لموسيقا ينتظم المزاج عليها.
على حدود المملكتين الحصينتين
اضطرته مطالعاته واحتكاكه بالكتاب والكتابة، وهو «الذي انغمست رأسُ[ـهُ] في أوحال القصيد، وما روى الرُّواةُ من أيام العرب»[5] وذلك منذ بداياته الأولى، إلى أن تواجد على تخوم «مملكتين حصينتين»؛ مملكة الشعر ومملكة النثر، يترنم بصوت حادي الحدود، يغازل النظم فيغرف منه معين اللفظ وشهي المعنى، ويداعب النثر فينهل منه حَسَن العبارة وجميل الفكر، أو يزاوج بينهما فيستطيب السرد والحكي، وتتراقص شذراته عذوبة وموسيقا؛ إنه في رحلة دائرية «على صهوة الكلام يعبر هذه المنامات بدونكيشوتية المغامر سابر الأغوار، ومحرك السادر، ومخلخل اليقين، والحقائق، وما يستتبعها من إرثها، وقوالبها، وعوالمها، وأشتاتها»[6]. وبهذه الغارات والمناورات، وعلى مشارف هاتَيْن القلعَتَيْن المنيعتَيْن، يقول: «بحثْتُ عن سرّ القصيدة في رِئتَيَّ؛ أستنشِقُ هواءً من شعرٍ ودخَان، أزفر الثاني ويضيع الأول في خبر كان. أستقبِلُ الشعرَ ولا أرسله، أفتح له طريق الذاكرة كي يرقد في هدوء، وأُغلِق عليه سبيل الهروب كما يُغْلق على السجين السجّانُ. لكنّ قريحتي قاحلة وإن أتيتُ القرضَ كثيراً، وأسهبْت في التمرين على النقائض والحماسة، على غزلٍ أبعثُه في رسائل بلا عنوان»[7]. وفي النثر قال: «؛ النثر صِنْوها حين يتبدّخُ في البلاغة وضُرَّتُها... كلّما تخيّرْتُ بينهما تحيّرْتُ، ومسَّني من اليقين القليل ما يشبه المحال. امرأتان تتبادلان التباهي، أمامي، بما ملكت أيمانهما من نفائس المعادن، وما ملَكَتَا، كلتاهما، من آيات الجمال»[8]. ثمّ يخلصُ بصريح العبارة إلى القول: «لا أكتب شعراً، حين أكتب، ولا أكتب نثراً؛ أعبر الحدود بين المملكتين مثلما يفعل المهرِّب سرّاً. أخشى على كلامي من الجمارك وحرّاس الحدود، وألعن في سرّي الدهاقين وسدنة المعابد؛ يزِنون، بأصدإ الموازين، متاع الروح واللسان، ويدقّون إسفيناً بين الترسّل والقصائد»[9]. فمَثَلُه في النزوع إلى النص المفتوح مَثَل مَن تتملّكه الرغبة في تطعيم نصّه الأدبي بفنون أخرى تكتسح المجال الإبداعي، وهو الذي «اكتشف، في ما بعد، أن دُرْبة السمع عند[ه] أشحذ من دُربة العين، وأنّ وقع الكَلِم في النفس أشدّ من خَدَر الصورة، تلك قِسْمتُ[هُ] من الطبيعة والثقافة [يـ]رتضيها من غير نكران، وإن ظلّ في الداخل قليل من حسرة يكفي للسؤال عن سرّ فقدان العدالة في الميزان»[10]. واستدعاءُ هذه الفنون وتوظيفُها يُكسب النص حركة أنيقة في نسجها، بديعة في سردها، تنتقل من همس الشفاه إلى طبل المسامع بلا رتابة مُمِلّة أو تنميط مُستَثْقل. يَخرقُ الصمتَ المضروبَ على هذا التجاوز، ثم يتصَعْلك ويثور على القبيلة وشيوخها، يقول حالماً في صحوه: «في ما تبقّى لي من الوقت، سأعلن في القبيلة أنّي عصيْت أمر الجماعة المأسورة بتعاليم الشيخ، وأحكام العصبية. لست سجين دمي أيتها القبيلة؛ فدمي ليس سلالة غير اللسان والأبجدية»[11].
لزوم ما لا يلزم في مضارب المعرّي
هي حلَقِيات ثلاثة[12] قدّمها بلقزيز، ومن خلالها قدّم سيرته الذاتية، والتي أعتقد، أنه لم يُنْهها بعد. تدخل باحة هذه النّصوص، فيسبح بك صاحبها في عالم الكلمة العذبة، كلمة تنساب في يسْرٍ، ويأخذك معه إلى فضاء يتشكّل من عناصر البناء السّردي الكلاسيكي: الزمان والمكان والأحداث ثم الشخصيات. يَمِيز هذه العناصر أنّها ذاتُ بُعدين: البعد الآني الذي يرسمه الكاتب للمحطات التي يختارها وينتقيها بعناية شديدة ممّا سمح به مستوى البَوْح عنده، أو تُسعِف به الذاكرة. والبعد الافتراضي، وهذا يطال كل العناصر؛ يصحبك فيه بلقزيز إلى أماكن وأزمنة وأحداث وشخصيات، مرّت وتركت الأثر؛ يمكن الاستغناء عنها في بناء النص، وهو إذ يستحضرها في نصوصه، فليس من باب التأثيث والزينة، وإن كان هذا الجانب حاضراً ومطلوباً؛ فإنه باستحضارها يفتح، من خلالها، خَوْخاتٍ ونوافِذَ للقارئ والمهتمّ علَّه يهتدي ويتلمّس المؤثرات التي انتقشت في ذاكرته، وساهمت في إنضاج طقس الكتابة عنده. لم يقدم في نصوصه كل تفاصيل حياته، بل يرحل بك، عبر هذه النصوص، فرسخاً بعد فرسخ ثم يحدثك بأسلوبه الجميل عن محطة من محطات حياته؛ والتي دفعتني إلى القول بأنها لم تكتمل بعد. الذاكرة، عنده، تصارع النسيان «العنيد في صمته، لكنه يربّي الخيال على وظيفته في اللعب بين شقوق الذاكرة»[13]. يطوّفُ بك ويُطِلق «الجنون من جنونه كي يتعقّل أكثر، [يستصحِبه] شعراً [ويُلجِمه] نثراً، [ويُعلِّبه] في لغة لا يبرحها لئلاّ تزند جذوته ويضيع هدْراً»[14]. يترجّل من على صهوة فرسه، فيُجلسك مع أدباء ومفكرين وفلاسفة؛ أولئك الذين لم يكتفِ بمعاشرتهم، منذ وقت ليس باليسير، بل جالسهم غير ما مرّة في الغياب، وبين مقابر نصوصهم: تصنّت إليهم وعليهم، وأخذ منهم وعنهم. لم تخُنْه الحيلة ولا طول الباع في السير على نهجهم؛ يتتبّع خطاهم، خطوة خطوة، قارئاً ودارساً، مُعارضاً وناقداً، مستوعباً وفاهماً... فناقَشَهُم وناظرهم، ثم أخذ عنهم وردّ عليهم، وطوّر ما قلّدهم فيه.
ألزم الكاتب نفسه في نص «على صهوة الكلام» ما لا يلزم، ألزم نفسه ألا يكتب شعراً مثلما هو محفوظ في جملة من الدواوين؛ لأن «الشعر ما كان القصيد في أوّل خلقه، قبل أن يرن رنين الذهب؛ الشعر ما قالت العرب في القفر، وما أوقد الحطب في زمهرير الليل، والشعر ما أعلى مقام النسب»[15]. أحبّ الشعر والأدب، وأحبّ الشعراء والأدباء من لم يتكسّب منهم أو يتملّق. كما أحب ّأن ينزل ضيفاً عليهم وينهل من معينهم، وأجده في هذا النص يحاكي رهين المحبسيْنِ في لزومياته. إذ بفلان تُقرن الصّعْبة في أمثال العرب.
أجد ذلك في هندسة الشكل المعماري للنص، اجتهد بلقزيز في حبكه بطريقة حسابية دقيقة، وهو المتأفِّفُ من «دروس الحساب البليدة»[16] التي كانت تعكّر عليه الجميل في رأسه زمن الدراسة، حيث وزَّع النصّ إلى ثلاثة أبواب، وهو عدد الكلمات المكوِّنة للعنوان «على صهوة الكلام»، وجعل لكل باب من الأبواب الثلاثة عنواناً، وردت تتْرى على الشكل التالي:
كلما وجدت إلى المعنى سبيلاً؛ (خمس كلمات)
بحثت عنك؛ (كلمتان)
في تفاصيل الغياب. (ثلاث كلمات)
مجموع كلمات هذه الأبواب عشرة، وهو نفسه عدد الفصول التي قسم إليها النص، وقد ضبطها بالرقم الروماني. وإذا جاريْتَ الكاتب وأنْجزْت تركيباً للجمل من خلال العناوين الثلاثة السالفة، تألّف باب رابع تحت عنوان: «كلّما وجدت إلى المعنى سبيلاً بحثت عنك في تفاصيل الغياب»؛ هذا الباب يشكل وحدة تختلف في بنيتها عن الأبواب السابقة؛ أو قلْ، خصّصه إجابة لما وصل إليه في بحثه في تفاصيل الغياب.
ألزم السارد نفسه أن يبدأ فقرات كل فصل من الفصول العشرة للنص بكلمة من الكلمات المكونة لعناوين الأبواب، وذلك حسب ترتيبها، إن في عنوان بابها، أو العنوان التركيبي للباب الرابع، وتمت الإشارة إلى ذلك ببدْءِ الفصل بالكلمة، بيت القصيد، مسوّدة ومضغوطة؛ وفي هذا خالف أبا العلاء المعري الذي شدّد على نفسه في القافية ورويها، أما بلقزيز فقد شدّد على نفسه في مطلع الفقرات.
يفترض الأسلوب السردي في مجال السيرة الذاتية أن يتحدّث الكاتب عن نفسه بوصفه سارداً بضمير المتكلم أو الغائب، ويكون ذلك بلسانه أو لسان غيره (سيرة ذاتية أو سيرة غيرية)، كما يعمد إلى المونولوج في تقديم شريط سيرته. لكن بلقزيز، في هذا النصّ، اختار أن يحوِّل المونولوج إلى حوار ثنائي – ديالوج-، حاور نفسه بنفسه وكلّمَتْ أناه أناه؛ أي أنّه أحدث انفصاماً بين السارد الحاكي والمحكي عنه. وأشعل حواراً داخلياً لكنّه مسموع ومُصوِّت.
حاشَت فقرات النص صيغاً صرفيةً متباينةً، تبدو في ظاهرها مألوفة ومتداولة، لكن تطبيقها على ألفاظ وعبارات ذات الجذر البسيط والسهل، وإيرادها بأوزان صرفية معروفة لكنها على غير المسموع بيننا اليوم؛ يندرج ضمن التفرُّد في توظيف هذه الأوزان وتطويع اللسان ليعبِّر عن المرغوب فيه بالشكل والنوع الذي يريده صاحب النص. من هذه العبارات: (قُدمة (108)، الطِّلْبة (163)، التّشرّر (113)، التقرّي (119)، التولّه (141)، الانظهار (173)، انقحطت (111)، يطّاحن (133)، استربت (145)، انداح (154)، أهتاب (156)، توثنت (183)، اشتجر....).
وفي السياق ذاته، ينزِع إلى المتضادات من الألفاظ ليخلق حيوية داخل النص، ويكسبه إيقاعاً يُبْعدُ عن المَلَل ويُخرجُ من "الكوْدرَة"؛ ومثال ذلك ما ورد في هذا الاقتباس: «كالعجاج المترَّب في عاصفة صيفية تجتاحني النوازع، وتتركني أغطّ في فوضاي، وأمدّ لشهوتي شهوتها؛ أتقشّف وأتبدّر، ألتدّ وأتنسّك، أتأمّل وأهذي، أُقدِمُ وأُحْجم، أصدّق وأكذّب، أتعجّل وأتريثُ، أرحل وأتلبّث»[17]. ومثل ذلك ما يذكر «في تفاصيلك ما تقول؛ ما تدري، وما ترى، وما تسمع، وما تمسح عيناك من شواهد الحِبْر عليه، وما في الخاطر يجول»[18]. وهو سياق يتماهى مع «لاعب النرد» للرفيق محمود درويش حين تراقصت عباراتُ نظْمِه: «أَمشي / أهرولُ / أركضُ / أصعدُ / أنزلُ / أصرخُ / أَنبحُ / أعوي / أنادي / أولولُ / أُسرعُ / أُبطئ / أهوي / أخفُّ / أجفُّ / أسيرُ / أطيرُ / أرى / لا أرى / أتعثَّرُ / أَصفرُّ / أخضرُّ / أزرقُّ / أنشقُّ / أجهشُ / أعطشُ / أتعبُ / أسغَبُ / أسقطُ / أنهضُ / أركضُ / أنسى / أرى / لا أرى / أتذكَّرُ / أَسمعُ / أُبصرُ / أهذي / أُهَلْوِس / أهمسُ / أصرخُ / لا أستطيع / أَئنُّ / أُجنّ / أَضلّ / أقلُّ / وأكثرُ / أسقط / أعلو / وأهبط / أُدْمَى / ويغمى عليّ /».[19]
تقْصُر فقرات النص فتجيءُ على شكل شذرات وتأملات. شذرات وتأملات ضمَّنَها مواقف فكرية وما ينتوي التنقيب فيه وعنه، أو ما حلَكَت رؤْيته عليه؛ وقد تكون رغبة منه في الدفع بالملتقي والدارس إلى الخوض فيها ورفع اللبس عنها. وأنت تقرأ هذه الشذرات ينتابك الإحساس بأنها تتزَيّا بزي الوعظ والإرشاد. وتتدثّر في لبوس الحكماء والعارفين؛ وتتساءل عن كنهها: أهي حِكم عطائية؟ أم وصايا لقمانية؟ أم تُراها إشارات إلهية؟ يمكن الوقوف على بعضها بالصفحات التالية: (85/89 – 170/174).
يعظك ويرشدك بالقول: «اذهب بعيداً في لعبة يتقنها الكبار كي يصعدوا فوق، اذهب وراءهم، معهم، بلا خوف ولا وجل؛ لك الذوق ميزان تقيس به الأشياء، ولك الجدل: أثمن ما في الجبّة مما ملكت يمينُك من العلل»[20]. وهو الذي تعلّم من السياسة الكياسة، تعلم كيف يصغي ويُصيخُ السمع للرياح القادمة.
سيرة أنثى من صورة امرأة
تحتلّ الأنثى مساحة تكاد تملأ كل فضاءات بلقزيز الإبداعية؛ فلها رمزية كبيرة إن في الحياة أو في الأدب. ولأنك لا تستطيع، كنت من كنت، أن تتخلّص من المساحة الوجدانية فيك، أو ترمي بالغلاف العاطفي الذي يدفِئُك من صرٍّ يخِزُ الفؤاد. ولَأَنْ يُهديَ نصّه «على صهوة الكلام» إلى الأمهات الثلاث: «إلى ذكرى زينب، وفتوحة، ورقيّة: أمّهاتي الثلاث»[21]: الأم المُطْفِل، والخالة المربّي، ثمّ الجدّة المؤدِّب؛ فهو إشارة قوية إلى الحضور الروحي للأنثى في حياة الكاتب المعيشة والإبداعية. الأنثى، الكائن المدخور بدفق عاطفي، يُركعك وأنت تطلب القربى منه، تنحت ما طاب لك من العبارات خِطبة لودّها. الأنثى التي عدّها شاوول: «الفرادة والتجربة والمزاج والبيئة والتاريخ»[22]. كما هي في نصّ بلقزيز «زمرده، في معصم الطبيعة، وكَوْن يهيم في لا نهايةٍ ليحصد قتلاه من الشعراء، ويوزع الأرق بالتساوي بين الأفئدة»[23]. هي الأمومة تحكم قبضتها على الرجل طفلاً صغيراً وكهلاً كبيراً؛ تسبِقه عبراتُه إذا ألّم بالأمهات ألمٌ، أو غادرنه بلا وداع، فهن عند بلقزيز «الماء في البيداء، والأمثولة الغرّاء»[24]. وهي الحبيبة التي يركب بحر الأهوال قاصداً ضفّتها.
«للذاكرة طريقة في التغليط مقصودة؛ تسألها عن غميسك القديم، فلا تمنحك منه غير المبهم، عساك تجرّب ثانية أن تقف بين يديها كما يقف أمام عشيقته المتيم»[25]. ومن هنا يصعب عليه أن يستحضر الذاكرة، التي تشحُّ عليه بالمعلومة، ويتعصّى عليه فعل التذكّر عندما تصبح «مساحة النسيان أوسع من حديقةِ المحفوظ، وأفْقَعُ من بياضِ الفراغ الذي لا يملؤُه نسْجٌ من خيال»[26]. أمام فعل التذكّر يتمثَّل «الذاكرة امرأة هاربة من شِباك صيدك المنصوبة في بلاهة، وحِرْباء تلبس لونك حين يأخذ لونك أصباغاً شاحبة»[27] التذكّر يُنازعه المواقع فيُحوِّل السؤال إلى أمه قائلاً: «هل تذكرين، أمي، حين عُدْت، وبين حِضْنَيْك ارتميتُ وأسدلتِ عليَّ الصفح؛ ما بكيْت عندها، حين بكيت، لأن ندماً من الهروب مسّني، ولكن لأنّي أحبّك وإن جار عليَّ من كلامك ما هدَّني»[28]. يرقُّ فؤادُهُ لنسيم يدغدغ وصلة شعرها، أو أزيز يوقظُ أمّه من غفوة تنتابها وهي تَحْنو عليه. يسمع صوتها رطباً عبر الهاتف من فاس فيغالب العبرات، يتمنّى الجناحين وبساط الريح ليدنُوَ من أمه؛ إنه إحساس رقيق ينأى به أن يكون فضّاً غليظاً أمام أمهاته؛ ويُقرُّ بالقول: «ما خفْتُ، أمي، على نفسي وأنا أُهدي المصير المجهول؛ خشيت المعاقَبَة في دموعك ودموع أختك والجدّة حين يخبرونَكُنَّ بما إليه أؤول، بين أيدي جلاوزة لا يعرفون، في الغلظة، فارقاً بين الحي والمقتول»[29]، فهو يريد السلامة من أجلها وأجلهنَّ. تلك هي الأم في عقيدة بلقزيز، يكْمُن «في الأم سرُّ أسرار الكون، وبين يديْها مفتاح الأبدية؛ هي هي لا تتبدَّل، ولا تبغي من الدنيا غيرَ ما تمنحها الطبيعة من دور»[30]. فقد حشْرَج وتحسّر، تألّم وكَلَم، ثم همس عميقاً: «لم تستفيقي كي أودّعك، مثلما اشتهيْت، أطلْتِ نومك، وأطلْتِ أرَقي، ولم أشعر أني انتهيتُ إلا حينما انتَحَبت بناتك بعد صرخة هزّت سقف البيت، ونثرت على حوافّ الحديقة مفردات النهاية»[31].
حظه ونصيبه أن يوجد بين يدَيْ أمهات أسْبَغْن عليه كل أنواع العطف والحنان؛ كل واحدة تعمل فيه بعمل الأنثى وحنكتها، وما يتواصَيْن به وهن يرقُبْن القادم من وراء المشربيات والشبابيك المغلقة بالرياض المراكشي. كان من الجدّة قريبٌ، وقريبةٌ منه كانت، «كتوأميْن لم تنجح الجراحة في فصلهما، أتنفّس برئتيْك، وتأكلين بفمي، وأرتمي في آخر الليل بين ذراعيْك لأحتميَ من شبح يُخيِّم على صباي»[32]. هي الجدّة التي أرادتْه أن يكون مثلَ بعْلِها؛ «أردتِهِ مثل جدِّه، زوجِك؛ هكذا قلت له مرّة حين رفع إليكِ مظلمةً، وأنَّبتِهِ على خوف لا يليق بأخلاق جدِّه، وسجايا البطولة في سيرة مجده»[33]. ونفس المسافة، كانت تفصله عن الخالة أو أضْيَق؛ عنها لم ينزع «الأمومة وإن لم توقعها برحِم ووحْم؛ [خرج] إلى الدنيا [ليلقاها] لابثةً [بقربه]، لا [تبرحه] وإن [تخطَّفَه] النوم»[34]. ملأت عليه الفضاء، وملأته حبّاً وحناناً، فهي قمر كلما أطلَّت عليه نثرت في صدره الأمن والأمان. ««فتوحة» امرأة جموح في الحب، والإحسان، والنكتة؛ أُحبّها وأَرهبها، وأضحك منها –أحياناً-حين تُغالي في الخرافة»[35]. لم يتذكّر في أي يوم ميّزها عن أمّه التي أطفلته، وعلم أنّ له أميْن اثنتيْن تُثلِّثُهما قرّة عيْنيْه الجدّة. جمعت «فتوحة» ممّا في الأم والجدّة؛ «في الخالة وداعة أمي والأريحية، وفيها بعض ما في الجدّة من الحزم؛ تخاصمني لتؤدبني، وتمعن في الهجر، ثم تطبع على جبيني قبلة في أول الفجر، كي تمسح بالحب ما تركت على سبورة قلبي من تعاليم الزجر»[36]. ويثقُل عليه الفراق، ويشتدُّ عليه المشهد لمّا انهزم أمام عنقود الأمهات حين أخطأت تَذَكُّره ولم تعرفه، ليرثيها بعد عامين: «يا امرأة تسكنني، وإلى المعارج ذكراها ترفعني؛ وإن انحنَيْت فلَكِ أنحني، كما تنحني للنهاية القِمم»[37]. ليس لك منها ولا من سحر أنوثتها فكاك، فهي «المريمية في صحوتها من نداء السماء، والأمّ وحدها تجثو أمام هيبتها مفردات الحبّ، وتسَّاقَط على حوافِّ ذكراها لغة الرثاء»[38].
هو ذا، بلقزيز شكّلت معالِمَه العاطفيةَ أنثى، وانتقَشَتها تنشئةٌ في وسط حميمي يكسر صمته حديث الأمهات، ويغرزن بَصَمات في ذاكرةِ مَن مرَّ بالمكان؛ بصمات الأمهات الثلاث غائرة في ذاكرته غوْرَ جُبٍّ ضنَّتْ عليه السماء بما يروي ظمأه، إذ له «منهن ما قدّمن من عبَق وحبَق ورَيْحان، ولهنَّ منّي ما تركت على اللسان من آثار ما محتها أطواري»[39]. وعلى مدارج اللسان، ينتظم غزل نوعي يشاغب به بلقزيز على الحبيبة. غابت الحبيبة ويسكن بين جنبات البيت غياب؛ «الغياب أن تستفيق صباحاً، فلا ترى من حولك إلا الفراغ: كتباً تملأُ الرفوف والجدران، وشاشة قلَّما تُمسك بأزرارها لتخرج من معزلك، ومطبَخاً لم تُزايِله رائحة الأمس، وخصاصة في الشعور بطعم الأمان»[40]. معادلة صعبة تلك التي تجعل الغياب ثم الفراغ طرفاً، والطرف الآخر الحبيبة والأمان. الحبيبة نوع ثان من الإناث اللائي طبعن حياته؛ وإنْ سمح له معدل البوح بالإفراج عن الأمهات الثلاث؛ فقد حال حائل بينه وبين أن يفرج عما يثوي خلف هذه العلاقة، وعلى استحياء يفتح ملفاً دون الإفصاح عن اسمها؛ علاقته بالحبيبة تلك التي اشتعلت جذوتها بفاس وظلَّت: «في الحلق مفردة متوحلة منذ زمان قديم»[41]؛ يصارع الذكرى ويقاوم النسيان لولا أن مفردته لم يعثر لها عن مرادف في القاموس ليخفّف من وطأة الحيرة وهو يتردّد على [جنان الحارثي]. «مفردتي حائرة ومُحيِّرة، ولا أدري أبِحُروف هي نقشت أم هي من مادة روح متصيرة؟»[42]. وإن كان عصاميا في الحُبّ هولامياً في العواطف وخصامياً مع مَن ينصحه، فإنّه ينأى ويبتعد عن ضوضاء الحبّ، وإن نصح بإخراج الحب من الغيب لإنضاج المعنى، لينغمس بين مقابر النصوص، يعاند الموتى ويعارض، يشاكس ويحاور؛ يستسلم للنوم ومع الصباح، حين يفتح عينيه ويتأهب لليوم الجديد بوجبة الفطور التي لها عنده «طقس لم يتبدل: فنجان قهوة مرّة وسيجارتين؛ واحدة لصدري الجائع للدخان، وأخرى لصورتك الضاحكة في صدر المكان»[43].
سلك الكاتب ذكاءً لطيفاً في الحديث عن المحبوبة وإليها في الغياب، من خلال بورتريه لها أو بورتريهات تَأثّثَت بها مرافق البيت. على طاولة السرير الجانبية، كانت قد وضعتها، أو وضعاها كلاهما؛ إشارة قوية كذلك إلى حفظ الذِّكرى والميثاق الغليظ. أن يغازلَ طيفها من خلال صورتها، والكلمات الواصفة لها تمتلئ صبابة؛ فهي «كأميرة تتفرج على أسراب الغجر»[44]؛ لعل في النفس بقية لم تكتمل. وفي الفؤاد خدْش يعود إلى القديم «في مطلع الثمانين احْتَرَبْنا، واقتربْنا، واحتبَبْنا، وسَرَت كهرباءَ ودٍّ في الخافقيْن. وفي آخر القرن انتَصَبْنا مُقابِليْن: لا شيء في الماضي شفع، ولا في جعبة الشعر ورسائل القلب النّديّة ما نفع»[45]. مسافة سطرين على سطح أبيض لخّص قصة حب نشأ، فكان التقارب ثم الفراق؛ فراق لم يحُلْ دونه دفء العينين، ولا لونهما منَع التباعد، ولا نهاه عن القول: «أنا لا أعاني الشعورَ بالخطيئة من ذبول عيْنَيْن تقولان ما تحملان من الحقيقة، لكنّي شقيّ من رؤية زهرة تتحلّل ورَيْقاتها، من عطش، في قلب اخضرار الحديقة»[46].
يحدث الصّدع والشقاق ثم الفراق، لكن يتأخر أن يسبر غوْرَ جرحها ولا دلالات نظراتها التي «مع الوقت، [يكتشف] أن ألوان [عينيها]تتبدّل مع الفصول، كما يتبدّل [مزاجها] بين الجبال وبين السهول»[47]. كم هو صعب عليك، أيّها القلب الوَالِه، حين تمتهن الحرفة الواحدة: «لا مهنة للقلب غير الحب»[48]؛ صالِح قلبك بشعر أو فكر، لاطِفه بنغم أو رقص، وحُلّ معادلَة: وما القلب إلا للحبيب الأول... الكلوم تبرأُ لكن الآثار تنغرس في كل المفاصل والتفاصيل، وتعبر حدود الوعي عبر الشرايين والشعيرات.
امتلأ القلب الذي مهنته الحبّ حتى رشح ضغطاً: أحبّ بلقزيز الأمهات الثلاث، وأحبّ الحبيبة التي لا زال طيفُها بالبيت، وأحبّ مَن عبرْنَ تُرَع القلب من الزائرات؛ وضاق الصدر بِتِيه من المعاني وهي كُثْر، حلّ لغزَ بعضِها واستشكل حلّ أخرى؛ واختنق الصدر بدخان سيجارة يطارده ما انطفأت جذوتها. و«في القلب منطقة عازلة، لا سلاح فيها تَمتَشِق؛ لا حبّ، ولا كره، ولا عاطفة من العواطف»[49].
لخّص مراحل عمره هكذا: «كان لي في صِبايَ ما أخاف عليه؛ عقابٌ يؤلمني، أو غيابٌ يوجِعني، أو خوفٌ يسكن الفؤاد ويؤجِّل الشجاعة إلى ما بعد موعدها. كان لي في شبابي ما أعضُّ الجمرَ عليه؛ مدينة فاضلة يسكنها العشّاق، وتُتلى ألواح شرائعها من قلوبٍ تودّع حَيْفَ الناس على الناس، وتقتلع الصراع إلى الأبد. أما الآن فلا أخشى من الأشياء غيرَ ذاكرةٍ تتملّص مني، وتودِعُني لرياح المتاهة تشرِّدني عنّي، وتحوّل بقايا الأول فيَّ إلى الأبد»[50]. يقطع كل هذه الأشواط من العمر، وقد أنْهَك الجسد وأعياه توعُّكات، وأخرى ورِثَها وهو ما يدافِعُه اليومَ؛ طنينٌ في الأذنين، وانسدادُ شرايين من دخان، أو بياضٌ يتهدّد المقلتيْن، «لي من بصمات أهلي في دميَ الكثيرُ، ولإخوتي منها ما لكلِّ مَن يرثُ الجينات من السلالة. لي ضغطيَ الدموي، وضِيقُ التّنَفُّس، والنُّقرُسُ، والغضبً السريع، والقليل من التقيةِ، والنُّفور من القطيع»[51]. لكنّه لو خُيِّرَ في العودة إلى الماضي، أو أُعيد إليْه؛ وتلك رغبة لديه كائنة امتنعت مع امتناع العوْدِ؛ لكان ما أرسل: «لو كان لي أن أعود إلى الماضي لقدّمْت اعتذاري لي على ما فعلت بنفسي: ما أدْرَرت من وقت لأقرأ العالم في فنجان نصّ مقفل؛ ما أدمنت من خوف لأشعر أني حي، وأنّ الموت مؤجّل؛ ما عبدت من الآلهة ليكون لي من اليقين ما يفوق المحصَّل؛ ما أحببت من النساء واستبدلت في البحث الرتيب عن الأجمل»[52].
إحداثيات المكان بين النص والاستذكار
تُحيلك علاقة العنوان بالنص إلى العلاقة القائمة بين المبتدإ والخبر. العنوان مبتدأ والمتْنُ خبره. وإنْ كان المبتدأ يمتطي صهوة الكلام، فما عليك إلاّ أن تُسرِج فرسَك وتنْضمَّ لِسُرْبة الفرسان، وهم يتنافسون في صُنع الكلام. سُربة قِوامها الحروف الأبجدية؛ تصطفُّ زاهية لقطع المسافة بين المبتدإ والخبر؛ وكلما تبادلت المواقع في النصّ تغيّر المعنى، وازْدانت بها المتعة، وارتفعت هامات الفرسان وهم يقطعون المضمار.
بدءاً من العنوان، يضع بلقزيز ملامح المكان الذي سيكون فضاءً لنصّه: الصهوة والكلام والراكبُ متْنَهما؛ ثلاثة عناصر كلها حركة ودينامية. لا يليق أن تَرْكن في مكان واحد وتُحبَس فيه، خاصة وأن كل عنصر منها يستدعي أحداثاً ووقائع. سأحاول في هذه الفقرة، أن أحدّد إحداثيات المكان الذي يترنّح النص بين مضاربه؛ إذ للمكان في النصوص الإبداعية قيمة جمالية تتجاوز المجال الجغرافي والحدود الطبوغرافية؛ يتخطّى المكان الواقعي القائم والذي كانَهُ زمن الانتقاش بالذاكرة، إلى ما هو تاريخي وثقافي وتخيُّلي.
يبدأ المكان، في نص «على صهوة الكلام»، في الارتسام، منذ اللحظة الأولى التي خطرت خاطرة فكرة الكتابة. وهو في النص فضاءان:
الفضاء الأول: فضاء ارتسمت معالمه الأولى وهو يتقلّب في المخاض بمُخ صاحبه بين المادة الرمادية ومنعطفات الذاكرة؛ ثم تنْتصِب معالم هذا الفضاء وتبْرُزُ على ورق التسويد حين يتأسطر. ترتفع أرقام إحداثياتِه بقلم الحبر الجرماني الذي لا يجد عنه صاحبه مَحيداً لكتابة الكلمات ورصِّ اللّبِنات. يسترسل في الكتابة، ثم يتوقف عندما تشِحُّ عليه الذاكرة؛ أو يراوغ لمّا يتعذّر البوح، ساعة ما تكون «في الذاكرة فوضى تزدحم بالفوضى، وخطوط من ذهاب وإياب تتشابك في نسيج عبثي لا يعقله أحد»[53]. هي الخطوط الأولى للمكان قبل أن يُرْقن النص على الآلة. ينتقل النص إلى فضاء الآلة، وإن صاحبه من الجيل الورقي، فيُمَدَّد في المكان ويُقلَّص، ويصير النص في حلّة قشيبة كما تصوّرها صاحبه، أو مَن أوكِلَ له تفويض المشاهدة الجمالية؛ لحظتها يصبح النص مؤهّلاً للإبحار في العوالم الافتراضية والفضاء الأزرق. لكن، يُفضّل بلقزيز أن يُقْبِره في كتاب. مكان آخر يجد فيه النص قراراً، وهو شكل ثان يتمظهر فيه المكان؛ يحتل موقعاً على صفحات متوسطة الحجم، تميل إلى نعومة صفراء لا تُؤْذي البصر، ولعل اختيار الشكل هنا يكون بالاتفاق مع ناشره إن صحَّ الظّنّ.
يُجمَع النص، ويُحْصرُ بين دَفّتين. تحمل الأولى عنوان النص كعنوان البيت في أعلى الباب ويعلوه اسم صاحبه. صفحة هذه الدَّفّة تميل إلى الأزرق الشاحب المضمّخ بالرمادي المنبعث من غيوم المتن. وفي أسفلها أبجدية تغلي كغلي المِرْجل، يتطاير لَظاها ليرسم العنوان بالأحمر. والحُسنُ أحمرُ، هكذا قالت العرب. تُقلِّب الدّفة لتَلِج فضاء النص الداخلي. في الصفحة الأولى، تُطالعني، مع المودة، وقد وقعها بلقزيز على رأس الورقة؛ وهو على صهوة الكلام يسافرُ بك حتى تبلغ آخر المضمار، معه، من الكتاب / (الصفحة 189)؛ عندها تجد إشارة أخرى إلى المكان.
الفضاء الثاني: ترتسم حدوده بين الرباط وبيروت؛ هو ذاك المكان الذي اختاره بلقزيز. مكان يعرفه ويتماهى معه، يسكن المكانَ والمكانُ يسكنه؛ ويعُدّه سبيلاً أوْحد يُسعِف على التذكّر؛ «لا سبيل إلى التذكّر إلاّ باشتمام المكان، تبتعد عن المكان ولا يبتعد منك، هل أنت من تسكنه وترحل أم هو من يسكنك وإن ترحل؟ كظلّك يتبعك، أنى تكن، وإن هجرته لم يهجرْك. تخون ولا يخون، تحسه جغرافياً وهو تاريخ وسيرة ولسان»[54].
يبدأ المكان صغيراً ثم يأخذ في النمو والنماء والازدحام بالرموز والإحالات، يكبر مع أهله وذويه، وتشكله العلاقات الإنسانية والذاكرة البصرية التي تنشَدّ إلى اللامرئي، التي ترسخ في ذهن المرء وهو ينمو ويكبر. يكبر وكلما تقدّم في السن تتسع رقعة المكان عنده. يجنح المكان، عند بلقزيز، عن رحلتَيِ الرباط وبيروت الخطية فيتنكّر للحدود. ويرتمي في أحضان البحر المتوسط، يعتصر الذاكرة المكان بعدما ادلهمَّ الليل البهيم، يحاول الاستنارة بمنارات ضفاف هذا البحر، أمسك على ذات ألواح ودُسُر، يتعقب قراصنة المعنى والفكر من شطّ لآخر، ومن مَدَنية لأخرى. يقدم من هذه الأمكنة / المنارات للقارئ المشارب التي نهل منها وشكّلت فكره. أو قل، يتعقب خطى معلّميه الذين تلقى عنهم، في الربع الخالي أو بلاد الرافدين، في بلاد فنيقيا أو الإغريق، في أرض الفراعنة والروم، أو بلاد الغال والفردوس المفقود. فهو «في أثينا [يـ]بحث عن طريق المعلّم، مثلما [بحث] عن قبر حفيده في قرطبة»[55]، أو يتحسّس أصول جذوره التي بها ينطق، «في أثينا جذورك الأولى، كما في عصر «الجاهلية»»[56]. وإذ يستعرض هذه المواقع فلأنه منبهر بمن صنع الحضارة الإنسانية، وبدر فيها اللمسة البهية، «في باريس من الجمال العادل ما يُوزِّع الأقساط بالإقساط، لمن تذوق ألوان طيفِها وتبطّن رائحتَها كما يتبطّن الصورةَ الشاعرُ»[57]. ويحضره واجب تحية هؤلاء البناة الذين خلقوا الدهشة، وخلّدوا ما يأخذ بعقول البشر، «أحيّي روما على مجد خلّدته الحجارة»[58]، و«ما خط «ساحة إسبانيا» إلاّ من له الجدارة في صناعة الدهشة، مثلما صنعت أثينا دهشة السؤال في الزمن القديم»[59]. وفي كل هذا التّقَلُّب بين الضفاف والأمكنة، يراوغ الحنين إلى الماضي ويراجعه بحثاً عن التوازن والتماسك، يسجّل ولهه وعشقه لمراكش وفاس، وإن قرّ قراره بالرباط، «ففي بيروت صورة تتبع[ه] كالظلّ...لم [يـ]عقد مع المدينة ميثاقا لأن[ه] [يـ]رتاب كثيراً في وعود[ه]، ...بيروت حدود[ه]، حين تمر حدود[ه] بين مراكش والحجاز؛ وبيروت صبية غجرية تعبث ب[ه] حين [يـ]سلمها سلطة الكلام بالمجاز»[60].
ويظل بلقزيز «مقيم [اً] في مكان المكان؛ كما اللغة تقيم بين أصابع شاعر، أو يشيّد خصبها عبق من اللسان»[61]؛ لا يبرح أماكنه وقد حوّلها، من مجرّد خلْفية تقع عليها الأحداث أو تتحرك عليها وعبرها الشخصيات، إلى عنصر انضاف إلى الزمان ليشكّل بعداً جمالياً أكسب النص فسيفساء بديعة أطّرت مادته الحكائية ونظّم الأحداث. هو ذا المكان في نصوص بلقزيز، يتخذ دلالات تاريخية وسياسية وفكرية وفنية وجمالية، وتكبر قيمته داخل النص من خلال العلاقة التي تربطه بصاحب النص، إذ يتبادلان التأثُّر والتأثير في علاقة تشابكية، فلا هذا ينفصل عن هذا، ولا ذاك بمنفصل عن هذا. ويستحقُّ المكان في نصوص بلقزيز الثلاثة مقالة خاصة.
تيه المعنى في موسيقا النص
ذكرْتُ أن بلقزيز في نصوصه الثلاثة عموماً، وفي نصه «على صهوة الكلام» خصوصاً، يأخذك معه في رحلة ماتعة، تنتشي فيها بالكلمة العذبة والتركيب الرفيع. فإذا ما تساوَقَ ذوقُك مع ذوقِه، وكنت ممن يلهجون خلف الكلمة والمعنى، فإنك لا تحسّ المسافة التي تقطعها، حتى يُقال لك الخاتمة، توقف. يحكي لك عن حياته دونما تفصيل، لكنه يفْصِل بين حدث وآخر بفقرات قيعانُها مروج خُضْرٌ مزهرة. يتخلل هذه الفقرات والمقاطع عُرْمة من المعاني تؤثث فضاء النص وتكسيه حلّة قشيبة، تجعلك تفكر في المعنى أكثر مما تفكر في ترتيب حكايا السارد عبر الزمن. لا يُسلِمُك معنى إلا ليرميك في أحضان آخر. في المعنى، تكلّم في الغياب والخيال، في الكتابة واللغة، في الحب والجمال، في التاريخ والسياسة، في الموسيقا، وفي قضية القضايا فلسطين، وفي أشياء أخرى عفوْتُ عنها أو لم ينتبه لها بال.
يبدؤك القولَ عن الخيال، «ما أبهى الخيال حيث يعلو على درج البعيد، ويعرف طريق العودة من معراجه إلى الحقيقة»[62] التي عدها نسبية في تمظهُرِها إذ أنّك «تعلم ما تعلم اليوم بيُسْر، ويعسُر عليك كثير مجهول»[63]. فلعل الخيال من يجعل المرءَ يطلُّ على المستور والمكنون، وينزل به من العوالم البعيدة إذ «للخيال جناحان، والمدى اللانهائي ملعبُه ومضرب خيامه والمقصد، وللواقع ما ترسل الشمس من جدائلها على الرمال»[64]. يُرجِع البصر ويصوِّبه عبر عدسةِ مجهرٍ بعيدِ الرؤية، يبحث عن الخيال خوفاً من أن تنْقَحِط تربته وتصفرَّ سنابله فتعتل النفس باعتلاله؛ يتمهّل قليلاً بعدها قال: «بحثت عن الخيال في خيالي؛ لم أجد ما يكفي من شارات المرور لأمضي في الشظايا حتى آخر السبيل»[65]. ربما هو السبيل إلى الواقع، واقع يتزيّنُ بالصهباء المعتقة أو السوائل المخلَّلة منذ كانت طعاماً للأنبياء والعارفين. بحث «عن الخيال في الواقع، فوجد[ه] أمامـ[ه] ماثلاٌ في نثر الطبيعة والجمال. بين الواقع والخيال ألف مودّة حين يلتقيان على ورق، أو يندسّان في هدأة قيلولة مطولة. توأمان هما في الخاطر حين تنهار الحدود بين الصخر والسنبلة»[66]. ما وسّع الكون، ولا فسح فيه إلا الخيال. كما ما انتجع القوم إلا بعدما أجدبوا. عندها يروح الخيال يشيِّد كونه في مملكة البياض الحرّ؛ «حِبرها وعرشها وسادن المقامات والجمر. الخيال خمر تعتّق في جِرار الدهشة كالجمرة تحت رماد البركان»[67].
سأل بلقزيز المرحوم محمد درويش لمَاَّ عاد إلى فلسطين: كيف وجدت فلسطين؟ ردَّ محمود: فلسطين من بعيد أبهى، هي الفكرة، وليست المكان الحي الذي نراه.
معنى يفوق المعاني ك على صهوة الكلام، ص لَّها حين تكون فلسطينُ «شمعة في قلب اليافع انطفأت، ودمعة سُفحت على شال كوفية على المنكبين مُسْدله»[68] أو تكون قِبْلتَه وقُبْلتَه وخَيْلَه «أنتِ خيلي وركائبي وزاد الرحلة، وأنتِ سيْلي حين يتقحَّل داخلي من قَحطِ ما يُحوِّمُ حولي»[69]. زهرة المدائن هي، ومهرة سليلة أفراس حرة أصيلة؛ بكى أبو البقاء أخواتها وما أجدى بكاؤه؛ ويناديها بلقزيز متوسّلاً بها «يا ابنة شام وأندلس لا تمضي إلى غدك وحدك، فليس لك بدٌّ من أهلك، وإن تفرّقت بهم طُرُق، وتكسّر سيف الفروسية فيهم، واتسع الخرق على الشعر، واستطال الزمان. يوماً ما سيكتُبُك غيرنا واقفين مثل سَرْوٍ على ترابكِ، يرمي بالجذور في قاع الأرض، ويرسِل في المدى آيات العنفُوان»[70]. قضية القضايا العربية، وليس للعرب غيرها قضية «نقولُكِ باللسان، وفي الغِمد سيفٌ يصدأ من رقدته الطويلة، وفي الفرائص قُشَعْريرة من الخوف وفيض من هوان»[71]. ليس للعرب قضية غير فلسطين. استبشروا خيراً بربيع يُغيِّر ملامح الخريطة، وكانت المعالم قد خطّت من مرصد يُسيِّرُ المُزْن حيث شاء وكيف شاء؛ فتهتزُّ الأرضُ وترتجُّ، ويُخلق العُجبُ والعَجَب من بلاد «تبحث عن حرّيتها في الفناء، وتسلم رقابها إلى الخوارج، وترمي بتعاليم الله في الحطب!»[72]. إنه ربيع لا ربيع فيه: العماءُ والتيهُ والخواءُ والخرابُ؛ وحربٌ لا تبقي ولا تدر، ومدنٌ تخرُّ مُنْصاعةً، لا ترى شيئاً فيها، غير الاصفرار ومعالم الأجداد قد دُكّت، وحرائق في المنقوش والمكتوب شبَّت.
«هزائمنا مغانمنا، ونصرنا نسلِّفه لغيرنا لئلا يخدعنا فنألف الوقوف! مَن لنا غيرُ التواضع سجيةً أو جِبلّةً أو صهوة للتفسّح في داخلنا. ما أحدٌ يشبهنا في الطباع وحبِّ السلام، واقتناء الضياع، وإدمان الرَّيْع: في الطبيعة والحب، وعشق المتاع السهل»[73].
***
محمد رزيق مبارك
الدار البيضاء: 29 نيسان 2025
.......................................
[1] عبد الإله بلقزيز، على صهوة الكلام. منتدى المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2016.
[2] عبد الإله بلقزيز، على صهوة الكلام. ص 9.
[3] على صهوة الكلام، ص 10.
[4] على صهوة الكلام، ص 14.
[5] على صهوة الكلام، ص 28.
[6] على صهوة الكلام، ص 19.
[7] على صهوة الكلام، ص 117.
[8] على صهوة الكلام، ص 117.
[9] على صهوة الكلام، ص 17.
[10] على صهوة الكلام، ص 31.
[11] على صهوة الكلام، ص 154.
[12] رائحة المكان (2012)، ليليات (2014)، على صهوة الكلام (2016).
[13] على صهوة الكلام، ص 32.
[14] على صهوة الكلام، ص 27.
[15] على صهوة الكلام، ص 118.
[16] على صهوة الكلام، ص 44.
[17] على صهوة الكلام، ص 113.
[18] على صهوة الكلام، ص 162.
[19] محمود درويش، لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي. (بيروت: دار رياض الريس للنشر، 2009)، ص 25.
[20] على صهوة الكلام، ص 102.
[21] على صهوة الكلام، ص 5.
[22] انظر: https://www.nizwa.com بول شاوول، «الشاعر لا يصنع تاريخ المرأة وإنما هي تصنع الشاعر» (1 أبريل 2014)
[23] على صهوة الكلام، ص 67.
[24] على صهوة الكلام، ص 131.
[25] على صهوة الكلام، ص 139.
[26] على صهوة الكلام، ص 30.
[27] على صهوة الكلام، ص 140.
[28] على صهوة الكلام، ص 126.
[29] على صهوة الكلام، ص 126.
[30] على صهوة الكلام، ص 131.
[31] علة صهوة الكلام، ص 127/128.
[32] على صهوة الكلام، ص 123.
[33] على صهوة الكلام، ص 123.
[34] على صهوة الكلام، ص 128.
[35] على صهوة الكلام، ص 129.
[36] على صهوة الكلام، ص 130.
[37] على صهوة الكلام، ص 130/131.
[38] على صهوة الكلام، ص 132.
[39] على صهوة الكلام، ص 131.
[40] على صهوة الكلام، ص 172.
[41] على صهوة الكلام، ص 149.
[42] على صهوة الكلام، ص 150.
[43] على صهوة الكلام، ص 151.
[44] على صهوة الكلام، ص 150.
[45] على صهوة الكلام، ص 67.
[46] على صهوة الكلام، ص 68.
[47] على صهوة الكلام، ص 152.
[48] على صهوة الكلام، ص 62.
[49] على صهوة الكلام، ص 144.
[50] على صهوة الكلام، ص 142.
[51] على صهوة الكلام، ص 46.
[52] على صهوة الكلام، ص 94.
[53] على صهوة الكلام، ص 139.
[54] على صهوة الكلام، ص 99/100.
[55] على صهوة الكلام، ص 159.
[56] على صهوة الكلام، ص 159.
[57] على صهوة الكلام، ص 158.
[58] على صهوة الكلام، ص 159.
[59] على صهوة الكلام، ص 159.
[60] على صهوة الكلام، ص 156.
[61] على صهوة الكلام، ص 177/178.
[62] على صهوة الكلام، ص 107.
[63] على صهوة الكلام، ص 162.
[64] على صهوة الكلام، ص 110.
[65] على صهوة الكلام، ص 112.
[66] على صهوة الكلام، ص 112.
[67] على صهوة الكلام، ص 32.
[68] على صهوة الكلام، ص 132.
[69] على صهوة الكلام، ص 133.
[70] على صهوة الكلام، ص 134.
[71] على صهوة الكلام، ص 134.
[72] على صهوة الكلام، ص 155.
[73] على صهوة الكلام، ص 143.