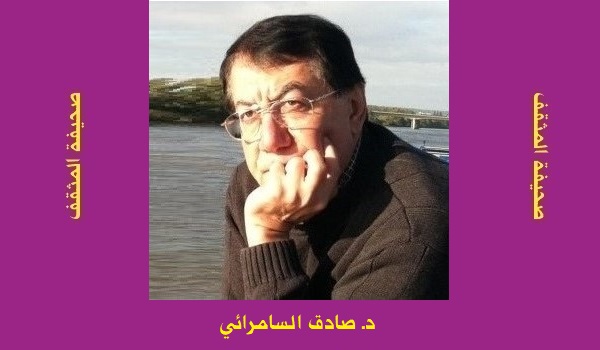قضايا
مجدي إبراهيم: فلسفة الحمد في الإسلام

الحمد لله: الحمد لله على نعمتيّ الإيجاد والإمداد. الحمد لله أعظم الحمد وأكثر الثناء. يكمن الدين كله في ظلال الحمد، وبالحمد في البدء والمنتهى، والحمد لله سلوك الإنسان المؤمن بإزاء الغيب : أن يحمد الله على الدوام بغير انقطاع، وهذا الحمد ينقله إلى رحاب المعيّة نقلاً في مثل لمح البصر من الغفلة إلى الحضور، ومن الإستنامة إلى اليقظة والتنبُّه. إذا صَحّ - ولا بدّ أن يصح - أن يكون الحمد عنوان حضور داخل المعيّة الإلهيّة لا هو بخارجها، فهو من ثمّ فلسفة لها دعائمها المُثلى في الإسلام، فلسفة تحيط بالمعنى بداية ثم تنزع إلى العمل بمقتضى فهم المعنى وفهم المضمون من ورائه.
والحمدُ أساسٌ جامع للدين في مبادئه التأسيسية، وجامعٌ للشعور - كما هو جامع للتفكير- بموجبات التحقق بأجواء المعيّة الإلهية، فالذي يتحقق من فاعلية الحمد فيما هو بسبيل إدراك قوة وصلته بحضور المعيّة الدائمة، يصدق صدقاً مباشراً مع كل توجه من توجُّهات الحق، فيكون الحمد أساس توجهه، ومصدر فاعليته، وحركة تجاريبه الواعية في كل حال.
وإنمّا قلنا فلسفة؛ لاتصال مفهوم الحمد بالجانب العقدي بدايةً، أعني جانب الإيمان بالله كركن تتحقق فيه عمل الأحكام الشرعية الاعتقادية، ثم تطبيق هذا المفهوم من الناحية العمليّة كسلوك دائم للمسلم الذي يعرف بالتحقيق ألطاف الله عليه، ويحترم أقداره فيه، فيكون الحمد غاية مبتغاه؛ ديدنه الدائم وهجّيره العميم.
فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد لله. وأسماء سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد ومحمود : محمودٌ في الأرض ومحمودٌ في السماء، والصلة بينهما أوثق ما تكون.
كان أبو طالب يقول:
وشقّ له من اسمه ليُجلّه فذو العرش محمودٌ وهذا محمّد
العلاقة بين سورة الحمد، (فاتحة الكتاب)، واسم سيدنا رسول الله علاقة وطيدة، لم يكن أحبّ إليه من فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين، وإنما سُمي نبينا بهذا الاسم العظيم؛ لأنه محمودٌ عند الله، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند إخوانه من المُرسلين، ومحمودٌ عند أهل الأرض كلهم، وإن كفر به بعضهم، فإنّ ما فيه من صفات الكمال محمودةٌ عند كل عاقل، وإن كابر عقله جحوداً وعناداً، أو جهلاً باتصافه بها.
وهو صلوات الله وسلامه عليه أختصّ بجماعٍ من صفات الحمد بما لم يجتمع فيها لغيره؛ فإنَّ اسمه - كما تقدّم - محمد، وأحمد، قال القاضي عياض صاحب كتاب (الشّفاء) قد حمي الله هذين الاسمين، يعني محمداً وأحمد، أن يتسمّى بهما أحدٌ قبل زمانه، أمّا (أحمد) الذي ذكر في الكتاب وبُشّر به عيسى عليه السلام، فمنع الله بحكمته أن يتسمّى به أحد غيره، ولا يُدْعى به مدعوّ قبله، حتى لا يدخل اللّبس ولا الشك فيه على ضعيف القلب. وأمّا (محمد) فلم يتسمَّ به أحد من العرب ولا غيرهم إلا حين شاع قبيل مولده أن نبياً يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته.
وكما خصّه الله باجتماع صفات الحمد في ذاته وفي اسمه، كذلك خصّ الله أمته بخصوصية الحمد الدائم والتسليم القويم لله رب العالمين؛ فأمته الحمّادون، يحمدون الله على السّراء والضرّاء، وهو صلى الله عليه وسلم، حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وخطبه مفتتحة بالحمد، وهكذا كان في اللوح المحفوظ عند الله، أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحاً بالحمد، وبيده، صلوات الله وسلامه عليه، لواء الحمد يوم القيامة.
ولمّا يسْجُد عليه السلام بين يدي ربّه للشفاعة، ويُؤذن له فيها : يحمد ربّه بمحامد يفتحها عليه حينئذ، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الآخرون والأولون كما قال تعالى :" وعسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً".. ، وإذا قام في ذلك المقام، حمده حينئذ أهل الموقف العظيم كلهم، مُسلمهم وكافرهم، أولهم وآخرهم، فجُمعت له، صلى الله عليه وسلم، معاني الحمد وأنواعه.
وهو، صلوات الله وسلامه عليه، محمودٌ بما ملأ به الأرض من الهُدى والإيمان، ومحمودٌ بما ملأ به الأرض من مزايا العلم النافع وفضائل العمل الصالح، ومحمودٌ بما فتح الله به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض، واستنقذهم من أسر الشياطين، ومن الشرك بالله والكفر به، والجهل به، حتى نال به أتباعه شرف الدنيا وشرف الآخرة وهو مُستحق الحمد تحقيقاً في كل ما أعطى وكل ما أبقى ممّا لا يقدر فضله علماً وهداية سوى الله.
ومُجرّد النظر إلى رسالته مستحقٌ الحمد، وكل ما فيها من مطالب وأغراض يستوجب الحمد ويستقصيه ومع ذلك لا يستوفيه؛ فإنّ رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها، وأغاث الله به البلاد والعباد، وكشف به الظّلَم، وأحيا به الخليقة بعد الموت، وهَدَى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ورفع به بعد الخَمالة، وسمَّى به بعد النكرة، وجمع به بعد الفُرقة، وألف به بين قلوب مختلفة، وأهواء مُشتتة، وأمم مُتفرّقة، وفتح به أعيناً عُمياً، وآذاناً صٌماً، وقلوباً غلفاً.
فعرف الناس ربّهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قُواهم من المعرفة، فأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى تجلّت معرفته في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والرِّيب عنها، كما ينجاب عن القمر ليلةَ إبداره، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف وغيره، لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم، وأغناهم عن كل من تكلم من الأولين والآخرين، بما أوتيه من جوامع الكلم وبدائع الحكم : (أو لم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إنّ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون).
وكفى بهذا كله من محمدة لرب العالمين لا نظير لها ولا شبيه، ولا انقطاع لدوامها حيث ينقطع كل شيء ولا يدوم.
ومن صفته - صلوات الله وسلامه عليه - في التوراة : محمد عبدي ورسولي سمّيته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخّاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، وأفتح به أعيناً عُمياً، وآذناً صماً، وقلوباً غُلفاً، حتى يقولوا: لا إله إلا الله ..
وهو أرحم الخلق وأرأفهم بهم، وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم ودنياهم، وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد، وأصبرهم في مواطن الصبر، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم إيثاراً على نفسه، وأشدُّ الخلق ذَبَّاً عن أصحابه وحمية لهم ودفاعاً عنهم، وأقومُ الخلق بما يأمر به، وأتركُهم لما ينهى عنه، وأوصلُ الخلق لرَحِمه، إلى غير ذلك ممّا يجلُّ عن الوصف ولا يمكن حصره .. صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرآ.
فليس هنالك أحقُ بالحمد الذي ينقطع معه النظير من تكرار الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وجوداً وإمداداً واستمداداً، فهو الوجود الحق والإمداد الحق والاستمداد الحق، يستمد من الله مباشرة ونحن نستمد منه، وجوداً وإمداداً واستمداداً، هو وسيلتنا الى الله من حيث لا وسيلة لنا سواه، فلا شئ إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط، كما تقول الصلاة المشيشية.
ونحن من بعدٌ ومن قبل لا نعرف الله، وليس لنا من قدرة على معرفته إلا من خلاله: "قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يُحببكم الله"، مُمُد الهمم بالقيل الأقوم، صلى الله عليه وسلم وبارك وشرف وعظم وحقق وأكرم وعلى آله وصحبه وسلم.
ومن مولده المبارك حتى الانتهاء إلى الرفيق الأعلى عاش، صلوات الله وسلامه عليه، حياته في بعدها الزمني المحدود بزمان ومكان، تحت ظلال الحمد فكان كاملاً مكمّلاً في خصاله الشريفة ومناقبه العفيفة. لم تصف اللغة، ولن تستطيع أن تصف، وصفاً من أوصافه على التحقيق؛ لأن الكمال فيه لا يوصف بلفظ ولا يحيط به تصوّر محدود، وبخاصّةٍ إذا كان الكامل يجسّد صفة إلهيّة لا وصف لها إلا النور الذي يشملها ويضمّها.
محمدٌ رسول الله، ولكنه مع ذلك هو قبضة النور. محمدٌ المُبلغ رسالة الله للعالمين، هو الرحمة المُهداة من قبل الله إلى خلق الله، ولكنه مع ذلك لولاه لم تُخلق الدنيا من العدم، لولا محمد في البعد الروحي لا البعد الزمني ما خُلقت الدنيا من العدم. وجوده الروحي أسبق من وجود جميع الأنبياء، ومددُ الأنبياء وعلومهم ومعارفهم من مدد نوره السابق.
ولمّا أن ولد صلوات الله عليه في الفترة الزمنية التي وجدت في زمانها ومكانها، تمثل النور فيه كاملاً فظهرت حقيقته النوريّة الباطنة في مظهره الكامل، ولكنها مع ذلك لم تكن لتظهر فيه ولا في غيره من إخوانه الأنبياء إلّا لإظهار الحقائق الإلهيّة. ومع أنه السابق للخلق نوره إلا أن الأنبياء أسبق منه في الوجود الزمني، ولم يسبقوه في الوجود الروحي، غير أنه خاتمهم.
خاتم هذا الموكب الخالد، موكب النور الذي تقدّمه وختمه في نفس الحال.
لقد سمّاه القرآن الكريم داعياً إلى الله بإذنه، وسمّاه سراجاً منيراً، فالدّعوة إلى الله على الإذن خاصّةُ محمد رسول الله كما كانت خاصّة الأنبياء جميعاً من قبله، فهو يدعو إلى الله بالإذن المخصوص بالرسالة، فهو رسول مبلغ للرسالة، مأذونٌ بالدعوة إلى الله على بصيرة لا بل على وحي الشريعة والتنزيل.
هذا بعدٌ زمني محدود بزمان ومكان، المساحة فيه مع كمالها محصورة في تاريخ المولد والنشأة والدعوة ثم الانتقال إلى الرفيق الأعلى، لكنه في نفس الوقت رحمة للعالمين، تتجاوز حدود الزمان والمكان والمدّة الزمنية التي عاشها في حياته الشريفة المباركة بمدد لا ينقطع ولا يزول، هو مدد الحمد، ومدد النور المحمّديّ : أوليّته وقدمه.
ومن أجل هذا، سمّاه سراجاً منيراً، سراجاً منيراً للكون من الأزل إلى الأبد. الإنارة سرمديّة لا تتوقف على فترة زمنية محدّدة بزمانها ومكانها، فإذا السّراج المنير هذا لا ينصرف إلى البعد الزمني وحده بل يتعدّاه إلى البعد الروحي الذي لا ينقطع بانقطاع فترة النبوّة، فهو الذي منه يشع النور ليملأ الأرض والسّماء كما يملأ القلوب والأرواح والأسرار واللطائف والأذواق، ومنه تكون الهداية يتوخّاها الصُّلحاء، وفي التعلق به يكون الهُدى والكمال والرفعة كما تكون علوم الأولياء.
لم يكن عُرفاء الإسلام بالذين يستقون من مشكاة الأنوار نوراً غير نور النبوة؛ ليمدُّهم بمدد موصول لم يكن لينقطع ولا ليزول في حين انقطعت النبوة بوفاته على التحقيق، وبقى منها الميراث وهو الأبقى والأدوم، يدور في فلك إظهار الحقائق الإلهيّة حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ولم يكن ميراث النبوة سوى هذا المدد الدائم من فيض فضل نوره عليه السلام، سواء كان علماً أو خُلقاً أو نوراً أو ولاية وتحقيقاً.
وسمّاه القرآن الكريم الإمام المبين؛ إذ أحصى كل شيء فيه، (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين). ولم يكن المجيئ سابقاً في الترتيب على المعجزة إلا بفضلٍ تقدّمه سبق النور (قد جاءُكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين) فالنور أسبق في الترتيب من المعجزة التي هى الكتاب المُبين، إذا كان النور التام الكامل هو محمد رسول الله.
وسمّاه القرآن الرحمة المُهداة وأهداها منه ومن خلاله للعالمين: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خيرٌ ممّا يجمعون)؛ ففضل الله هو القرآن، ورحمته هى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه.
وعلى هذا البعد الروحي جاز للذين عرفوه أن يصلّوا عليه بمطلق الأمر الإلهي، وبمطلق استمراريته في قوله "يصلون": الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرارية، بمثل هذه الصيغة: (اللّهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتيٍ والسرُّ السّاري سرُّه في سائر الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم). وفي الصلاة عليه اتصال باليقين الذي لا شك فيه. فلا يتصل متصل إلا من طريق الصلاة عليه، ولا ينقطع منقطع وفي قلبه محبته وموالاته على تحقق المنهج وموافقة الاتباع.
تحتاج الحفاوة بسيّدنا النبيّ إلى لطيفة ربّانية ملآنة بالمحبّة له تتحقق فيها ظلال الحمد على الدوام الذي لا ينقطع. والمحبّة اتّباع : (قُل إنْ كنتم تحبُّون الله فاتّبعوني يُحببكم الله). ولا يجب في كل ما كان محبوباً أن يكون محبوباً لشيء آخر وإلا لدار أو تسلسل، بل لا بدّ أن ينتهي إلى ما يكون محبوباً لذاته. وعليه؛ فالاستقراءُ يدلُّ على أن معرفة الكامل من حيث هو كامل يوجبُ محبّته. ومحبته تقتضي الحمد على نعمة وجوده وإمداده، صلوات الله وسلامه عليه.
***
بقلم : د. مجدي إبراهيم