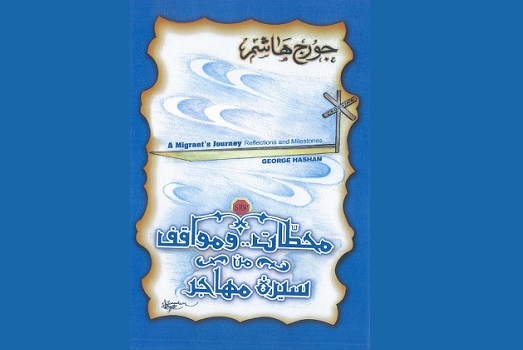قضايا
عبد الله الفيفي: القراءة وكهوف الأساطير!

(قراءة في بِنية العقليَّة الاتِّباعيَّة)
ناقشنا مع (ذي القُروح) ما أثاره بعض المحدثين ممَّا يزعمه تناقضًا في آيتين متجاورتَي الورود من (سُورة النساء: الآية 78 و79)، وهما: «أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ المَوْتُ، وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، يَقُولُوا: هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّـهِ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، يَقُولُوا: هَذِهِ مِنْ عِندِكَ! قُلْ: كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّـهِ! فَمَا لِهَؤُلَاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا؟! مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ، فَمِنَ اللَّـهِ، وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ، فَمِنْ نَفْسِكَ. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَكَفَى بِاللَّـهِ شَهِيدًا.» وتساؤله: ألم يَقُل كلٌّ من عندالله؟! فكيف يعود للقول: « وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، فَمِنْ نَفْسِكَ»؟ وقول ذي القروح: إنَّك لن تجد أبلغ من الإجابة عن هذا التساؤل بالسؤال القرآني نفسه: «فَمَا لِهَؤُلَاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا؟!» ذلك أنَّ الآية الأُولى تشير إلى الإرادة الإلاهية المطلَقة في كلِّ شيء، من حَسَنٍ وسَيِّء، والثانية إلى السبب البَشَريِّ المباشر، حسب السُنَن في عالم الكون والفساد. ولا تناقض بين الأمرَين. ذلك أنَّ الإنسان، عادةً، يعرِّض نفسه وغيره للبلايا والمصائب، ثمَّ يجأر بالشكوى إلى الله. وهذا معنى الآية: «فَمَا لِهَؤُلَاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا؟! مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ، فَمِنَ اللَّـهِ، وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ، فَمِنْ نَفْسِكَ.» كما جاءت الآية في معالجةٍ للتطيُّر عند العَرَب، وما كانوا ينسبونه ممَّا يصيبهم إلى النَّحس، أو الجنِّ، أو الشياطين، أو حتى إلى الرسول نفسه. وهي عادة لدَى الشعوب البدائيَّة عمومًا، تنهض على ما يُسمَّى (المغالطة البَعديَّة، أو السبب المتوهَّم). قلتُ:
ـ ومن جانبٍ آخر، تُشير إلى ما كانوا ينسبونه من هزيمةٍ إلى سوء تدبير الرسول.
ـ نعم. أمَّا إنْ كان ظَفَرٌ، فكانوا يُنكرون حُسن التدبير على الرسول، وينسبون ذلك إلى الله وحده! فأخبرَ أنَّ النصر والخُسران معقودان في نهاية الأمر بإرادة الله، التي كأنَّما هم لم يراوغوا لإسقاطها إلَّا لغرضٍ، وهو تجريد الرسول من الفضل، ورميه في المقابل بالتسبُّب في ما يقع لهم من سوء. فأخبرَ أنَّ المتحكِّم في ذلك جميعًا هو الله. ثم أردف تفصيلًا: بأنَّ ما يصيب المرءَ من سيِّئةٍ فبسبب أعماله هو، من عقابٍ على ذنبٍ أو تقصير في عمل. ولذلك جاء الخطاب في الآية الأُولى للجمع، ثمَّ جاء، في الآية الأخرى، للحديث عن العمل الفردي، فنبَّه إلى مسؤولية الفرد في ما يقع له. وما كان ليقول: «ما أصاب من سيئة فمن الله» هنا؛ فالله لا يصيب بالسيِّئات، وإنما تقع بذنب، أو لتقصير، كما في الآية من (سُورة الشُّورى): «وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ». أمَّا الإحسان، فما كان ليقول: «ما أصاب من حسنة فمن نفسك»، فالإحسان كلُّه من عند الله، إنعامًا أو توفيقًا.
ـ إنَّه الفارق، إذن، بين الكلام عن الحاكميَّة والكلام عن السببيَّة.
ـ صحيح. فالحاكميَّة المطلقة لله، وكلُّ شيءٍ من الله، ولا يجري إلَّا بإذنه، أمَّا السببيَّة، فلها قانونٌ كونيٌّ وسُنن، لا تخطئ: من اجتهدَ نجح، ومن أهمل فإلى حيث ألقت.
ـ فأيُّ تناقض؟
ـ إنما القائل بهذا يضاهئ حمقَى الملحدين، الذي يزعمون التناقض في الآيات: «هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، قَالَ: رَبِّ، هَبْ لِي مِنْ لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. فَنَادَتْهُ المَلَائِكَةُ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي المِحْرَابِ: أَنَّ اللَّـهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى، مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّـهِ، وَسَيِّدًا، وَحَصُورًا، وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ: رَبِّ، أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ، وَقَدْ بَلَغَنِيَ الكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ؟! قَالَ: كَذَلِكَ اللَّـهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.» فيقول الملحد: كيف يَستغرب (زكريَّا) الإجابة، وهو الذي دعا، وقال: «إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ»؟ وواضح أن هذا القائل لا يقرأ.
ـ كيف؟
ـ بمعنى: لا يفهم ما يقرأ. لأنَّ أيَّ عامِّيٍّ يفهم أنَّ (زكريَّا) لم يقل في الدُّعاء: رَبِّ، هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، مِنِّي، أنا الطاعن في السِّن، ومن امرأتي العجوز العاقر (أليصابات)! فالذُّرِّيَّة ليست بالضرورة من أبناء الصُّلب، فأبناء الأخ والأخت يُعَدُّون من الذُّرِّيَّة، فضلًا عن الأحفاد والأسباط. بل أبناء العمِّ، وأبناؤهم من الذُّرِّيَّة. فالمعنى يشمل غير الأبناء، من الأقرباء، وبخاصَّة الورثة منهم. فتلكم «ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ.» إنَّ الذُّرِّيَّة في اللُّغة لها معانٍ كثيرة، لكنَّ أولئك لا يتعاملون مع العَرَبيَّة التي نزل بها «القرآن»، بل مع عامِّيَّاتهم المعاصرة، وبعض شذرات مدرسيَّة مختلطة من العَرَبيَّة في رؤوسهم. ومن معاني الذُّرِّيَّة في اللُّغة: النِّساءُ، والأطفال. جاء في الحديث: أنَّ الرسول رأى امرأةً مقتولة، فقال: «ما كانت هذه تُقاتل! الحَقْ (خالدًا)، فقل له: لا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، ولا عَسيفًا!» بل الذُّرِّيَّةُ: الآباء والأجداد، كما في الآية: «وآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الفُلْكِ المَشْحُون». وبذا فهؤلاء النَّقَدَة الأدعياء لا يقارِنون المفردات حتى في «القرآن» نفسه. والذُّرِّيَّةُ: الطائفة من الناس، قال: «فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْن.»
ـ هذا، كما قلتَ، يدل على أنَّ هؤلاء لا يقرؤون حتى «القرآن»، الذي ينتقدونه، ليقارنوا بين نصوصه، كي يفهموا دلالات الألفاظ.
ـ ثمَّ يتبجَّحون، وكأنَّهم قد اكتشفوا اكتشافاتٍ خطيرة. لكن لنسلِّم أنَّ المقصود بالذُّرِّيَّة الأولاد من المرء نفسه. لقد كان تعجُّب (زكريَّا) لدهشته من سرعة الإجابة، كما تعجَّبت (مريم)، وكما تعجَّب (إبراهيم)، حتى قال: «رَبِّ، أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى؟!» والمرء، من فرط فرحه، قد يقع في مثل هذا الاختلاط، وعدم التصديق. ولعلَّ زكريَّا أيضًا إنَّما كان يدعو الله أن يهيِّئ حاله وحال امرأته أوَّلًا للذُّرِّيَّة؛ لأنه قد بلغ من الكِبَر عِتِيًّا، وامرأته كذلك، وفوق ذلك هي عاقر. ولذا لم يقل «هَبْ لِي ذُرِّيَّةً»، بل «هَبْ لِي [مِنْ لَدُنْكَ] ذُرِّيَّةً.» فهو مؤمن بقُدرة الله، غير أنَّه بقي محلُّ التساؤل لديه والتعجُّب: كيف تكون الذُّرِّيَّة منه، وقد بلغ من الكِبَر عِتِيًّا، ومن امرأته وهي عاقر. فلمَّا جاءت البِشارة بيحيى، أو (يوحنَّا المعمدان)، تعجَّب من البِشارة بالولد مع عدم تغيُّر الظروف، فتساءل: «أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ، وَقَدْ بَلَغَنِيَ الكِبَرُ، وَامْرَأَتِي عَاقِر؟!» بدليل أنه قال: «رَبِّ، اجعلْ لي آية.» فهو متعجِّب ممَّا يسمع. هذا كل ما في الأمر.
ـ وهو موقفٌ واقعيٌّ وإنساني، ويمكن أن يشاهده هؤلاء في أي حادثةٍ واقعيَّةٍ أو سرديَّةٍ أو حتى سينمائيَّة، ولا تَنقاض في الموضوع، لولا المماحكات والتمحُّل.
ـ واحتمالٌ آخَر وارد. وهو أنَّ الدُّعاء لم يكن في الوقت نفسه الذي أُجيب فيه. وإنَّما نادته الملائكة، وهو قائمٌ في المحراب، في وقت لاحق.
ـ الأمر هكذا أبسط حتى من افتراض بعض المفسرين، كـ(الطبري)، أن (زكريَّا) تشكَّك هل الصوت هو صوت الملائكة، أم صوت الشيطان؟
ـ وما أدراهم بحدوث ذلك التشكُّك؟! وكيف هذا اللجوء الجاهلي، إزاء كل جهل، إلى تعليقه بالجِنِّ والشياطين لحلِّ الألغاز؟
ـ ما أكثر ما يهرف المفسِّرون- من أكياسهم أو من إسرائيليَّات «العهد القديم» و«التلمود»- بمثل هذه الخزعبلات الخياليَّة، التي ما أنزل الله بها من سُلطان! وكأنَّهم مفسرو رؤى مناميَّة لا مفسرو نصوص!
ـ لا تنس أنَّ هؤلاء، وإن لُقِّبوا بالعلماء، كان مفهوم العالم في عصرهم إنَّما يعني: الحافظ والراوية. الحافظ هو العالم، وإنْ لم يكن يعقل ما يحفظ، ولا ينقد ما يروي. وتراثنا العَرَبيُّ مليء كلُّه بحطب اللَّيل هذا، الذي كانت تُملَأ به الرؤوس ثمَّ يُفْرَغ على الطُّروس.
ـ وكلَّما كان الحطب أثقل حظي حامله بوصف العلَّامة النحرير!
ـ إنَّ موقف (زكريَّا)، إذن، لدَى تبشيره بـ(يوحنا المعمدان/ يحيى) هو موقفٌ إنسانيٌّ طبيعي، و«القرآن» يقصُّ ما وقع بصورة واقعيَّة. فإنْ كان من تناقُض، ففي موقف زكريَّا نفسه، بوصفه إنسانًا، عوامله النفسيَّة والذهنيَّة قد تجعله يقع في مثل هذا، وليس تناقُضًا في النَّص، إلَّا في عقلٍ يتصنَّع مثل هذا، وعلى نحوٍ طريف، حقًّا. ولقد كان ينتحل أنماطًا من هذا النقد بعض المُجَّان قديمًا، للفرتخة والتفكُّه وإظهار الحذق الظاهري المجَّاني. ولو أُجري هذا النهج على أيِّ خطاب، لأمكن أن يبدي المرء عبر هذه اللُّعبة ما يبدو تناقُضًا، ولا سيما مع إبراز الناقد بعض العبارات من النصوص ودسِّ بعض.
ـ وكذا هم يشغبون بوجهٍ قرائيٍّ أحيانًا على إمكانيَّات قرائيَّة يحتملها النصُّ.
ـ مثل ماذا؟
ـ مثل الآية: «حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. قُلْنَا: يَا ذَا القَرْنَيْنِ، إِمَّا أَن تُعَذِّبَ، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا.» (سُورة الكهف، الآية ٨٦). قائلين: كيف وجد الشمس؟ وكيف تغيب الشمس في عَين؟ وكيف وجد عندها قومًا؟
ـ لاحظ هنا أنهم يحصرون دلالات الألفاظ والتراكيب في ما يريدون. وهذه المحاكمات لما ورد في «سُورة الكهف» يذكِّرنا- للمفارقة أو للموافقة- بما وردَ في «صُورة الكهف»، لدَى (أفلاطون)، في الكتاب السابع من «الجمهوريَّة الفاضلة»، الذي ضربه مثلًا في أنَّ الإنسان يظلُّ في سُبات الغفلة، عُدُوًّا لما يجهل، وما يجهل أكثر ممَّا يعلم، بل لعلَّ ما يراه حقائق ويظنُّه كذلك لا يعدو خيالات وأوهامًا. بما في ذلك ذهن أفلاطون نفسه، الذي كان ما يزال غارقًا في كهف الأساطير القديمة؛ حتى إنَّه- على جلال قَدره العقلي والفلسفي- لم يكن قد تخطَّى عقليَّة الجاهليَّة، كما عهدناها عند العَرَب أيضًا، المعتقدة في ألوهيَّة الشمس، عبر رمزها (اللَّات)؛ لما لحظوه من دَورها العظيم في الحياة. لكنَّ هذا مهيعٌ يطول، فليكن مساقنا المقبل، بحول الله.
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي