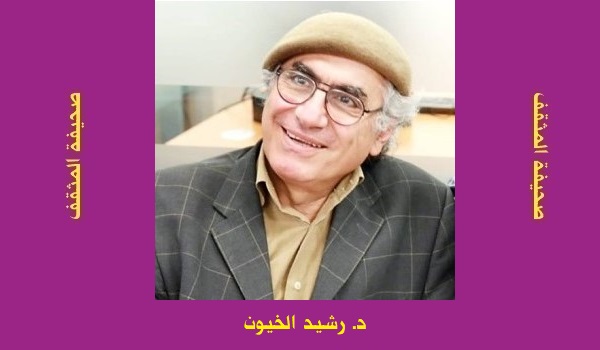قضايا
عبد الله الفيفي: المغالطة البَعديَّة.. السبب المتوهَّم!

(قراءة في بِنية العقليَّة الاتِّباعيَّة)
قلتُ لـ(ذي القُروح)، في معرض استطلاعي رأيه حول ما يثيره أحد المتفيهقين المعاصرين:
ـ يعود (القبانجي) إلى القول، في بيان ما يزعمه تناقضًا في آيتين متجاورتين في ورودهما من (سُورة النساء: الآية 78 و79)، وهما: «أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ المَوْتُ، وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، يَقُولُوا: هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّـهِ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، يَقُولُوا: هَذِهِ مِنْ عِندِكَ! قُلْ: كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّـهِ! فَمَا لِهَؤُلَاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا؟! مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ، فَمِنَ اللَّـهِ، وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ، فَمِنْ نَفْسِكَ. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَكَفَى بِاللَّـهِ شَهِيدًا.» فيقول لك: ألم يَقُل كلٌّ من عندالله، أي الخير والشَّر؟! هكذا- وهو ينسب الشَّر إلى الله؛ لأنَّ مفهومه للشَّر عجيب؛ فالعقاب على الذَّنْب شَرٌّ عنده، ووَصْف الله نفسَه بالعِزَّة والكبرياء شَرٌّ، وهلمَّ جرًّا!- قال: فكيف يعود للقول: « وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، فَمِنْ نَفْسِكَ»؟
ـ الحقُّ أنَّك لن تجد أبلغ من الإجابة عن سؤاله هذا بالسؤال القرآني نفسه، الوارد في الآية- المنطبق عليه وعلى أمثاله-: «فَمَا لِهَؤُلَاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا؟!» ذلك أنَّ الآية الأُولى تشير إلى الإرادة الإلاهية المطلَقة في كلِّ شيء، من حَسَنٍ وسَيِّء، والثانية إلى السبب البَشَريِّ المباشر، حسب السُنَن في عالم الكون والفساد. ولا تناقُض بين الأمرَين، إلَّا في ذهنٍ بَليدٍ مضطرب.
ـ واستطرادًا، فإنَّ مأساة الإنسان، مؤمنًا وكافرًا، تتمثَّل في أنه غالبًا لا يتحمَّل مسؤوليَّته، ولا يسلِّم بسُنن الكون.
ـ صحيح. ونضرب على ذلك مثالًا من حادث ذلك الطفل المغربي (ريَّان)، الذي وقع في بئرٍ سحيقةٍ في قرية (شفشاون)، في 1 يناير 2022، وبقي في البئر إلى ليلة السبت 5 يناير، في حادثٍ شهده العالم أجمع، وتفاعل معه، وكأنَّما جاء ليكون شاهدًا على طبيعة الإنسان وعقليَّته المريضة.
ـ كيف؟
ـ ما حدث لم يكن حَدَثًا عَرَضيًّا، بل هو آية، بل آيات، على أمور. أوَّلها أنَّ الإنسان لا يتحمَّل مسؤوليَّته في الحياة، بل ستراه يحفر بئرًا، مثلًا، ويتركها هكذا مصيدةً لمخلوقات الله، ولا يشعر بجريمته. والإنسان، أبًا أو أُمًّا، لا يتحمَّل مسؤوليَّته، حتى في رعاية أطفاله، وحمايتهم، بل لعلَّه هو مَن يُعِدُّ لهم مثل تلك البئر بنفسه، ولا يشعر بجريمته.
ـ والمفارقة الملحوظة هنا أنَّ أواصر القرابة في المجتمعات التي ننعتها بالبدائيَّة، والشعور بالمسؤوليَّة فيها، أمران يبدوان أشدَّ من نظائرهما في ما ننعته بالمجتمعات الحضريَّة!
ـ بكثير. ولذا نادرًا ما تناهَى إلى ذاكرتنا عن العصور القديمة شيءٌ من أشباه الحوادث التي تقع في عصرنا، على الرغم من ضعف الإمكانيَّات قديمًا قياسًا إلى عصرنا. وشِعرنا القديم شاهدٌ على أواصر العلاقات بين الناس وإعلاء شأنها. خذ مثالًا من قول الشاعر الجاهلي (طَرَفَة بن العَبْد، -562م)(1):
فَفِــداءٌ لِـبَـنِــيْ قَيْــسٍ عَلَـى
ما أَصابَ النَّاسَ مِنْ سُرٍّ وضُرْ
*
خـالَتِي والنَّفْـسُ قِـدْمًـا إنَّهُـمْ
نِعِمَ السـَّاعُونَ في القَوْمِ الشُّطُرْ
أو قول معاصره (عمرو بن قميئة، -540م)(2):
[أ] إِنْ أَكُ قَدْ أَقْصَرْتُ عَنْ طُولِ رِحْلَةٍ
فـيا رُبَّ أَصـْحابٍ بَعَثْــتُ كِــرامِ
*
فَقُلْـتُ لهُمْ: سِـيرُوا فِدًى خالَـتِي لَكُمْ
أمــا تَجِــدُونَ الرِّيْــحَ ذاتَ سَـهامِ
فما علاقة (الخالة) لتُذكَر في مثل هذا السياق؟
ـ وكيف يستقيم هذا مع الصورة النَّمَطيَّة عن موقف العَرَبيِّ القديم من المرأة عمومًا؟
ـ إذا كان من المألوف التَّفدية بالأب والأم ، تعظيمًا لمكانتهما من الإنسان، فإنَّ المرء يستغرب هنا تفدية هذين الشاعرَين الآخَرين بـ«الخالة»!
ـ وإنْ كان التعبير الشَّعبي ما زال يقول: إنَّ: «الخال والد». لكن ماذا أردتَ أن تقول، يا (ذا القُروح)؟
ـ ليس التعبير الشَّعبي وحده الذي يقول: إنَّ «الخال والد»، بل هذا قول عَرَبي قديم؛ وقد ورد أن (الأسود بن وهب بن عبد مناف بن زهرة)، استأذن على (الرسول، صلى الله عليه وسلم)، فلمَّا دخل عليه، بسطَ له رداءه، وقال: «اجلس عليه؛ إنَّ الخال والد.«(3) وإنَّما أردتُ أن أقول: إنَّ هذا نموذجٌ على ما كان يربط الإنسان من أواصر قويَّة بأفراد عائلته، وإعظام لعلاقته بهم، بل بأفراد عشيرته وقبيلته؛ حتى إنَّه ليصل به الحال إلى ذوبان شخصيَّته الفرديَّة في أهله وجماعته وقبيلته.
ـ يا حبيبي، تريد أن تعود بنا إلى القَبَليَّة، وإلغاء الحُريَّة الفرديَّة، وإلى عقليَّة «إنَّا وجدنا آباءنا...»؟! وتلك العقليَّة هي أساس البِنية العقليَّة الاتِّباعيَّة في الثقافة العربيَّة! ألا ترى أنَّك هنا قد أخذت تناقض خطابك التنويري؟
ـ النظر إلى الأمور بمعيار (أبيض وأسود) عمًى مطلق! لكلِّ وجهٍ محاسنة ومقابحه. وإذا كانت للماضي سلبيَّاته، فإنَّ له إيجابيَّاته، ممَّا تقطَّعت عُراها في العصور المتأخِّرة في شرقنا العَرَبي، سَيرًا على أعقاب المجتمعات الغربيَّة.
ـ خرجتَ بنا عن الموضوع، كعادتك!
ـ الخارج مولود والداخل مفقود! حتى في هذا كثيرًا ما نقع في المغالطات، حين نتذرَّع بالموضوع، وداخل الموضوع، وخارج الموضوع.. إلخ. ولكي أربط لك ما تراه خارج الموضوع بمسألة صاحبك (هبنَّقة)، المعمَّم بالسَّواد، أقول: إنَّ الإنسان، منذ أن ينشأ طفلًا، وهو يعرِّض نفسه وغيره للبلايا والمصائب، ولا يشعر بجرائره. بل ستجد كلَّ هؤلاء يبكون أخيرًا، وينتحبون، ويجأرون إلى الله، إذا وقع ما أَوْكَتْه أيديهم وما نفخته أفواههم! وهذا معنى الآية: «فَمَا لِهَؤُلَاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا؟! مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ، فَمِنَ اللَّـهِ، وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ، فَمِنْ نَفْسِكَ.»
ـ أمَّا أحسننا طريقة، في ظاهرنا الثقافي الإيماني، فستسمعه يُلقي بتبعة ما أَوْكَتا يداه وما نَفَخَ فوه على مشجب القضاء والقَدَر.
ـ لماذا؟ لكي يحمِّل الله سبحانه مسؤوليَّة حماقاته الإنسانيَّة، ثمَّ يدعوه ليجعل له منها مخرجًا! أمَّا هو، فحاشاه، فهو حَمَلٌ بريء! لم يرتكب خطأً، ولا إثمًا، في حقِّ نفسه، وحقِّ غيره!
ـ قلتَ: إنَّ في ما حدث للطفل (ريَّان المغربي) آيات. وقد عرَّفتنا أُولاها، ماذا عن سائرها؟
ـ ثاني الآيات، التي تتجلَّى من مثل ذلك الحادث، أن الجميع لا يكادون يؤمنون بالله إلَّا وهم مشركون!
ـ يا لطيف! إيَّاك والتكفير!
ـ هذا الواقع، شئتَ أم أبيتَ! وإنْ تظاهر الناس بعكسه. فهُم، في الواقع، يؤمنون أشدَّ الإيمان بالحياة الدُّنيا، ويعبدونها عبادة مطلقة. «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، ...، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ». فأولئك المتظاهرون بالإيمان كانوا، خلال تلك الحادثة، يضجُّون بالدعاء، والنحيب، ويصيحون بجنون، ابتهالًا من أجل حياة (ريَّان)، موقنين بأنَّ الله لن يخيِّب دعواتهم ودموعهم وصراخهم، وكأنهم بضوضائهم كانوا يدعون أصمَّ، أو غائبًا، أو غافلًا، أو طاغيةً، يستمتع لإظهارهم كل ذلك التذلُّل، والإقبال- لا عليه، بل على الحياة من خلال التوسُّل به- فما انفكُّوا يَرْجُون أن يُستجاب دعاؤهم، وأن تَحُلَّ المعجزة بهم، وتنخرق قوانين الطبيعة، أمام مسرحيتهم الهزليَّة تلك! وما ذاك إلَّا اعتقادًا منهم بأن الحياة الدنيا هي غاية الغايات، وأقصى ما يتمنَّاه الإنسان. والغريب أنهم ما يفتؤون يحدِّثونك عن الآخِرة ونعيمها، وعن الشهادة، وعن جِوار الله، وبأنَّ الدُّنيا ظِلٌّ زائل...، ولو كانوا يؤمنون حقًّا بما يقولون، لما أصابتهم تلك «الهستيريا» التي أصابتهم، طلبًا للحياة، ثم أصابهم مثلُها جَزَعًا من مغادرتها. وعودًا إلى الآية الأُولى «وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، يَقُولُوا: هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّـهِ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، يَقُولُوا: هَذِهِ مِنْ عِندِكَ!»- حتى لا يُجَنَّ جنونُك لاستطراداتي الجاحظيَّة- فإنَّها قد جاءت في معالجةٍ خاصَّةٍ لقضية التطيُّر عند العَرَب، وما كانوا ينسبونه ممَّا يصيبهم إلى النَّحس، أو الجنِّ، أو الشياطين، أو حتى إلى الرسول نفسه. وهي عادة لدَى الشعوب البدائيَّة عمومًا، تنهض على ما يُسمَّى (المغالطة البَعديَّة، أو السبب المتوهَّم). بمعنى: الربط التعليلي بين حدثَين لا رابط سببيًّا بينهما، سِوَى أنَّ ما تُنسَب إليه العِلِّيَّة جاء أوَّلًا. يُروَى من ذلك، مثلًا، ما حدث في إحدى قرى (جنوب أفريقيا) من أنَّ بعض البِيض أهدى رجلًا من (البوشمن) عصًا مرصَّعة، كرمزٍ للسيادة، لكن- لمساوئ الصُّدَف- سرعان ما تُوفي الرجُل، وورَّث العصا ابنَه، فسرعان ما توفي هو الآخَر! فأعاد البوشمن العصا المشؤومة إلى مهديها، خشية أن يموت البوشمن جميعًا! ومن ذلك كذلك ما يُروَى من أن مرض الجدري انتشر بين شعب (الياكات)، وصادف أنْ كان ذلك بعد أن شاهدوا جَمَلًا لأوَّل مرَّة؛ فوَقَر في نفوسهم أنَّ الجَمَل الملعون هو السبب في حدوث المرض!(4) ولله في خلقه شؤون! وقد كان العَرَب في الجاهليَّة، وربما ما زال كثيرٌ منهم، كأولئك المتطيِّرين الأفارقة، أو أشدَّ منهم استطارةً في التطيُّر.
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي
.......................
(1) (1900)، ديوان طَرَفَة بن العَبْد البكري، شرح: يوسف الأعلم الشَّنْتَمَري، عناية: مكس سلغسون، (شالَوْن- فرنسا: مطبعة برطرند)، 66/ 68- 69.
(2) (1965)، ديوان عمرو بن قميئة، تحقيق وشرح: حسن كامل الصَّيرفي، (القاهرة: معهد المخطوطات العَرَبيَّة- جامعة الدول العَرَبيَّة)، 39، 41/ 1-2. وقد وقع في البيت الأوَّل (خَرْم)، لم يُشِر إليه المحقِّق: «إنْ أكُ قد...». وكثيرًا ما يُنسَب هذا إلى الشاعر، وربما وقع عن خطأ الرواي، أو الناسخ. وصوابه: «أإنْ أكُ»، أو «وإنْ أكُ».
(3) يُنظَر: الحلبي، علي بن برهان الدِّين، (2013)، السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)، عناية: عبدالله محمَّد الخليلي، (بيروت: دار الكتب العلميَّة)، 2: 313.
(4) يُنظَر: مصطفى، عادل، (2019)، المغالطات المنطقيَّة: فصول في المنطق غير الصُّوري، (القاهرة: رؤية)، 177.