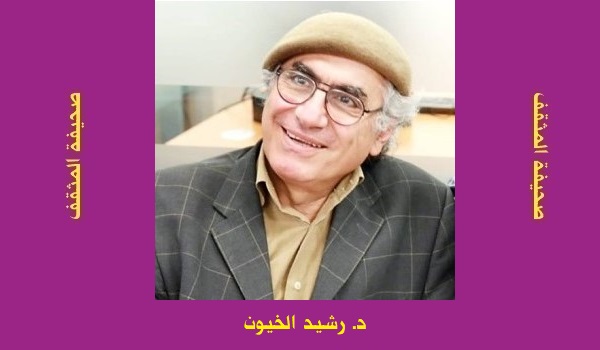قضايا
مراد غريبي: المثقف العربي والسلم الثقافي كأفق تجديدي

مفتتح: قرأت مقالة (مؤسسة تكوين وضجيج مؤتمر التأسيس) للصديق الأستاذ بدر العبري من سلطنة المحبة والتسامح والحوار والتعارف والابداع الثقافي حول الضجيج الذي انتشر في ربوع أرض الكنانة مصر الحبيبة بخصوص المؤتمر التأسيسي لمؤسسة تكوين، للأسف مصر عاصمة الفكر والثقافة والتأليف والطباعة، التي قرأنا وسمعنا عنها أيام الدكتور طه حسين والأديب العالمي نجيب محفوظ والدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور حسن حنفي والدكتور عبد الفتاح إمام وغيرهم كثر، هذه البلاد التي لا تكف عن ميلاد العباقرة والعلماء والمفكرين الأحرار والمجددين والمصلحين المميزين في التفكير الديني وغيره، للأسف غابت عنها تقاليد الحوار وإحترام الرأي الآخر والفكر الآخر وما هنالك من صور التمدن الذي راح ضحيته عمالقة في الفكر والثقافة والدين، ليس مصر العربية وحدها التي أصبح الفكر الحر فيها غير محترم رغم الاختلاف مع بعض تفاصيله، إنه العالم العربي برمته كذلك حيث اكتسح التلوث الفكري – كما يعبر المفكر الراحل حسن التل- كل أركان التفكير العربي الحديث والمعاصر، فلا غرابة في هكذا ضجة مفتعلة – كما يعبر المفكر الفلسطيني الشهيد فتحي الشقاقي- لأن ضرورات دوام التلوث والضمور والتطرف ووالتسقيط تستدعي مثل هذه السيناريوهات عبر الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العامة وكأن القيامة قامت، لا لشيء سوى لأن الحرية الفكرية والحوار العلمي والتعارف الثقافي مهددات لواقع التفاهة والرداءة المستشري من طنجة إلى مسقط ..
الراهن الثقافي العربي:
هذه اللحظة الثقافية المشوهة من المشهد الثقافي الأصيل هي محل إشكال ليس مصري فقط بل عربي أيضا وبإمتياز: لماذا هذا التشظي في تركيبة الذهنية العربية المعاصرة ؟ ومتى تنتهي الخصومة في الثقافة العربية برسالة تسامح ضد التخلف والرجعية والحاكمية الثقافية المطلقة بلا شرعية ولا أدنى مسوغ منطقي؟
بكل بساطة إن من يفكر بحرية في جغرافية مأسورة للتطرف الطائفي وو الإثني والجهوي والحزبي لا يمكنه أن يرفع رأسه، لأنه بالأساس فوق ميول مجتمع ملوث فكريا وبيئيا والمنحرف أخلاقيا، هنا بالتحديد تبرز وظيفة المثقف الحر النزيه المخلص الكوني – بتعبير صديقي الدكتور سامي عبد العال-[1] على طول المحاور الثقافية في العالم العربي، لأن المثقف الكوني ( هناك مفهوم أراه مماثل المثقف الرسالي عند الأستاذ ماجد الغرباوي[2]) يحمل غاية واحدة هي بعث الوعي بالكرامة للجميع لذلك كان يمازح الدكتور علي الوردي -و هو القامة العراقية العربية التي عاشت وماتت دون أن تنتبه لها المجتمعات إلا بعد عشر سنوات من رحيلها - لا تتحدثوا علانية عن ابن خلدون لأن اسمه فقط مستفز للرداءة والتلوث وما هنالك...
هناك حاجة ماسة للوقوف والمعاينة والتمحيص بكل قوة وحزم وصلاية على ردود الفعل – المسماة ثقافية- وهي واقعا إفرازات لقيم اجتماعية وأخلاقية لا حضارية، هناك أعطاب أخلاقية وإنحرافات إجتماعية تمكنت من ترسيخ "البلطجة" كثقافة تهدد كل فكرة حرة تطرح للنقاش أو للحوار أو للمداولة بين من هم أهل لذلك، مما ضيق الخيارات على الأحرار في الفكر والثقافة والدين والجامعات رغم رحابة بلادنا العربية وغنى مخزونها الثقافي الخلاق للوعي والنباهة والابداع، أليست القاهرة وبغداد ودمشق وبيروت والجزائر العاصمة وطنجة وتونس والكويت كانت مدن حافلة بالانتعاش الثقافي في سبعينيات القرن الماضي ومسقط مع نهايات القرن الفائت، كلها كانت مقاصد المثقفين العرب بكل مشاربهم وتوجهاتهم، لقد كانت تحتوي كل التنوعات لذلك انتعشت ولم تتسم بالأحادية الفكرية الخانقة لثقافة السؤال والضاغطة على رقاب الوعي، حيث أجدني هنا مضطرا للتنبيه أن كل ما يفتعل من ضجات مرجعه الأساسي هو القبلية الثقافية ( قيم العشيرة الناتجة عن الاستبداد الديني والسياسي كما يعبر عن ذلك المفكر الغرباوي[3]) حيث يعبر بالقول: الفرد الغربي يعتز أيضا بإنتمائه لعشيرته وبيته، لكن الفارق أن قيم العشيرة لا تفرض سلطتها عليه، ولا تنافس القانون في ولائه، فهو منحاز دائما للقانون وسلطته، وعليه ينبغي لنا من أجل نهوض حضاري ناجح تحرير عقل الفرد من سلطة العشيرة وقيمها، حينما تتعارض مع القيم الإنسانية أو تتقاطع مع القانون. فيكون ولاء الفرد أولاً للقانون، وليس العكس كما في المجتمعات المتخلفة . بل يجب التحرر من سلطة كل نظام أبوي، في البيت والمدرسة والعمل والسلطة[4]. ولعل هناك سبب آخر يوافق ما سبق ذكره، ساهم في صناعة التلوث الثقافي في المجتمعات المهزومة أو الضعيفة وهو الانشداد إلى الماضي والجمود الفكري وتقديس غير المقدس، وهذه حالة شعورية تسيطر على المهزوم وتجعله – هاربا من تحديات الواقع وإخفاقات الوعي المتحكمة فيه- فيلوذ بالماضي ويقدسه بغثه وسمينه بحيث يصبح لا يفرق بين المقدس وغيره وما هو دليل أصلي عما هو فرعي وتابع كما لدى الأصوليين، لذلك نلاحظ إعلاء غير عقلاني للماضي ومكوناته كلها بلا تحقيق ولا تمحيص، والأكيد أن هذه الظاهرة موجودة لدى كل المجتمعات البشرية وعاشتها في مرحلة ما، كل ما هنالك أن هناك من تجاوزتها وتحررت من قيودها وأخرى ظلت أسيرة فيها، وهنا الضحية الأولى هي الحقيقة والوعي والموضوعية، لأن الواقع الذي يتعاطى مع الأسئلة والنقاشات ومداراتها ومضامينها وآفاقها بعقلية ملوثة وجامدة في مرحلة تاريخية معينة وبخطاب تحنيطي للتخلف سيشكل – بلا أدنى شك- عائقا ومعوقا وسدا أمام حركة التجديد الثقافي والتنمية الحضارية، لأن العقل المستغرق في التلوث الطائفي وملكية الحقيقة وهالات الشرعية وما هنالك من شعارات محرفة محجوب عن بلوغ الحقيقة، هذا العقل الفرعوني البيزنطي المهووس بالأحادية الفكرية لا يتحمل حضور العقل النقدي في المشهد الثقافي..
ماذا عن مفهوم السلم الثقافي الصحيح؟
إن انحسار دور العقل النقدي في المجتمعات العربية، يعني تفسير الواقع وظواهره بتفسيرات غيبية وأسطورية أحيانا بعيدا عن منطق الأسباب والمسببات، ولعل العلة الأولى لذلك أن ذوي العقول الملوثة هم المسيطرين على الشأن الثقافي غالبا والديني تحديدا منه في الأغلب وإلا لماذا هناك توجس غير طبيعي من أي محاولة لمناقشة سبل التجديد والإصلاح ونقد التراث وما هنالك، فالمقدس معلوم ومحدد وليس هناك أية جهة لها سلطة منح القداسة لما ليس بمقدس، لكن العقل الملوث فكريا يعمل على شيطنة كل ثقافة السؤال حتى يبقى الحال على حاله ولا يتجاوز المجتمع إخفاقات الوعي لديه في تفاصيل واقعه، والمؤسف أن تلفق مفاهيم حضارية لتعمل عمل المخدر ويبقى الواقع في رداءته والمدينة تترّيف أكثر فأكثر حتى تنتفي معالم التمدن نهائيا، فمفهوم السلم الثقافي يراد له أن يتماهى ومفهوم الخمول الثقافي، لأن اللوثة الثقافية التي لا تعالج، تستشري وتسيطر فتروض المشهد الثقافي لتنطفئ مصابيح الوعي فيه وعندها تدرج مفهوم السلم في سياق معاكس كليا وتماما لمدلوله الصحيح، بينما السلم الحقيقي لا يجنح إلى العنف ويخضع للاعتدال والحوار العلمي الموضوعي، ولا يتحقق إلا في جو من الديمقراطية السليمة من الفساد والعجز الفكري ودناءة السلوك، لأن السلم الثقافي يعني فيما يعنيه الشعور بالآخر واحترامه والدفاع عن حقوقه والتعارف معه والإحساس بجمال التنوع والتعدد الذي يقوي الوحدة الجامعة والعادلة..
السلم الثقافي ومحنة المثقف:
هناك شرائح عدة من المثقفين في عالما العربي أو كما يسميهم الدكتور سامي عبد العال بأنماط المثقفين، شريحة انبهرت بالغرب لحد الذوبان فيه، وهذا ما يطلق عليه الإغتراب الثقافي بحيث يعمل هذا المثقف على إجراء قطيعة مع تكوينه الثقافي ورؤاه وقيمه الأخلاقية والاجتماعية، لكن الخطورة بالنسبة لهذه الشريحة أنها خدمية في الغالب وليست موضوعية كل همها إرضاء الآخر الغربي بمشروعها الذي يسعى لللحاق بمشروع القطيعة مع ثقافة العصر الوسيط لدى الغرب، فمشكلة الثقافة لدى هذه الشريحة قد تصل لحد الخيانة وقد تسمى اندماجا ثقافيا ولكنها في الحقيقة انسلاخ عن التكوين الثقافي واللهث وراء الثقافة الغربية بلا كرامة ولا حتى موضوعية في ذلك سوى هروب من محنة الثقافة في الوطن العربي لا هي علمانية بالمعنى العلمي ولا هي ملحدة بالمعنى اللا ديني، فقط تعاني من لوثة ثقافية أفقدتها وعي المخاض وسبل الخلاص.
بينما الشريحة المقابلة هي على العكس تماما من الشريحة الخدمية للغرب، إنها شريحة مستبدة فكريا وسلوكيا وتجنح للعنف بشكل مروع، لا تقبل نهائيا الرأي الآخر، تمتهن الابتزاز الفكري والإعلامي والثقافي الاجتماعي وتسعى للسيطرة على المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية ومحاصرة الخطاب الثقافي وتسييجه بحدود تتوافق مع مداراتها الفكرية والعقائدية والثقافية، فتعادي الغرب بكليته حتى علومه، بينما هي تستخدم تقانته تحت غطاء أنه مسخر لخدمتها ضمن معادلة القداسة التي ترسم معالمها في اللاوعي الجمعي حولها، فالسلم الثقافي لدى رواد هذه الشريحة هو ما يقبلونه ويدعون إليه غير ذلك فهو عدو وخطر ولابد من محاربته، ولا تقتصر على الدينيين فقط لأن خلفية هذه الشريحة هي العصبية القبلية والإثنية والدينية والطائفية والسياسية، يمتازون بالتثبيط الثقافي إلى درجة العنف بشتى أشكاله من أجل تحقيق استبدادهم الذي يعبرون عنه بهتانا وزورا بالسلم الثقافي الذي يتأسس بثقافة "البلطجة" السيئة الصيت !!
في حين الشريحة الأخيرة وهي المثلى والتي كانت ولا تزال وسطا في ركوب أمواج البحث عن الحقيقة دون التفريط أو الإفراط في الدين والأخلاق والعلم والمعرفة والتكنولوجيا، هذه الشريحة رسالتها إنسانية وليست من أجل الغرب وعيونه أو العصبيات ونزواتها، وتعمل جاهدة من أجل تجاوز أشكال الاستبداد والقابلية للإستعمار وتنقية التلوث الفكري الكاسح للعقول والمجتمعات والمتحكم في الواقع بالتثبيط والإخفاق والرجعية والشذوذ، هذه الشريحة سلمها سلم لأنها تستمد رؤيتها من ثقافة السلام العادل والكريم والحضاري، هذه الشريحة تؤمن بالحوار العلمي والتعارف الثقافي والاحترام المتبادل بين الذات والآخر الجواني والبرّاني، أهدافها واضحة في البحث عن الحقيقة، لا تتوقف أمام الضجيج المفتعل لأنها تدرك حالة إخفاق الوعي لدى ذلك المبرمج لتعطيل كل مشاريع النقد والإصلاح والتجديد والتنوير في العالم العربي، تعلم أن هناك يد للمستعمر تتلخص في مناهج فكرية وثقافية محددة يراد لها أن تنتشر دون أخرى، وتركز بجسارة في مشروعها التنويري حتى لا تستقطب نحو مستنقعات التنويم الثقافي للشعوب والقتل البربري للأفكار والمشاريع الفكرية الهادفة للتجديد والإصلاح، إن مثقف هذه الشريحة لديه كامل الوعي والأهلية والمصداقية في تصور مناورات الاشتباك الثقافية، إنه مثقف رسالته إنسانية كونية تحترم الإنسان وتسعى من أجل تخليصه من إخفاقات الوعي الحاصلة لديه، إنه مثقف أفكاره حية بحياة الإنسان وليست قاتلة أو مميتة أو ميتة...
و كما يعبر المفكر الغرباوي "سلسلة اليقينيات-طبعا السلبية- تتناسل في ثقافتنا" في معرض تحليله لما يطلق عليه اليقين السلبي والذي أراه يقينا مبتلى به أتباع الشريحتين السابقتين كل بحسب مقاصده ومصالحه، لكن ما يهمنا بهذا الخصوص هو اليقين الإيجابي لدى المثقف الكوني والرسالي في محنته الثقافية داخل المشهد الثقافي العربي، لكن هذا اليقين هو مغاير تماما لليقينيات السلبية المسيطرة على مجتمعاتنا والتي تحاط بقداسة عظيمة أحيانا تستغرب أن أغلبها لا تعرف من أين حصلت على القداسة تلك !!
يقين المثقف الكوني الرسالي هو يقين يتطور بالايجابية أي هو تحصيل مسيرة بحث وتنقيب وتمحيص وتحقيق متجدد وليس جامدا كمجمل اليقينيات السلبية المقيدة للوعي والنباهة والنهضة في عالمنا العربي، ولعل هناك طرفة فيزيائية إن صح التعبير، المتيقن أن كل ماهو سلبي يتطلب إيجابي حتى ينتج طاقة، لذلك سلبية الواقع الثقافي المنتشرة بحاجة لمثقف يفكر بإيجابية حتى تنتج طاقة التغيير والتجديد والتنوير، فليس هناك مبرر للسلبية في التعاطي مع النقد والحوار فحتى الدين شرّع السؤال ليكون الإيمان نتاج مسيرة البحث عن اليقين، الله تعالى يدعو الناس لسؤال أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون، فتركوا الأمر بالسؤال وانشغلوا بالصراع حول أهل الذكر، رغم وضوح معالم أهل الذكر عقلا ونقلا، هنا طبيعي أن ينتج يقين سلبي جامد مستغرق في التفاصيل وغافل عن الأساسيات ومنقلب على الضروريات للتقدم نحو اليقين الإيجابي والاقتراب من مقتضيات القلب السليم، وأحد مسببات هذا التلوث الفكري في جمهور الشريحة الثانية أن علم الكلام في تموضعه التاريخي في الثقافة العربية الإسلامية أصيب بالركود والخمول بسبب التقليد الذي ساد العقل الفقهي في حقبة من تاريخ المسلمين وخصوصا مرحلة أفول الحضارة الإسلامية- يمكن البحث حول حركة علم الفقه وعلم الكلام ما بعد الموحدين- فتمدد التقليد لكل أبعاد المعرفة الإسلامية خصوصا علم الكلام إلى يومنا هذا، حيث نجد أغلب من اشتغلوا ونادوا بإحياء علم الكلام وسموه علم الكلام الجديد هم من غير المثقفين العرب، بل أكثر من ذلك كانوا من المثقفين النقاد وأصحاب مشاريع فكرية حساسة[5].
عموما محنة المثقف الكوني أو الرسالي تتلخص في انه مجمل المشهد الفكري في الفضاء العربي يفتقد للسلم الثقافي، مما طور الحساسيات على حساب مناهج البحث والحوار والتفكيك والتحليل، فأصبح الإبداع ابتداع والعنف وسيلة في فرض الإستبداد المدعى أنه سلماً، فالتقليد في علم الكلام جعل القوم جامدين في عصر غير عصرهم ويدّعون فهم تحديات معاصرة مركبة وخطيرة بمنهج كلامي تقليدي لو حضر أصحابه لاستنكروا صنيعهم هذا، وفي السياق أستشهد هنا بما تمناه الكاتب المصري أحمد أمين من عودة الفكر المعتزلي إلى واقعنا في كتابه ضحى الإسلام: لكان للمسلمين موقف آخر في التاريخ غير موقفهم الحالي، وقد أعجزهم الضعف وشلهم الجبر وقعد بهم التواكل"[6]..
و عليه إن الضجة المفتعلة بخصوص مؤتمر التأسيس لمؤسسة فكرية ثقافية، التي وقع فيها هؤولاء الرافضين للآخر هي في العمق عجزهم عن الموائمة بين الحرية الفكرية الذاتية والقراءة المتعددة فكريا في الواقع، إننا أمام هذا الشكل من أشكال الغطرسة الفكرية والثقافية التي تبخس الآخر حقه في التفكير والتعبير والمواطنة، مع تهميش دوره وعزله لا يسعنا سوى القول: إن هذه الضجة سوى تلوث فكري يحاول تطويق المشهد الثقافي العربي بأي شكل من الأشكال العنفية مسيئا لكل ماهو مقدس حقيقي للإنسان العربي ويؤثر بسلبية بالغة في الواقع العربي..
إن الهدف من السلم الثقافي وتحققه هو البناء المعرفي والابستيمي للفكر والثقافة العربية والإسلامية، ولقد حاولت الوقوف على عدة صور ومشكلات وإشكاليات بعجالة حيث واقعنا مليء بالطروحات الطائفية والعصبية الجاهلية المنافية لمفهوم السلم تماما، وتناولت بالشيء من الإسهاب الشريحة الثالثة من المثقفين لمحاولاتها التوفيق والعمل بجد واجتهاد وحزم وجسارة في التفكير الحر والبناء والبحث عن الحقيقة خارج الصندوق العربي المتوقف في ما بعد الموحدين أو أكثر رجعية من ذلك، كما أشرت في عدة مواضع لضرورات الوعي الثقافي بالدراسات النقدية وخصوصا الظاهرة الدينية، فبينما الغرب انتقل بهرمس إلى اللغوس، نَقَلنَا أهل الضجيج والبلطجة من السلم إلى الاستبداد، ولن يكون هناك سلم ثقافي ما لم يتصالح الفقيه مع الفيلسوف في راهننا... لابد للصراع الفكري في البلاد العربية أن يتهذب بالحوار الموضوعي والحماية الفكرية والقبول بالآخر والتعارف معه، تأسيسا لمجتمع مدني حقيقي مرتكز على قيم التسامح والحوار والتعارف والسلم ...
أختم بحوار جرى بيني وبين أحد الأصدقاء طبيب ببلد أوروبي قبل مدة، حيث قال لي: إنني مندهش في القوم يقرأون في كل مكان حتى في وسائل النقل المكتظة بالناس، فسألته: هل تعلم لماذا يقرأون في كل مكان؟ فأجابني: أكيد للزيادة من المعرفة والثقافة !! فأجبته: هذه جزئية، لكنهم يقرأون في كل مكان لأنه الهدوء متوفر للتركيز والنهل المعرفي، والهدوء دليل احترامهم لبعضهم البعض، وغالبا يقرأون الروايات الهادفة في الأماكن العامة بينما العلوم فلها أمكنتها وأهلها كونهم يحترمون والعلوم وتخصصاتها والآخر المفكر ومشاريعه، هناك سلم ثقافي فعلي نتاجه مجتمع مدني متقدم، وصل لما بعد الحداثة لأنه مجتمع مفتوح على آفاق المعرفة العظيمة كما عبر كارل بوبر وفريديريك هايك...
***
أ. مراد غريبي – كاتب وباحث ومترجم
................
[1]
https://almothaqaf.com/aqlam-3/969699
[2] يمكن العودة إلى كتاب إشكاليات التجديد للمفكر ماجد الغرباوي
[3] راجع كتاب تحرير الوعي الديني الجزء 5 من سلسلة متاهات الحقيقة لماجد الغرباوي، ص 388
[4] ن، م
[5] يمكن العودة لكتاب علم الكلام الجديد للدكتور عبد الجبار الرفاعي للاستيعاب أكثر
[6] ضحى الإسلام الجزء 3 ص 70