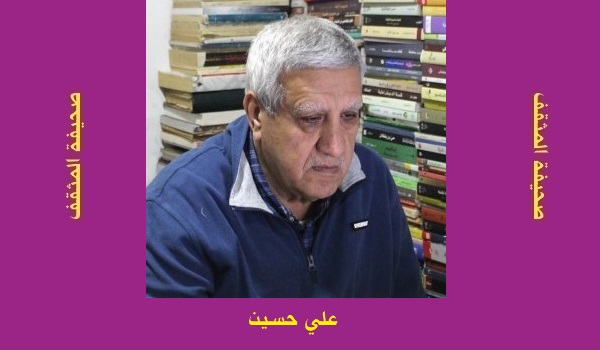شهادات ومذكرات
عبد السلام فاروق: سيرة الكلمة والذاكرة مع هشام عطية

في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، كانت أروقة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تشبه كتاباً مفتوحاً على أسئلة لا تنتهي، تتهامس بين جدرانها حكايات من مروا هنا حاملين أحلاماً كالفراشات، تلمع في أيديهم دفاتر فارغة تنتظر أن تكتب بمداد الحياة. في الطابق الرابع، حيث تتعانق أشعة الشمس مع ظلال الحكمة، كان يجلس "هشام عطية" كحارس للأسئلة، ينسج من كلماته جسراً نعبر منه إلى عوالم لم نكن نعرفها إلا بخيالنا الواسع.
لم يكن هشام عطية زميل الدراسة، مجرد أستاذ جامعي يلقن المعلومات، بل كان رساماً يرسم خريطةَ الوجود بقلمه. يمسك القلم وكأنه يمسك ريشة تخلط الألوان بين العلم والحياة، بين الحرف والروح. في عينيه، كنا نقرأ ذاكرةَ الأروقة العتيقة، وهو يهمس: "الإعلام رسالة تولد من رحم الألم، لا تورث مثل مجوهرات العائلة". كنا نجلس معه عطشى للجديد، نسمع صوته الهادئ ينساب كجدول ماء يحمل في تياره قصص السابقين وأحلام اللاحقين.
في قاعة محاضرات الكلية الواسعة، حيث تطل النوافذ على شارع يغلي بالحياة، كنا نتعلم أن الكلمة ليست مجرد حروف تسجل، بل نبض يلامس الأشياء الخفية. كان يشير إلى الزحام خارج النوافذ، مذكراً إيانا بكلمات أستاذنا خليل صابات: "اكتبوا كأن قلوب الناس تقرؤكم، فهم جمهور لا ترونه". هناك، بدأنا نفهم أن الخبر الحقيقي ليس جملة تختزل في ورقة، بل هو نبضة قلب تسمع من وراء الضجيج.
رفاق السهر والقهوة المُرة
كانت مكتبة الكلية بمثابة ميناء للعقول التائهة. وهشام يغوص بين الكتب كأنه يبحث عن كنز ضائع في أعماق المحيط. في المساء، حين تخلو الأروقة من أصوات الطلاب، كان يقف عند باب المكتبة يودع الشمسَ بابتسامة تشبه عنوان كتاب لم يكتب بعد.
لم يكن يخجل من قول "لا أعرف"، بل كان يعتبر الجهل أول خطوة نحو المعرفة. "العلم بحر بلا ساحل، والتواضع قوة تمنح الكلمات أجنحة"، هكذا كان يردد بينما نتبادل القهوة المرة في الاستراحات، نكتب أحلامنا على حواف الدفاتر، وهو يحوّلها إلى مناهجَ للحياة.
رحل الجسد.. وبقي النور
حين رحل هشام، لم يغلق الباب خلفه. صار ظلُّه جزءاً من ضوء الأروقة، وصرنا نراه في كل زاوية تلمع فيها كلمة صادقة. ذاك اليوم، وقفت عند النافذة القديمة المطلة على شارع المدينة الجامعية، وهبّت ريح حملت صوت ضحكته الخافتة. تذكرت دفتره القديم الذي تركه لي، عليه آثار قهوةٍ وبعض الكلمات الباهتة. "لا تنس أنك تحمل رسالة"، كأن صوته ما زال يتردد بين السطور.
اليوم، وأنا أحمل قلمي في "الأهرام"، أعرف أن ما زرعه العمالقة - خليل صابات، عواطف عبد الرحمن، جيهان رشتي - لم يكن علماً يتبخر، بل جذوراً تتعمق كلما هبت عواصف المهنة. حين تتلبسني الشكوك، أسمع همساتهم: "اخرج إلى الناس، فهم مدرستك الأخرى".
الوداع الأخير يوم رحيله، كأنه لقاء يتجدد كلما سقطت ورقة من دفتر الذكريات. في كل مرة أمر فيها بمبنى الكلية العتيق، أرى ظل طالبين يجران نحو المحاضرات، يحملان دفترين وكوب قهوة متسربل بالحنين. أبتسم وأهمس: "اتركا للذاكرة مساحة في دفتركما، فربما تصيران جزءاً من حكاية آخرين.. كما كنا نحن".
هكذا تخلد الأرواح الطيبة نفسها.. تضيء في كل قلم يبحث عن الحقيقة، وتلمع في كل قلب يرفض أن يصمت. هشام عطية.. لم يكف عن أن يكون الحارس، حتى صار النجمة التي تضيء درب الكلمة.
عبَق الذكريات
كانت خطواتنا على درجات سلم الكلية تشبه عزفًا على بيانو الزمن. كل طابق يحمل نغمة مختلفة من أسرار توارثتها الأجيال. في الطابق الرابع، المقترض من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ حيث ينساب الضوء عبر النوافذ العتيقة كشاعر يهمس بأبيات منسية، كان هشام عطية يعلمنا أن الحرف ليس مجرد رسم على الورق، بل هو نبضة تبعث في الفراغ.
فصلنا الدراسي لم يكن مكانًا للدرس فحسب، بل معملًا لصهر الأحلام. كنّا نرى في عينيه بريقًا غامضًا كلما تحدث عن "صحافة المواطن" قبل أن تولد المصطلحات، وكأنه يستعير عدسة من المستقبل ليرى ما لا نراه. في إحدى الأمسيات الباردة، بينما كنا نتصفح أوراقًا قديمة، وجدت إجابة له في امتحان صحفي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. كتب على هامش الورقة: "هذا الطالب سيعلّم من سيعلّمون". نظرت إليه متسائلًا، فابتسم كمن يحمل سرًا: "أحيانًا تسبق أحلامنا أعمارنا".
المقهى الصغير..
خارج أسوار الجامعة، في مقهى تعلوه طبقة من زغاريد السجائر، كنا نلتقي. كان يطلب قهوة سوداء، ويقول إنها تشبه حبر الكاتب: مرة لكنها توقِظ الروح. يحكي عن لياليه في المكتبة، حين كان ينام بين الكتب، وكيف كانت الصفحات الصفراء تغنيه عن البطانيات. "الكلمة الدافئة تعيد للقلب دفئه"، كان يردد بينما ننظر إلى شارع الحسين المزدحم، حيث تتحرك الحياةُ كمسرحية لا تُعرف نهايتها.
ذات يوم، بينما كنا نناقش مقالًا عن "الإعلام في زمن الحروب"، أخرج دفترًا قديمًا من حقيبته القديمة. قال: "هذه أولى محاضراتي.. كنت أرتجف كالطفل الذي يخطو نحو البحر لأول مرة". فتحت الدفتر، فوجدت كلمات بسيطة تكاد تختفي تحت بقع القهوة. فهمت يومها أن العظماء يبدؤون صغارًا، لكنهم يحملون في قلوبهم نارًا لا تنطفئ.
في القاعة الكبرى، حيث تلامس النوافذ العالية ضجيجَ الشارع، تعلمنا أن الصحفي ليس ناقلًا للأخبار، بل صائد للجوهر. كنا نرى الدكتورة عواطف عبد الرحمن تشير إلى الحشود خارج الزجاج: "انظروا.. كل وجه هنا قصة تنتظر من يرويها". كان هشام يضيف: "لا تخافوا من الضياع في الزحام، فالحقيقة تولد من رحم الفوضى".
اليوم، حين أمر بجانب مبنى الكلية، أتوقف عند النافذة ذاتها. ما زالت تطل على الحياة نفسها، لكن بأعين جديدة. أسمع أصوات طلاب جدد يتناقشون بحماس، وكأنهم يعيدون تمثيل ذكرياتنا. أتخيل هشام يقف بينهم، يوزع الأسئلة كبذور في تربة خصبة.
الرحيل
يوم غادرَ هشام، لم يغلق البابَ خلفه. صار حضوره أكثرَ قوة، كصوت الموج الذي يظل يرافق الشاطئ حتى بعد أن يتراجع. في زاوية مكتبي بـ"الأهرام"، أضع دفتره القديم بجانب لوحة المفاتيح. كلما اشتدت علي المهنة، أفتحه لأقرأَ العبارة الأخيرة التي كتبها بخط مرتعش: "لا تدع الحبر يجف.. فالكلمة الباقية هي التي تكتب بالروح".
حين أعود إلى أروقة الكلية العتيقة، ألمس الجدرانَ كأنني أقرأُ سيرة المكان. كل بصمة هنا تشبه جملة في رواية لا تنتهي. هشام.. صار جزءًا من ضوءِ النوافذ، وظلَه يرافق كل من يجرؤ على السؤال.
الخيط الرفيع
الآن، وأنا أجلس في صالة التحرير، تحيط بي شاشات تلمع بأخبار عابرة، أتذكر كيف كنا نكتب الأحلامَ على أطراف الدفاتر. تلك الأحلام التي صارت اليوم عناوين رئيسية. كلما سقطت ورقة من على الطاولة، أتخيلها تسقط في دهاليز الكلية، حيث يلتقطها طالب جديد ليبدأَ حكاية أخرى.
هكذا تظل الأرواح العظيمة حية.. كل كلمة نكتبها تعيد رسمها من جديد. هشام عطية.. لم يرحل، بل صار قصيدة نرددها كلما اشتد الظلام.
في أحد أيام الخريف، حين كانت السماء تمطر ذكريات رطبة على أسطح الكلية، اجتمعنا تحت مظلة الرواق الطويل. كان هشام يحمل مظلة سوداء مهترئة، ويقول: "انظروا كيف تغسل الأمطار غبار السنين عن هذه الجدران.. هكذا يجب أن تكون الكلمة؛ مطرًا ينقي الأرواح من غبار الصمت". يومها، كتبنا خواطرنا على أوراق ابتلت حوافها، وكأن المطر نفسه يشاركنا كتابةَ الحكايات.
دروسنا في تلك اللحظات العابرة حيث تتوقف الحياة لتصغي إلى همسِ الأسئلة. كنت أسير معه في حديقة الكلية، وهو يلتقط أوراق الأشجار المتساقطة، ويقول: "كل ورقة ميتة تحمل قصة شجرة حية.. ابحث عن القصص التي لا يراها غيرك". كانت عيناه تتابعان تحليق حمامة فوق المبنى القديم، وكأنه يرى في جناحيها صفحة بيضاء من صحيفة الكون.
ذاتَ ليلة، تأخرنا في المكتبة نبحث عن مراجعَ لبحث عن "الإعلام والمهمشون". فتح هشام باب القاعة فجأة، وحملقَ بنظرة اخترقت ظلام المكان: "هل تعرف لماذا تضاء المصابيح ليلًا؟ لأن الظلمة هي التي تعلم النور كيف يشرق". ثم أطفأ الأنوار فجأة، وجلس معي في العتمة. بدأ يحكي عن تجاربه الأولى في الصحافة الورقية، حين كان يكتب مقالاته على آلة كاتبة عتيقة يسميها "صديقةَ الروح". قال: "كنت أسمع طرقات المفاتيح كأنها دقات قلب ثان ينبض في الغرفة". في تلك العتمة، فهمنا أن الكلمةَ الحقيقية تولد من رحم الشك، لا اليقين.
رسائل إلى الذات
قبل رحيله بأيام، دعاني إلى مكتبه الذي تفوح منه رائحة القهوة والورق القديم. أخرج من درج خشبي دفترًا جلديًّا أغبر، وقال: "هذا دفتر الأسئلة التي لم أجد إجاباتها بعد.. خذه، فربما تكمل أنت ما عجزت عنه". تصفحت الصفحات الأولى، فوجدت أسئلة تائهة عن معنى المهنة، عن دور الكلمة في زمنِ الضوضاء، عن كيف نكتب دون أن نخونَ ذاتنا. كتبت أسئلتي بجانب أسئلته، وكأن الدفتر صار حوارًا بين صديقين يربطهما حبل سري من الحنين.
اليوم، حين أعود إلى ذلك الدفتر، أكتشف أن الإجابات الحقيقية كلمات تكتب، وحياة تعاش. كل سطر فيه يذكرني بأننا لسنا سوى جسر بين ما كان وما سيكون.
في زحمة عملي الصحفي، أتذكر دائمًا نصيحة هشام: "اخرج إلى الشارع قبل أن تكتب، فالحروف تكتسب أنفاسًا إذا تنفست هواء الواقع". ذات مرة، صحبني إلى سوق خان الخليلي، وقال: "اكتب ما تراه بعين القلب، لا الكاميرا". كتبت عن بائع التوابل العجوز الذي يحفظ تاريخ المدينة في راحة يده، وعن طفل يحمل صناديق الشاي كأنه يحمل أحلام عائلة بكاملها. قال لي: "هذا هو الخبر الذي لا يموت.. حين تمسك بيد القارئ وتدخل به إلى عوالمَ لم يجرؤ أن يطرق بابها وحده".
الضوء الذي لا ينطفئ
الآن، كلما مررت بجوار مبنى الكلية عند الغروب، أرى ظلال الطلاب الجدد تمتد على الجدران ككلمات مكتوبة بخط غير منظور. أتخيل الدكتور هشام عطية واقفًا خلفهم، يبتسم كشخص يعرف سرا جميلاً عن المستقبل. في يد كل طالب دفتر فارغ، وفي عيونهم جوع العطش الذي كنا نحملهُ ذات يوم.
رحل الجسد، لكن الكلمات التي زرعها صارت أشجارًا تظلِّل كل من يمر من هنا. في النهاية، نحن لسنا سوى حكايات ترويها الجدران للريح، ورسائل يكتبها الضوء على صفحة الزمن.
***
د. عبد السلام فاروق