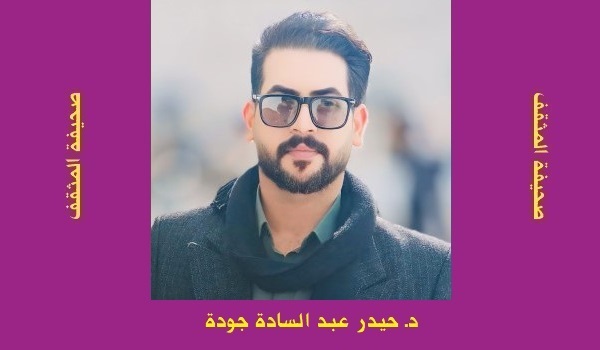أقلام حرة
عبد السلام فاروق: الذاكرة المبتورة للثورة العرابية

في كل أمة لحظات فارقة تختزن في ذاكرتها الجمعية وتتحول إلى محاور كبرى في تاريخها. الأمم العاقلة وحدها هي التي تعرف كيف تصون تلك الذاكرة وتستثمرها في بناء الحاضر والمستقبل. أما نحن، فكثيرًا ما نتعامل مع تراثنا وكأنه عبء ثقيل أو سلعة مؤقتة للاستهلاك السياسي والأيدلوجيي، لا كنزًا معرفيًا وإنسانيًا يحتاج إلى رعاية وصيانة.
تأتي ذكرى الثورة العرابية لتضعنا وجهًا لوجه أمام هذا المأزق: كيف نتعامل مع رمز بحجم أحمد عرابي، الضابط الفلاح الذي قاد ثورة هزت عرش الاستبداد، ودوى صوته بشعار «الشرع أساس الملكية والحقوق الوطنية»، ثم انتهى به المطاف إلى أن يختزل في صورة بطولية مفرغة من مضمونها؟
إن مأساة مذكرات عرابي ليست مجرد قصة وثيقة ضائعة، بل هي صورة مكثفة لطريقة تعاملنا مع تاريخنا: نأخذ ما يخدمنا ونلقي بالباقي في هوامش النسيان. حولنا الرجل من إنسان متكامل بتناقضاته وآماله وأخطائه إلى أيقونة مسطحة صالحة للعرض في المناسبات. وهكذا ضاعت النصوص الأصلية وبقيت الصورة، سريعة الاستهلاك، سهلة الاستخدام، ولكنها عاجزة عن بناء وعي نقدي أو إنتاج ذاكرة حقيقية.
بين الاحتفاء والاستفهام
تمر هذه الأيام ذكرى اندلاع الثورة العرابية، لا كذكرى وطنية عابرة، بل كلحظة فارقة هزت عرش السلطة المطلقة، ورفعت شعار «الشرع أساس الملكية والحقوق الوطنية». ومع ذلك، فإن الكتابة عنها ليست للاحتفال بقدر ما هي دعوة للتساؤل: ما علاقتنا بتراثنا؟ وكيف نزعت الأمة أوصال ذاكرتها الجماعية بإرادتها أو بتفريطها أو بمزيج مأساوي من الجهل والحمق؟ إننا، شعوبًا ونخبًا، لا نحفظ تراثنا حتى حين يكون هو رأس مالنا الرمزي، وسند شرعيتنا التاريخية، وسر قوتنا الناعمة.
تمثل قصة مذكرات أحمد عرابي النموذج الأبرز لهذا البتر المتعمد للذاكرة. لم نهملها فحسب، بل حين استدعيناها، أتينا بها مشوهة، مهندسة لتخدم أهواءنا الراهنة. لقد تعاملنا مع تراث الرجل كما لو كان تمثالًا أثريًا عُثر عليه في حفرة: أخذنا ما راق لنا، صورة البطل الثائر الفلاح، ورمينا الباقي من تفاصيل معقدة، وتناقضات، وأخطاء، في غياهب النسيان. وهكذا تحول من إنسان عظيم إلى أيقونة مشوهة تخدم خطابًا سياسيًا عابرًا.
أتساءل مندهشاً: لماذا نخرب تراثنا؟ هل لأن الصورة أوضح وأسهل في الاستهلاك من النص؟! الصورة تمنحنا بطلًا صافيًا، وشعارًا حماسيًا، وعدوًا جاهزًا. أما النص الكامل بمذكراته ووثائقه، فيظهر واقعًا ملتبسًا يحتاج إلى جهد نقدي وعقلي لفهمه. السلطة لا تريد هذا التعقيد؛ هي تفضل "عرابي الشعار" لا "عرابي الإنسان"، "اللافتة" لا "الكتاب"!
استعادة الأوصال المقطوعة
جزء من الإهمال ليس مؤامرة، بل انعكاس لثقافة قصيرة النظر لا ترى في المعرفة إلا منفعة عاجلة. ناشر خمسيني لن يغامر بتمويل تحقيق علمي لمذكرات عرابي كاملة، والمجتمع آنذاك مشغول بالخبز والكساء أكثر من الوثائق. لقد كان الطلب على «أسطورة عرابي» أكبر من الطلب على «حقيقة عرابي». فاختار الناشر، بدافع تجاري بحت، أن يقدم الجزء الأول فقط، الأكثر إثارة ودراماتيكية، متخلياً عن الباقي لأنه «غير مجد تجارياً». إنه منطق السوق الأعمى، لا مؤامرة متعمدة.
حتى التراث الذي يخدمنا نهمله، تلك هي المفارقة المؤلمة؛ ثورة يوليو وجدت في عرابي سلفًا مثاليًا ورصيدًا رمزيًا ضخمًا، لكنها لم تستثمر في تحقيق مذكراته كاملة أو أرشفتها. اكتفت بالصورة، وتركت النصوص للضياع. وكأنها تقول: "هذا البطل لنا، لكن أفكاره وتعقيداته ليست لنا". إنها عقلية تستثمر في الرمزية السريعة لا في المعرفة العميقة.
في ذكرى الثورة العرابية، الدعوة ليست إلى بكاء على مذكرات ضائعة، لكن إلى الوعي بالنمط المتكرر في علاقتنا بتراثنا: الاستهلاك السطحي، الإهمال، والتشويه. الاحترام الحقيقي يبدأ حين نجرؤ على مواجهة التراث بكامل تناقضاته، حين نحقق نصوصه كاملة، ونفتحها للباحثين والجمهور بلا خوف من الأسئلة المربكة.
صراع على الذاكرة
تمثل مذكرات أحمد عرابي (١٨٤١-١٩١١) إشكالية تاريخية متعددة المستويات، تتجاوز قيمتها الوثائقية المباشرة إلى كونها حقلًا لصراع الذاكرة الجمعية وتشكيل الوعي التاريخي في مصر. فالمذكرات - في نسخها المتعددة والمبتورة - ليست مجرد سرد شخصي لأحداث الثورة العرابية، إنها مرآة عاكسة لتحولات الخطاب السياسي والثقافي المصري على مدى قرن من الزمان.
من خلال المنهج التحليلي النقدي، يمكننا تقصي آليات تشكل الخطاب التاريخي حول عرابي، حيث تم توظيف سيرته ومذكراته لخدمة أغراض أيديولوجية متعاقبة. فبينما قدمته النخبة الليبرالية في عشرينيات القرن الماضي كبطل دستوري، حوله خطاب ما بعد ١٩٥٢ إلى رمز للثورة الشعبية والصراع الطبقي، مجتزئًا من سيرته ما يلائم كل مرحلة.
المذكرات الموسومة: (كشف الستار عن سر الأسرار، مذكرات الثورة العرابية)، تعاني إشكالية التعدد والتناقض؛ تحتوي على الجزء الأول فقط من مذكرات مزعومة، مما يشير إلى عملية قصدية لـ"تدجين الذاكرة" وتشكيلها وفقاً للحظة السياسية السائدة. هذا التبدل الغريب في علاقتنا بتاريخنا يجعل من مذكرات عرابي نموذجاً صارخاً لـ"اختطاف الذاكرة".
لقد كتب عرابي مذكراته في سنوات نفيه الأخيرة، بعيداً عن الأضواء، في ظروف لم تكن تحفل كثيراً بـ"ترميم الذاكرة". والمجتمع المصري آنذاك كان منقسماً بين من يراه بطلاً ومن يراه متهوراً. كما أن الظروف المعيشية الصعبة في ظل الاحتلال الإنجليزي جعلت الاهتمام بنشر المذكرات ترفاً فكرياً عندما تكون المعدة خاوية
التوظيف السياسي للمذكرات
لطالما نظرت النخبة المصرية إلى التاريخ كبضاعة قابلة للتغليف وإعادة التدوير وفقاً لمزاج السلطة وأهواء الأيديولوجيا. فالثورة التي قامت في 1952، وهي ثورة ضباط في الأساس، احتاجت إلى سلف ثوري تبرر به وجودها. ووجدت في عرابي الضابط الثائر الضحية المثالية. لكنها لم تريد عرابي بكامل تفاصيله، بل أرادت "عرابي المعدل".. نسخة مطابقة لمواصفات المرحلة!
المفارقة المأساوية تكمن في أن ثورة 1952 التي اتخذت من عرابي رمزاً لها، هي نفسها التي قدمت مذكراته في صورة مبتورة! أليس هذا أشبه بمن يقدس النبي ثم يحذف نصف أحاديثه؟
سؤال جدلي
نطرح هنا سؤالاً محوريا: هل كانت مذكرات عرابي "غير مكتملة" لأن الرجل مات قبل أن ينهيها، أم لأن المشروع الفكري والسياسي الذي مثله هو نفسه كان "غير مكتمل"؟
الجزء الأول من المذكرات يركز على "رد الاعتبار" و"كشف المؤامرة". إنه رد فعل على هزيمة مذلة، وليس تأملًا موضوعيًا في تجربة ثورية. هذا يشبه إلى حد كبير وعينا الجماعي المصري الذي غالبًا ما يعلق في مرحلة الدفاع عن الذات والحديث عن "المؤامرات" بدلاً من تشريح العيوب الذاتية والاستفادة من الدروس.
الأكثر إيلامًا أن صوت الضابط الفلاح صودر مرتين: أولًا على يد الاستعمار والنخبة التركية، ثم على يد أبناء وطنه الذين اختصروا مذكراته وشوهوها. الفلاح الذي نادى بـ"مصر للمصريين" حرم حتى من أن تسمع روايته كاملة.
مرآة الذاكرة المختطفة
حكاية مذكرات أحمد عرابي ليست مجرد وثيقة تاريخية ضاعت بعض أجزائها في زحام النسيان، لكنها مأساة كبرى تختصر كيف نصنع نحن مع تاريخنا، وكيف نصوغ وعينا الجماعي على مقاس السلطة والأهواء العابرة. فالمذكرات المبتورة ليست نقصًا في الورق فحسب، بل بترًا للذاكرة نفسها، ومصادرة لحق الأجيال في معرفة الماضي بكامل تعقيداته، لا في صورته الملساء التي أعدت للاستهلاك السريع.
إن السلطة، أي سلطة، لا تريد مواطنًا يقرأ تاريخًا شائكًا، متعرجًا، مليئًا بالتناقضات، بل تفضل "رعية" تكتفي بأساطير بطولية مبسطة، تنعش العاطفة وتدعم الشرعية دون أن تثير أسئلة. من هنا جاءت النسخة المختصرة من مذكرات عرابي، كوجبة سريعة للوعي: تشبع لحظة، لكنّها فقيرة في قيمتها المعرفية، عاجزة عن تغذية العقل النقدي أو صقل البصيرة التاريخية.
والدرس البليغ الذي يقدمه هذا المصير هو أن الاستقلال الحقيقي لا يقاس براية مرفوعة أو نشيد وطني، بل بقدرتنا على استعادة ذاكرتنا من سطوة الرواية الرسمية. استعادة الذاكرة تعني أن نفتح الأرشيف المغلق، أن نعيد الاعتبار للنصوص المبتورة، أن نبحث عن الأصوات التي جرى تهميشها عمدًا لأنها لا توافق خطاب المرحلة. وبهذا فقط نستطيع أن نخرج من الطفولة السياسية التي نحبس فيها كلما صدقنا صورة جاهزة للبطل أو رواية معدلة للتاريخ.
مذكرات عرابي، رغم ما أصابها من نقص وتشويه، تظل مرآة صافية لما هو أعمق من سيرة رجل واحد. إنها مرآة لرحلة مصر في لحظة تأسيسية، لحظة صعود الوطنية الحديثة في مواجهة الاستبداد والاحتلال، ولحظة احتدام الصراع بين الجيش والشعب والسلطة؛ صراع لم يحسم بعد، بل يواصل إنتاج صور متجددة من نفس العقدة التاريخية.
إنها تدعونا إلى أن نقرأ التاريخ لا كقصة مكتملة، ولا كحكاية بطولية منقوشة على جدار، بل كعملية مستمرة للبحث عن الحقيقة. مثل هذه الحقيقة، كما تكشف لنا مذكرات عرابي، ليست خطًا مستقيمًا ولا حكمًا نهائيًا: فقد يكون البطل في جانب منها ضحية، وقد يكون الضحية في جانب آخر بطلًا، وقد تظل الحقيقة ذاتها سرًا من أسرار الزمن، لا ينكشف كاملًا أبدًا، لكن السعي إليه هو ما يمنح الذاكرة معناها، والتاريخ قيمته، والحاضر بصيرته.
***
د. عبد السلام فاروق