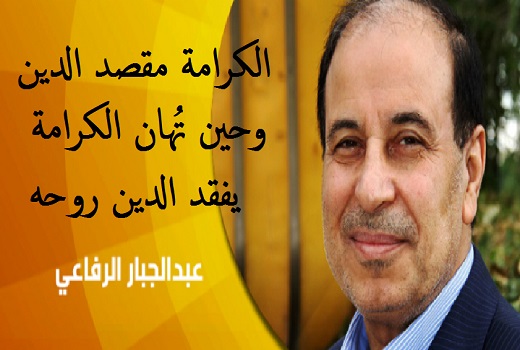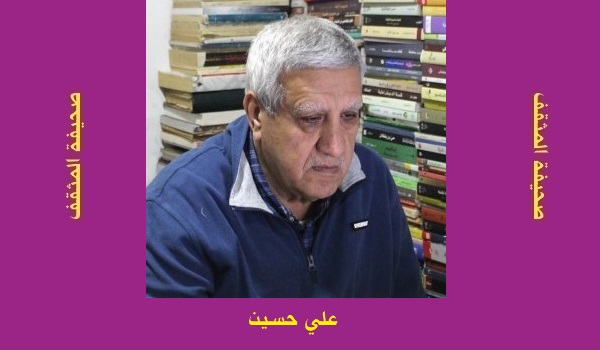أقلام فكرية
زهير الخويلدي: الكشف عن الأنطولوجيا في الفلسفة الميتافيزيقية

عند عمانويل كانط، مارتن هيدجر، وجاك دريدا
(إن كلمة "الوجود" تقال بمعانٍ متعددة) أرسطو، الكتاب الرابع، الميتافيزيقيا،
تُمثل الأنطولوجيا، أو علم الوجود، أحد أهم فروع الفلسفة الميتافيزيقية، حيث تسعى إلى فهم طبيعة الوجود، الكينونة، والعلاقة بين الوجود والموجودات. في هذه الدراسة، سنستعرض كيف تناول ثلاثة من أبرز الفلاسفة في التاريخ الفلسفي الحديث والمعاصر، وهم عمانويل كانط (1724-1804)، مارتن هيدجر (1889-1976)، وجاك دريدا (1930-2004)، مفهوم الأنطولوجيا، مع التركيز على كيفية كشفهم عن هذا المفهوم وتفكيكهم للميتافيزيقا التقليدية. يهدف هذا البحث إلى تحليل مقارناتي لهذه الرؤى، مع الإشارة إلى السياقات الفلسفية والتاريخية التي شكّلتها، وصولاً إلى استكشاف التحولات في فهم الأنطولوجيا من منظور نقدي وتفكيكي. تتبنى الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا، مع الاعتماد على النصوص الأصلية للفلاسفة الثلاثة، إلى جانب مراجع ثانوية لتوضيح السياقات وتفسير الأفكار. سيتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، كل قسم يتناول فيلسوفًا وإسهاماته في الأنطولوجيا، مع خاتمة تربط بين الرؤى المختلفة وتسلط الضوء على نقاط التقاطع والاختلاف. فماهي الأنطولوجيا؟ وماهو تاريخها؟ وكيف تناولها كانط؟ وما الفرق بين المقاربة الهيدجرية الأنطولوجية والمقاربة التفكيكية لجاك دريدا؟ وأي مستقبل لها ؟
عمانويل كانط ونقد الأنطولوجيا الميتافيزيقية
عاش كانط في عصر التنوير، حيث كانت الفلسفة الميتافيزيقية التقليدية، التي سيطرت عليها أفكار ديكارت وليبنتز وولف، تهدف إلى تقديم تفسيرات عقلية شاملة للوجود والكون. لكن هذه الميتافيزيقا واجهت تحديات من التجريبية (مثل هيوم) التي شككت في قدرة العقل على معرفة الحقائق المطلقة. في هذا السياق، قدم كانط في كتابه نقد العقل الخالص (1781) ثورة فلسفية تهدف إلى إعادة تعريف حدود المعرفة والميتافيزيقا.
كانط والأنطولوجيا: نقد الوجود كمحمول
ركز كانط على نقد الأنطولوجيا التقليدية، خاصة فكرة الوجود كمحمول. في حجة "الوجود ليس محمولًا"، يرفض كانط الفكرة التي قدمها أنسيلم وديكارت بأن الوجود يُضاف إلى جوهر الشيء كصفة. يقول كانط: "الوجود ليس محمولًا حقيقيًا، أي أنه ليس مفهومًا لشيء يمكن إضافته إلى مفهوم شيء آخر". بمعنى آخر، الوجود هو شرط تحقق المفهوم في الواقع، وليس صفة تزيد من كماله. على سبيل المثال، يوضح كانط أن مفهوم "كائن حقيقي" لا يختلف في محتواه عن "كائن متخيل"، لأن الوجود لا يُضيف شيئًا إلى المفهوم نفسه، بل يتعلق بتحقق هذا المفهوم في الواقع. هذا النقد يهدم الحجة الأنطولوجية لإثبات وجود الله، التي تعتمد على اعتبار الوجود جزءًا من كمال المفهوم.
الأنطولوجيا في إطار النقد الكانطي
أعاد كانط تعريف الأنطولوجيا ضمن إطار "الفلسفة النقدية". بدلاً من دراسة الوجود بمعزل عن الذات العارفة، رأى كانط أن الأنطولوجيا يجب أن تُفهم كدراسة للشروط الترانسندنتالية (أي الشروط المسبقة) التي تجعل المعرفة ممكنة. في كتاب نقد العقل الخالص، يقسم كانط المعرفة إلى مستويين:
المعرفة الحسية: التي تعتمد على الحدس في الزمان والمكان.
المعرفة العقلية: التي تعتمد على المقولات مثل السببية والجوهر.
هذه المقولات ليست موجودة في العالم الخارجي، بل هي هياكل يفرضها العقل على التجربة. وهكذا، تحولت الأنطولوجيا عند كانط من دراسة الوجود المطلق إلى دراسة شروط إمكانية التجربة.
تأثير كانط على الأنطولوجيا
أحدث كانط ثورة في الأنطولوجيا بتحويلها من ميتافيزيقا تأملية إلى تحليل نقدي للمعرفة. لقد وضع حدودًا للعقل النظري، مؤكدًا أننا لا يمكننا معرفة "الشيء في ذاته" بل فقط "الشيء كما يظهر لنا". هذا التمييز أعاد صياغة الأنطولوجيا كدراسة للوجود كما يتمثل في التجربة البشرية، مما مهد الطريق لتطورات لاحقة في الفلسفة، خاصة عند هيدجر ودريدا.
مارتن هيدجر وإعادة طرح سؤال الوجود
السياق الفلسفي لهيدجر
عاش هيدغر في فترة ما بعد الحداثة، متأثرًا بالفينومينولوجيا (خاصة هوسرل) وبنقد كانط للميتافيزيقا. في كتابه الرئيسي الوجود والزمان (1927)، سعى هيدجر إلى إعادة طرح سؤال الوجود الذي رأى أن الفلسفة الغربية قد أهملته لصالح دراسة الموجودات.
الأنطولوجيا الأساسية عند هيدجر
يفرق هيدجر بين الوجود والموجودات. ان الموجودات هي الأشياء التي توجد فعليًا (مثل الإنسان، الحجر، الشجرة)، بينما الوجود هو ما يجعل هذه الموجودات ممكنة. يرى هيدجر أن الفلسفة التقليدية ركزت على الموجودات وأهملت سؤال الوجود نفسه. في الوجود والزمان، يقول: "إن سؤال الوجود هو السؤال الأساسي للفلسفة". لتحليل الوجود، يركز هيدجر على الإنسان (الدازاين - الذي يتميز بقدرته على طرح سؤال الوجود. الدازاين ليس مجرد كائن بيولوجي، بل هو الكائن الذي يفهم وجوده ويواجهه في سياق الزمانية والموت. يقدم هيدغر مفهوم "الكينونة-في-العالم" ، حيث يُظهر أن الوجود ليس مجردًا، بل هو متجذر في التجربة اليومية والعلاقة مع العالم.
نقد هيدجر للميتافيزيقا التقليدية
يتهم هيدجر الميتافيزيقا الغربية بـ"نسيان الوجود. فمن أرسطو إلى هيجل، ركزت الفلسفة على تصنيف الموجودات وتحليل خصائصها بدلاً من استكشاف معنى الوجود. حتى كانط، رغم ثورته النقدية، ظل ضمن إطار الميتافيزيقا التقليدية لأنه ركز على شروط المعرفة بدلاً من الوجود نفسه[6].
الأنطولوجيا والزمانية
يرى هيدجر أن الوجود مرتبط بالزمانية. فالدازاين يوجد في سياق زمني، حيث الماضي (الوضعية)، الحاضر (الانشغال -، والمستقبل (الإسقاط - تشكل تجربته. هذا الارتباط يجعل الأنطولوجيا عند هيدجر ديناميكية، بعيدة عن التصورات الثابتة للوجود في الفلسفة التقليدية.
تأثير هيدجر
أعاد هيدجر صياغة الأنطولوجيا كمشروع فينومينولوجي يركز على التجربة الأنطولوجية للإنسان. هذا التحول مهد الطريق للفلسفات الوجودية والتفكيكية، حيث ألهم فلاسفة مثل دريدا وسارتر بتركيزه على الوجود كتجربة حية وليست كمفهوم مجرد.
جاك دريدا والتفكيك الأنطولوجي
السياق الفلسفي لدريدا
عاش دريدا في عصر ما بعد الحداثة، متأثرًا بهيدجر، هيجل، ونيتشه، بالإضافة إلى اللسانيات البنيوية (سوسير). في كتابه عن الغراماتولوجيا (1967) وغيره من الأعمال، قدم دريدا منهج "التفكيك" لتحليل النصوص الفلسفية وكشف تناقضاتها الداخلية.
التفكيك ونقد الأنطولوجيا
يرى دريدا أن الأنطولوجيا التقليدية، سواء عند أرسطو أو كانط أو هيدجر، تقوم على "ميتافيزيقا الحضور"، أي افتراض وجود معنى أو جوهر ثابت يمكن الوصول إليه. ينتقد دريدا هذا الافتراض من خلال مفهوم "الفرق " (différance)، الذي يشير إلى تأجيل المعنى وعدم استقراره في النصوص والمفاهيم. على سبيل المثال، يرى دريدا أن مفهوم "الوجود" عند هيدغر لا يزال محكومًا بميتافيزيقا الحضور، لأن هيدجر يسعى إلى كشف معنى الوجود كشيء أساسي. يقول دريدا: "لا يوجد حضور خالص، بل دائمًا آثار وتأجيلات". التفكيك، إذن، لا يسعى إلى تقديم أنطولوجيا جديدة، بل إلى تفكيك الأطر الميتافيزيقية التي تحاول تثبيت الوجود.
الأنطولوجيا واللغة
يركز دريدا على اللغة كموقع للوجود. فالوجود، في نظره، لا يمكن فصله عن اللغة التي نعبّر بها عنه. لكنه يرفض فكرة أن اللغة يمكن أن تُحيل إلى معنى نهائي أو ثابت. في هذا السياق، يصبح التفكيك أداة لكشف كيف تحاول الأنطولوجيا التقليدية فرض معانٍ مطلقة على الوجود.
تأثير دريدا
أحدث دريدا ثورة في فهم الأنطولوجيا بجعلها مسألة نصية ولغوية. بدلاً من البحث عن جوهر الوجود، دعا إلى فهم الوجود كسلسلة من الآثار والاختلافات التي لا تستقر أبدًا. هذا المنهج أثر على الفلسفة ما بعد الحداثية، الدراسات الأدبية، والنظرية النقدية.
خاتمة:
نقاط التقاطع: كانط، هيدجر، ودريدا ينتقدون الميتافيزيقا التقليدية. كانط يحد من طموحاتها العقلية، هيدغر يتهمها بنسيان الوجود، ودريدا يفكك افتراضاتها حول الحضور.
الثلاثة يركزون على الذات البشرية كمفتاح لفهم الوجود، سواء عبر العقل (كانط)، الدازاين (هيدجر)، أو اللغة (دريدا).
نقاط الاختلاف: كانط يبقى ضمن إطار العقلانية، بينما هيدجر يتحول إلى الفينومينولوجيا الأنطولوجية، ودريدا يتبنى التفكيك ما بعد البنيوي.
كانط يرى الأنطولوجيا كدراسة لشروط المعرفة، هيدجر يربطها بالزمانية والتجربة الوجودية، بينما دريدا يرفض فكرة الأنطولوجيا كمشروع متماسك.
في النهاية، يُظهر هذا التحليل أن الأنطولوجيا ليست مفهومًا ثابتًا، بل تطورت من نقد عقلي عند كانط، إلى استكشاف وجودي عند هيدغر، وصولاً إلى تفكيك لغوي عند دريدا. هذه التحولات تعكس تغيرات في السياقات الفلسفية والثقافية، وتدعو إلى إعادة التفكير في طبيعة الوجود والمعرفة في عالم متغير. فكيف أعاد بول ريكور النظر في القول الأنطولوجي بعد أن كاد عمانويل ليفيناس أن يستبدلها بالايتيقا؟
***
د. زهير الخويلدي - كاتب فلسفي