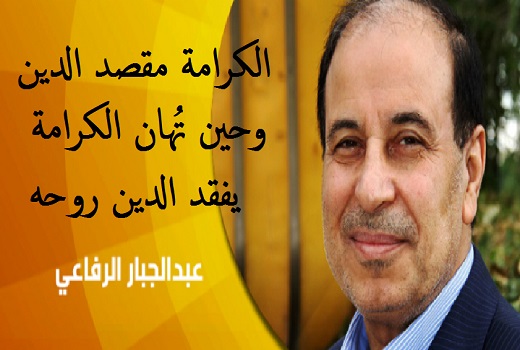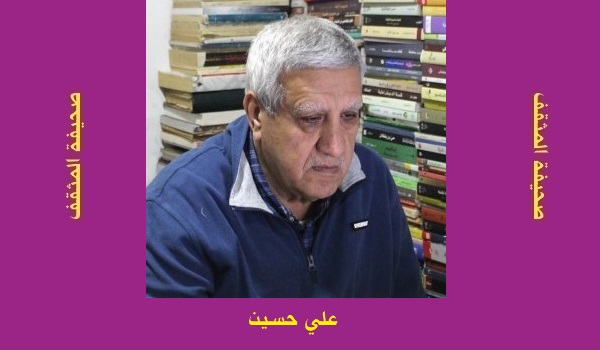أقلام فكرية
عبد الأمير كاظم زاهد: جدل الحداثة والاجتهاد الإسلامي.. قراءة تحليلية

مقدمة البحث: لايزال المفكرون في العالم العالم الإسلامي مختلفين في: هل ولدت لحظة التنوير في عالمنا مطلع القرن العشرين او انها لم تولد بعد؟ وعلى رأي من يرى انها ولدت فلماذا لم تتعاظم معطياتها؟ ولماذا أفل التنوير في العالم الإسلامي مطلع القرن العشرين؟ ولماذا خسر العالم الإسلامي جولته لتحقيق الحداثة؟ ويتساءل المفكرون: هل العلمانية شرط كوني للحداثة؟ وانها منطق حصري للتقدم عابر للازمنة والبيئات او انها صيرورة خاصة باوربا، واذا كانت العلمانية شرطا لحداثة اوربا، فلماذا تعمم كانها نهاية التاريخ او خاتمة الجهد الإنساني وتقدم على انها المدار المعياري للفكر والثقافة والممارسة السياسية والمجتمعية
ثمة مقاربة أخرى تتساءل هل إعادة فهم النص الإسلامي على مسلك الإيجابية والنزعة الإنسانية وفلسفة العدل والانفتاح يمكن ان يكون طريقاً لتنوير العقل الإسلامي ومقدمة للحداثة على معايير الايمان العقلاني(1)؟
ويتأمل المفكرون بالتجربة التاريخية للممارسة السياسية للخلافة الإسلامية (الاموية، والعباسية، والعثمانية) تأملاً يفضي الى انها تجربة عجزت ان تمارس الشورى الحقيقية، وعجزت تماما عن تحويل الشورى الى ديمقراطية منتزعة من تراث المسلمين الفكري، لكن دعونا نتساءل هل تجربة المفكرين المسلمين الإيجابية حققت قدراً من تنظيرالمدنية من دون علمانية في الفكر والثقافة ونظام الحكم ديمقراطي
ويتساءلون عن الآثار والمعطيات لتجربة العلمانيين التي عرفها العالم الإسلامي خلال القرن العشرين الذي حكمت دويلاتنا بنظم (علمانية) هل كانت تجارب ناجحة؟ وهل حاولنا اكتشاف سبب فشل مشروع النهضة والتنمية عند علمانيي اوطاننا، وهل بحثنا عن سبب طغيان سلطة القمع عند العلمانيين؟ وما انتجته تلك التجربة السياسية من ظهور للتيار الاصولي المتطرف والراديكاليات الدينية وجماعات العنف واكتسبت قدرتها على كسب من اهملت تجربة العلمانيين تحصينهم بالمعرفة الحقيقية والتفكير العلمي والثقافة الدينية المعتدلة فوقعوا في فخاخ السلفيات الارهابية
ان عالمنا المعاصر يقف إزاء مشروعات فكرية ثلاثة:
مشروع الدولة الدينية او شبه الدينية الذي لم يحقق نجاحا لانه كان على غرار انموذج الخلافة الاستبدادية التي أعلنت نهايتها في مطلع القرن الماضي بانتهاء الخلافة العثمانية عام 1924.
المشروع العلماني المتطرف الذي ينازع الموروث الحضاري الإيجابي ويتقاطع معه، والذي فشل هو الاخر خلال القرن الماضي. أي من عصر الانتداب الأوربي الى عصر الانقلابات وسيطرة العسكر الى عصر الربيع العربي
المشروع المدني – الإسلامي الذي يقيم الثوابت المشرقة للتراث، وينفتح على المنجزات الإنسانية في سعيه لإقامة دولة الانسان بكل ما تتميز به من رؤى تنويرية، ونزعة مستفيدة من التجارب العالمية، وتبنيها لمفهوم دولة الرفاهية ولكن على مرجعية إسلامية وهذا المشروع يجمع حسنات الانموذجين السابقين ويستبعد اخفاقاتها لكنه لم يطبق بعد. فقد بدأ مشروعا فكريا وسياسيا وحورب من الاستعمار الغربي والقوى الدينية المحافظة معا ولكنه بقي كتلة فكر مضيي ء ينتظر ارتقاء المجتمع في مدارج وعيه ليتفهم ضرورة هذا المشروع
عن هذه الأسئلة والتأملات يتحرك هذا البحث
عناصر مشروع الإسلام المدني: بايجاز شديد ان عناصر المشروع ومرتكزاته أربعة (العقلانية في الفكر والنظم، والمنهج النقدي في البحث والتحليل، ونزعة المقارنة، و مبدأ نسبية المعرفة الإنسانية) ويطبق هذا النهج على الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالدين والاعتقاد وهنا رؤيتان:
الأولى: ترى ان التزاحم والتعارض الحاصل بين الدين والعلم او بين الاعتقاد والتحديث تخضع لقواعد منطقية واحدة شرط ان يكون لها القدرة على التحليل والاستنباط، لضبط التشابه في ميزات تلك الظواهر مع بعضها باستثناء ما يظهر في جزء منها من متغيرات هامشية لا تمس جوهر القانون المفسر للظاهرة. ويمكن ان تدرس في ضوء التقدم المنهجي للعلوم الإنسانية وادواته الاركيولوجية والتاريخية وسوسيولوجيا الفكر الاجتماعي
الثانية: ان لكل تجربة دينية في مجتمع ما منطق خاص يخضع لطبيعة الوضع التاريخي والاقتصادي لذلك المجتمع يمكن تسميته ب (الصيرورة الحضارية) فالتجربة المسيحية تختلف تماماً عن التجربة الإسلامية. وهكذا بقية تجارب الأديان فتكون لكل تجربة موازينها الخاصة ونسيجها المغلق او المفتوح لضم المتغيرات في الفكر الانساني
وقد رجح أصحاب الاتجاه الاول القواعد العامة للتفكير الفلسفي في قراءة الظواهر، فالأديان عندهم: انقلاب تغييري شامل على الوضع الذي يسبق ظهورها) تبدأ بنص ثم يتداخل معه الجهد العقلي للمؤمنين به فيتحول الاتباع اما الى عقلانيين او نصيين ويكون لكل من المسلكين قواعد منظمة للسلوك ونزعات فكرية صانعة للموقف، وتتفرع عن المدرسة العقلانية اتجاهات يصل بعضها الى ما يقف الملتزمون بالتراث الإسلامي فيه على حافات العلمانية، اما المدرسة النصوصية فيظهر فيها تطرف يصل الى مقاربة وثيقة الصلة بالمنهج السلفي في تعامله مع (النصوص المفسرة للنص التأسيسي) وهذا يؤسس الصدام بين الدين وكل نظريات التحديث في ازمنة الإسلام المتعاقبة وهذا الذي حصل في التطورات الحضارية مع مجتمع الديانات اليهودية والمسيحية والجماعات التي انتمت الى الأديان الشرقية بل وحتى المعتقدات الوضعية كالماركسية، وطبقاً لبدايات هذا البحث فان افضل من يمثل الاتجاه الأول د.عبد الوهاب المسيري فهو يرى ان العلمانية نتاج لتحولات عالمية (لكل الشعوب) وانها قرّبت العالم بعضه مع بعض من ناحية التاريخ والمسارات العامة في الاجتماع السياسي، وانها صورة العالم المستقبلية من خلال تحولات اجتماعية حتمية، وأقصى الخلاف ان اوربا قد سبقت العالم في نشأتها وانها ستحصل في غير اوربا بحسب المنطق التاريخي، ولو بصور أخرى
كما يرى ان مسيرة التاريخ عبارة عن سلسلة متراكمة ليست بالضرورة متكاملة مكونة من عمليات اجتماعية ومعرفية بسياق متماثل فقد تتشابه تماماً وقد تتفاوت جزئياً فهي كغيرها من مميزات أي مركب تاريخي، فيه من الهوامش والمتغيرات غير الجوهرية لكن يبقى منطقها واحد من حيث الجوهر(2)والمبادئ العامة والمنطق الاساس.
اما الاتجاه الثاني: فيرى ان لكل امة ظرفاً تاريخياً خاصا بها وهو (المرّكب من ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) ولهذا الظرف أثره في أي فكر بشري سواء كان مستندا الى الفكر الديني ام الفكر البشري المطلق، وان لذلك الفكر أثر على الواقع الاجتماعي وهذا الذي يسمونه (التموضع الجدلي) أي انعكاس آثار الوضع الحضاري والتطور الاجتماعي على المنتج الفكري او التحولات الفكرية، وتاثيرالتحولات الفكرية على خلق ظروف اجتماعية، وعليه فإنَّ العلمانية في اوروبا نتاج اوروبي خالص لا يمكن قسره وفرضه على بلدان غير اوربية او بلدان مرت بتجارب أخرى، لاسيما التجربة التاريخية في الشرق الأوسط لاختلاف الصيرورة التاريخية لاوروبا عنها في الشرق الإسلامي لأن العلمانية فكر ناتج عن الصراع بين المسلك الكنيسي من جهة (3) وبين النزعة العقلانية المتولدة في جامعات اوربا واللافت ان المسلك المعرفي الايماني الكنسي فكر المسيحية، لا يتشابه مع علاقة الإسلام بالعلم والعقلانية، وعلى هذا فأن هذا الاتجاه يقلل من فرص تقبل العلمانية الاوربية في منطقة الشرق الأوسط ويراها محاولات تنويرية غربية قد تفضي الى مفاصلة بين الحاضر والتراث وتخشى ان تؤدى الى نزعة علمانية متطرفة تقف من القيم الموروثة موقفا مضادا نتيجة تأثرها ببعض المدارس التجديدية الغربية في اوربا.
ولذلك فاستراتيجيات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي هي غايات السياسات العامة ومتطلب استراتيجي لأمريكا واوربا في رؤيتها لشرق أوسط جديد تواجه صعوبات جمّة لإنها تريد نقل التجربة الاوربية للعالم الاسلامي (4)نقلا لا يراعي الصيرورة الفكرية للمجتمعات الشرق أوسطية وتبعا لرفض مجتمعاتنا للمفهوم الغربي للعلمانية فان نظريات الحداثة في العالم الإسلامي تواجه مشكلة ايديولوجية(5) مرتبطة بالتراث والاعتقاد، وتواجه تطبيقاتها رؤى مشوّهة مثل مهمات منظمات المجتمع المدني، والتشكيل الديمقراطي المستنسخ للسلطة في بلدان الشرق الأوسط ويواجه صعوبات التصادم بين العقل السياسي الموروث وموجبات الحداثة، لان اصل هذه المفردات الأربعة (العلمانية، الديمقراطية، الحداثة، المجتمع المدني) مفاهيم غربية لها تطوراتها كونها من نتاج اوروبي أولاً . ولان العقل التراثي يربط بين نتاج التجربة الغربية وبين الكفر الاعتقادي وبينها وبين العدوان الاستعماري، ولان التجربة الغربية في ممارستها الانتدابية بعد الحرب الأولى على العالم الإسلامي قد مارست التصادم بدل التعاون وتعطيل التنمية والاستلاب والمواجهة العسكرية وعلى خلفية التضاد الحضاري المرتبط بالدين فان الوعي التاريخي ينفر تماما من التجربة الاوربية، إضافة الى ان المستقر في الذهنية العربية والمسلمة من ان الغرب مصدر العدوان على الشعوب الاسلامية
ومن جهة السلوك المتعصب نجد ان من أبرز دوافع اليمين الاوربي (فرنسا: إنموذجا)، واليمين الأمريكي الإنجيلي في ممارسة الحرب على العالم الإسلامي هو الدافع الحضاري المتضاد فيكون الامر استحالة بناء علاقة سلمية مع الغرب، والمحصلة انه لا الغرب يساعد الناس في الشرق الأوسط من خلال سياسات الشراكة الدولية المتكافئة على اجراء التفكيك بين التقدم المنهجي والمعرفي والحصائل الإيجابية للتجربة الغربية وبين السياسات الاستعمارية، ولا العالم العربي يستطيع ان يكتشف مشروعه النهضوي حتى لا يحتاج الإنجاز الغربي (التقني والمعرفي والمنهجي) ولا يفصل بين التضاد الديني والنزعة الاستعمارية قديمها وجديدها في تصوره عن الغرب.
وهناك اتجاه ثالث يحاول الخروج من قهريات هذين الاتجاهين الى مركب ثالث: وهو ان الظواهر الاجتماعية (الدينية /الاقتصادية /الاجتماعية) لها قوانينها المركزية ككل حركة في هذا الكون للاعتقاد بان الكون بأجزائه وحركته يخضع لقوانين السببية، وكثيرا ما تتشابه الأسباب وتتكرر المسببات، وبتشابه الأسباب تتشابه النتائج وبتكررها تتكرر النتائج – فهناك إذن حزمة ثابتة من قوانين الفعل التي تحدد مخرجاته وتعمل في صلب او في مركز الحركة الاجتماعية التاريخية، وهذا هو القدر المقبول في تنظيرات هيجل وكارل ماركس(6)، وهذه الأسباب ربما تتحد بالنوع وتتفاوت في الرتبة فتتفاوت النتائج تبعا لها، وقد تختلف حتى في النوع وهو نادر لان الأفعال والاستجابات بإزاء التحديات تدخل في اطار النمطية الفطرية للإنسان، فالاختلاف يقع في نوع عوامل التحدي ورتبتها، اما تفاوت الردود والاستجابات فستكون تبعا لها، واظن ان ذلك التصور ناتج عن قوانين فيزياء الحركة الاجتماعية أي وجود قوانين ثابتة وهامش متغيرات الى جانب ذلك فان هذين الاتجاهين حصريان في اعتمادهما على حزمة محددة من عوامل التفسير، بينما الحركة الاجتماعية متسعة لأكثر من حزمة من عوامل التفسير، لذلك فان الذي هو اقرب للقناعة في تفسير الظواهر هو الإقرار بوجود(قوانين سببية مركزية ثابتة)، وان التموضع في تلك الظواهر يعتمد على نوع الاسباب ودرجتها الى جانب هوامش فاعلة لكنها متغيرة فالعلاقة بين الوحي والعقل والعقلانية مثلاً يحكمها قانون من الصعب اكتشاف نقطة التوازن فيه، فاذا كانت مهمة الوحي والانبياء والشرائع العمل على تأهيل الانسان لكي يؤدي مهامه الاستخلافية في الأرض كما نصت عليه آيات القرآن فالأديان اذن عبارة عن نظريات في الأطر العامة والكليات المؤسسة (فما وجد فيها من التفاصيل في النصوص فهو نافذ وما كان من المبادئ العامة والكلية فان بوصلة التفكير العقلي وما حصل من استنتاج عقلي قاطع ايضا فهو حكم قطعي لا مجال بعد ذلك لرده، لان النص من عند الله الذي هو في عقيدة الاسلام سيد العقلاء والمحيط المطلق بمكنونات الأشياء ويستحيل ان يتضاد مع العقل).
لقد ظهرت هذه الجدلية في زمن مبكّر من أزمان حضارتنا حين طرح المفكرون المسلمون نظرية التحسين والتقبيح العقليين التي استند فقه المصالح وفقه المقاصد عليها كما تأسس عليها أصل الاستحسان وسد الذرائع وفتحها، والاحكام المؤسسة على البراءة العقلية والاحتياط العقلي وأبحاث الملازمات العقلية المستقلة(7) ثم حصل التطور الذي اعقب ذلك عند ابن رشد في ان الحكمة والشريعة مرجعيتان لا يتصور تضادهما فكلاهما مصدر لاكتشاف الحقيقة الكونية وان اختلف المنطلق والمسار(8)، واني اظن انه لو لم يقف الابداع الفكري للمسلمين بعد ابن رشد ولو تراكمت منطلقاته على فصل الخطاب لاستطاع العقل العربي ان يكتشف مشروعه النهضوي الجامع بين اشتراطات الوحي وضرورات العصر، و بين مساحة العقل في التأسيس النظري والعملي للرؤية المتوازنة لتطور المجتمع الإسلامي المنسجم مع تجارب التقدم الإنساني بعامة.
على ذلك فانه: لا يصح- بناءً على هذا التصور نقل تجربة اوربا للشرق الأوسط والعالم الاسلامي لاختلاف عوامل الصيرورة او لتفاوت درجة تلك العوامل حتى مع افتراض التناظر بينها، كما لا يصح الاغفال القسري والمتعمد لتجارب الشعوب لوجود حزمة من القوانين الثابتة لأي حركة في أي مجتمع بوصفها قوانين جوهرية تخص صلب عملية التحولات الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لاعتبار حزمة القوانين الفاعلة وان كانت متغيره، وكمثال على ذلك ا لجهد العلمي المبذول لتحقيق التقدم الإنساني في مجالات الحياة في الوسط المسيحي في اوروبا، والجهد المبذول في الوسط الإسلامي الذي دار حول العلاقة الجدلية بين النص الديني والعقلانية، والنزعة النقدية، او بين قداسة النص فلقد تعددت المواقف بإزاء هذه الجدلية الإشكالية المتقادمة تاريخياً مع التذكير بان الفكر الاسلامي قد تحسس هذه الإشكالية تحسسا مبكرا وبذل لأجلها جهودا تنظيرية عميقه ومتواصلة، ومن ذلك ما عرف من اراء على مستوى العلاقة بين النص ومعطياته والاجتهاد ومعطياته والدائرة المتاحة لكل منهما(9) ولقد تبلور عن تلك التنظيرات اتجاهات منهجية متعددة
الاتجاه الأول: ظهور اتجاه مبكر يتبنى نظرية معرفية مستلة من منطوق النص فقط، ويوجب على المؤمنين به الاعتراف بقراءة واحدة لذلك النص رغم أنه نص متعدد الدلالات، ويميل هذا الاتجاه الى ان مالم ينص على واقعة من الوقائع نص فالحكم فيه اما المنع اوالتوقف حتى يرد الدليل على الجواز، والنماذج المبكرة لهذا الاتجاه هم عبد الله بن عمر ومفكرو الخوارج عقديا، والحنابلة رواية والظاهرية فقها، وامتدادات هذه الاتجاهات التي استمرت حتى يومنا هذا وان حصل فيها قدر من التعديلات على مسارها وتطورها الفكري.
الاتجاه الثاني: هو اتجاه يتعامل مع النصوص على انها في الغالب قواعد كليه وأطر قيمية موجهة، وتتساوى فيها مجموعة من الدلالات المتعددة في النص الواحد من جهة مشروعية الاستنباط فالاختيار في العمل بها يتم بين الراجح والأرجح والصحيح والاصح بحيث يفسح المجال لإجتهاد يستند الى تعدد الدلالات حتى يستوعب المستجدات والتطورات الزمانية ويتسع لتعدد الآراء والمواقف.ويلجا فيما سكت عنه النص الى العقل والمقاصد اللذين لهما الامكان على ادراك المصالح والمفاسد من خلال متعلقات الأحكام وان كان ذلك في نطاق الاحكام الظاهرية وهو اتجاه يطلق عليه بالفرق العدلية (الاجتهاد والعقلانية).
الاتجاه الثالث: يعتقد ان النص جاء مرتبا لأوضاع تاريخية في القرن السابع الميلادي وقد طور النص الديني العقل البشري للاجيال حتى إذا تمكن عقل الانسان من الرشد الحضاري خوله النص نفسه باعتماد النظم الاجتماعية التي تؤدى الى سعادة الانسان، فانجازات الفكر الإسلامي تراث فكري وهذا الذي نعيشه هو انعكاس لعصور انتاجه (10).
ويمثل امتداد الاتجاه الأول ما يطلق عليه بالسلفية العقدية وفروعها، ومنها السلفية القتالية، ويمثل الاتجاه الثاني التنويريون الإسلاميون على مختلف قراءاتهم المتفاوتة في الدرجة وليس في النوع، ويمثل الاتجاه الثالث حاليا الاغتراب الفكري والقوى العلمانية التي تضم الى جانب هذه الرؤية تأثرها بالتجربة الغربية العلمانية بعد القرن الثامن عشر الميلادي
الجذور الفلسفية للعلاقة بين النص الديني والعقلانية:
ان جذور هذه الإشكالية في العلاقة بين الوحي والفكر الفلسفي الإنساني قديمة ومبكرة وكانت على اتجاهات أربعة:
الأول: اتجاه الفيلسوف الكندي المبكر زمنيا، والذي يرى ان الفكر الفلسفي خادم للشريعة، ووظيفته ان يقوم بصناعة البرهان لتصديق مقولات الشريعة، وبهذا يكون الفكر الفلسفي أقرب الى علم الكلام وان كان الكندي يرى ان منطلقات هذا الفكر تبدأ حرة مستقلة لكنها تهدف الى نقل الحقائق الشرعية من نمط الدليل الخطابي الى الدليل البرهاني (11).
الثاني: إتجاه الفارابي الذي يرى ان مقولات الوحي هي (المثالات الفلسفية وان الشريعة هي التطبيق الاجتماعي لتلك المقولات فيقول (ان ما في الملة هي مثالات لِما في الفلسفة سوى ان الادلة العملية خطابيات وجدليات لكنها تعبر عن الحقائق المثبتة بالبرهان)(12).
الثالث: اتجاه ابن سينا والذي يرى ضرورة دمج الفلسفة في ثنايا الشرع ودمج الشريعة في النظر الفلسفي وقد (استند محمد عابد الجابري على رأي ابن سينا فعده المؤسس للالتجاه العرفاني الذي تسبب في ضمور النزعة البرهانية في العقل العربي، وعد رسائل اخوان الصفا تراكمات علمية على أسس ابن سينا (13)
الرابع: اتجاه ابن رشد: ويرى ان الحقائق الكونية المادية والإنسانية والفكرية حقائق ثابتة وازلية وان لاكتشافها فرعان: فرع الوحي (الشريعة) وفرع الحكمة (الفلسفة) وهذان الطريقان وان اختلفا في المنطلق والمسار لكن مع صحة الاستدلال فيهما سواء أكان الشرعي ام العقلي وسلامة المنطق فانهما سينتهيان الى موقف واحد، وإكتشاف واحد للحقائق، ولأنهما – معاً - يؤديان الى اليقين، وحيث هما كذلك فلا يتصور بينهما حصول التناقض او التضاد، وعليه فالنظر البرهاني لا يخالف الحق ولا يؤدى الى مخالفة الشرع فالحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. (14)
ونكرر هنا: ان لو كان مشروع النهضة قد تأسس على الرشدية فقد كان من الراجح ان يصل الى صياغة موقف متوازن بين الشرع والحداثة والعقلانية، ويؤيد ذلك مايراه اكثر من باحث من ان الرشدية كانت عاملا فكريا مهما في الموجة التنويرية الاوربية، لكن بزوغ الرشدية عندنا كانت على اعتاب بدء زمن التردي في منتجات الحضارة الإسلامية فتاريخ وفاة ابن رشد (595 هـ - 1198 م) هو الزمن المقارب لذروة افساد حضارة القرن الرابع الهجري ذلك الافساد الذي أدى الى سقوط بغداد 656 هـ - 1258 م والذي سبقه تحريم الشهرزوري ت (643 هـ)للفلسفة والمنطق وغلق الاجتهاد، ولأنه لم تظهر بعد الرشدية نظرية نهضوية تجمع بين مفاهيم التحديث والعقلانية ومسالك الاستنباط التنويري من النص اذ القرون الخمسة التالية على سقوط بغداد كانت قرون الحواشي والشروح والمطولات على المتون الإبداعية التي انتجتها القرون السابقة، ثم جاء زمن اختصار الحواشي والشروح التي سميت بـ (المختصرات) والاراجيز الشعرية التي جمدت المعرفة في قوالب التلقين (15)وقد اسلم هذا الوضع الفكري العالم الإسلامي بعد خمسة قرون الى عصر المواجهة مع الغرب في أواخر القرن التاسع عشر فواجه الغرب وهو مثقل بالمعرفة (المنتجة قبل عدة قرون) حتى بانت الفاصلة التاريخية بين الفكر العلمي المنتج في مطلع القرن العشرين الميلادي وبين الواقع الفعلي لمشكلات الواقع في بلدان المسلمين فلم تعد المعرفة الاستنباطية تعبّر عن الواقع القائم في اشكالياته وعلاجاته فسميت هذه الفاصلة بالفجوة المعرفية بين الواقع ونظم المعرفة الاسلامية ومكوناتها، في وقت جاء الغرب متدرعا بالنواتج المعرفية الجديدة والمنهج المطّور والتقنية المتقدمة ودخل في مواجهة مع مجتمع تخلفت معارفه عن واقعه الفعلي فكانت خسارة العالم الإسلامي لمعركته مع الغرب حالة منطقية، لاسيما اذا عرفنا ان الدراسات الاستشراقية كانت قد وفرت للغرب خارطة تفصيلية عن الثغرات الكبيرة الفاصلة بين العقل الإسلامي والواقع الفعلي، ومع تخلف التراث الموروث عن الواقع الفعلي آنذاك فقد جاءت اوربا برؤيتها التبشيرية عن العلمانية بوصفها المنقذ من التخلف في عالم المسلمين كما نجحت في انقاذ اوربا من التخلف الكنسي فانتشرت فكرة العلمانية في العالم الإسلامي كطريق من طرق تفكيك ازمة التخلف.
فما هي العلمانية وما مراحلها وما الخلاف في توجهاتها؟ وهل تصلح مشروعا نهضويا في العالم الاسلامي؟
لعل مفهوم العلمانية من المصطلحات او المفاهيم التي أصابها لبس فكري كبير وتغايرات في التوصيف العلمي وذلك اما من جّراء تموضع الظاهرة كما تقدم او من تداعيات الترجمة فهناك من يرى انها ترجمة لكلمة (secularism) أي النمط العلمي في إدارة الحياة بعيدا عن التوجهات الماورائية الغيبية سواء اكتسبت قداسة دينية ام لم تكتسب، ويرى آخرون إنَّها نسبة الى العالم المادي بما يقابل الروحي والكهنونية والاكليركية أي أَنْ تدار المجتمعات في ضوء قوانين الطبيعة وقوانين الاجتماع الإنساني(16) أي ان ترجمة العلمانية (هي الدنيوية) أي إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة واللادينية في الحكم. وعلى الترجمة الاولى: يعلق الشيخ محمد مهدي شمس الدين بالقول (ليس هناك انسان عاقل يمانع في تسيير حياته بما وفره العلم ولأجله لامعنى لتسمية دولة بانها علمانية لأنها تستخدم منجزات العلم فحتى دولة الفاتيكان على هذا التوصيف دولة علمانية، ثم يستنتج ان حقيقة المصطلح يعني ان مرجعية السلطة السياسة والتشريعية خارج الفكر الديني مطلقا) (17) .
وفي مدى العلمانية هناك قراءات منها مالا يتعامل مع الابعاد المعرفية الكلية الشمولية أي لم تتحول عنده العلمانية الى فلسفة كونية، انما تبقى رؤية إجرائية سياسية يتوقف فيها اسناد السلطتين التشريعية والسياسية للبلدان على الإرادة الحرة للناخبين، وهذه الوجهة لا تنكر وجود مطلقات او كليات أخلاقية او غيبية او لكنها لا توظفها ولا تستمد منها الشرعية ولا تجعلها مرجعية لها (18)
وقراءة ترى ان نشأة العلمانية وماهيتها انها رؤية كونية مادية شمولية تتعارض تماماً مع الدين وتحاول التشكيك بكل القيم السماوية المطلقة وانهاء اثارها على المجتمع، وهناك تصورات لهذه الرؤية منها ما ينكر انها متتالية تاريخية تتحقق في كل المجتمعات، انما ظهرت في اوربا بشكل حصري فلانها في اوربا كانت المصداق الاسبق فقد حفز تعسف سلطة الكنيسة وتطرفها بتكفير العلم والحداثة فجاءت حلاً لازمة الصدام بين سلطة الكنيسة والسلطة الزمنية التي تبنت العلم والعقلانية الواقعية، وقد ابتنت عليها الثورة الفرنسية والامريكية والثورة الصناعية وكانت مقدمة لموجة الحداثة – وما بعد الحداثة وصولاً الى العولمة والموجة الرقمية فهي لا ترى ذاتها قانوناً مجتمعياً وحتمية تاريخية تحصل عند اتباع الأديان كافه بعد اصطدام العقل بتفسير النص. مقابل من يرى انها قانون كوني وحتمي لابد ان تمربه كل المجتمعات
وبحسب الإنجاز الأوربي فقد قدمت العلمانية نفسها بأنها الرؤية الارقى وأنها المحقق لحلقات التقدم التقني، وانها نهاية التاريخ لكن الذي نعتقدْه ان عدة عوامل أنجزت التقدم ربما تكون العلمانية هي من بينها، او من أفضل عوامله ولكنها قدمت الى الفكر الاسلامي بدرجة من الشمولية والتعميم الفلسفي على انها علة التقدم، ولم تقدم على انها الغطاء الأيديولوجي الموظف لنمط السيطرة الغربية على العالم فكرياً وسياسياً وعلمياً كقراءة لتأسيسات (جون هوليوك 1817-1906) الذي يرى ان العلمانية هي (الايمان بإمكانية اصلاح حال الانسان من خلال الطرق المادية دون التصدي للأيمان بالله سواء بالقبول او الرفض) (19) وهذا التوصيف يفترض الحياد. لكن الذي حصل فعلاً انها لم تمارس الحيادية التي وصفها هوليوك من جهة، وظهر انحيازها للمعايير القيمية الدنيوية من جهة اخرى لتأكيد قضية عزل الدين تماماً عن الاسهام في ادارة الحياة وفي صياغة الانسان والمجتمع.بل ان انحيازها الى اعتماد معيارية القيم المادية جعلها تقدم نفسها جزءاً من رؤية كونية شمولية، تتوسل بعقلانية متطرفة غير مرنة وآداتية إقصائية ترفض المرجعيات الاخرى، وتعبر هي عن نزعة أصولية راديكالية تبدو في كثير من الأحيان اكثر تأزماً من الراديكاليات الدينية فالعلمانية بهذا المسلك لا تتجسد في النشأة السياسية كبوابة للتقدم فقط لكنها تتداخل في المجالات الانسانية الأخرى كأنها الضد النوعي للفكر الديني وتنمو فيها راديكالية اقصائية عنيفة كما تنمو في داخل التيارات الدينية السلفية. وبهذا لا تقدم العلمانية كونها رؤية وليدة للغرب وناتجة عن ظروفه التاريخية وهي بالنسبة للعالم الاسلامي فكر مستورد مفروض على المجتمع الاسلامي لاسيما على النخب الحاكمة المتحالفة مع الغرب منذ تأسيس الدولة العلمانية بعد معاهده سايكس – بيكو، انما قدمت نفسها بوصفها رؤية فلسفية لبناء الدولة وإدارة المجتمع على أسس علمية لكنها عندما طبقت في العالم العربي نتج عنها فشل المشروع التنموي على مدى قرن، واقترنت معها ممارستها القمعية ضد حقوق الانسان فصارت مثالاً لارهاب الدولة وفشلها في تحقيق الحداثة الحقيقية، فتساوت مع الاصوليات الدينية من حيث المحصلة حتى فقدت الممارسة العربية الاسلامية للعلمانية مصداقيتها التاريخية، بل ساهمت في زيادة المآساة في مجتمع طحنه الغرب المبشر بالانموذج المادي والمتطلع الى نهب ثرواته. ولعل مراجعة تاريخية سريعة لبعض التجارب العلمانية في العالم الاسلامي يكشف عن فقدانه المصداقية التاريخية لها وسنرى ذلك بعد قليل في استنطاق تجاربها.
لقد صيغت العلمانية على انها نتاج تحولات عالمية قربت العالم مع بعضه من ناحية التاريخ والمسارات العامة في الاجتماع والتقدم فهي رؤية للعالم كله وان نشأت من تحولات (سبقت في اوربا) اما التحولات التي حصلت في غير اوربا والتي ستحصل فلا صلة لها بالصيرورة العلمانية الاوربية انما لها صلة بالمنطق الذي يحكم العلاقة بين الدين والعقلانية كما يرى أصحاب هذه النظرية.لكن الذي يجب ان نتامل فيه ان مسيرة التاريخ وان كانت سلسلة متراكبة لكنها ليست بالضرورة متكاملة من العمليات الاجتماعية والمعرفية، وغيرها من ميزات المرّكب التاريخي وعلينا ان ندرك، ان التزام المسلمين بالحقوق والحريات المدنية يعد التزاما منهم باحترام الفكر الانساني فلم نجد فيه على مدى قرون تصادماً بينها وبين حقائق الشريعة،وليس التجربة السياسية الاسلامية لانها وقعت في إشكالات كثيرة ولم تفرض الشريعة حجراً على العقلانية كطريق لاكتشاف المعرفة وصنع السياسات، كما انه لاشرعية لسلطة لم تتشكل بموجب الارادة الحرة في النظرية الإسلامية (القرآن والصحيح من السنة الشريفة) لذلك يعتقد. حسن حنفي ان جوهر الحقائق في العلمانية متحقق في الرؤية التنويرية الاسلامية فاعتماد المسلمين على العلم والعقلانية يمكن ان يتم في ظل القيم الدينية الانسانية الرفيعة ومبدأ المساواة حاصل إذا قرأنا الاسلام من منظور انساني وان مبدأ الاجتهاد عند المفكرين المسلمين لا معنى له إذا لم يتبنً الروح النقدية الموضوعية لكل الفكر سواء كان تراثياً او وافداً ولكن على منظور المنهجيات الإنسانية المبرهنة.
فالعلمانية -اذن في الواقع الاسلامي-ليست مشكله فكريه وليست تحدياً جوهرياً على مستوى الدين ولا على مستوى السياسة ولا على مستوى المجتمع.لان في الاسلام مزجاً باحكام بين الديني والدنيوي، وبين العلم والعقيدة، وليس فيه ازدواج في السلطة الدينية والدنيوية فالسياسيون مجتهدون في صياغة السياسيات التي تطبق في ظل القيم الإنسانية وتجري طبقاً لها تطبيقات المعرفة العلمية الان والتكنوقراط المسلمون ليسوا ضد الدين، كما ان علماء الدين ايضاً ليسوا ضد الحقيقة العلمية، فاذا عرف التكنوقراط ان لهم منهجا استدلاليا يؤخذ منهم ويرد عليهم تعاملوا معه برحابة صدر، كما ان الفقه وأحكام العقيدة ليست مجموعه أسرار وطلاسم اذ هي عرضة للحوار والنقد وعندئذ فانهم سيشاركون باكتشاف الحل للمشكلات الاجتماعية.واذا كانت العلمانية تقدم نفسها بوصفها فلسفة للتقدم فان تجارب عالميه متقدمة كانت قد احترمت التراث الديني وتقدمت تقنيا، فاليابان مثلا ودول جنوب شرق اسيا وكذلك الصين والهند كلها تجارب علمانية ناجحة على اختلاف منهجها لكنها تشترك في احترام التجربة الدينية فكان التقدم حصيلة فعل الانسان ووعيه الديني والتاريخي والسعي لإقامه مجتمع المعرفة دون اقصاء الدين.
إنَّ قراءة علمية للإسلام، وقراءة متوازنة لتجربة العلمانية في الغرب يمكن أنْ تقدم مشتركا فكريا، وحلاً للخصومة التاريخية بين الإسلاميين والعلمانيين، ويمكن أنْ تصنع التقدم والعقلانية والديمقراطية وكرامة الانسان والتعايش السلمي وتؤسِّس لشرعية الاختلاف واحترام الأخر على اسس الموضوعية وليس على ثقافة الاتهام، وقراءة كهذه يمكن ان تحقق الاهداف التي يتم اعتماد العلمانية لتحقيقها دون استلاب للهويه الحضارية ودون إحداث القطيعة مع التراث الديني المشرق ودون حصول ازدواج وتضارب بين الحاضر والماضي.
واجابة على سؤال الاتجاهات العلمانية حول كون التراث الفكري الإسلامي هل يصلح اساساً للمشروع الإسلامي للنهضة؟ والجواب ان الافكار في التراث على ثلاثة انواع افكار حيه مستمرة في الاسهام الفاعل بمشروع النهضة وافكار ميته أنتهى دورها، وافكار قاتله، والرؤية النقدية كافيه للفرز بين هذه الأنماط من الافكار واحياء الأفكار العظيمة التي بها تحققت اهداف المشروع النهضوي، فان دعم القراءة التنويرية للإسلام والتخلص من الاستتباع الحضاري لاوربا هو المنقذ للخروج من مأزق الارتباط بالغرب، فعلى الاسلاميين ان يراجعوا عصور استخدام العنف الصادر (من السلطة او من المجموعات المتشددة) في ثقافة تجربتهم كما ان على العلمانيين مراجعة استخدامهم العنف في العصر الحديث تحت مظلة العلمانية لتطبيق فلسفة اللاعنف ولابد من مراجعة فشل المشروعات التنموية في العالم الإسلامي ومراجعة الأسباب التي دفعت بالدعاة الإسلاميين لكي يتحولوا من دعاة سلميين ومتسامحين الى عصابات قتل وتدمير ومجموعات متشددة لا تملك مشروعاً للانسان. وإذ كنا نعتقد أنَّ العلمانية شرط للحداثة في اوربا، فانها ليست شرطاً للحداثة في العالم الإسلامي ونرى أنَّ التنوير الاسلامي شرط للحداثة في العالم الاسلامي، وإنها شرط للديمقراطية في اوربا في حين ان التنوير يعني الفهم الإيجابي القويم للنص الديني فيكون شرطاً لتجربة متقدمة في الشورى في بلدان العالم الإسلامي وعلمية. واعتقد ان الموجه الفكرية التنويرية في عالمنا لها من الامكان ان تجدد ذاتها بتجديد التراث الفكري برمته وان على القوى العلمانية ان تقبل اسلمة الحداثة على اسس برهانية وصارت معرفة متداولة . ودخل على التصوف مد تصحيحي قدمت فيه تعاليم نظرية لدعم الممارسات وكان جلال الدين دواني قد احيا فلسفة نصير الدين الخواجة وعلق على فلسفة السهروردي فصارت الثقافة العقلية مركبة من (المشائية نهج ابن عربي وتنويرية السهروردي)
وظهر صدر الدين الشيرازي صاحب الاسفار والحركة الجوهرية، وفلسف حيدر املي تعاليم اهل البيت ووصفها بلائمه الكمال النهائي لقد وفر الملا صدرا ثيولوجيا اماميه مندمجة مع الاطار الفلسفي، ثم نجد عملاقا اخر هو الشيخ البهائي العاملي (ت 1622م) الذي كان الى جانب كونه فقيها كان عالما بالفلسفة والتصوف ومتادبا بالشعر العرفاني ثم مهندسا معماريا لكن هذه الحداثة قوبلت كاي تجديد علمي وفكري بمعارضة، فظهر الحر العاملي (1111هـ) في كتابة (الفوائد الدينية في الرد على الحكماء والصوفية) لقد كان ذلك الإنجاز المعرفي المهم قاعدة فكرية للانطلاق نحو افق ارحب للمعارف والعلوم والفكر الإسلامي المنطلق مع التأمل والبرهان معا
***
الأستاذ المتمرس
د.عبد الأمير كاظم زاهد
.................................
توثيقات البحث
سامي زبيده: الشريعة والسلطة في العالم الإسلامي 135
عبد الوهاب المسيري: إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد 1/271
محمد مهدي شمس الدين: العلمانية 27
برنارد لويس: صدام الإسلام والحداثة ص 126
عادل ضاهر: اللامعقول في الحركات الإسلامية 73
كارل ماركس: رأس المال ترجمة فالح عبد الجبار ظ 17 ص 115
حمد الكبيسي: أصول الاستنباط ص 77، ظ كذلك: السيد محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن ص 361
ابن رشد الحفيد: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال تحقيق محمد عماره 37
محمد احمد شريف: فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين ص 61
محمد عابد الجابري: نقد العقل العربي (البنية والتكوين) جـ 1 ص 259
حسام الدين الالوسي: فلسفة الكندي ص 351
الفارابي: المدينة الفاضلة، ظ محسن مهدي: الفارابي وتأسيس الفلسفة الإسلامية 239
محمد عابد الجابري: نقد العقل العربي (البينة والتكوين) جـ 1 ص 259
ابن رشد: فصل المقال، مصدر سابق ص 38
د.عبد الأمير زاهد: ازمة المشروع الحضاري، الصيروره واشكالية المنهج، بحث في اعمال المؤتمر الفلسفي العربي الثاني (بيت الحكمة) آذار / 2001 ص 120
المسيري: إشكالية التحيز 1/272
محمد مهدي شمس الدين: العلمانية ص 28
المسيري: إشكالية التحيز 1/273