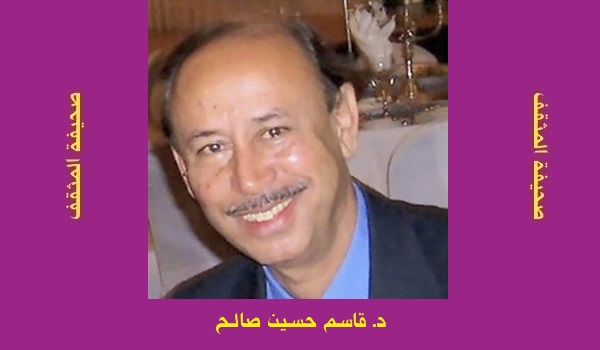أقلام فكرية
محمود محمد علي: سؤال نظرية هوية العقل بوصفه مخاً

نظرية هوية العقل بوصفه مخاُ the mind–brain identity theory هي نظرية تابعة للمدرسة الفيزيائية في فلسفة العقل، وهذه النظرية تؤكد هوية العقل من خلال أنه يمكن تجميع الأحداث العقلية (المخية) وفرزها إلى أنواع types (مقولات أو فئات) من الحالات العقلية، كحقيقة عرضية، متطابقة حرفيًا مع بعض أنواع (مقولات، أو فئات) وذلك من خلال حالات عقلية، وهي في الأصل حالات فيزيائية في المخ، والعقل والمخ شيء واحد. وإن شئت عبارة موجزة تلخّص لك نظرية الهوية، فها هي عبارة "هربرت فايجل" (1902-1998) نقلا عن أستاذنا الدكتور صلاح إسماعيل: “حالات الخبرة المباشرة التي تحيا بها الكائنات البشرية الواعية، والحالات التي ننسبها بثقة إلى بعض الحيوانات العليا، تكون متطابقة مع جوانب معينة من العمليات العصبية في هذه الكائنات".
وفكرة أن الحالات العقلية هي حالات مخ ليس جديدة، حيث يمكن أن نتلمس إرهاصاتها عند فلاسفة اليونان القدماء، من أمثال ديمقريطس، والذي كان يرى أن النفس مادية ومؤلفة من أدق الجواهر (الذرات) وأسرعها حركة، إذ إن النفس امثل مبدأ الحركة في الأجسام الحية، وهذه الجواهر منتشرة في الهواء الذي يدفعها للأجسام فتتغلغل في البدن كله، وتتحدد في النفس في كل آن، وما دام التنفس مستمرا دامت الحياة والحركة والشعور للبدن، وإذا فقد بعضها كان النوم واللاشعور، وإذا فقدت كلها كان الموت الحقيقي فناء البدن، وأمضى ديمقريطس مذهبه ووضعه في الصيغة النهائية التالية " إن كل شيء هو امتداد وحركة ولم يستثن النفس الإنسانية، ولم يستثن الآلهة أيضا، فيرى أنهم مركبون من جواهر كالبشر إلا أن تركيبهم أكثر دقة، ولذلك هم أحكم قدرا وأطول عمرا بكثير، ولكنهم لا يخلدون بل كل شيء خاضع للقانون العام ؛ أي للفساد بعد الكون واستئناف الدور على حساب ضرورة مطلقة ناشئة من المقاومة والحركة والتصادم دون أي غائية أو علة خارجية عن الجواهر.
كذلك نجد إرهاصاتها لدى الفيلسوف اليوناني " أرسطو"، والذي رأى أن النفس هي صورة الكائن الوحيد، وأنه لا يمكن فصل الصورة عن المادة (الهيولى) من الناحية العملية، وإن أمكن ذلك من الناحية النظرية العقلية، وقد فهم أنصار الهوية هنا أن عدم الانفصال هذا إشارة إلى وحدة النفس والجسم.
ومن تجليات هوية العقل بوصفه مخاُ ما نجده في تراثنا العربي الإسلامي، حيث إنه عندما جاء الإسلام بنزول القرآن تبلورت فلسفة عملية ترتكز على جملة مسلمات عقائدية، من بينها، الإيمان بالمعاد الذي يستند بدوره إلى الاعتقاد بلا مادية النفس واستقلالها عن البدن، وأن اتصال النفس بالجسم اتصال زمني، حيث تغادره بعد الموت إلى عالم الخلد، حيث الحساب أو المحاكمة، وهذه هي النقطة الجوهرية المؤثرة في مسيرة الإنسان وتوجيهها.
كذلك نجد إرهاصات هوية العقل بوصفه مخاً تتبلور على يد أكبر فلاسفة الإسلام وهو ابن سينا، فأحد أهم الأدلة التي قدمها ابن سينا على وجود النفس واستقلالها عن الجسم، هو ما أسماه دليل الإنسان المعلق في الفضاء. إذا افترض ابن سينا بتجربة خيالية (مستحيلة عمليا)، أنه إذا تصورنا إنسانا خلق دفعة واحدة في فراغ ليس فيه شيء يلامس جسده، أو أعضاؤه الحسية، فإننا يمكن أن نتصور أنه قادر على إدراك ذاته، على الرغم أنه لم يدرك جسده (أو يحس به) بعد، وهذا لا يريد به ابن سينا وجود النفس وحسب، بل وأنه مستقلة عن الجسم. ويتضمن دليل ابن هذا الانتقال من المعنى التصوري إلى التحقق الوجودي. ويبدو أنه أراد أن يقول إن الاستبطان يصلح دليلا كافيا على إثبات ذواتنا مستقلة، بينما طبقا لنظرية هوية العقل- المخ فإن في ذلك مفارقة كبيرة وواضحة، فإن عمليات الاستبطان ليست مستقلة عن الجسم، ولذلك فهي وإن كانت وعيا بالذات، إلا أنها ليست دليلا على استقلال الذات عن الجسم، أو أن طبيعتيهما مختلفتان جوهريا.
وفي الفلسفة الحديثة ارهاصات لنظرية هوية العقل بوصفه مخاً لدي العديد من الفلاسفة وفي مقدمتهم توماس هوبز (1679) الذي اعتبر الفكر حركة أو انفعلا لجزئيات المخ. ونقدها اسبينوزا (1677) وصرح بأن الفكر والمادة جانبان لشيء واحد، وأنكر التفاعل بينهما معتقدا بوجود موازاة لا التقاء بينهما، فكل حادث عقلي يوازيه حادث فيزيائي، ولكل حدث فيزيائي حدث عقلي مواز، من غير أن تقوم بينهما علاقة سببية فهما وجهان لحقيقة واحدة، أو خاصيتان إلهيتان ولذلك لا توجد بينهما علاقة سببية.
كذلك نجد إرهاصات لنظرية هوية العقل بوصفه مخاً لدي " بيير جاسندي" (1655) والذي رفض الرواية الأبيقورية للنفس البشرية، والتي تقول إنها مادية ولكنها تتكون من ذرات أخف وأكثر دقة من ذرات الأشياء الأخرى.
وفي الوقت الذي كانت توجد فيه إرهاصات لنظرية هوية العقل بوصفه مخاً مؤيدة لها، إلا أنها جاءت معارضة تماما لفكرة الثنائية لأبو الفلسفة الحديثة " رينيه ديكارت" الذي طرح النظرية الثنائية التفاعلية، وأقر الانفصال (وجوديا) بين النفس والجسد. كما أقر أن الحركات التي تحصل في المخ تنتج أفكارا فيما يسميه العقل غير الممتد الذي ظن أنه يعمل عن طريق الغدة الصنوبرية بوصفها نقطة اتصال بين العقل والمخ.
ولذلك يكون ديكارت في نظر المؤيدين لنظرية هوية العقل بوصفه مخاً مؤسسا للفصل الوجودي (الفعلي) على الفصل الابستمولوجي. إذ يرى أنه إذا أمكننا أن نفكر بالنفس، بشكل واضح وتام، من دون أن نفترض الجسم مسبقا، وإذا كنا قادرين على أن نتصور الجسم شيئا متميزا عن النفس، فإن ذلك يثبت لنا أن لدينا شيئن متميزين، أو جوهرين أحدهما مستقل عن الآخر تماما.
ومهما يكن الأمر فإن تأسيس الفصل الوجودي على الفصل الابستمولوجي ليس له ما يبرره في نظر أنصار نظرية هوية العقل بوصفه مخاً، فالانتقال من التصور إلى الوجود لم يُبنى على نسبة بينهما، وهذا ما جعل ديكارت يهرع إلى فكرة خارجة عن الموضوع لتسويغ هذا الانتقال، وهي فكرة اللامتناهي أو الله بوصفها فكرة واضحة بذاتها يقول:"... فإنه بمجرد معرفتنا وجود الله نستطيع القول بأن أي شيء يمكننا إدراكه متمايزا عن الشيء الآخر قد خلق متمايزا عنه، بواسطة الله، ولما كانت لدينا فكرة واضحة ومتمايزة عن النفس بوصفها شيئا منفصلا عن الجسم، فإننا نستطيع القول في هذه الحالة بأن النفس منفصلة بالفعل، لأن الله قد أراد جعلها منفصلة ".
لكن برغم فإن ديكارت في نظر أنصار نظرية هوية العقل- المخ أفاد البحث العلمي في نظرته إلى الجسم باعتباره مجرد آلة، وطن أن الشعور والإدراك آليان أيضا على الرغم من أنه لا يعتقد بآلية الوعي. وقد أثر هذا الاعتقاد على أبحاث البيولوجيا وعلم النفس الإدراكي والمعرفي، إذ سمح للعلماء أن يستقصوا تكوين البشر مندفعين بتأثير الاعتقاد الديكارتي بآلية الجسم، وأنه ليس مقدسا، ولذلك يمكن تشريحه ودراسته كأي نظام فيزيائي آخر.
وفي الوقت الذي كان فيه أنصار لنظرية هوية العقل- المخ يصولون ويجولون في الكشف عن ابستمولوجيا ديكارت في ثنائية النفس والجسم، نراها يجادلون المدرسة السلوكية والذين يؤمنون كما أستاذنا الدكتور صلاح إسماعيل بعامة إن كل ما يعرف أو يقال عن الحالات العقلية للناس يمكن معرفته أو قوله في حدود سلوكهم القابل للملاحظة. ويمكن تحليل فكرتهم هذه إلى ثلاث دعاوي: الأولى إبستمولوجية تتعلق بكيفية الحصول على معرفة بالحالات العقلية. والثانية دلالية تدور حول معاني مصطلحات مثل " اعتقاد " و" رغبة". والثالثة ميتافيزيقية تدور حول الطبيعة النهائية للحالات العقلية والسلوكية اسم لحركتين متميزتين إحداهما في علم النفس. وهي السلوكية النفسية أو المنهجية أو التجريبية أو العلمية، والأخرى في الفلسفة، وهي السلوكية الفلسفية أو المنطقية أو التحليلية.
وفي الوقت الذي كانت فيه السلوكية كما يذكر د. صلاح إسماعيل هي فلسفة العقل المسيطرة في الفترة المبكرة من القرن العشرين، كانت الأدبيات الفلسفية والنفسية تتضمن تعبيرات منعزلة لنوع مختلف من وجهة النظر الفيزيائية، وجهة النظر التي تطابق الحالات العقلية ليس بالاستعدادات السلوكية وإنما تطابقها بالحالات الفيزيائية للمخ.
ولكن هذه الفكرة لم تعرض عرضًا جيدًا كما يذكر د. صلاح إسماعيل إلا في أواخر خمسينيات القرن الماضي. وذلك عندما دافع عنها ثلاثة من الفلاسفة هم أولين بليس (1924-2000) في مقالة له بعنوان “هل الوعي عملية مخ؟” وقد نشرت عام 1956، وهربرت فايجل في مقالة له بعنوان ”العقلي والفيزيائي” وقد نشرها عام 1958، وجون سمارت (1920- 2012) في مقالة له بعنوان “الإحساسات وعمليات المخ” وقد نشرت عام 1959.
واتفق هؤلاء الفلاسفة يذكر د. صلاح إسماعيل على النقاط الأربع التالية
1- الخبرات والإحساسات الخاصة بالفرد تقبل الرد من دون بقية إلى حوادث أو عمليات في المخ (دعوى الهوية).
2- دعوى الهوية قضية ممكنة، أعني أنها ليست حقيقة ضرورية منطقيًا.
3- صدق دعوى الهوية هو في جانب على الأقل مسألة تحديد تجريبي.
4- لا تنطبق دعوى الهوية إلا على جوانب معينة من الحياة العقلية- الوعي، والمشاعر الخام للخبرة، والإحساسات. أما الجوانب المعرفية والإرادية (القصدية) من الحياة العقلية فلا تقبل الرد إلى عمليات أو حالات مخ، وإنما تقبل الرد مفهوميًّا إلى نوع من المقدرة أو الميل الدلالي أو المنطقي أو اللفظي.
وفي الختام أقول مع أستاذنا الدكتور صلاح إسماعيل صحيح أن نظرية الهوية يمكن تتبع أصولها عند فلاسفة قدماء ومحدثين، ولكن النظرية في صورتها المعاصرة تنفصل عن النظريات السابقة بطريقتين أساسيتين. فأما أولاهما فهي أن أصحاب نظرية الهوية عندما ركزوا على عمليات المخ اصطفوا في جانب علم الأعصاب. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التقدم الهائل في البحث العلمي العصبي في القرن العشرين، فإن هذا الاصطفاف منح نظريتهم مصداقية. وأما الثانية، وربما الأكثر أهمية، فهي أن أصحاب نظرية الهوية يرون أن المطابقات النفسية الفيزيائية مماثلة مباشرة للاكتشافات العلمية الأخرى.
ومن ثم فإنه إذا كان العلماء في القرن التاسع عشر، ينظرون للمخ بوصفه أداة للعقل فحسب. أما اليوم فإن العلماء يعرفون حقائق عديدة عنه على الرغم من أنهم يؤكدون على أن هذه المعرفة مازالت أولية مقارنة بالتعقيد الهائل الذي يمثله المخ البشري، فهم يعرفون القليل عن تركيب الأعصاب وعملها، ويعرفون بعض الأشياء عن التنظيم البنائي الأساس للمخ، ولديهم مقدار أكبر من المعرفة بالتنظيم الوظيفي للمخ، وتسهم تلك العناصر المختلفة لبنية المخ في خلق المحتوي الكلي لوعي الإنسان وتنظيم سلوكه.
***
د. محمود محمد علي
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بجامعة أسيوط
...........................
المراجع:
1-كرم، يوسف، 2012: تاريخ الفلسفة اليونانية، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 54-57.
2- زهير الخويلدي: نظرية الهوية من وجهة نظر فلسفية، مقال منشور بجريدة الهدف، الأحد 22 اغسطس 2021.
3- د. صلاح إسماعيل: العقل بوصفه سلوكا، مقال منشور بمؤسسة الفكر العربي.
4- د. صلاح إسماعيل: العقل بوصفه مخا، مقال منشور بمؤسسة الفكر العربي.
5- الجابري، صلاح: مشكلة العقل والدماغ بين العلم والفلسفة، مجلة الجامعة الأسمرية الإسلامية، س3، ع 5، 2005، 357-397.