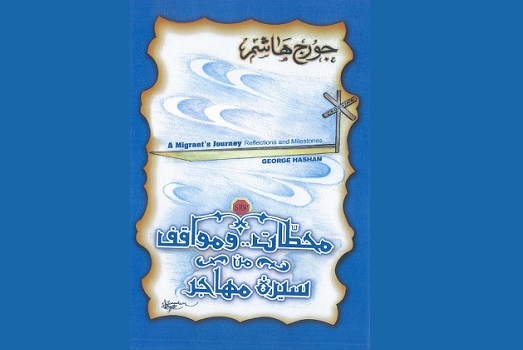أقلام فكرية
سامي عبد العال: تأويل النعال (6)

"إني أنا ربُك فاخْلع نعليك، إنّك بالوادي المُقدّس طُوى ... " (طه/ 12) ....
خلال هذا السياق أو ذاك من حياة الإنسان، توازي دلالة النعل أية أشياء أخرى طالما لا يصح وجودها في مقام التقديس. فالشيء غير المقدس مرةً يساوى جميع الأشياء غير المقدسة في كل المرات. وليست المساواة حسابية بلغة الرياضيات، ولكنها أمرٌ وارد منطقياً بالنسبة لتجارب الإنسان مع التقديس والايمان. إذْ هي تجارب علو وتجاوز، بحكم كونّها ليست من جنس التجارب العادية. وبخاصة أنَّ مصدر التقديس (وهو الله) قد ذَكرَ ذلك مباشرةً: (اخْلع نعليك). أي أنَّ نعلاً مُدنساً قد يُوازي بعض الملابس غير المقدسةِ، وقد يوازي مساحةَ أرض غير مقدسة، وقد يوازي غطاء رأس مدنس، وقد يوازي قدماً بوضعها التشريحي في الأسفل. ذلك لأنَّ المتعلقات (الأحوال) التي تتضاد مع الحضور المتعال أشياءٌ هامشية، وتُلحق بصاحبها بعض الدلالات غير المقبولةِ.
إنَّ الطابع المشترك بين هذه المفردات السابقة والنعل هو الإحساس. لأن النعل أحد مظاهر الحس التكميلي supplementary sense، فهو ملحق بأقدامنا ومكمل لوجودنا، نتيجة تجارب المشي والسير والحركة التي نقوم بها. ولكن: لماذا لا تصح الأشياء السابقة في حال التقديس؟! لأنَّ النعل هو ما ينتعله الفرد، وهو ما يتخذه مطيةً لشيءٍ سواه. أي ليس النعل شيئاً أصيلاً لدى الإنسان ولن يكون. فهو بالنسبة إلينا شيءٌ عرضيُ (الإرتداء) وعرضيُ (الخلع) بالوقت نفسه. وما ينطبق على النعل سينطبق على وضع اليد (اللمس) أو القدم (المشي) أو العين (الرؤية) كآلة للإحساس. فعندما تكون الأشياء وسائل لا غايات، وعندما تكون الأشياء غيرَ جوهريةٍ، لن تنال قدراً كبيراً من الوجود في ذاته.
ربما وحدُها آلات الإحساس في تاريخ البشر كانت محل ارتياب تجاه المقدس. مثل أدوات اللمس والشم والتذوق والحركة والرؤية ... فهذه تقوم بعمليات بشرية ليست واردة ضمن دائرة التقديس. ولا تتم بالإيقاع الموضوعي ذاته الذي يجري في حياتنا تجاه الأشياء المألوفة. على الأقل تقف آلات الإحساس عند مرحلة معينةٍ لا تتعداها، ذلك من باب استغلاق دلالة المقدس بما يفيده من غموضٍ وخفاءٍ، وما ينطوي عليه من أسرارٍ وإلغاز. ونتيجة أنَّ المقدس قابع في المنطقة اللاواعية من وجودنا، فهو لا يدخل إحساسنا الغُفل ولا يقفز داخل معرفتنا الواضحة بسهولة.
على سبيل المثال لا يمكننا بلوغ حقيقة المقدّس بواسطة الإدراك الحسي. كما أن الأخير مصدر تشوش واضطرات تجاه امتناع الماوراء أمام عقولنا وعجز التطلع إليه مثلما نتطلع إلى الأشياء الأخرى. والإحساس في ذاته يُعلن قصور الإنسان، طالما لم يتمكن من تحقيق تصوراته القصوى ولا ماذا يريد. حتى أنَّ كل معرفة بإمكان الإحساس تحقيقها تحتاجُ إلى درجاتٍ أخرى من الإدراك. ودوماً الدرجات الأخرى من المعرفة خارج إمكانية الإحساس، حيث لا يتمكن من بلوغها بطبيعته غير المناسبة للتقديس.
المفارقة أنَّ المعرفة الناتجة عن الحس تبرهن على فشل الحس في بلوغ المعرفة الحقيقية. ولذلك كانت دلالة الآية السابقة دافعةً بمعنى النعال إلى درجة القابلية للتأويل. فالمقدس يحدد ما نمتلكه نحن البشر بصورة مجازية، لأن ما نقول عنه كمعرفة حيال وجوده المتعال سيكون مصيره في النهاية أشباحاً أو استعارات. بالفعل الإنسان يمتلك أشباحاً معرفية وإستعارات لبناء حياته حول المقدس.
ربما ذلك هو علة أن الله - في الآية- يعبر عن ذاته مباشرة بالضمير (إني)، في إشارةٍ إلى وجوده المتعال قصداً وحضوراً. والقصد هو العلاقة التي تدل على التواجد الفريد غير القابل للتكرار. وكل تواجُد لون من الحضور على خلفية الأصل الذي يجب العمل به. ولذلك ثنى الله (أني) بضمير المتكلم (أنا)، أي أنت في معية الرب (ربُك). وكأنَّ الكلام يغلقُ كل المنافذ وأربعة أركان: الوجود والتعالي والحضور والمعنى عن دلالة السياق. إذ طالما كان موسي في معية الرب، فلا مجال لغير المقدس.
وبناءً عليه سيكون النعل مفتاحاً لما هو خارج السياق بشكل مجازي. والمجازي يعني قدرتنا نحن البشر على عملية الاستحضار لكائنات العالم، سواء أكانت استعارة أم خيالاً أم فكراً. وهو ما يجعل النعل معنى غير مباشر يجوز تأويله وإدخاله في نصوص ووجود الناس غير المقدسين بالتبعية. وحرصت الآية بهذا التمايز على مخاطبة موسى بالضمير (أنت). أي أن هناك: (إني أنا) وهناك (إنك أنت). ومتى وجد الأنا والأنت في دلالة الحضور المقدس وغير المقدس، فهناك التواجد من قبيل التأويل معرفةً وفهماً.
ومن ثمَّ، فإن كلمة النعال- على خلفية المعنى- تمارس (دور البديل) الذي يقبل وجهي (الأخذ والترك) لمتعلقات الإنسان الأخرى. فالأشياء إذا كانت قابلة للتبديل، فهي تنتمي إلى دائرة من تلك الدوائر. إذن كل تقديس هو في الحقيقة (موقع تبديل) للأشياء دون حدود. نظراً لعدم قدرتنا نحن الكائنات البشرية على ملئه. فهو متعالٍّ بطبعه وهو غير قابل للتحديد، كما أننا لا نمتلك له كياناً واضحاً. وبالتالي لا يكف الإنسان عن محاولات مواكبته والتطلع نحوه، ولكنه يظل يجرب البدائل تلو الأخرى لهذا الغرض دون جدوى. وإخلع تعني اترك وإلقِ شيئاً دخيلاً على كيانك عند حضور المقدس رغم عدم محدوديته. ونظراً لأن الإنسان لا يفهم إلاَّ بهذا الشكل الوجودي في لغة الآدميين، فالآية كانت أمراً لنبي الله موسى في الحقيقة.
لكن فعل (إخْلع) بمثابة الفعل الذي يوازي مجازية الوجود. وهذا هو موطئ التأويل فيه. الخلع هو لون من صرف الأشياء بعيداً حتى تغيب، حتى تبتعد. ولكي تكون غير مرئية وملقاة جانباً، علينا الاحتفاظ بصورتها دون كيانها الفعلي. فالتأويل أحد أشكال الغياب الحقيقي مع الحضور المجازي. أي أنني كذات إنساني ليس حاضراً على نحو كلي. وحتى عند الاعتراف بوجودي، فإنني أيضاً كيان مؤول بالنسبة للإله. فمن أكون أنا مقارنة به على صعيد ميتافيزيقي؟! لأنَّ الغياب يعني اتساع الوجود بما لا يستطيع الإنسان الحضور فيه بصورة شاملة. والحضور المجازي للإنسان واضح لكونه موجوداً مقارنة بالإله والوجود المقدس. فالإنسان غائب بالنسبة للقداسة بوصفه كائناً غير مقدس، بدليل دخول موسى بنعليه وهو لا يعلم كون النعال مدنسة. وهو كإنسان حاضر أيضاً مجازياً في حضرة المقدس الإلهي، باعتباره ليس إلهاً ولا يصح مقارنته بالإله.
وحضور الإنسان في الأديان لابد أنْ يكون حضوراً مجازياً تجاه المقدس. إنه يجسد إشكالية التواجد بحسب المواقع التي يندرج فيها وليس مساراً للوجود على الأصالة. فالإنسان يأخذ (جانبه المؤول interpreted side) من المقدس طالما يحضر في ساحة الميتافيزيقا. وبالتالي سيكون على الإنسان أن يحذر من جميع متعلقاته الهامشية كذلك. لأنَّه ما لم يأخذ التقديس بعين الاعتبار والعناية، فلن يكون كيانه إلاَّ غياباً لا قيمة له. فالقيمة الوجودية بهذا الشكل تأتي من قدرتنا نحن البشر على التقديس. ولكن: ماذا لو كان ما ننتعله غير مناسبٍ لذلك الوضع؟ هل الكينونة التي نمتلكها تأتي خالصة دون شوائب؟ ماذا يعني أن النعال قابلة للتبديل (الخلع والارتداء)؟ هل كل قداسة تحتاج إلى خلع شيءٍ ما ؟!!
إن إيراد الآية القرآنية كاملة يضعنا أمام معان أخرى: " فلما أتاها نُودي يا موسى إني أنا ربك، فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، فاستمع لما يُوحى، إنني أنا الله لا إله إلاَّ أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري. إنَّ الساعة آتية أكادُ أخفيها لتُجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى " (طه 11/ 14).
النعل مادة الأرض في الإنسان، أي يتعلق بالأديم الذي خُلق منه. والأرض رمز الشهوات، رمز الغرائز، رمز الفناء الذي يطلب البشر على حافة النهاية. وعندما يتم النداء إلى موسى، فهو نداء معبر عن العلو، نداء الله الذي جعل ارتداء النعال أمراً غير لائق. كان النداء سابقاً لما ترتبت عليه من حيثيات. وكانت أولى الحيثيات (اخلع نعليك)، فلا يجب أنْ تكون متعالياً وترتدي ما يقلل من ذلك إنسانياً وفي عرف الإله. المؤشران مرتبطان ببعضهما البعض. قد يقول قائل: إذا كانت النعال متدنية الدلالة لدى البشر، فما بال الإله يأخذ بذلك؟ الإجابة بسيطة أن تجربة التقديس موضعها الإنسان. وما يعتبره الأخير مدنساً، سيكون كذلك حتى من قبل الإله. ولذلك أشارت الآية إلى الوادي المقدس، لأنه أرض مستثناة، أرض خارج التدنيس.
لماذا النعال مُحقرة إلى هذا الحد؟ ربما لكونها تلامس الأشياء والمتعلقات غير المحببة. وأنها من ثمَّ رمز التدني، والمقدس يحيل الأشياء المحقرة إلى استعارات للنجاسة والشرور وعالم الأرواح الخبيثة. والأشياء التي يشتم منها المؤمنون نجاسة لا يحبب وجودها لديهم، بل سيكون وجودها موضع احتقار وإزدراء. هذه الفكرة قديمة قدم البشرية ومراراً أكدها الوحي في الديانات التوحيدية. لأن الأشياء النجسة مثل الدم وبعض الحيوانات كانت محل مهابة بالنسبة للناس ومحل خوف وبالوقت عينة تشعرهم بالنفور. النجاسة في غابر المعتقدات لم تكن بعيدةً عن القداسة، فالأمر بين الإثنين كان شديد التجاور بالمثل. فالمقدس قديماً كان يحمل معاني الخوف والتعالي، الرعب والقرب، المحرم والمحبوب.
في الثقافة الشعبية، كانت النعال مرتبطة بالحط من قدر الأشخاص. فرفع النعال دلالة على إزدراء وإهانة تجاه البعض. وذلك من بقايا المعتقدات القديمة التي تربط النعال بالأرض في مقابل السماء. والتدني في تضاد مع العلو.
وربما من بعض تأويل كلمة النعل في الآية أنها تساوي العقل. بمعنى أنَّ التقديس يقتضي خلع العقل كذلك، لكون الأخير لن يجدي ولن يفهم ما يجري في حضور المقدس. وأن الإنسان في حضرة الإله لن يجد العقل مسعفاً ولا قادراً على استيعاب الموقف. فالعقل لدى أغلب الناس بمثابة المطية التي يمتطيها الإنسان وصولاً إلى أهدافه، العقل بالمعنى الفردي والعقل بالمعنى الجمعي الذي يعني إقامة نظام عام لأجل تماسك المجتمع. بينما العقل في أمور التقديس لا يُجدى، وربما ينفُر منه أهل الايمان باعتباره غير قادر على التجاوز إلى أكثر مما يرى النظر أو يشتم الأنف أو يحس الجلد!!
هل يمكننا القول: اخلع عقلك إنك بالوادي المقدس طوى؟! لا ريب أن العقل لن يعرف كنه المقدس، رغم أنه مسكون بالمجهول والفضول الميتافيزيقي الأصيل. لأنَّه مصدر الأسئلة، غير أنَّ الإدراك ليس يتجاوز حدود ما يعرفه. بل قد يكرر العقل ما يستطيع عمله والوصول إليه في كل مرةٍ أخرى. إن الصوفية يرفعون شعاراً مؤداه إخلع عقلك أمام ما تعرف من فتوحات. لأن العقل حجاب كثيف في مثل تلك المعرفة. وبخاصة أن المعرفة التي قد يتوصل إليها العقل لا تنفك عنه، بل قد تشكل حوله قوقعه سميكة لا يصل إليها نور ولا هواء.
إن مقولة "اخلع عقلك " تفيد اتصالاً بذلك في مواقف الحرية والإنطلاق نحو المختلف. لأن مواطن العقل تجيد المجتمعات البشرية غلقها تماماً، تغلقها بالمنطق نفسه الذي يقبله العقل لا بعيد عنه. إن كل المجتمعات المتخلّفة تسعى إلى التشبث بالعقل لأنها تسعى جاهدة للتمسك بالواقع الذي تزعم التمسك به أيضاً. فالتخلي عن التخلف عندئذ هو تخلي عن العقل. إذن ماذا سيقول الإنسان غير (إخلع عقلك) من جذوره. ولكن الخلع في هذه الحالة ليس سهلاً، لأن من أصعب الأمور أن يدرك العقل أنه قيدٌ على ذاته، رغم أن ذلك القيد كامن في بنيته كبرت أم صغرت. فهل يمكننا أن نقول (اخلع عقلك القديم) الذي كان سبباً في تكلُس الحياة والواقع.
***
د. سامي عبد العال – أستاذ فلسفة