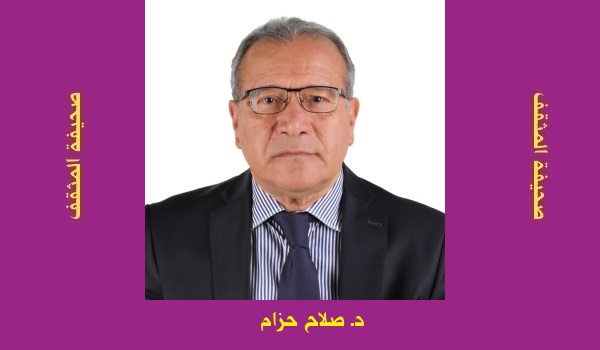أقلام ثقافية
عبد السلام فاروق: الدراما المصرية.. هل انتهى زمن الأسئلة الكبيرة

إذا كانت الدراما القديمة ترفع أسئلة الوجود والعدل والحرية، فإن دراما اليوم ترفع سقف الإثارة والعنف والإغراء. لم يعد الجمهور "متلقيا" يحاور العمل الفني، بل "زبونا" في سوقٍ تتنافس فيه المسلسلات على جذب انتباه بأسرع الطرق: صراخ مبالغ فيه، أزياء فاضحة، حوارات تكرس الفصحى المُكسرة والعامية المُبتذلة. التجارة هنا لا تبيع منتجًا، بل تبيع وهما سريعَ التلف. أليس غريبًا أن نرى مسلسلًا عن "مافيا الآثار" يُنتج في أسبوع، بينما رواية مثل "عمارة يعقوبيان" تحتاج عقدًا من الزمن لتصير دراما؟!
المرأة والشباب
المرأة في الدراما المعاصرة إما "ضحية" تجلدها الأقدار، أو "انتهازية" تبيع جسدَها للسلطة أو المال. أما المرأة التي تحمل تناقضات العصر، وتصارع من أجل هويتها المهنية والاجتماعية، فلا وجود لها إلا في أعمال نادرةٍ تهرب من التيار الرئيسي. والشباب - الذين يشكلون وقود ثورات الربيع العربي - يختزلون في شخصيات عابثة تتنقل بين الحفلات والمخدرات، وكأن الدراما ترفض أن ترى فيهم قوةَ تغيير، أو حتى أسئلة مزعجةً عن المستقبل.
السياسة والمحظورات
في زمن تشهد فيه مصر تحولات جيوسياسية واجتماعية هائلة، تتحول الدراما إلى جزيرة معزولة عن التاريخ. أين الأعمال التي تتحدث عن تداعيات الحرب في غزة على الوعي المصري؟ أو عن تأثير سد النهضة على حياة المزارع البسيط؟ أو عن صراع الأجيال في ظل التحولات التقنية؟ الدراما اليوم تختبئ وراء "المسلسلات التاريخية" التي تجمل الماضي، أو "الكوميديا السوداء" التي تتهكم على الواقع دون أن تنتقده. حتى الثورة التي غيّرت وجه المنطقة قبل عقد صارت تابوهًا لا يمس.
هل ننتظر معجزة؟
ليست المشكلة في غياب المواهب، بل في اختناقها بفعل ثلاثي المال والرقابة والجمهور المستسلم. ما لم تفتح نوافذ جديدة - كدمج الأدباء في كتابة السيناريوهات، أو دعم إنتاج أعمالٍ مستقلة تتحرر من سطوة الراعي التجاري - ستظل الدراما تدور في حلقة مفرغة. لماذا لا نرى تعاونًا بين كتاب السيناريو وأسماء مثل عبد الرحيم كمال أو أحمد مراد؟ ولماذا لا تخصص قنوات حكومية مساحات لتجارب جريئة بعيدًا عن قيود "الريتنج"؟
الفن كفعل مقاومة
الدراما العظيمة ليست ترفًا، بل ضرورة كالهواء. هي التي تذكرنا بأننا لسنا أرقامًا في ملفات الفقر أو العنف، بل بشرًا نحمل قصصًا تستحق أن تروى بجمال وعمق. حين حول شكسبير الصراعاتَ السياسية إلى مآس إنسانية، أو حين حول توفيق الحكيم السجن إلى مسرحٍ للأسئلة الفلسفية، لم يكونا يعكسان الواقع، بل كانا يصنعان واقعًا جديدًا. الدراما المصرية مدعوة اليوم إلى ثورة على نفسها: ثورة تبدأ باعتراف بأن الفن الحقيقي لا يرضي الجمهور، بل يزعجه. يقلقه. يدفعه إلى المرآة.
رقصة على حافة الوجود
كانتِ الأسرة مَهداً ينبت الأحلام قبل الأجساد، تعلم الطفل أن يسأل عن النجومِ قبلَ أن يحفظَ أسماءَ الشوارع. اليومَ، صارتْ سجناً يقيد الأجنحة بأغلالِ التوقعات. آباء يخافون على أبنائهم مِن شمسِ المغامرة، فيعلمونهم العيش تحت ظل اليقين. الطموح يختزل في وظيفة "مُريحة"، والإبداع يطرد مِن الباب كضيف ثقيل.
التاريخ يروي أن عبقرية ابنِ خلدون أو ابنِ رشد لم تولد مِن رحمِ الخوف، بل مِن رحمِ أسئلةٍ حركتْها عائلات آمنت بأن الرياحَ تهيئ السفنَ لا تغرقُها. فهل نعيد للأسرةِ دورَها كحاضنة للجرأة، أم نتركُها تنتج أفراداً يخافون مِن ظلِّهم؟
الديناميت الخفي
المجتمع المصري، بتعددِ طبقاتِه، يشبه بركاناً خامداً يخفي تحتَ رماده ناراً لا تنطفئ. النخب الحقيقية ليستْ مَن تتصدر الصورَ، بل مَن تعملُ في الظل كالنملِ الذي يبني مملكتَه بعيداً عن الضجيج. لكن الضجيجَ صارَ اليومَ سلطةً، والظلَّ صارَ مكاناً للمنسيين.
أليست حضارات ما بينَ النهرينِ علّمتنا أن العظماءَ لا يظهرون إلّا حينَ يختفي ضجيج العالم؟ وأنَّ التاريخَ لا يكتبُه من يصرخونَ، بل مَن يصنعونَ في صمت؟
في زمن شيوع التسطيح، ينظر إلى المثقفِ كعدو للبهجة، أو كشبحٍ مِن الماضي. الثقافة صارت تقاس بسرعة الاستهلاك، لا بعمقِ التأثير. الروايةُ التي كانتْ مرآة المجتمعِ صارتْ تُقرأُ إذا تحوّلتْ إلى مسلسلٍ تلفزيوني. المفكر الذي يرفض الانحناء للتيّار يتهم بالغرور، بينما يكرم مَن يلوّنونَ كلماتِهم بألوانِ السلطة.
الثقافة التي تخون عمقها تشبه أماً تبيع أطفالَها لتنعمَ بسلامٍ زائف. فهل نصلح ثقافتَنا بِردّ الاعتبار إلى السؤالِ الممنوع، أم نتركُها تُغرقُ في بحرِ التافهات؟
الفضاء الرقمي، الذي افتتحَ أبواب المعرفة للجميع، صار ساحة لمعركة بينَ الجوهرِ والوهم. الشباب الذي كان يفترض أن يغرف مِن محيطِ العلمِ صارَ يصارع أمواج "التيك توك". التكنولوجيا، التي وُعدنا بأنها ستحرر العقل، صارت تقيّده بخيوط غير مرئية.
لكنّ التاريخَ يعيد نفسَه: كلُّ أداةٍ جديدةٍ تحملُ في يدَيّها الخطر والفرصة. فهل نحول التكنولوجيا إلى جسرٍ نحوَ النهضة، أم نتركها سكيناً تُقطع بها أواصر الهوية؟
هُويةُ المجتمعِ المصري، التي صمدتْ أمام غزواتِ الرومانِ والعثمانيين، تواجه اليومَ غزواً أخطر: غزوَ العولمةِ الذي يذوب الخصوصيةَ في بوتقةِ النمطية. النخبُ التي كانت حارسةَ الهُويةِ صارت تقلّد الآخرَ كالطاووس الذي ينسى ألوانَه حينَ يرى مرآة.
لكنّ الهويةَ ليست متحفاً للحفاظِ على الماضي، بل حقل لزراعة المستقبل. فهل نصنع هوية تتحدّثُ بلغة العصر دون أن تخون جذورها، أم نتركها غريبة في وطنِها؟
بذور تحتَ الركام
تحت أنقاض الأزمة، ثَمّة بذور تنمو بصمت. شباب يرفضون أن يكونوا نسخاً مكررة، ويحفرون طريقَهم بِمِطرقةِ الإرادة. مدارس ظل تعلم الفلسفةَ في الأزقّة، ومبادرات فردية تحيي الحرفَ القديمة، ومثقفونَ يكتبونَ على جدرانِ الفيسبوكِ ما لا يستطيعونَ قولَه في الصحف.
التاريخ يؤكد لنا أن النهضةَ لا تصنع بقرار مِن الأعلى، بل بانتفاضة مِن الأسفل. فهل نرى في هؤلاءِ الأقليةَ التي ستُشعل النور، أم ننتظر حتى يغطّي الركام كل شيء؟
المجتمع المصري يقف على مفترق طرق: إما أن يستعيدَ قدرتَه على إنتاجِ نخبٍ تحمل مشروعاً حضارياً، أو يستهلكَ ما تبقى مِن رصيد الماضي. النخبُ ليستْ هِبَة، بل مسؤوليةٌ تكتسَب بالتجربة والخطأِ والإصرار.
السؤال الأخير ليس عن "ماذا نفعل؟"، بل عن "مَن نكون؟". فإمّا أن نختارَ أن نكونَ جسراً بينَ الماضي والمستقبل، أو أن نكونَ أحجاراً تُلقى في نهرِ النسيان. التاريخُ لا يرحمُ، لكنّه يمنحُ الفرصةَ لِمَن يجرؤُ على أن يخطوَ خارجَ القطيع.
***
د. عبد السلام فاروق