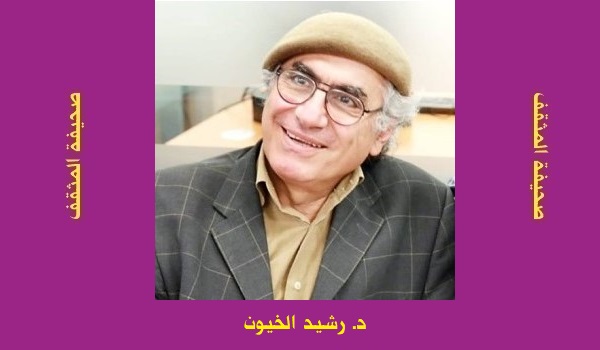دراسات وبحوث
خليل الحمداني: حقوق الإنسان بين الكونية والتموضع

تفكيك بنيوي لانحسار الخطاب الحقوقي
تمهيد: في خريفٍ قريب، وبينما كانت صور الدمار والضحايا المدنيين في غزة تتدفّق بلا انقطاع، بدا العالم وكأنه يقف مجددًا أمام اختبارٍ أخلاقيٍ مألوف، لكنه هذه المرة أكثر حدّة ووضوحًا. لم يكن السؤال المطروح آنذاك هو ما إذا كانت الانتهاكات جسيمة—فذلك لم يعد محلّ نزاع—بل ما إذا كان الخطاب الحقوقي العالمي قادرًا على إنتاج استجابة متماسكة، غير انتقائية، وقابلة للفعل. فبين بيانات متعارضة، وشللٍ مؤسسي، وتأويلات سياسية لمفاهيم راسخة في القانون الدولي، انكشفت فجوة عميقة بين ثبات المعيار المعلن، وهشاشة الممارسة الفعلية في السياسة الدولية.
- هذا الانكشاف لم يكن ناجمًا عن غياب القواعد أو نقص المعايير؛ فحماية المدنيين، وحظر العقاب الجماعي، وصون البنية التحتية الأساسية، كلها مبادئ مستقرة في صميم منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. غير أن طريقة الاستجابة الدولية—صمتًا أو تبريرًا أو انتقائية—أعادت إلى الواجهة سؤالًا أقدم وأكثر إرباكًا: هل نحن أمام أزمة التزام سياسي بهذه المعايير، أم أمام مأزق أعمق يتصل بطبيعة الخطاب الحقوقي نفسه، وحدود قدرته على الصمود حين يصطدم بتوازنات القوة ومصالح الدول؟
- من هذه اللحظة الكاشفة، لا بوصفها حالة استثنائية، بل باعتبارها مرآة مكثفة لعالم اليوم، ينطلق هذا النص لمحاولة مساءلة وضع الخطاب الحقوقي في راهنه. فالسؤال لم يعد يدور حول مشروعية حقوق الإنسان أو قيمتها الأخلاقية، بقدر ما بات يتعلّق بقدرتها على التموضع والفعل داخل عالم متغيّر، غير متكافئ، ومتفاوت البنى. فالخطاب الذي وُلد وعدًا كونيًا بحماية الكرامة الإنسانية، يبدو في لحظتنا الراهنة أقل حضورًا كأفق ناظم للسياسة الدولية، وأكثر حضورًا كلغة إدانة أو تبرير انتقائي، تُستدعى حيث تسمح موازين القوة، وتُعلَّق حيث تشتدّ كلفتها السياسية.
- إن هذا التراجع الظاهر لا يمكن فهمه بالاختزال في ازدواجية المعايير أو سوء النوايا وحدها، بل يستدعي مساءلة أعمق تطال بنية الخطاب الحقوقي نفسه، وسياق نشأته، وحدود قابليته على التشكّل داخل بيئات متباينة العناصر. فقد افترض هذا الخطاب، منذ تشكّله الحديث، أن عالمية المعيار كافية لإنتاج شرعيته واستمراره، وأن الكرامة الإنسانية، بوصفها قيمة مجردة، قادرة بذاتها على عبور السياقات السياسية والاقتصادية والثقافية المختلفة. غير أن التجربة التاريخية، خصوصًا خارج المركز الذي نشأ فيه هذا الخطاب، كشفت عن فجوة متنامية بين كونية الادعاء ومحلية التحقق.
- تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن انحسار الخطاب الحقوقي لا يعود فقط إلى تحوّلات السياسة الدولية أو صعود البراغماتية القاسية، بل إلى توتر بنيوي داخله: توتر بين معيار كوني غير قابل للتجزئة، وبيئات متباينة تفتقر، بدرجات مختلفة، إلى الشروط المؤسسية والسياسية والاقتصادية التي تسمح بتحققه. ومن هنا، لا يسعى هذا النص إلى التشكيك في عالمية حقوق الإنسان، ولا إلى الدفاع عنها دفاعًا إنشائيًا، بل إلى تفكيك شروط إمكانها وحدودها، عبر مساءلة العلاقة بين الكونية والتموضع، وبين الثابت المعياري وتعدد مسارات التحقق، وبين الخطاب بوصفه وعدًا أخلاقيًا، والواقع بوصفه بنية قوة
المبحث الأول: أزمة التكوين البنيوي للخطاب الحقوقي: الكونية بلا حامل
- لم تتجلَّ أزمة الخطاب الحقوقي في عجزه عن توصيف الانتهاكات أو تسميتها، بل في عجزه البنيوي عن حماية نفسه من التعليق والتأجيل حين يدخل حيّز السياسة الواقعية. فبينما يقدّم هذا الخطاب نفسه بوصفه منظومة كونية، غير قابلة للتجزئة، تقوم على كرامة إنسانية واحدة، فإنه يظل في مستوى التحقّق العملي تابعًا لبنى سيادية واقتصادية لا يملك السيطرة عليها. ومن هنا، لا يمكن فهم انحساره الراهن إلا بالعودة إلى شروط تكوينه الأولى، لا إلى ممارساته اللاحقة فحسب.
1. الكونية المعيارية والاعتماد البنيوي على الدولة
- نشأ الخطاب الحقوقي الحديث في لحظة تاريخية خاصة، بوصفه ردًّا أخلاقيًا وقانونيًا على فظائع القرن العشرين، وخصوصًا ما كشفته الحرب العالمية الثانية من قابلية الدولة الحديثة لتحويل الإنسان إلى موضوع للإبادة أو الإقصاء المنهجي. غير أن هذا الخطاب، على الرغم من طابعه الكوني، لم يُؤسَّس بوصفه بديلًا عن الدولة أو نقيضًا لها، بل بوصفه منظومة تعتمد عليها في التشريع والتنفيذ والحماية.
- هنا تتشكّل المفارقة البنيوية الأولى:
فالحقوق تُعلن كونية، لكنها لا تُنفَّذ إلا وطنيًا؛
وتُقدَّم بوصفها فوق-سيادية، لكنها تظل رهينة السيادة.
- هذا الاعتماد لم يكن خيارًا عرضيًا، بل نتيجة حتمية لغياب أي سلطة عالمية قادرة على الإكراه الشرعي. وبذلك، أصبح الخطاب الحقوقي محتاجًا إلى الدولة بوصفها وسيطًا، حتى حين تكون الدولة نفسها مصدر الانتهاك. وقد لُخّص هذا التناقض مبكرًا في أطروحة حنّة آرندت حول “الحق في أن يكون للمرء حقوق”، حيث بيّنت أن الحقوق لا تصبح فعلية إلا داخل جماعة سياسية قادرة على حمايتها، وأن الإنسان حين يُجرَّد من هذه الجماعة لا يبقى له سوى إنسانيته العارية، وهي أقل ما يُحمى.
2. الحقوق بوصفها خطابًا أخلاقيًا في فضاء قوة غير أخلاقي
- منذ بداياته، حمل الخطاب الحقوقي توترًا بين لغته الأخلاقية وفضائه السياسي. فهو يتحدث عن الكرامة والمساواة والحرية، في حين تعمل السياسة الدولية بمنطق القوة، والمصلحة، والردع، والصفقات. هذا التوتر لم يكن بالضرورة قاتلًا في مراحل سابقة، حين كانت حقوق الإنسان تُوظَّف ضمن صراع أيديولوجي أوسع، أو حين كانت الدولة القومية لا تزال تحتفظ بهامشٍ من القدرة على التوفيق بين الشرعية الأخلاقية والمصلحة الوطنية.
- غير أن هذا التوازن الهشّ بدأ ينهار مع تحوّلات أعمق: صعود الأمننة، توسّع منطق الاستثناء، وتراجع الفكرة الكلاسيكية للمساءلة. وفي هذا السياق، لم يُلغَ الخطاب الحقوقي، بل أُفرغ من قدرته على الإلزام، وتحول إلى لغة تُستخدم عند انخفاض الكلفة السياسية، وتُعلّق حين ترتفع.
- هنا لا يعود الإشكال في “ازدواجية المعايير” بوصفها انحرافًا أخلاقيًا، بل في كونها نتيجة منطقية لبنية خطاب لا يمتلك أدوات فرضه، ويعتمد على فاعلين لا يتعاملون معه إلا باعتباره أحد عناصر التفاوض السياسي.
3. غياب الحامل السيادي المستقل
- على خلاف الدساتير الوطنية، أو العقود الاجتماعية الداخلية، لم يمتلك الخطاب الحقوقي يومًا حاملًا سياديًا خاصًا به. فلا توجد سلطة عالمية منتخبة، ولا جهاز إنفاذ كوني، ولا احتكار مشروع للعنف باسم الإنسان. وما نشأ من آليات دولية للمساءلة ظل محدود الصلاحيات، خاضعًا للتوازنات الجيوسياسية، أو محكومًا بموافقة الدول نفسها.
- هذا الغياب البنيوي جعل الحقوق:
أ) قوية في النص،
ب) ضعيفة في الإنفاذ،
ج) هشّة أمام منطق الاستثناء.
- وحين تتوسّع حالات الطوارئ—سواء باسم الأمن القومي، أو مكافحة الإرهاب، أو حماية النظام الدولي—تتحوّل الحقوق من التزام أصيل إلى امتياز قابل للتعليق. وفي هذه اللحظة تحديدًا، يتراجع الخطاب الحقوقي لا لأنه خاطئ، بل لأنه بلا قوة ذاتية تحميه.
4. من وعد كوني إلى خطاب مشروط
- تُفضي هذه العناصر مجتمعة إلى نتيجة مركزية:
الخطاب الحقوقي، في بنيته التكوينية، خطاب كوني بلا سيادة، معياري بلا أدوات إكراه، وأخلاقي في فضاء تحكمه المصالح. وهو ما يفسّر لماذا يبدو هذا الخطاب قويًا في لحظات التوافق الدولي، وضعيفًا أو صامتًا في لحظات الصدام الحاد.
- ومن هنا، فإن انحساره الراهن لا ينبغي قراءته بوصفه انهيارًا للقيم، بل بوصفه انكشافًا لبنية طالما كانت قائمة، لكنها لم تُختبر بهذا العنف من قبل. فحين تشتدّ الأزمات، لا يسقط الخطاب الحقوقي لأنه كوني، بل لأنه لم يُصمَّم ليعمل دون وسائط قوية، عادلة، وقابلة للمساءلة.
المبحث الثاني: الراهنية المفرطة للخطاب الحقوقي: من الاستجابة الأخلاقية إلى الهشاشة التاريخية
- إذا كان المبحث الأول قد عالج الخلل البنيوي في تكوين الخطاب الحقوقي، فإن هذا المبحث ينقل التحليل إلى بعدٍ زمني لا يقلّ أهمية: راهنية الخطاب الحقوقي المفرطة، وافتقاره النسبي إلى عمق تاريخي يمكّنه من الصمود حين تتغيّر الشروط السياسية والاقتصادية التي نشأ في ظلّها. فحقوق الإنسان، على الرغم من ادّعائها الكونية، هي—في صيغتها الحديثة—خطاب حديث العهد، تشكّل في لحظة صدمة كبرى، أكثر مما تشكّل عبر تراكم تاريخي طويل داخل البنى الاجتماعية.
1. خطاب وُلد من الصدمة لا من التراكم
- تبلور الخطاب الحقوقي الحديث في أعقاب كوارث القرن العشرين، بوصفه استجابة أخلاقية عاجلة لما بدا آنذاك انهيارًا شاملًا للمعنى الإنساني: الحروب الشاملة، الإبادة، معسكرات الاعتقال، وتحوّل الدولة الحديثة إلى أداة قتل جماعي. في هذا السياق، جاءت حقوق الإنسان لتعيد تثبيت حدٍّ أدنى من الكرامة، لا بوصفها ثمرة تطوّر اجتماعي طويل، بل بوصفها ردّ فعل على قطيعة أخلاقية عميقة.
- ان هذه النشأة، على أهميتها، تركت أثرها على طبيعة الخطاب ذاته. فقد تشكّل بوصفه خطابًا:
أ) عالي النبرة الأخلاقية،
ب) مكثّفًا معياريًا،
ج) لكنه ضعيف التجذّر في البنى الاقتصادية والاجتماعية التي تُنتج العنف واللامساواة.
وبذلك، حمل منذ البداية توترًا بين سرعة الاستجابة وبطء التاريخ.
2. بين الكونية واللحظة: حقوق الإنسان كخطاب راهن
- على خلاف مفاهيم سياسية كالدولة أو السيادة أو السوق، التي تبلورت عبر قرون من الصراع الاجتماعي والتحوّل المؤسسي، ظلّت حقوق الإنسان مرتبطة بلحظة تاريخية محددة، وبسياق دولي معيّن. هذا الارتباط جعل الخطاب الحقوقي يبدو—في كثير من الأحيان—كأنه ينتمي إلى زمن أخلاقي سابق، لا إلى الحاضر المتحوّل.
- ومع تغيّر السياق العالمي—صعود الشعبويات، عودة السياسات القومية الصلبة، توسّع الأمننة، وتحوّل التكنولوجيا إلى أداة ضبط—أصبح الخطاب الحقوقي أقل قدرة على إعادة تعريف نفسه. فهو يستدعي مفردات صيغت لعالم ما بعد الحرب، في مواجهة عالم تُعاد فيه صياغة السلطة على أسس مختلفة.
- من هنا، لا يبدو التراجع الراهن في حضور الخطاب الحقوقي مفاجئًا؛ إنه نتيجة منطقية لخطاب لم يُطوّر أدواته الزمنية بما يكفي، ولم يُنتج سردية تاريخية تسمح له بالتحوّل مع تغيّر الشروط.
3. غياب التاريخ الاجتماعي للحقوق
- إحدى نقاط الضعف الجوهرية في الخطاب الحقوقي هي أنه غالبًا ما يُقدَّم بوصفه منظومة قيم مكتملة، لا بوصفه مسارًا تاريخيًا متنازعًا عليه. نادرًا ما تُربط الحقوق بتاريخ الصراع الاجتماعي، أو بتاريخ العمل، أو بتاريخ الفقر، أو بتاريخ الاستعمار، رغم أن هذه السياقات شكّلت الشروط المادية لانتهاك الكرامة الإنسانية.
- هذا الانفصال بين الحقوق والتاريخ الاجتماعي جعل الخطاب الحقوقي:
أ) أخلاقيًا أكثر منه اجتماعيًا،
ب) قانونيًا أكثر منه سياسيًا،
ج) ومجرّدًا أكثر مما يحتمله واقع معقّد.
- وفي هذا السياق، يصبح من السهل على الفاعلين السياسيين التعامل مع الحقوق بوصفها خطابًا طارئًا، يمكن تعليقه في أوقات “الضرورة”، بدل اعتبارها نتاجًا تاريخيًا لنضالات لا يجوز التراجع عنها.
4. الراهنية بوصفها نقطة ضعف لا قوة
- قد تبدو الراهنية، للوهلة الأولى، مصدر قوة؛ فهي تمنح الخطاب الحقوقي قدرة على الاستجابة السريعة للأزمات. غير أن هذه الراهنية تتحوّل، في غياب عمق تاريخي، إلى نقطة هشاشة. فالخطاب الذي لا يرسّخ نفسه في البنى العميقة للمجتمع والدولة والاقتصاد، يظل قابلًا للتجاوز حين تتبدّل الأولويات.
- هنا يمكن الاستعانة بتحليل ميشيل فوكو للخطاب بوصفه ممارسة مرتبطة بعلاقات القوة، لا بوصفه مجرد منظومة أفكار. فالخطاب الذي لا يعيد إنتاج نفسه داخل شبكات السلطة والمعرفة، يبقى خطابًا هشًّا، مهما بلغت نبل مقاصده.
5. من خطاب كوني إلى ذاكرة قصيرة
- تُفضي هذه الملاحظات إلى نتيجة أساسية:
الخطاب الحقوقي يعاني من قِصر في الذاكرة التاريخية. فهو يستحضر الماضي بوصفه فاجعة أخلاقية (لا ينبغي تكرارها)، لكنه لا يستوعبه بوصفه مسارًا اجتماعيًا واقتصاديًا مستمرًا. وبهذا، يفقد قدرته على تفسير الحاضر، فضلًا عن توجيه المستقبل.
- إن انحسار الخطاب الحقوقي اليوم لا يعود فقط إلى صعود قوى تناهضه، بل إلى عجزه عن التحوّل من خطاب استجابة إلى خطاب تاريخ؛ من لغة “عدم التكرار” إلى لغة تفهم لماذا يتكرر العنف بأشكال جديدة.
خلاصة المبحث الثاني
- يُظهر هذا المبحث أن أزمة الخطاب الحقوقي ليست بنيوية فقط، بل زمنية أيضًا. فهو خطاب وُلد من صدمة أخلاقية كبرى، لكنه لم يُطوّر سردية تاريخية تمكّنه من التكيّف مع تحوّلات العالم. وبين كونية المعيار وتسارع الزمن السياسي، بقي الخطاب الحقوقي أسير لحظة تأسيسه، عاجزًا عن إنتاج أدوات زمنية جديدة تحميه من التآكل.
من الخلل البنيوي والراهنية إلى سؤال البيئة والاقتصاد السياسي
- يُظهر المبحثان السابقان أن انحسار الخطاب الحقوقي لا يمكن عزوه إلى عامل واحد أو لحظة عابرة. فالخلل البنيوي في تكوينه—بوصفه خطابًا كونيًا بلا حامل سيادي مستقل—يتقاطع مع راهنية مفرطة جعلته أسير لحظة تأسيس أخلاقية لم تُستكمل بتجذّر تاريخي عميق. غير أن هذين البعدين، على أهميتهما، لا يكتمل فهمهما دون الانتقال إلى مستوى ثالث أكثر مادية وملموسية: البيئة التي نشأ فيها الخطاب الحقوقي، والاقتصاد السياسي الذي يفترض به أن يعمل داخله.
- فالخطاب لا يتحرك في فراغ، ولا يتجسّد في نصوص مجردة، بل يتموضع داخل دول، وأسواق، وعلاقات قوة، وأنماط إنتاج وتوزيع غير متكافئة. ومن هنا، يصبح سؤال الحقوق مرتبطًا بسؤال الدولة القادرة، والعدالة التوزيعية، وحدود السوق، وطبيعة النظام الدولي ذاته. إن الانتقال إلى تحليل البيئة المنشِئة لا يعني اختزال حقوق الإنسان في الاقتصاد أو السياسة، بل إدراك أن الكرامة، بوصفها قيمة، لا يمكن أن تصمد طويلًا في بنى تُنتج اللامساواة والعنف بوصفهما شرطًا للاشتغال. وعلى هذا الأساس، يتناول المبحث التالي العلاقة الإشكالية بين الخطاب الحقوقي والاقتصاد السياسي العالمي، لا بوصفها علاقة عرضية، بل بوصفها أحد مفاتيح فهم تراجعه الراهن.
المبحث الثالث: البيئة المنشِئة والاقتصاد السياسي للحقوق: حين تُنتج البُنى نقيض القيم
- إذا كان الخطاب الحقوقي قد قدّم نفسه بوصفه تعبيرًا عن ضمير إنساني كوني، فإن البيئة التي نشأ فيها—الدولة الليبرالية الحديثة واقتصاد السوق الرأسمالي—لم تكن يومًا بيئة محايدة أخلاقيًا. بل على العكس، فقد تشكّل هذا الخطاب داخل نظام اقتصادي وسياسي يُنتج، في جوهره، تفاوتًا بنيويًا في الثروة والسلطة والفرص. ومن هنا، لا يمكن فهم هشاشة الخطاب الحقوقي دون مساءلة التناقض الأصلي بين منطق الحقوق ومنطق التراكم.
1. حقوق الإنسان في ظل اقتصاد ينتج اللامساواة
- تقوم الرأسمالية الحديثة على مبدأ التراكم، لا على مبدأ الكرامة. فهي تنظّم العلاقات الاجتماعية من خلال السوق، وتعيد تعريف القيمة على أساس الربح، والكفاءة، والقدرة على المنافسة. في هذا السياق، تصبح الحقوق—خصوصًا الاقتصادية والاجتماعية—مكلفة، قابلة للتفاوض، أو مشروطة بالقدرة المالية للدولة.
- هنا يبرز التوتر الجوهري:
فالحقوق تفترض مساواة في الاستحقاق،
بينما يفترض السوق تفاوتًا في النتائج بوصفه أمرًا طبيعيًا.
- وقد أشار كارل بولاني إلى أن إخضاع المجتمع لمنطق السوق يؤدي حتمًا إلى تآكل الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها. وحين تُترك الصحة، والتعليم، والسكن، والعمل لقوى السوق، تتحوّل الحقوق من التزامات عامة إلى سلع، ومن ضمانات إلى امتيازات.
2. الدولة بين الحماية والوساطة
- في هذا الإطار، لا تعود الدولة حارسًا محايدًا للحقوق، بل وسيطًا بين مطالب اجتماعية متزايدة ومنطق اقتصادي ضاغط. ومع تراجع دولة الرفاه، وصعود النيوليبرالية، تقلّصت قدرة الدولة على لعب دورها الحمائي، وازداد اعتمادها على سياسات التقشّف، والخصخصة، وتقليص الإنفاق الاجتماعي.
- ان هذا التحوّل لم يُضعف فقط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل أثّر أيضًا على الحقوق المدنية والسياسية. فالدولة التي تفشل في توفير الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، تميل إلى تعويض هذا الفشل بتشديد الضبط، وتوسيع الأمننة، وتقليص الحريات باسم الاستقرار. وهكذا، يصبح انتهاك الحقوق جزءًا من آلية إدارة الأزمات، لا انحرافًا عنها.
3. النظام الدولي: الكونية في ظل اختلال القوة
- على المستوى الدولي، يتضاعف هذا التناقض. فالنظام العالمي الذي يتبنّى حقوق الإنسان خطابًا، هو ذاته نظام غير متكافئ في توزيع السلطة والثروة. الدول الأقوى اقتصاديًا وعسكريًا تملك القدرة على:
أ) فرض أولوياتها،
ب) تعطيل آليات المساءلة،
ج) وتحديد متى وأين تُفعّل المعايير الحقوقية.
- في هذا السياق، تتحوّل حقوق الإنسان إلى لغة قوة ناعمة تُستخدم لتعزيز النفوذ، لا إلى إطار ملزم للجميع. ولا يعود ضعف تطبيق الحقوق في الأطراف نتيجة “قصور ثقافي” أو “غياب وعي”، بل انعكاسًا لموقع هذه الدول داخل اقتصاد سياسي عالمي غير عادل.
4. الحقوق في بيئات هشّة: من الالتزام إلى الإدارة
- في الدول الهشّة، أو الريعية، أو الخارجة من نزاعات، يتخذ هذا التناقض شكلًا أكثر حدّة. فالحقوق تُدار لا تُحقّق؛ تُقدَّم في خطط واستراتيجيات، لا في سياسات قابلة للنفاذ. ويصبح الخطاب الحقوقي جزءًا من إدارة الهشاشة بدل أن يكون أداة لتفكيكها.
- في هذه البيئات، لا تفشل الحقوق لأنها غير كونية، بل لأنها تُطالَب بالعمل داخل نظم لا تنتج مواطنة كاملة، ولا اقتصادًا منتجًا، ولا مؤسسات مستقرة. وهنا، يتحوّل الخطاب الحقوقي إلى وعد مؤجّل، أو إلى شرطٍ دولي للشرعية، لا إلى عقد اجتماعي حيّ.
5. خلاصة المبحث الثالث
- يُظهر هذا المبحث أن أزمة الخطاب الحقوقي ليست أخلاقية ولا قانونية فحسب، بل اقتصادية–سياسية في جوهرها. فالحقوق التي لا تجد بيئة تُنتج المساواة، ولا دولة قادرة على الحماية، ولا نظامًا دوليًا منضبطًا، تبقى معلّقة بين النص والواقع. ومن هنا، فإن أي محاولة لإحياء الخطاب الحقوقي دون مساءلة الاقتصاد السياسي الذي يعمل داخله، ستظل مجرّد إعادة تدوير لغوي لقيم تُفرَّغ عمليًا من مضمونها.
المبحث الرابع: التموضع عبر البيئات المتباينة: حدود العالمية وإمكانات الترجمة دون التفريط بالثوابت
- يُثير ضعف قدرة الخطاب الحقوقي على التشكّل المتماسك داخل بيئات متباينة—سياسيًا، واقتصاديًا، ومؤسسيًا—سؤالًا نظريًا بالغ الحساسية: هل يعكس هذا الضعف مأزقًا في عالمية حقوق الإنسان نفسها، أم يكشف حدود آليات تموضعها وتحققها؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تكون ثنائية أو تبسيطية، إذ إن الخلط بين المعيار الكوني ووسائط إنفاذه هو أحد أكثر مصادر الالتباس شيوعًا في النقاش الحقوقي المعاصر.
1. عالمية المعيار أم محلية التحقّق؟
- تقوم عالمية حقوق الإنسان على افتراض أخلاقي وقانوني بسيط في صياغته، عميق في تبعاته: أن الكرامة الإنسانية غير قابلة للتجزئة، وأن الحقوق متساوية في الاستحقاق، بغضّ النظر عن السياق أو الهوية أو الموقع الجغرافي. غير أن هذا الافتراض لا يتضمن، بالضرورة، تماثل البيئات في القدرة على التحقّق. فالعالمية هنا تتعلق بالمبدأ، لا بالشروط المادية والسياسية لتنفيذه.
- إن الخلل لا يكمن في كون الحقوق كونية، بل في افتراضٍ ضمني—غالبًا غير مُعلَن—بأن الكونية قادرة بذاتها على إنتاج شروطها. وفي الواقع، تتوسّط بين المعيار والواقع سلسلة من البنى: الدولة، الاقتصاد السياسي، الثقافة السياسية، والنظام الدولي. وكلما اختلّ أحد هذه الوسائط، تراجعت قدرة الخطاب الحقوقي على التموضع، دون أن يعني ذلك انهيار المعيار نفسه.
2. عدم القابلية للتجزئة وإشكالية الأولويات
- يُعد مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزئة والترابط أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الحقوقية. غير أن هذا المبدأ، حين يُقرأ قراءة حرفية أو تجريدية، قد يتحوّل من ضمانة أخلاقية إلى عائق عملي أمام السياسات العامة. فالدول لا تعمل في فضاء مثالي، بل ضمن قيود الموارد، والهشاشة المؤسسية، والضغوط الأمنية.
- التمييز الضروري هنا هو بين:
أ) عدم القابلية للتجزئة بوصفها قاعدة معيارية (لا يجوز إسقاط حق بذريعة حماية حق آخر)،
ب) والترتيب التنفيذي للأولويات بوصفه ضرورة سياسية وإدارية، بشرط عدم التحلل من الالتزامات الجوهرية، وعدم التمييز، وعدم تحويل التدرّج إلى تأجيل دائم.
- إن الخطر الحقيقي لا يكمن في وضع أولويات، بل في تسييس الأولويات وتحويلها إلى مبرر لتعليق الحقوق أو إفراغها من مضمونها.
3. الترجمة المؤسسية للحقوق: من المعيار إلى الممارسة
- لا تتحقق الحقوق إلا بقدر ما تُترجَم إلى مؤسسات وسياسات وقواعد توزيع. وهذه الترجمة ليست عملية تقنية، بل صراع اجتماعي–سياسي. ففي البيئات التي تسود فيها من بين امور اخرى :
أ) الدولة الريعية،
ب) الاقتصاد غير المنتج،
ج) الزبائنية،
د) أو هشاشة سيادة القانون،
تتحوّل الحقوق إلى وعود خطابية أو أدوات إدارة للأزمات، لا إلى التزامات قابلة للإنفاذ.
- في هذا السياق، يكتسب تحليل كارل بولاني أهمية خاصة. فقد بيّن بولاني، في عمله المرجعي التحول الكبير، أن إخضاع المجتمع لمنطق السوق يؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية وتآكل الأسس الأخلاقية، وأن حماية الإنسان تتطلب دائمًا حركة مضادة تعيد إخضاع الاقتصاد للاعتبارات الاجتماعية، لا العكس.¹
وإذا نُقل هذا التحليل إلى المجال الحقوقي، يتّضح أن الحقوق لا يمكن أن تصمد في بيئات يُترك فيها السوق—أو الريع—لإعادة تنظيم المجتمع دون ضوابط عدالة.
4. التموضع لا النسبية: دفاع مختلف عن العالمية
- من هنا، فإن ضعف التموضع لا يُفهم بوصفه دليلًا على نسبية الحقوق أو عدم صلاحيتها العابرة للثقافات، بل بوصفه اختبارًا لقدرة الخطاب على تطوير أدوات ترجمة مرنة دون التفريط بالنواة الصلبة للمعيار. فالعالمية التي لا تسمح بالتجسيد المتعدّد تتحوّل إلى تجريد أخلاقي، والعالمية التي تُفرّط بثوابتها تتحوّل إلى نسبية مريحة للسلطة.
- البديل النظري الممكن هو تصور ثلاثي المستويات:
أ) نواة صلبة غير قابلة للمساومة (الحق في الحياة، حظر التعذيب، عدم التمييز الجسيم، الكرامة).
ب) مساحات ترجمة مؤسسية متعددة تتكيف مع السياقات دون انتقاص من الجوهر.
ج) ترتيب تنفيذي مرحلي خاضع للمساءلة، ومقيّد زمنيًا، ومؤشراتيًا.
- بهذا المعنى، لا تكون العالمية نفيًا للاختلاف، بل إطارًا لضبطه.
5. خلاصة المبحث الرابع
- يُظهر هذا المبحث أن أزمة الخطاب الحقوقي في البيئات المتباينة ليست أزمة عالمية، بل أزمة تموضع وترجمة. فالحقوق تظل كونية في معيارها، لكنها تفشل حين تُطالَب بالعمل داخل بنى لا تنتج مواطنة كاملة، ولا عدالة توزيعية، ولا دولة قادرة. ومن هنا، فإن الدفاع الجاد عن عالمية حقوق الإنسان لا يمرّ عبر الإنكار أو التبرير، بل عبر بناء نظريات وسياسات تُعيد وصل الكرامة بالبنية، والمعيار بالمؤسسة، والحق بالقدرة على إنفاذه.
1. Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, 1944), esp. chapters 6–12.
المبحث الخامس (التطبيقي)
الخطاب الحقوقي في السياق العربي: بين الدولة الريعية، الهشاشة المؤسسية، وأزمة التموضع
يُعدّ السياق العربي من أكثر البيئات كاشفية لاختبارات الخطاب الحقوقي، لا بسبب “خصوصية ثقافية” مفترضة، بل نتيجة تركيبة سياسية–اقتصادية جعلت التوتر بين المعيار الكوني وشروط التحقّق المحلي أكثر حدّة ووضوحًا. ففي معظم الدول العربية، لا يعمل الخطاب الحقوقي داخل دولة قانون مكتملة، ولا ضمن اقتصاد منتج يولّد مواطنة متساوية، بل داخل أنماط دولة ريعية أو شبه ريعية، تتداخل فيها السلطة السياسية مع شبكات الزبائنية، وتُدار فيها الحقوق بوصفها موارد تفاوض لا التزامات أصيلة.
1. الدولة الريعية والحقوق بوصفها امتيازًا
في الدولة الريعية، لا تقوم العلاقة بين الدولة والمواطن على الضريبة والتمثيل، بل على إعادة توزيع الريع مقابل الولاء أو الصمت السياسي. وفي هذا الإطار، لا تُفهم الحقوق باعتبارها استحقاقات قانونية متساوية، بل بوصفها:
- منحًا قابلة للسحب،
- أو خدمات مرتبطة بالانتماء،
- أو أدوات تهدئة اجتماعية.
هذا النمط البنيوي يضعف الخطاب الحقوقي من الداخل، لأنه ينزع عنه شرطه الأساسي: المواطنة المتساوية. فالحق الذي لا يُمارَس بوصفه حقًا، بل بوصفه منّة، يفقد طابعه الإلزامي، ويتحوّل إلى لغة خارجية لا تجد لها حاملًا اجتماعيًا داخليًا.
2. هشاشة المؤسسات وتحويل الحقوق إلى إدارة
في كثير من السياقات العربية، لا تُلغى الحقوق صراحة، بل تُدار إداريًا. تُنشأ استراتيجيات وطنية، وتُعتمد خطط عمل، وتُقدَّم تقارير دورية، بينما تظل آليات الإنفاذ:
- ضعيفة الاستقلال،
- محدودة الصلاحيات،
- أو خاضعة للاعتبارات الأمنية والسياسية.
في هذه البيئة، يتحوّل الخطاب الحقوقي إلى لغة تنظيمية: تُستخدم لإدارة العلاقة مع المجتمع الدولي، أو لامتصاص الضغط، لا لإعادة توزيع السلطة أو مساءلتها. وهنا يظهر بوضوح ما يمكن تسميته “فجوة الترجمة”: حيث توجد نصوص ومعايير، لكن تغيب البنية التي تحوّلها إلى ممارسة.
3. الأمننة وحالة الاستثناء الدائمة
يُضاف إلى ذلك أن عددًا كبيرًا من الدول العربية يعيش في حالة استثناء شبه دائمة: صراعات داخلية، تهديدات أمنية، إرهاب، أو عدم استقرار إقليمي. وفي هذا السياق، تُعاد صياغة الحقوق بوصفها:
- عبئًا على الاستقرار،
- أو ترفًا مؤجلًا،
- أو خطرًا محتملاً.
لا تُلغى الحقوق هنا باسم الثقافة، بل باسم الضرورة. ومع تراكم هذا الخطاب، يصبح تعليق الحقوق هو القاعدة، لا الاستثناء، ويتآكل حضورها بوصفها خطوطًا حمراء غير قابلة للتجاوز.
4. الخطاب الحقوقي بين الخارج والداخل
في السياق العربي، غالبًا ما يُستقبل الخطاب الحقوقي بوصفه خطابًا خارجيًا، حتى حين تكون مضامينه منسجمة مع مطالب اجتماعية داخلية. ويعود ذلك إلى:
- تاريخ طويل من التسييس الدولي للحقوق،
- استخدام انتقائي للمعايير،
- وغياب مسار داخلي متجذّر لربط الحقوق بالعدالة الاجتماعية والكرامة اليومية.
النتيجة أن الخطاب الحقوقي يجد نفسه معلقًا بين:
- ضغط دولي لا يمتلك أدوات إنفاذ عادلة،
- وواقع محلي لا ينتج شروط التملّك المجتمعي للحقوق.
5. ما الذي يكشفه السياق العربي؟
لا يكشف السياق العربي فشل عالمية حقوق الإنسان، بل يكشف حدود الخطاب حين يُنقل إلى بيئات لا تنتج دولة مواطنة، ولا اقتصادًا منتجًا، ولا مؤسسات مستقلة. وهو، بهذا المعنى، مختبر نظري حيّ يؤكد أن أزمة الحقوق ليست ثقافية، بل بنيوية–اقتصادية–سياسية.
الخاتمة التركيبية: من نقد الخطاب إلى إعادة بناء شروط الإمكان
سعى هذا النص إلى تفكيك انحسار الخطاب الحقوقي المعاصر بعيدًا عن القراءات الاختزالية التي تُرجعه إلى ازدواجية المعايير أو تراجع الأخلاق الدولية وحدها. وقد بيّن التحليل أن هذا الانحسار هو نتيجة تراكب ثلاث أزمات مترابطة: خلل بنيوي في تكوين الخطاب بوصفه كونيًا بلا حامل سيادي مستقل، راهنية مفرطة جعلته أسير لحظة تأسيس أخلاقية دون تجذّر تاريخي عميق، وبيئة منشِئة—اقتصادية وسياسية—تُنتج اللامساواة والعنف بوصفهما شروط اشتغال.
وفي مواجهة هذه الأزمات، لا يكون الدفاع عن حقوق الإنسان عبر الإنكار أو الخطاب الإنشائي، ولا عبر التفريط بالعالمية باسم الخصوصية، بل عبر إعادة بناء شروط الإمكان. ويقترح هذا النص، في هذا السياق، إطارًا تركيبيًا يقوم على أربعة عناصر مترابطة:
1. نواة معيارية صلبة غير قابلة للمساومة
تشمل الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية (الحياة، حظر التعذيب، عدم التمييز الجسيم، المحاكمة العادلة).
2. ترجمة مؤسسية متعددة المسارات
تسمح بتجسيد الحقوق داخل سياقات مختلفة، دون اختزالها أو تفريغها من مضمونها.
3. ترتيب تنفيذي مرحلي خاضع للمساءلة
يميّز بين التدرّج المشروع والتهرّب السياسي، ويضع سقوفًا زمنية ومؤشرات واضحة.
4. ربط الحقوق بالاقتصاد السياسي
بوصف العدالة الاجتماعية، والقدرة الاقتصادية، والدولة القادرة، شروطًا لا غنى عنها لتحقّق الكرامة.
بهذا المعنى، لا تُفهم حقوق الإنسان بوصفها خطابًا أخلاقيًا عابرًا للواقع، ولا بوصفها أداة ضغط سياسية، بل بوصفها مشروعًا تاريخيًا غير مكتمل، يتطلب صراعًا اجتماعيًا، وبناءً مؤسسيًا، ومساءلة دائمة للبنى التي تدّعي حمايته.
إن السؤال لم يعد: هل حقوق الإنسان كونية؟
بل: هل نمتلك الشجاعة الفكرية والسياسية لإعادة بناء العالم على نحو يسمح لهذه الكونية بأن تتحقّق؟
***
خليل ابراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان