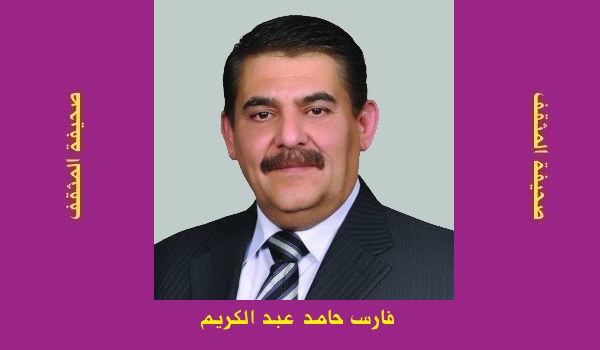قراءات نقدية
سعد غلام: مدخل تمهيدي لدراسة نقدية وإجرائية سيمو-قرائية عن قصيدة:

"حي بن سكران" للشاعر شلال عنوز
1//الدِكّاكُ أَرائِكَ المَنامْ
والسَّماءُ تَقطُرُ ياقوتا
مقدمة: تشكّل السيميائية ومفهوما القراءة والتلقي أحد أبرز التحولات المنهجية في النقد الأدبي الحديث. ففي البداية، كانت إسهامات رولان بارت وأمبرتو إيكو وغيرهما كثيرون قد نقلت المناهج البنيوية التكوينية والدرس النقدي النسقي عمومًا إلى مرحلة جديدة، حيث أصبح التوسع في بحث الرموز والعلامات مدعاة للخروج إلى واقع حال السياق للتعرف على جذور الطبقات العميقة للرمز والتناصات ودلالة الألوان والعلامات والإشارات والتنقيط والفراغات... إلخ. وجاءت نظرية التلقي لتوسع آفاق تلقي النص، إذ انتقل الاهتمام من سلطة المؤلف إلى فاعلية القارئ. وقد أرست مدرسة كونستانس الألمانية [ياوس، إيزر] دعائم هذا التوجه عبر "جمالية التلقي"(1)(2). ورغم أن النقد الغربي وضع أطرًا متعددة لهذا الحقل، فإن النقد العربي ما زال يتأرجح بين الانطباعية والاقتباس غير المكتمل للبنيوية والسيميائية(3).
تهدف هذه الورقة إلى تقديم تمهيد نظري متين لنظرية التلقي، انطلاقًا من مفاهيمها الجوهرية: أفق التوقع، المسافة الجمالية، القارئ الضمني، الفجوات النصية، مع رصد أبرز الإشكالات التطبيقية في الدرس النقدي العربي، تمهيدًا لتطبيقها على قصيدة "حي بن سكران" - وهي قصيدة لا تُقرأ بسهولة، ولا تُستهلك بيسر، بل تفرض على القارئ أن يكون شريكًا في صناعة المعنى، مُعيدًا تركيب الرموز، ومُستنطقًا للفراغات، ومُستحضِرًا للسياقات - وهو ما يجعلها نموذجًا مثاليًا لاختبار فاعلية النظرية التلقّوية في السياق العربي.
لماذا "حي بن سكران"؟ مبررات الاختيار في ضوء الإطار النظري
لم يكن اختيار قصيدة "حي بن سكران" اعتباطيًا، بل جاء نتيجة توافق تام بين خصائص النص ومقتضيات الإطار النظري. فالقصيدة:
- تنشئ فجوات دلالية عميقة، تبدأ من العنوان ذاته الذي يُعيد تشكيل تناص فلسفي-صوفي معروف ("حي بن يقظان")، ليقلب "اليقظان" إلى "سكران"، في إشارة إلى حالة من الهذيان أو التحرر من العقلانية، مما يُربك أفق توقع القارئ.
- غنية بالعلامات والرموز المتعددة الطبقات: حيوانات، ألوان، حركات جسدية، صور متدفقة كأنها من عالم الأحلام أو الهذيان، كلها تشكل شبكة سيميائية معقدة تتطلب قارئًا فاعلًا.
- تتحدى القارئ الضمني الذي يفترضه النص: قارئ ملمّ بالتراث الصوفي، متابع للشعر الحداثي، قادر على التعامل مع التفكيك واللادلالة، ومستعد للدخول في لعبة التأويل دون البحث عن "معنى واحد".
- تنتمي إلى سياق ثقافي-اجتماعي معاصر يعج بالتحولات والهويات المتشظية، مما يجعلها صالحة للتحليل السوسيولوجي والثقافي جنبًا إلى جنب مع التحليل السيميائي والتلقّوي.
بهذا، تصبح القصيدة مختبرًا نظريًا مثاليًا لاختبار فاعلية القراءة التكاملية التي نقترحها.
إشكالية الدراسة
دراسة الرمز والاحتفاء بالقارئ تحت أي مسمّى ينبغي أن يستجيب لمواصفاته النوعية، ومهما عظم شأن القارئ في عقدتنا النقدية، فإنه لا يلغي حضور المؤلِّف. وهذا الفهم يتأتّى من قراءة تختلف عمّا ذهب إليه العديد من النقاد لفقه معنى مقاصد رولان بارت عن المؤلف مثلًا، آخذين في الاعتبار مرجعية النقد الغربي بشقَّيه الأنكلوسكسوني والفرانكوفوني، لغالب النقاد المتسيّدين لمعالجة النصوص الحداثية وما بعد الحداثية.
الشبابية في فهم المصطلح والنظريات والمناهج المتعددة أوقعت الكثير في عدم الركون لمفاهيم مستقرة، فانعكس ذلك على أن المعالجات النقدية العربية يعتريها التخبط، بل إن كثيرًا من الممارسات لم تغادر الانطباعية والنفسية الواقعية المتخشّبة التي تجاوزها أصحابها أنفسهم. وحتى من طرق البنيوية التكوينية كما يزعم بعض النقاد، فإنه لم يبارح البنيوية في شكلها البدائي. أما الأسلوبية فإن العديد ما زال في فضاء بوفون.
من ذلك: كيف يمكن لنظرية التلقي أن تُخرج القراءة العربية من دائرة الانطباعية واقتباس المفاهيم الشكلي إلى ممارسة نقدية منتجة تُفسح للنص باب التعدد والتجدد؟ وما مظاهر الإخفاق العربي في تداول هذه النظرية؟ وكيف يمكن تجاوزها من خلال قراءة تكاملية تجمع بين الخصوصية الثقافية العربية والمنجز الغربي؟
أولًا/ نظرية التلقي بين الأصل والتطور
1- أفق التوقع (ياوس): هو التراكم التاريخي والثقافي الجماعي الذي يُقاس عليه الجديد الأدبي(4).
2. المسافة الجمالية: فجوة إنتاجية بين توقع القارئ وعرض النص؛ كلما اتسعت دون انقطاع كانت القراءة أكثر تأويلًا(5).
3- القارئ الضمني (إيزر): بنية نصية تفترض كفايات معرفية وسيميائية تسمح بملء الفجوات(6).
4- الفجوات: مناطق غياب يُنجز القارئ خلالها إنتاجه المعنوي(7).
5- فعل القراءة: براكسيس تفاعلي يُنتج المعنى ويُجدده باستمرار(8).
ملاحظة منهجية: نستخدم في هذه الدراسة مصطلح "السيمو-قرائية" كاختزال لعبارة "**القراءة السيميائية التلقّوية التكاملية**"، أي تلك التي تجمع بين تحليل العلامات (سيميولوجيا النص) ودور القارئ في إنتاج المعنى (جمالية التلقي)، في إطار منهجي واحد يتجاوز التجزئة، ويُعيد تركيب النص من الداخل (علامات) والخارج (سياقات وتوقعات).
ثانيًا/ نظرية التلقي في النقد العربي - أزمة التطبيق
1- الاقتباس الشكلي دون تفعيل تحليلي.
2 -تعدد تعريفات "القارئ" بلا معيار موحد.
3- قراءة النصوص بمعزل عن أنساقها الثقافية، فاستُعيدت الاستاتيكية التي جاءت النظرية لكسرها(9).
إثراء مرجعي عربي: إلى جانب إحسان عباس، يمكن الاستعانة بدراسات نقدية عربية حديثة ساهمت في توطين نظرية التلقي أو تطوير السيميائية الشعرية، مثل:
- د. عبد الملك مرتاض في "السيميولوجيا والنص الشعري".
- د. صلاح فضل في "جماليات التلقي وتأويل النص".
- د. سعيد يقطين في "النص والخطاب والتأويل".
- د. عبد الفتاح كيليطو في "الناقد والتأويل".
هذه المراجع تمنح الدراسة بعدًا عربيًا متجددًا، وتكسر احتكار المرجعية الغربية.
ثالثًا: نحو قراءة تكاملية
يقترح البحث منهجًا يجمع:
- السيميائية (لبنيات النص وتحليل العلامات)،
- السوسيولوجيا (سياق الإنتاج والخطاب المجتمعي)،
- التحليل الثقافي (آفاق التوقع وطبقات التناص)،
- الظاهراتية (الفينومينولوجية) (وعي القارئ وتجربته الذاتية أثناء القراءة)،
فتتحول نظرية التلقي من شعار نظري إلى أداة تحليلية منتجة.
تحديد أولي للقارئ الضمني في "حي بن سكران":
يفترض النص قارئًا:
- ملمًّا بالتراث الصوفي والفلسفي (خصوصًا ابن طفيل وابن عربي).
- على دراية بالشعر الحداثي وتقنياته (التفكيك، التدفق، اللاخطية).
- قادر على التعامل مع الرمز واللادلالة.
- مستعد للدخول في حالة من "التخلي عن اليقين" والانغماس في عالم النص الهلامي.
هذا القارئ ليس "حقيقيًا"، بل هو بنية نصية يُعيد القارئ الحقيقي التشكل وفقها أثناء القراءة.
خريطة منهجية مختصرة للتطبيق العملي على القصيدة
عند الانتقال إلى التحليل، سيتم تقسيم الدراسة وفق المحاور التالية:
1- تحليل العنوان وتفكيك التناص:
- "حي بن سكران" مقابل "حي بن يقظان": تحوّل من العقل إلى الهذيان، من اليقظة إلى السُكر.
- دلالات "السكر" في التراث الصوفي والأدبي.
2- رسم أفق التوقع وقياس المسافة الجمالية:
- ما الذي يتوقعه القارئ من قصيدة بهذا العنوان؟
- كيف يُفاجئه النص؟ وأين تقع "المسافة الجمالية"؟
3- تحليل الشبكة السيميائية:
- العلامات الحيوانية، اللونية، الحركية.
- التكرارات، التقابلات، الصور المتدفقة.
- دلالات الفراغات والتنقيط والإيقاع الداخلي.
4-رصد الفجوات النصية ودور القارئ في ملئها:
- أين يصمت النص؟ وما الذي يُترك للتأويل؟
- ما الأسئلة التي يطرحها النص دون إجابة؟
5-القارئ الضمني والقارئ الحقيقي:
- من يفترضه النص؟ ومن يقرأه فعليًا؟
- هل هناك توتر بين القارئ المثالي والقارئ العادي؟
6-السياق الثقافي والسوسيولوجي:
- لماذا هذا النص الآن؟
- ما الخطاب المجتمعي أو النفسي الذي يعكسه أو يتحداه؟
خلاصة
أظهرت نظرية التلقي تحولًا جوهريًا يجعل القراءة فعلاً جدليًا بين النص والقارئ. لكن تطبيقها العربي لا يزال يعاني الاضطراب والاقتباس الشكلي؛ لذا تبدو الحاجة ملحة إلى قراءة تكاملية تجمع المنجز الغربي بالخصوصية العربية، بما يكسر الاستاتيكية ويفتح النص على تعددية القراءات وبتوظيف السيميولوجيا والبنيوية التكوينية وغيرها من المناهج.
***
د. سعد محمد مهدي غلام
....................
الهوامش
(1) هانس روبرت ياوس، نحو جمالية التلقي، ترجمة فخري صالح، عمّان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004.
(2) فولفغانغ إيزر، فعل القراءة: نظرية في جمالية التلقي، ترجمة سعيد الغانمي، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1991.
(3) إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، بيروت: دار الثقافة، 1971.
(4) ياوس، المرجع السابق، ص 45-48.
(5) إيزر، المرجع السابق، ص 87-92.
(6) أمبرتو إيكو، دور القارئ، ترجمة سعيد بنكراد، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009، ص 33-38.
(7) ميشال ريفاتير، سيمياء الشعر، ترجمة محمد الولي، الدار البيضاء: توبقال، 1988، ص 76-79.
(8) إيزر، المرجع السابق، ص 135-142.
(9) ستانلي فيش، هل هناك نص في هذا الصف؟، ترجمة علي حاكم صالح، بغداد: دار المأمون، 2012، ص 55-62.
(10) عبد الملك مرتاض، السيميولوجيا والنص الشعري، الجزائر: دار الغرب الإسلامي، 2003.
(11) صلاح فضل، جماليات التلقي وتأويل النص، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2005.
(12) سعيد يقطين، النص والخطاب والتأويل، الدار البيضاء: افريقيا الشرق، 2007.
(13) عبد الفتاح كيليطو، الناقد والتأويل، ترجمة حسن بن صالح، الدار البيضاء: توبقال، 1993.