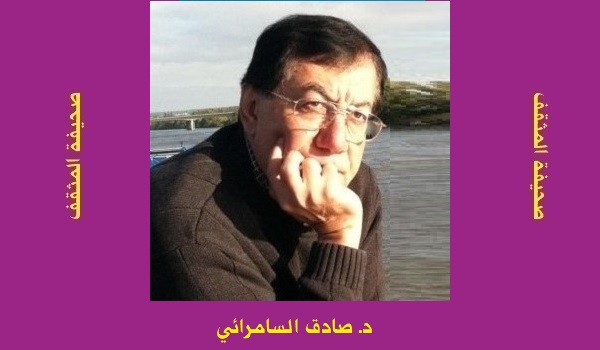قراءات نقدية
صالح الرزوق: مفهوم الأسرة في قصص جمال الهنداوي

عن دار السرد في بغداد صدر لجمال الهنداوي مجموعة، تتكون من ثماني قصص، جاءت بعنوان "حب وحمص وثالثهما نيتشة".
تصدرت الكتاب مقدمتان.
الأولى لكريم شوقي حسن، وورد فيها أن حكايات الهنداوي تدور في أرجاء المدينة، وتتابع وجوه شخصياتها الطيبة والعفيفة.
والثانية لقصي الشيخ عسكر، وبدوره يؤكد أن للقصص عين كاميرا لكنها مدعومة بعاطفة القارئ ووجدان الكاتب، بمعنى أنها حكايات تتداخل فيها حياة جميع شرائح المجتمع، حتى أنها تبدو أقرب لشهادة عن أحياء المدينة وسكانها ومعاناتهم.
من الناحية الفنية يمكن إدراج كل القصص في مجال أو فضاء حزام الخمسينات الذي حمل هموم الناس، وكان مرحلة انتقالية على مستويين.
في التفكير انتقل من معاناة جيل الهزيمة إلى جيل الاستقلال، ولذلك كانت الموضوعات بمعظم الأوقات مغمسة بالدم ثم بالعرق، أو بمشاكل التحرير ثم مشاكل البناء. وفي الحالتين لم يكن يخلو أي مشروع أدبي من أحزان وفجائع وصدمات تنم عن وعي شقي وخسارة مهينة.
وفي أساليب التعبير كان محطة استراحة تفصل بين حداثتين، الرومنسية التي انقلبت على تقاليد الكلاسيكية الجديدة، وعلى ما بعد الواقعية - وهو الاتجاه المعروف في النقد الأدبي باسم الحداثة. وغني عن الذكر أنها حداثة تتكون من أطياف موزعة على قوس عريض من التأويل والتعبير. ولعب هذا التوسيط دور جسر متحرك ساعد على تبديل إدراكنا لمعنى الذات، من مجرد قلب مكلوم وحزين إلى تجربة فردية داخل مجتمع ممزق ومضطرب. ويمكن متابعة هذا التواطؤ بين الأضداد في قصة "دليفري"، وهي عن أم تبتاع الطعام من عامل توصيل لأنه يذكرها بابنها المفقود. وكذلك في قصة "العطر"، وتدور حول صداقة بين بائعين في حي شعبي، وتنتهي بوفاة أحدهما. وأخيرا في قصة "زواج مصلحة"، وهي شهادة عن تحول العقد الاجتماعي إلى سياسة مكيافيلية، الهدف منها المصالح فقط. ولا يهم أن الزوجين امرأة ورجل، فكلاهما وجهان لورقة واحدة، وهما بتعبير رولان بارت، في دراسته عن بناء القصة، مجرد نمط. أو تكرار لحالة يسميها باسم "ذات الشخص". بمعنى أن المرأة والرجل لا يعبران عن طبيعتهما البيولوجية ولا عن الدور النوعي - أو الوظيفة المناطة بهما و لكن عن وعي كل منهما لموضعه في الحياة.
وإذا ابتعدنا قليلا عن الفهم السطحي لعذاب هذه الشخصيات، ولدورهم الاجتماعي، يمكن أن نلاحظ أنهم جزء لا يتجزأ من التفسير الفرويدي لقصة العائلة. فالشخصيات كلها من عائلة واحدة هي بسطاء وفقراء الناس، وجميعهم لا يستعملون عقولهم للخلاص من الأزمة ولكن قلوبهم. ولذلك يبدو أنهم كالجندي الأعزل، ولا خيار ولا حل أمامهم غير الاستسلام. وهم مستعدون لإقفال أبواب عقولهم. بتعبير آخر إلغاء متاعب التفكير، والاستسلام للقدر الأعمى والقاسي والذي لا يرحم أحدا.
ويمكن تصنيف كل هذه الشخصيات في ثلاث فئات - إذا دمجنا تحليل بارت مع تفسيرات فرويد.
أول فئة هي عن أمهات وأبناء. ومن الواضح أنها علاقة أنماط. فالابن هو أي شاب أو يافع، والأم هي كل امرأة عجوز سبق لها أن تكفلت بإرضاع وتغذية طفل. بمعنى أن الأبناء لا يعرفون أمهاتهم بالضرورة. وهذا هو حال قصة "دليفري". فعامل التوصيل، نائب الابن، ومبعوث من طرفه، ويذكرني كثيرا بصابر بطل "الطريق" لنجيب محفوظ والذي يعرف أمه ولا يوجد لديه أي فكرة عن والده، ويقوده هذا الحضور والغياب لحالة شك واضطراب وجودي ينتهي بسفك الدم كالعادة. ولكن يتمسك الهنداوي بالنظافة، ولا يلوث يديه بالدم. ويتحقق ذلك بخطوتين بمنتهى الأهمية إذا نظرنا إلى لغة الأعماق. أولا لا يوجد ولوج في القصة، فالشاب يراوح عند أعتاب الباب، ويلغي أي شبهة بالسفاح وزنى المحارم. وتقتصر الوظيفة على مبدأ التغذية الراجعة - وتسليمها رزم الطعام الجاهز. ويساعد على إتمام المهمة، بدون قتل أو سفاح، غياب الأب، السبب الأول في رهاب الخصاء.
ثاني فئة هي عن الأخوة. وفي حالة قصة "العطر" عن أخوين فقط. ولكن الأم هنا هي مثيل للأب أو ند له، ولذلك لا يوجد جريمة أوديبية ولا أي صدام بين الآباء والأبناء. يضاف لذلك أن الأخوين توائم. فهما متشابهان بالعمر والمهنة. وكذلك بالمكان والفترة الزمنية. ولا أتوقع في هذه الظروف نشوء عقدة تلصص تتطور إلى غيرة وحسد. ويحل محلها علاقة تكافل أو اتفاق شفوي على توزيع المهام.
ولنزع وربما تبريد فتيل الأزمة يخطف الموت الأم في قصة "دليفري"، والأخ التوأم في قصة "العطر". ويهيئنا للتعايش مع جو يخيم عليه الأسى وواجب العزاء. وذلك في إطار من ألوان رمادية وسوداء - ويرمز له في قصة "بجاه أبي الجوادين" بعباءة المرأة وطياتها. ولا أستطيع أن لا أرى أي صلة بين شبح الموت العابر في قصة "الغريب" لكامو - حينما يضع ميرسو إشارة حداد سوداء على ياقته، والمصير المحتوم في قصص جمال الهنداوي، والتي تبدأ بفكرة عامة عن وجود ناقص وغامض، وتنتهي بموت زؤام وصامت. وهذه إحدى أهم وسائط الإعراب عن العدمية عند العرب وعدم انسجامهم مع قوانين الأب ومرحلته. ولا تبتعد الروايات العسكرية التي صورت حروب الإنقاذ - عند العجيلي ثم حروب النكسة عند عبد النبي حجازي - عن هذا الهم الدفين. فالعجيلي يهرب من تبعات الخسارة إلى السياحة، وللتجول في أرجاء أوروبا حيث يخترع لنفسه آباء مهاجرين أو تاريخا قديما دالت دولته، وجمراته لم تنطفئ بعد (انظر قصص "قناديل إشبيلية"). وينقل حجازي المعركة إلى مكاتب تدور فيها المراوح، وإلى إثبات فحولته بضرب الزوجات وإقامة علاقة مع النساء الجميلات. وأخيرا بإلقاء الطرائف وشرب الكحول، وكلها أدوات لإلغاء الوعي المشؤوم، وإفساح المجال للشعور الباطن والغرائز. وأعتقد أنه أسلوب من أساليب النقد الذاتي لدرجة التجريح.
ثالث وآخر فئة عن نساء ورجال، أو أزواج وزوجات. ولكن في ظل هدنة مكيافيلية ومشبوهة، وتمثلها قصة "زواج مصلحة". وهي هدنة تجارية تعبر عن حركة إصلاح نفعي، مثل الاتفاقيات التي تعقدها أحزاب متنافرة لكن يجمعها حب التسلط، وأشبه ذلك بمؤسسة الجبهات الوطنية - والتقدمية في بعض البلدان. ومع أنه لا تتوافر أركان التشبيه، و بالأخص أن القصص بعيدة عن السياسة، لكن هذا لا يمنع أنها تنقل رسالة لخطاب اغترابي يفاقم من الإحساس بالمنطقة الرمادية التي نسقط في حفرتها. وتلمس قصة "حب وحمص وثالثهما نيتشة" هذه المشكلة حينما يقرر بائع الحمص أن يبدل مهنته إلى بائع كتب مع أنه لا يقرأ ولا يكتب، وذلك للاستحواذ على قلب صبية يرغب بها. ومن حسن الحظ أنه ترك النهاية معلقة، وهذه أهم نقطة في جميع القصص. فهي أشبه ببدايات تبحث عن نهاية مناسبة لشخصياتها. وهذا البحث المضني هو لب وجوهر موضوع كامل المجموعة.
***
د. صالح الرزوق – أديب وناقد ومترجم