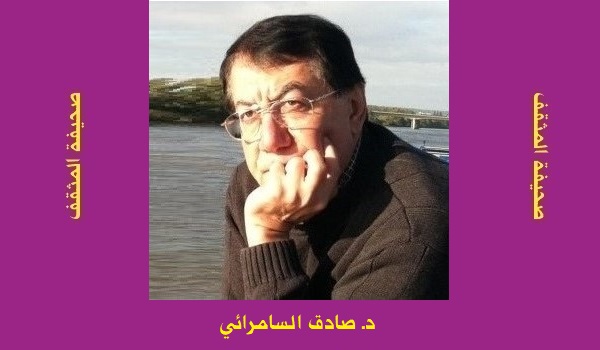قراءات نقدية
حسين القاصد: التشبيه بالحيوان.. نقد ثقافي

والذي حارت البريّة فيه
حيوان مستحدث من جمادِ
المعرّي.
أخطر الأكاذيب التي ألبست ثوب الإبداع، وخدعنا بها البلاغيون، ونقدة الأدب الملقَنين والملقِنين معاً، هو التشبيه البلاغي الذي لا بلاغة فيه ولا هم يفرحون؛ فالمرء من الصحراء إلى المدينة، ومن البعير إلى الطيارة، هو صديق موجودات بيئته التي هي عدوته في الوقت نفسه؛ أما معينه فثقافته واطلاعه، إن بصراً أو سماعاً:
لَقَد أَقومُ مَقاماً لَو يَقومُ بِهِ
أَرى وَأَسمَعُ ما لَو يَسمَعُ الفيلُ
لَظَلَّ يُرعَدُ إِلّا أَن يَكونَ لَهُ
مِنَ الرَسولِ بِإِذنِ اللَهِ تَنويلُ
هكذا كان كعب بن زهير يرتعد خوفاً، ولأنه يكابر في خوفه جعل الفيل يرتعد خوفا ثم شبّه نفسه به! ولعلّ مخبوءاً لوّح به الشاعر ليوقع عقداً ثقافيا يجلب له الأمان؛ ذلك لأن الرسول الأكرم ولد في عام الفيل وهو العام الذي غزا فيه إبرهة الحبشي الكعبة بجيش تصحبه الفيلة، لذلك كَسِيَ الشاعر خوفه بهول تلك الحادثة التي استهدفت الكعبة، ثم جعل الفيل الذي ظلت حادثته مرعبة، ولم ينكسر إلا بعد تدخل الله "عزّ وجل" حين دحر الفيل وأصحابه، بطيرٍ أبابيل.
الفيل ـــــــــــــــ الطير
الإنسان
لقد وفرت الشواهد أو الخزين المعرفي للشاعر ضمان الأمان، فمن الموروث والذاكرة الجمعية والثقافة القرائية الاستقصائية، من كل هذا تقترن الأشياء، وعلى الرغم من امتلاك الإنسان العقل والكلام، إلا أنه مع يقينه من أنه سيد المخلوقات تتسرب من بين جدران لغته بأنه أضعف من الحيوان والجماد، بل يتمنى أن يصل لبعض من مزاياهما؛ لذا نرى أن التشبيه في أسّه ثقافي، وذلك أمرٌ لم يدركه الأولون فوصلنا عبر التلقين، كما (إن الصورة الجديدة في القصيدة المعاصرة لم تدفع إليها نزوة طائلة، أو مجرد رغبة في التجديد، وإنما جاءت لتحول عميق لثقافتنا الفكرية والفنية)(1)، ويبدو أن محمد مندور أدرك التحول ولم يتناول عيوب الجذور، ولأن التحول ثقافي وفكري وهو تحول تصحيحي لمفاهيم رسخت بوساطة التلقين، فهذا يعني أن علينا أن نقرأ ما قبل التحول وحتى ما بعده، ونقول إن كل تشبيه هو ثقافي وكل صورة هي ثقافية، نابعة من علاقة المرء بالموجودات من حوله.
يذهب مارتن هايدغر إلى أن اللغة تكشف لنا خفايا الأشياء، وتظهرها بألوانها وأصواتها، فهو يرى) أن اللغة تُشكل الوسيلة التي ينهض من خلالها تاريخياً عالم أي شعب من الشعوب... ويلاحظ هايدغر في الوقت نفسه أنه بينما تشير هذه الصورة إلى ما يمكن قوله، تجلب اللغة أيضاً إلى العالم ما لا يقبل القول، فذلك الشيء الذي لا يمكن قوله، أو الظل الذي تُسقطه الصور الرأسية للأشياء، يرسم حدود الواقع دون أن يحاول تحديد معالمه)(2).
واقع الحال أنّ الإنسان العربي أو الشرق أوسطي، يمارس نسق التعويض بالشتائم فيصف خصمه بالحيوان، الكلب، القرد، الخنزير، هجاءً منطلقاً من حقيقة أن الإنسان أعلى منزلة، لكنه في الوقت نفسه يصف حبيبته بالغزالة والحمامة واليمامة ويصف الرجل الشجاع بالأسد، فهل في الأمر نوع من أنسنة الحيوان القوي الجميل، وحيونة الإنسان الضعيف القبيح؟ الجواب: لا، فالمرء ابن محيطه، ويتعامل مع ما يراه، جمالاً وقبحاً، قوةً وضعفاً، أليس هناك من يعبد البقرة؟ ولعلهم يعبدونها لما تهبه لهم، فالبشر عبد العطايا وعبد القوي وأسير الجمال، لذلك يلتصق بأقرب المعوضات لخيباته؛ فقد (يكون الواقع كبيراً جداً كضخامة الكون، على سبيل المثال، أو ربما يكون صغيراً جداً، إنما يكتنفه الغموض. سجل جاك دريدا (Jacques Derrida) تجربة مقلقة عندما التقت عيناه بعيني قطته التي كانت تحدق به وهو عار. فنحن ننظر إلى القطط في معظم الحالات أنها كائنات جديرة بأن تكون موضع اهتمامنا، ولكن كيف تنظر إلينا هذه القطط؟ هل ترانا كأي شيء آخر، أو ليس بالشيء الكثير؟ وما الشعور الذي ينتاب قطة عندما تنظر إلى إنسان دريدا؟)(3)، ودلالة أن الواقع كبير، وربما الموجودات تشكل قلقا وخوفاً للإنسان، نجد أبا الطيب المتنبي يجعل من حصانه معلّما موبّخا له ولنا:
يَقولُ بِشِعبِ بَوّانٍ حِصاني
أَعَن هَذا يُسارُ إِلى الطِعانِ
*
أَبوكُم آدَمٌ سَنَّ المَعاصي
وَعَلَّمَكُم مُفارَقَةَ الجِنانِ
أليس الحصان هنا أعلى رتبة من الناس جميعا؟ إن القطة التي هي حيوان أليف حيرت جاك دريدا، وجعلته يخشى أن ترى عريه، وإن كان ذلك افتراضاً، لكن لماذا رفع المتنبي حصانه إلى رتبة من يملك الحجة على راكبه؟ أليس في ذلك جلدٌ لضعف الإنسان، فالمتنبي نفسه، حين أراد أن يصف قوة وشجاعة ومنزلة سيف الدولة، شبهه تشبيهاً ثقافيا ورسم صورة سيرية ثقافية، لا صورة بلاغية، جيث قال:
يا سيف دولة ذِي الْجلَال وَمن لَهُ
خير الخلائق والأنام سميُّ
*
أَو مَا ترى صفّين كَيفَ أتيتها
فانجاب عَنْهَا الْعَسْكَر الغربيُّ
*
فَكَأَنَّهُ جَيش ابْن حَرْب رعته
حَتَّى كَأَنَّك يَا عَليّ عَليُّ
لقد اختلف مقام القول والاقتضاء التداولي، فارتفع المتنبي عن نسق الحيونة الثقافي، وشبه من يريده قوياً بسند تاريخي لرجل قوي معتمدا على ثقافته برسم الصورة والتشبيه الثقافي، من دون الاحتياج إلى الموجودات المحايثة له، بل غرف صورة من الأثر الراسخ المستمر الذي يمثل قوة إنجازية في أي حجاج.
لقد تعامل "أبو الطيب" مع الموجودات من حوله تعاملاً براغماتياً، فعلى الرغم من تهمة الفحولة التي وسمه بها عبد الله الغذامي الذي لم يفرق بين فحولة الشعر والذكورة النسقية، نجد أبا الطيب ينسف الذكورة من دون التنازل عن فحولته الشعرية:
فلو كان النساء كمن فقدنا
لفضلت النساء على الرجال
ولأن الشمس من الموجودات المؤرقة والمحببة للإنسان في آن واحد؛ والشمس من المعبودات تاريخيا، وجدنا المتنبي يصف المرأة بالشمس لكنه يفضلها على الشمس الحقيقية:
فليت طالعة الشمسين غائبةٌ
وليت غائبة الشمسين لم تغب
وقد يتساءل القارئ الكريم ويقول: نراك ذهبت إلى الجمادات وتركت الحيوان، فأقول: إن أبا الطيب نفسه احتاج إلى أن يصف نفسه بالأسد:
إِذا رأيتَ نُيوبَ اللَيثِ بارِزَةً
فَلا تَظُنَّنَّ أَنَّ اللَيثَ يبتَسِمُ
فكم هي مفارقة، وقد يقال: إنه مقام القول، لكن ألم يرفع المتنبي رتبة حصانه إلى منزلة الناصح المذكر/ الموبخ، وهل الحصان أعلى رتبة من الأسد؟ لكن الجواب يكمن في أن الإنسان يعيش شعورا لما يكمله، فهو من دون الموجودات من حوله، يبقى أسير الاحتياج والنقص، وهذا شائع جدا في الأدب العربي والشرق أوسطي.
وإذن، كل تشبيه هو ثقافي محض، نابعٌ من الثقافة والقلق الإبداعي، ذلك لأن (الأفكار التي أزاحت جذرياً آفاق فروع العلوم الإنسانية في نصف القرن الماضي ظهرت للوهلة الأولى كنظريات للثقافة بشكل عام، وعندما بدأ فردينان دي سوسير (Ferdinand de Saussure) بتقدير قيمة اللغة ورفع منزلتها بمعزل عن أي مرسى مفترض لها في الأشياء أو الأفكار، اتضح أن تفسير العالم الذي اتخذته المعاني التي تعلمناها قد لا يكون أكثر من نتاج للثقافة. وكانت الكيانات المستقلة التي ميزتها اللغة عن بعضها بعضاً مدينة لنظام الاختلافات الذي سلمنا به أكثر من كونها مدينة لأي وجود)(4)، وهذه الاختلافات هي بنت الاحتياج، فالمرء إن عدِم وجود ما يحتاجه، لجأ للغيبيّ؛ لأن (معظم المناقشات التي تتناول الثقافة تتجه بصورة ملحوظة نحو النقد الثقافي، وتسلم بالعلاقات الممكنة بين الصور المرئية والتراكيب اللفظية، من دون طمس الاختلافات العامة بينهما)(5).
ولنا أن نقر بنزعة الاحتياج لدى الإنسان، فضلا عن محاورته لما حوله من موجودات، بل حتى لما هو غيبي؛ فعلى الرغم من أنه يغدق على نفسه بكل الصفات الحيوانية، وهذا يشي بأن الحيوان أعلى رتبة! لأن المرء مجبول بالتطلع إلى الصفات الأسمى؛ لكننا وربما ننهي هذا بمفارقة، وهي أن المرء حين يتذكر عقله يرمي كل الموجودات جانباً ويحلق عالياً، كما في قول المتنبي:
حولي بكل مكان منهم خلقٌ
تخطي إذا جئت باستفهامهم بمن!
لقد رمى المتنبي خصومه بالحيونة أو انعدام العقل؛ لأن (من الاستفهامية) للعاقل. ولنا أن نختتم بقول أحمد الصافي النجفي:
يعترض العقل على خالقٍ
من بين مخلوقاته العقل!
أيعترض؟ وحين يصف ما يريد وصفه، يضفي على الموصوف صفات مستعارة من الحيوان؟ ليس من أمر سوى نسق المواءمة، وإن كل تشبيه إنما هو ثقافي.
وقد قالت العرب: (ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺸﺮ ﺧﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ اﻟﺤﻴﻮاﻥ: ﺳﺨﺎء اﻟﺪﻳﻚ، ﻭﺗﺤﻨﻦ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ، ﻭﻧﺠﺪﺓ اﻷﺳﺪ، ﻭﺣﻤﻠﺔ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺭﻭﻏﺎﻥ اﻟﺜﻌﻠﺐ، ﻭﺻﺒﺮ اﻟﻜﻠﺐ، ﻭﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻜﺮﻛﻲ، ﻭﺣﺬﺭ اﻟﻐﺮاﺏ، ﻭﻏﺎﺭﺓ اﻟﺬﺋﺐ، ﻭﺳﻤﻦ ﺑﻌﺮﻭا، ﻭﻫﻲ ﺩاﺑﺔ ﺑﺨﺮاﺳﺎﻥ ﺗﺴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺐ ﻭاﻟﺸﻘﺎء)(6). أبو حيان التوحيدي.
***
ا. د. حسين القاصد
أستاذ النقد الثقافي في الجامعة المستنصرية كلية الآداب
........................
(1) فن الشعر، محمد مندور: مؤسسة هنداوي للنشر (المملكة المتحدة)، 2017: 47.
(2) الثقافة والواقع، نحو نظرية للنقد الثقافي، كاثرين بيلسي، تر: باسل المسالمة، وزارة الثقافة- دمشق، 2017: 18.
(3) الثقافة والواقع، نحو نظرية للنقد الثقافي: 19.
(4) الثقافة والواقع، نحو نظرية للنقد الثقافي: 20.
(5) المكان نفسه.
(6) الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين، مؤسسة الهنداوي، ٢٠١٩ : ٤٩ – ٥٠.