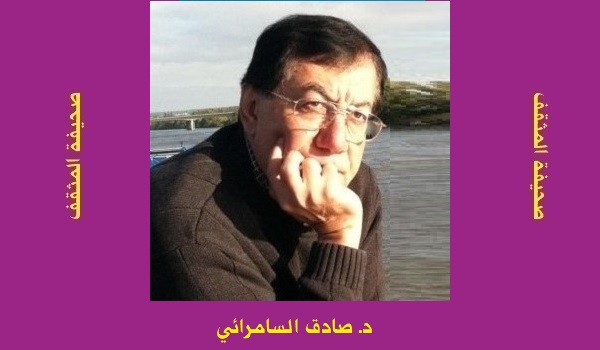قراءة في كتاب
عبد السلام فاروق: الرواية التاريخية والرؤية الغربية

قراءة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث
يطرح كتاب "تاريخ الشرق الأوسط الحديث" لـِ وليام كليفلاند ومارتن بنتون، والمترجم ببراعة بدر الرفاعي، سؤالًا جوهريا عن كيفية تشكيل السرديات التاريخية لوعينا بالمنطقة. لا يكتفي الكتاب بسرد الأحداث، بل يحولها إلى بانوراما حكائية تدمج السياسي بالاجتماعي والديني، متخذة من الزمان والمكان خيطًا ناظمًا يمتد من القرن الثامن عشر حتى الحادي والعشرين، ومن مصر إلى إيران. هنا، يتحول التاريخ من سلسلة أحداث إلى نسيج سردي معقد، يذكرنا بأسلوب المؤرخين العرب القدامى الذين جمعوا بين الإخباري والحكائي، لكن بمنهجية حديثة تستحضر "الرؤية الغيرية" للآخر الغربي.
السرد التاريخي بين التوثيق والتأويل
يميز الكتاب، الصادر حديثا عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة ، تركيبه السردي الذي يحول الوقائع إلى حكاية متصلة، حيث تقرأ تحولات المنطقة عبر مفاصل زمنية مترابطة، كأنها فصول رواية. هذا النهج يذكر بتحليلات النقد السردي الذي يعيد بناء الوقائع عبر منظور المؤلفين، حيث تقدم الشخصيات (الدول، الزعماء، الحركات) كأبطال ذوي دوافع متضاربة، تتقاطع مصائرهم بفعل العولمة والاستعمار. لكن هل يعكس هذا النهج "الرواية الغربية" للمنطقة، أم يحاول تجاوزها؟ هنا تكمن إشكالية "الاستشراق" التي نبه إليها إدوارد سعيد، فالكتاب - كمنتج غربي– قد يعيد إنتاج صورة الشرق كـ"آخر" مرصود من الخارج، حتى وإن حاول الموضوعية.
لا تنحصر أهمية الترجمة في نقل النص إلى العربية، بل في فتح حوار مع الرؤية الغربية. المركز القومي للترجمة، باختياره هذا العمل، يدفع القارئ العربي لمواجهة سؤال: "كيف يرانا الآخر؟"، ليس للتلقي السلبي، بل لتفكيك الخطاب الاستشراقي وإعادة بناء الذات عبر مرآة الغير. الترجمة هنا فعل مقاومة ثقافي، يحول النص إلى جسر لنقد الذات والآخر معًا. فكما أن التاريخ يكتب بمنظور متعدد، فإن الترجمة تعيد كتابته بوعي نقدي.
يبرز الكتاب تناقضين رئيسيين في تاريخ المنطقة: تشظي الحدود السياسية مقابل وحدة الثقافة، وصراع الهويات مقابل التمازج الحضاري. بتحليله المقارن لدول مثل مصر وتركيا وإيران، يكشف كيف تنتج الحقبة الواحدة وقائعَ متباينة بفعل التفاعل مع الاستعمار أو الحداثة. لكن هل يخفي هذا المنهج التكاملي اختلافاتٍ جوهرية في تكوين كل مجتمع؟ هنا، قد يقع السرد الشمولي في فخ التعميم، مهملًا خصوصيات المحلي، كأن يروى تاريخ المنطقة بلغة "المركزية الغربية" التي تعامل الشرق ككتلة واحدة.
يلمح الكتاب إلى مستقبل المنطقة، خاصة في علاقتها بالغرب والسلام، مما يطرح سؤالًا عن دور المؤرخ في استشراف المستقبل. هذا الانزياح من السرد التاريخي إلى التنبؤي يعيدنا إلى الجدل العربي حول العلاقة بين التراث والحداثة. فكما حاول رواد النهضة قراءة الماضي لاستلهام المستقبل، يحاول الكتاب ربط التحولات التاريخية بالتحديات المعاصرة، لكن بمنظور خارجي قد يغيب عنه الألم اليومي للإنسان العربي.
نحو سردية عربية جديدة
لا يكفي أن نقرأ كيف يروي الآخر تاريخنا، بل يجب أن نسائل آليات تشكيل سردياتنا الخاصة. كتاب كليفلاند وبنتون، بترجمته النقدية، يذكرنا بأن التاريخ ساحة صراع سردي قبل أن يكون مجموعة وقائع. فالمواجهة الحقيقية ليست مع "الرؤية الغيرية"، بل مع قدرتنا على إنتاج رواية عربية تجمع بين النقد الذاتي والانفتاح على العالم، دون اغتراب أو انكفاء. هنا، تصبح الترجمة فعلًا تنويريا، يحرر التاريخ من أحادية الرواية، ويحوله إلى حوار دائم بين الأنا والآخر.
التشكيل الثقافي والهوية في ظل الاستعمار
يثير الكتاب إشكالية تشكيل الهوية في الشرق الأوسط تحت وطأة الاستعمار، حيث تحولت الثقافة المحلية إلى ساحة صراع بين التقاليد المتوارثة والنماذج الغربية المُستوردة. فمن خلال تحليل سياسات التحديث في تركيا العثمانية أو مصر محمد علي، يتجلى كيف تم تفكيك النسيج الاجتماعي لصالح بناء دولة مركزية على النمط الأوروبي، مما أدى إلى انقسام الهوية بين "التراث" كرمز للانتماء، و"الحداثة" كشرط للبقاء. هذا الانقسام يذكر بنظرية هومي بابا حول "التمازج الثقافي" (Hybridity)، حيث تخلق هويات هجينة لا تنتمي كليًّا إلى الماضي ولا إلى الحاضر المستورد، بل تُنتج واقعًا جديدًا مليئًا بالتناقضات.
يعيد الكتاب طرح السؤال القديم-الجديد: كيف يمكن فهم الدين كعامل توحيد أو تفكيك في المجتمعات العربية والإسلامية؟ من خلال تتبع دور الأزهر في مصر، أو الثورة الإسلامية في إيران، يظهر الإسلام كإطار مرجعي يحرك الجماهير ويشكل وعيها السياسي. لكن النظرة الغربية غالبًا ما تختزله إلى "أيديولوجيا صراع"، متجاهلةً تعقيداته كنسق ثقافي يحمل أبعادًا روحية واجتماعية واقتصادية. هنا، يبرز تناقض الخطاب الاستشراقي الذي يعالج الدين كـ"مشكلة" يجب حلها، بدلًا من رؤيته كجزء عضوي من تشكيل الذات الجماعية.
يلامس الكتاب - ولو بشكل غير مباشر– دور المرأة والطبقات المهمشة في صناعة التاريخ، لكنه يبقى أسير المنظور الذكوري والبيروقراطي الذي يهتم بـ"الحدث الكبير" (الحروب، المعاهدات، الزعماء). هذا الإغفال يعيد إنتاج صورة المجتمع الشرقي ككيان ثابت، بينما تُخفي الوقائع التاريخية تحركات نسائية مبكرة، مثل مشاركة المرأة في ثورة 1919 المصرية، أو نضال العمال في مدن النفط. إن اختزال التاريخ في سردية النخب يمحو دور "التاريخ من أسفل" (كما سماه المؤرخ إريك هوبسباوم )، مما يعكس تحيزًا غربيًّا يركز على السلطة الرسمية دون قوى التغيير الشعبي.
النفط والتحولات الطبقية
يعتبر اكتشاف النفط في الخليج مثالًا صارخًا على كيفية تحويل الثروة الطبيعية إلى أداة تشويه للبنية الاجتماعية. فمن مجتمعات بدوية تعتمد على التضامن القبلي، تحوَّلت المنطقة إلى فضاء للاستهلاك المفرط والتبعية الاقتصادية للغرب. الكتاب يسلط الضوء على هذه التحولات، لكنه قد يفشل في ربطها بالاستعمار الجديد (Neocolonialism) الذي يحول الدول النفطية إلى "دول ريعية" تدار بإملاءات خارجية. هنا، تصبح الرأسمالية العالمية هي الوجه الآخر للاستعمار القديم، تعيد إنتاج التبعية تحت شعارات التحديث.
عند مناقشة الربيع العربي، يقع الكتاب في فخ السردية الغربية التي تصور الثورات كـ"فوضى عابرة" دون تعمق في جذورها الاجتماعية. فالثورات لم تكن مجرد رد فعل على الفساد، بل انفجار لتراكمات تاريخية من القمع واللامساواة الطبقية. إن اختزالها في "أزمة حكم" يتجاهل حقيقة أنها حركات ثقافية عميقة، عبرت عن رفض الشباب للهويات الجاهزة، سواءً تلك المفرَضة من الأنظمة أو المصدرة من الغرب.
لا يكفي نقد الرؤية الغربية للشرق الأوسط؛ فالمطلوب هو بناء منهجية عربية في قراءة التاريخ والثقافة، تعتمد على أنثروبولوجيا الذات، تدرس المجتمع ليس كـ"موضوع" للفحص، بل كفاعل في إنتاج معرفته. هذا يتطلب تفكيك الثنائيات المستهلكة (تقليد/حداثة، دين/علمانية، شرق/غرب)، واستعادة التعقيد الإنساني للمنطقة. فالشرق الأوسط ليس مجرد "مسرح أحداث"، بل نص ثقافي مفتوح، يعيد كتابة نفسه كل يوم بلغة الدم والأمل.
كلمة أخيرة
في زمن تتصارع فيه الروايات، يكون التاريخ حكاية نرويها بأنفسنا، أو نروى بها. وهذا الكتاب، بكل إشكالياته، دعوة لإعادة كتابة الحكاية.
***
د. عبد السلام فاروق