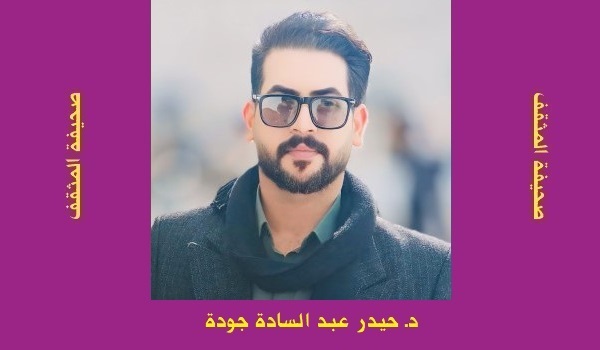قضايا
إبراهيم برسي: المكان بوصفه سؤالًا لا تُجيب عنه الفلسفة

ليس من السهل أن نكتب عن المكان من دون أن نتورّط فيه؛ وليس من السهل أن نتورّط فيه من دون أن ننكشف أمام تلك الحقيقة القاسية: أنّ الفلسفة لا تملك دائمًا الفصاحة ذاتها حين تلامس الأرض… تبدو المفاهيم كما في نصوص هايدغر وباشلار وميرلو-بونتي قادرة على فتح العالم، ولكن العالم نفسه لا ينتظر المفهوم كي يفتح أبوابه.
فـ“المكان” كما يُكتب عنه، شيء… و“المكان” كما يُعاش، شيء آخر تمامًا. وبين الاثنين تقوم تلك المسافة المربكة التي تجعل كل محاولة للتفكير امتحانًا للمفهوم أكثر من كونها انتصارًا له.
ذلك أنّ المكان، في تصوّر الفلاسفة، ليس مجرد حيّز، بل علاقة بين الكائن وما يحتضنه. يقول هايدغر إن الإنسان لا “يعيش” وحسب، بل “يسكن”، وأن السكنى هي جوهر الوجود نفسه. أما باشلار الحالم بالغرف والزوايا فيرى أنّ المكان يختزن فينا ذاكرةً شكلتها الطمأنينة. ويذهب ميرلو-بونتي أبعد من ذلك، فيجعل المكان شرطًا للجسد، والجسد شرطًا للوجود، والوجود شبكة من العلاقات التي تُختبر عبر الحركة والقلق والرغبة.
ولكن ماذا يبقى من كل هذا حين نضع المفهوم داخل سياقٍ مثل السودان؟
ماذا يحدث للمكان حين يُسحب من تأملاته الهادئة ويُلقى في يد الحرب؟
بل ماذا يحدث للفلسفة نفسها حين تُجبر على السير فوق أرضٍ محروقة؟
هنا تتكشّف المفارقة. فالمكان الذي يفترض أن يكون أساسًا للعناية - بالمعنى الهايدغري أو الفوكوي - يتراجع في السودان ليترك المجال لشيء آخر: لخرابٍ يسبق أي إمكان للعناية، ويعيد تعريفها لا كحضور، بل كغياب. فالعناية هنا تظهر من خلال انقطاعها… من خلال ذلك الفراغ الذي يتركه غيابها الفادح.
فالعناية، في بعدها الفلسفي، هي الإمساك بحياة الإنسان كي لا تتشظى. هي “اهتمام” قبل أن تكون “إحسانًا”، و“مسؤولية” قبل أن تكون “حماية”. وحتى فوكو حين تحدّث عنها بوصفها “تقنية للذات”، كان يشير إلى وعي يجعل الكائن قادرًا على النظر إلى نفسه داخل العالم بدل أن يُترك وحيدًا أمامه.
لكن ماذا لو كان المكان ذاته لا يسمح بهذا الوعي؟
ماذا لو كانت الجغرافيا كما هي في السودان لا تمنح للعناية فرصةً لكي تبدأ أصلًا؟
منذ منتصف القرن الماضي وحتى اليوم، ظلّ المكان السوداني عرضة لعمليات إعادة تشويه مستمرة:
مدن تُقصف كما لو أنها ملاحق غير ضرورية في دفتر الخرائط…
قرى تُمحى في غرب السودان بين ليلة وضحاها…
أحياءٌ في الخرطوم تُدار فيها الحرب كما تُدار لعبة فيديو، تُغيَّر حدودها بالرصاص لا بالمساكن…
ونازحون يهربون من مكانٍ لم يسكنوه إلا مؤقتًا إلى مكانٍ لن يُسمح لهم بسكنه إلا مؤقتًا أيضًا.
هنا يصبح المكان جريحًا، وتصبح العناية عاجزة عن أكثر من تسجيل الخيبة.
وإذا كانت الفلسفة الوجودية تبحث عن “انبثاق” المكان من ذاته، فإن السودان يمنحنا النموذج المضاد: المكان الذي لا ينبثق، بل يُنتزع؛ المكان الذي يُعاد تشكيله بالقوة لا بالعلاقات، وبالخوف لا بالطمأنينة، وبالسلطة لا بالحياة.
وهكذا تتبدّل العلاقة بين “المكان” و“العناية”: بدل أن يحتضن المكانُ العناية، نجد العناية هي التي تطارد المكان، تحاول أن تلحق به قبل أن ينهار. لكنه لا يستجيب. أو بالأحرى: يستجيب بوحشية. وكأنّه المكان الذي لا يعرف من العناية إلا ضدّها.
وهنا يتحوّل السؤال الفلسفي إلى سؤال سياسي وإنساني في آن:
هل يمكن لفلسفة المكان أن تبقى “مطلقة” من دون أن تواجه هذا الواقع العنيف؟
هل يمكن للمفهوم أن يظل مستقيمًا بينما تُعاد هندسة المكان بالبندقية؟
هل يمكن الحديث عن “سكنى الإنسان للعالم” بينما الإنسان يبحث عن جدارٍ واحد يأويه؟
إنّ أي تفكيرٍ في المكان هنا لا بدّ أن يعود إلى الجسد.
والجسد لا يكتب نظريات.
الجسد يكتب خوفه… يكتب جوعه… يكتب تلك اللحظة التي يصبح فيها العالم كله معسكر نزوح واحد أو حاجز طريق أو صرخة.
ولهذا يصبح المفهوم نفسه مطالَبًا بالهبوط من عليائه إلى مستوى الحادث اليومي.
ليس لأن المفهوم ناقص، بل لأن التجربة فائضة.
ليست الفلسفة قاصرة، بل الواقع أعمق وأكثر تشظيًا مما تمنحه المفاهيم من صفاء.
وفي هذا السياق، يصبح المكان السوداني ليس موضوعًا للتفكير فحسب، بل ناقدًا للفلسفة ذاتها.
المكان - بجرحه المفتوح - يسأل الفلاسفة:
كيف أتشكّل “من ذاتي”… وأنا أُقتلع كل يوم؟
كيف أسكن… وأنا بلا سقف؟
كيف أصبح فضاءً… وأنا بالكاد أحتفظ بالهواء؟
هنا لا تعود الفلسفة استعارةً جمالية، بل محاولةً للنجاة.
وتعود العناية، بكل ثقلها الأخلاقي والوجودي، لتطرح سؤالًا مؤلمًا:
من يعتني بمن؟
الدولة بالمكان؟ أم المكان بالبشر؟
هل يسكن الناسُ المكان؟ أم يهربون منه؟
هل العناية مفهوم؟ أم حالة مفقودة تبحث عن اسم؟
وهذا ما يجعل العودة إلى هايدغر ضرورية - لا لتمجيده، بل لمساءلته: فـ“السكنى” التي تحدّث عنها لم تكن يومًا ممكنة في مكانٍ مُصادَر، تُدار حدوده بالسلاح لا بالمعنى.
والسؤال الوجودي: “كيف نسكن العالم؟”
يغدو هنا سؤالًا آخر:
“كيف يسمح لنا العالم أن نسكنه؟”
تسقط المفاهيم حين تُختبر في السودان ليس لأنها ضعيفة، بل لأن الجرح أعمق من قدرتها على الالتئام.
ومع ذلك، يبقى شيءٌ أخير:
أن المكان - حتى في أقصى جراحه - يحتفظ بقدرته على التذكير…
التذكير بأن البشر يصنعون من هشاشتهم معنى…
ومن الخوف فرصةً ضئيلة للبقاء…
ومن العناية - حتى وهي مكسورة - ومضةً تُنقِذ الليل من العتمة الكاملة…
ليس مطلوبًا من الفلسفة أن تُشفى.
المطلوب أن تضع يدها - ولو للحظة - على هذا الجرح المفتوح، وأن تعترف بأن الفكر لا يكتمل إلا حين يلامس هشاشة الحياة.
***
إبراهيم برسي